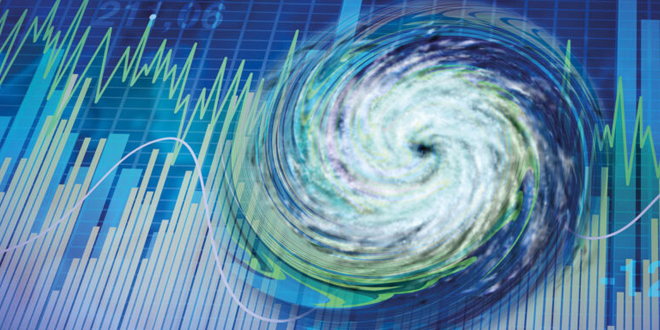الاجتهاد: المبحث الثاني : المعالجة الاقتصادية للتضخم: مهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه، مثل تمويل التنمية، فمما لا شك فيه أنه باتفاق جماهير الاقتصاديين يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً، ومن ثم تجب مواجهته والعمل الجاد على علاجه وشفاء الاقتصاديات منه. / بقلم الدكتورشوقي أحمد دنيا
ولن ندخل هنا في معمعة طرق وأساليب العلاج وتحليل مدى نجاعة كل طريق في مواجهة التضخم، فلذلك مواطنه المتخصصة المستقلة، ولكن في هذه الدراسة الموجزة قد تكفي الإشارة السريعة إلى أهم هذه الطرق والتأكيد على بعض الدلالات المستخلصة.
وبداية تجدر الإشارة إلى أن مواجهة التضخم أو بعبارة أخرى معالجة التضخم ذات بعدين، علاج للتضخم من حيث هو وعلاج له من حيث آثاره وبخاصة آثاره التوزيعية.
فالأول يحاول اجتثاث التضخم والثاني يستعيض عن ذلك بتعقيم أو تحجيم آثاره مع الإبقاء عليه.
وتدور المعالجة الاقتصادية للتضخم من حيث هو: حول التعامل مع أسبابه، الوقاية منها قبل وقوعها ومعالجتها بعد وقوعها.
والمعروف أن مصادر التضخم – أسبابه – ترجع بوجه عام إلى كل من الطلب والعرض، حيث إن التضخم في جوهره ما هو إلا اختلال جوهري في العلاقة بينهما، إذ يكون الطلب من القوة والزيادة بما لا يواكبه العرض.
وقد رأينا أن من منشأ هذا الاختلال قد يكون تزايداً في الطلب، وقد يكون تناقصاً في العرض، وقد يكون كلا الأمرين، ومعنى ذلك أن أي علاج يراد له أن يكون فعالاً عليه أن يتعامل باقتدار مع تلك المصادر.
ولعل من جوانب الصعوبة هنا أنه في حالات ليست بالقليلة، لا نستطيع التشخيص الدقيق لمصدر التضخم، وهل هو جذب الطلب أو دفع التكلفة أو كلاهما أو أي شيء آخر ؟
ويترتب على ذلك وجود احتمال قوي في عدم نجاعة وفعالية السياسة المتخذة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ربما يترتب على تلك السياسة، إذا لم تكن متوائمة مع المصدر، المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد القومي.
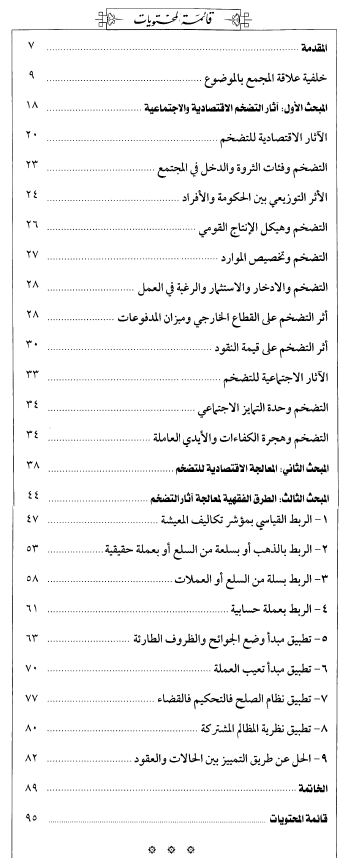
ودلالة ذلك قد تكون في ضرورة أن يكون العلاج حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات تقوم على عدة عناصر، من أهمها ما يلي:
۱ – الإصلاح النقدي: وذلك بحسن التعامل مع عرض النقود، بحيث تتواءم بقدر الإمكان مع حاجة الاقتصاد القومي، وكلما كانت هناك كوابح قوية تحول دون الحكومة والجهاز المصرفي والمزيد من النقود كلما كان الموقف أفضل حيال النضخم، ومعنى ذلك ضرورة تواجد سياسة نقدية رشيدة(1).
2- الإصلاح المالي: على أن يشتمل ذلك على أمرين معاً: الإنفاق العام والإيرادات العامة، وخاصة منها الضرائب والقروض. إن ترشيد الإنفاق العام يعد شرطاً ضرورياً لإمكانية مواجهة التضخم، وكذلك الحال في كل من الضرائب والقروض اللتين تعتبران من أهم مصادر الضغوط التضخمية، ومعنى ذلك حتمية توفر سياسة مالية رشيدة (٢).
3- الإصلاح المؤسسي: والمقصود به دعم وتوسيع رقعة المنافسة، والقضاء على ما يمكن القضاء عليه من أشكال الاحتكارات (۳). وخاصة منه ما يتعلق بالجانب الإداري، وبدون إدارات عامة جيدة وأجهزة إدارية وفنية قادرة فإنه من الصعوبة بمكان ترشيد الإنفاق العام والإيرادات العامة. كذلك من المهم توافر التشريعات والسياسات الصحيحة، وتوافر المساءلة الشعبية الفعالة(4).
ومن الواضح أن توفر كل تلك العناصر ليس بالأمر السهل، كما أنه من المهم أن تعمل مع بعضها في تناغم واتساق، فلا يكفي مجرد توافرها، وهذا أيضاً من الصعوبة توفيره.
ولا يخفي على مهتم ما هنالك من جماعات الضغط المختلفة ذات المصلحة والتي تقف بكل ما لديها من جبروت حيال الكثير من الإصلاحات، يضاف إلى ذلك ما أصبح معروفاً بأثر قصر النظر السياسي وما يحدثه من مزيد من التضخم.
وأخيراً فهنالك مسألة تجدر الإشارة إليها تتعلق بصعوبة مواجهة التضخم والعمل على اجتثاث جذوره، وهي ما أشار إليه بعض الاقتصاديين من وجود تكاليف اقتصادية باهظة لهذه العملية، عادة ما لا تتحملها الاقتصاديات القومية، والتي تتمثل في المزيد من البطالة ومن تدني حجم الناتج القومي.
وقد يصل الأمر إلى وقوع الاقتصاد فريسة للانكماش والركود وتوقف عمليات التنمية. وقدرت بعض الدراسات أن تخفيض التضخم بمعدل 1 % يؤدي إلى تخفيض حجم الناتج القومي الأمريكي بمقدار ۱۰٪ (5).
ويلاحظ على هذه المعالجة:
١- هي معالجة تواجه التضخم نفسه، فتمنع وجوده إن لم يكن موجوداً، وتزيله إن كان موجوداً. بعبارة أخرى هي تتعامل مع أصل القضية وجذورها، ولا تقف عند حد علاج آثارها.
٢- هذه المعالجة طويلة الأجل، وتتطلب من الدولة العمل على كل الجهات الاقتصادية وغيرها بما يحقق لقيمة النقود استقرارها الحميد. إذ هو مطلب رئيسي من مطالب الشريعة. وفي ظل الظروف الحالية للعالم الإسلامي في جملته فإن ذلك لن يحدث ما بين يوم وليلة، بل ولا خلال عدد قليل من السنين، لأنه يتطلب تعديلات جذرية في مناح عديدة وجوهرية من الحياة.
وهذا ليس بالأمر الهين الممكن تنفيذه في الأجل القصير. إنه يتطلب – على سبيل المثال وليس الحصر – تعديلات جذرية في سياسات الإنتاج والتمويل والاستثمار وأنماط الاستهلاك وسياسات التبادل والتوزيع وسياسات التصدير والاستيراد والسياسات المالية والسياسات النقدية.
بل إنه يتطلب تعديلات جذرية في الأنظمة السياسية والاجتماعية والأكثر من ذلك، وبفرض أن ذلك كله قد تحقق فإن تكلفته الاقتصادية والاجتماعية مرتفعة بدرجة قد لا تتحملها المجتمعات وبخاصة ما ينجم من ذلك على جبهة العمالة والبطالة. وعلى جبهة توقف النمو ودخول المجتمع في حالات انکماش و رکود.
ومن هنا نادى الكثير من الاقتصاديين بأهمية التعايش مع التضخم بمعنى الاكتفاء بتعقيم آثاره بقدر الإمكان أو تحجيمها والتقليل منها إلى أدنى حد ممكن دون العمل والإصرار على إزالته ومحوه من المجتمع. وفي ذلك طرحت أساليب عديدة منها الربط القياسي على خلاف بينهم في جدوى هذه الوسيلة (6).
المبحث الثالث: الطرق الفقهية لمعالجة آثار التضخم (7)
يلاحظ القارئ لما قدمه الفقهاء المعاصرون والاقتصاديون الإسلاميون من حلول لعلاج آثار مشكلة التضخم أو تغير القيمة الحقيقية للنقود أن هناك تنوعاً بل اختلافًا واسعا في المواقف والاتجاهات ينتج عنها وجود العديد من الحلول المطروحة.
وليت هذا الحشد من الحلول كان من قبيل توارد الحلول من قبل كل الفقهاء، بمعنى أنهم جميعًا أجازوا كذا وهم جميعا أجازوا كذا، لو كان الأمر على هذا النحو لكان الأمر في غاية اليسر، لكننا أمام حلول متغايرة متخالفة، فالذي قال بالحل الأول رفضه من قال بالحل الثاني، ومن قال بالحل الثاني رفضه من قال بالحل الثالث، وهكذا في معظم الحلول المطروحة وإن لم يكن في كلها.
وهذا ما يعقد المسألة، حيث يتطلب الموقف المقارنة والمفاضلة والترجيح.
وقد يكون من المفيد محاولة التعرف على منشأ هذا الخلاف الواسع في المواقف والاتجاهات. وفي اعتقادي أن وراء ذلك عوامل عديدة أهمها ما يلي:
١ – اختلافهم في فهم مواقف الفقهاء القدامى وتوجيهاتهم لها، فالبعض يرى في موقف أبي يوسف كذا ويبني على ذلك الفهم ما يراه، والبعض يفهم موقف أبي يوسف على منحى آخر، وهكذا.
٢ – اختلافهم في تكييف النقود المعاصرة وعلاقتها بكل النقود الأصلية والفلوس، فبرغم اتفاق الجميع على أنها نقد كامل النقدية فإنهم في مسألتنا هذه يختلفون اختلافًا شديدًا حول: هل هي مثل النقود الذهبية والفضية في كل شيء أم في أشياء دون أشياء؟ وهل هي مثل الفلوس في كل شيء أم في أشياء وأشياء؟ وهل تلحق بهذه في حال وبتلك في حال أخرى؟
تنوعت المواقف، ولو نظر الفقهاء المعاصرون جيدا في النظام النقدي القائم حاليا وفي النظام النقدي الذي كان ساريًا في الماضي؛ لعلموا أن هناك فروقا جوهرية بين النظامين، ولسهل عليهم التعرف على حقيقة النقود المعاصرة وعلاقتها بالنقود القديمة.
3- اختلافهم حيال قضية المثلي والقيمي التي شاعت في الفقه الإسلامي، من حيث ماهية وحقيقة كل منهما، ومن حيث تفريع الأحكام الشرعية على التمييز القائم بينهما. وبالتالي من حيث إدخال النقود المعاصرة تحت دائرة كل منهما.
4- اختلاف أفهامهم للأساليب والأدوات الإحصائية والاقتصادية، ولما تحدثه من آثار عند استخدامها.
ومع هذا الخلاف الواسع تجدر الإشارة إلى ما هنالك من نقاط اتفاق عديدة تجمع كل الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين على تنوع مواقفهم واتجاهاتهم، ومن ذلك أن الجميع لا يلتفت إلى التغير اليسير في قيمة العملة، وإن اختلفوا بعد ذلك في تحديد هذا اليسير،
كذلك فإن الجميع لا يلتفت إلى التضخم المتوقع أو التغير المتوقع في قيمة العملة عند التعاقد، طالما لاحظه المتعاقدان ولم يلتفتا إليه، عند ذلك لا كلام لأحد المتعاقدين عند الوفاء، حيث كان له أن يتحوط عند التعاقد لكنه أعرض عن ذلك، مثله مثل من رأى عيباً في المعقود عليه لكنه أعرض عنه وأجرى التعاقد، ولا يعني ذلك أن حديث الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين انصرف إلى التضخم غير المتوقع فحسب، إن الحديث والحلول المطروحة تتناول كلا الأمرين؛ المتوقع وغير المتوقع، طالما كنا في حال المتوقع في مرحلة التعاقد، فهل من حقهما أن يتحوطا له ويتعاملا معه بفرض حدوثه لاحقا أم لا؟
وإليك أهم ما طرحه الفقهاء من طرق للمعالجة:
١- الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة:
اختير هذا المؤشر على أن يكون ممثلاً للربط القياسي، على أساس أنه في رأي العديد من الاقتصاديين يعتبر أفضل من غيره (8).
۱ – معنى هذا الحل: أن يتفق طرفا التعامل على الاحتكام للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وما يحدث فيه من تغيرات، بحيث يكون هو الحكم عند أداء الحقوق أو الالتزامات في زمنها المحدد في المستقبل.
فمثلاً هنالك بيع مؤجل الثمن أو قرض ونخشى أن يحدث تضخم ونريد أن نؤمن أنفسنا منه ومن مخاطره، فيتم العقد على أساس الاحتكام لهذا الرقم عند السداد.
فلنفرض أن هذا الرقم عند السداد كان ٢٠٠ بالنظر لما كان عليه عند بدء التعاقد، فمعنى ذلك أن معدل ارتفاع الأسعار هو ١٠٠٪ ومعنى ذلك أن معدل انخفاض أو تدهور القيمة الحقيقية للنقود – طالما ارتضينا هذا المؤشر مقياساً لقيمة النقود – هو . ٥٠% ومعنى الربط هنا أن يسدد المدين ضعف مبلغ الدين، لأن هذا الضعف يعطي نفس القيمة الحقيقية لمبلغ الدين الأصلي.
٢ – الرأي حول هذا الحل: هذا الحل يقره عدد من الاقتصاديين الإسلاميين وعدد من الفقهاء. ويرفضه عدد آخر من هؤلاء وهؤلاء. وكلٌ من القبول والرفض مبني على اعتبارات اقتصادية واعتبارات شرعية قوية.
أ) أهم الاعتبارات التي يستند عليها من يقول بقبول هذا الحل:
* هناك – من جراء التضخم – ضرر وقع على صاحب الحق أو الدين، ورفع الضرر مطلوب، والربط القياسي يزيل هذا الضرر.
* عند حدوث التضخم، ومن ثم تدهور قيمة الدين أو الحق (النقدي) فإنه يزال مبدأ الرضى، حيث أن المتعاقد قد رضى في ضوء قيمة مالية معينة، فإذا هبطت هذه القيمة فإن مبدأ الرضى يتزعزع، وهو مبدأ أساسي في الشريعة.
* ثم إن التضخم يخل بالتكافؤ وتعادل القيم أو تقاربها في عمليات التبادل، وهي أمور أكدت عليها الشريعة وكذلك العقول السليمة. والربط يباعد بين هذه العمليات وبين اختلال التعادل.
* إن ربط الديون والالتزامات الآجلة يحقق التماثل المطلوب شرعاً، حيث أن المالية أو القيمة الحقيقية هي المعول عليه، وعدم الربط في ظل التضخم الكبير يخل بها، والنظر إلى القيمة الحقيقية أولى من النظر إلى القيمة الاسمية لعدد من وحدات النقود؛ إذ الأولى تمثل الجوهر والمضمون والثانية تمثل الشكل والصورة. ففي ظل التضخم الجامح تصبح وحدات النقود من عملة ما مثليات صورية محضة.
*ولهذا الموقف شواهد في الفقه الإسلامي، فقد ذهب عدد من الفقهاء إلى النظر للقيمة عند التعاقد عندما يعتري الفلوس وقيل أيضاً النقود تغير فاحش في قيمتها عند السداد. لكن هذه المبررات لم تسلم من الرد عليها من جهة، ومن إيراد مبررات ترفض قبول الربط من جهة أخرى.
ب) اعتبارات تدعو إلى رفض هذا الحل:
*القول بأن بعض الفقهاء القدامى كانت مواقفهم على النحو الذي يؤيد الربط حالياً مردود بأن جمهور الفقهاء على خلاف ذلك من جهة، وأن ذلك ما قيل في ذلك من قبل بعض الفقهاء قيل في مناسبات مختلفة، ومن ثم فلا يقاس أو يلحق هذا بذاك من جهة ثانية.
*إن الربط يؤدي لا محالة إلى الربا، حيث عدم التماثل في المقدار بين ما ثبت في الذمة وما يسدد، وهي عملية مشروطة في العقد. وقد أهدر الشرع اعتبار القيمة أو المالية عند تبادل مالين ربويين من نفس الجنس. ثم إن ذلك يعارض نص الحديث الشريف عن ابن عمر حيث أباح له الرسول صلى الله عليه وسلم تبديل الدَّين من مال معين بمال آخر، شريطة أن يتم ذلك بسعر الصرف عند السداد، ومعنى ذلك أن عدم الالتفات إلى القيمة عند التعاقد.
* في الربط غرر فاحش وجهالة كبيرة، فلا يعرف أي من الطرفين مقدار ما له وما عليه، لأن ذلك موكول إلى ما سيسفر عنه المستقبل. وشرط صحة المعقود عليه فيها نحن بصدده معلوميته لكل من طرفي العقد.
* إن الضرر الواقع على أحد الطرفين لم يكن سببه الطرف الثاني، وإن إزالة ضرر الطرف المتضرر أصلاً يلحق الضرر بالطرف الثاني. والمعروف أن الضرر لا يزال بالضرر.
* ثم أن القول بذلك يستلزم اطراده عندما تكون الديون والحقوق أموالاً مثلية عينية وليست نقدية، ولم يقل أحد من العلماء بذلك. وهل لو ارتفعت قيمة المُسَلَم فيه يكون من حق من هي عليه أن يقلل منه أو يطالب بزيادة رأسمال المُسَلَم (الثمن)؟ يضاف إلى ذلك أن الربط القياسي هو باعتراف عدد غفير من الاقتصاديين أسلوب ضرره أكثر من نفعه.
وكما أن الفريق الثاني أورد العديد من الاعتراضات على مستندات الفريق الأول فإن الفريق الأول قام بدوره بدفع هذه الاعتراضات وإيراد اعتراضات على مستندات الفريق الثاني. وهذا مدون في الأبحاث والدراسات والمناقشات التي دارت حول هذا الموضوع.
3- من ذهب إلى جواز الربط القياسي اشترط فيه عدة شروط أو قدم لذلك عدة ضوابط، أهمها أن يكون التضخم غير متوقع، حيث إنه في ظل التضخم المتوقع يمكن للطرف الذي سيضار أن يحتاط، كما في المعاوضات الآجلة، مثل البيوع .. وأنه قَبِلَ ذلك ورضى به، كما في حالة القرض.
وأن يكون التضخم كبيراً، قياساً على الغبن الفاحش، أما التضخم اليسير فلا اعتداد به ومعيار الكبر والصغر إما العرف وأهل الخبرة وإما التحديد بنسبة معينة من القيمة، قيل الثلث، وقيل غير ذلك. والبعض يقدم شرطاً ثالثاً وهو أن يتم الربط لاحقاً وليس سابقاً، بمعنى أن يجري العمل به عندما يحدث التضخم فعلاً، أي أنه لا يجري شيء عند التعاقد، لكن عند السداد إذا كان قد حدث تضخم كبير فإنه عند ذلك يجري الربط ويعمل بمقتضاه.
ولا ادري كيف يكون ذلك ربطاً بالمفهوم العلمي السليم للربط. وهناك شرط آخر يقول به الكثير ممن أجاز الربط، وأن يتم السداد بعملة مغايرة للعملة التي وقع بها التعاقد دفعاً لشبهة الربا، وهي عدم التماثل الصوري أو الشكلي، المتمثل في اختلاف عدد المبلغ أو مقداره، فإذا ما كان بعملة مغايرة فإن هذا التماثل لا يطلب.
٤- ما نراه حيال هذا الحل: هذا الحل محل خلاف قوي للغاية بين الاقتصاديين وبعضهم والفقهاء، وكل يصر على موقفه مع تعدد اللقاءات، وكل قد أبرز ما في جعبته من سهام.
ولا نرى أن هناك إمكانية، بل ولا ضرورة للطلب من أي فريق أن يقدم المزيد من التوضيحات والحيثيات حيال موقفه وحيال ما يلاحظه ويراه على الموقف المقابل.
واعتقد أننا حيال ذلك أمام شبهة الحل والحرمة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة حيال مثل هذا الموقف. ومن ثم فإنني أفضل البحث في حلول أخرى تسلم من هذا الخلاف القوي(9). ولعلنا نعثر عليها فيها طرح من حلول.
٢- الربط بالذهب أو بسلعة من السلع أو بعملة حقيقية:
الحديث هنا يدور على النحو التالي:
١ – لِمَ جمعنا بين الربط بالذهب وبسلعة من السلع وبعملة حقيقية؟ لأننا نرى أنه ليس بينها من الفروق ما له تأثير في الحكم الشرعي لكل منها. بمعنى أن من يقول بجواز الربط بالذهب لا يسوغ له أن يرفض شرعاً الربط بسلعة من السلع أو بعملة حقيقية من العملات المعروفة.
حيث إن حقيقة عملية الربط في الجميع واحدة. وإن كانت هناك بعض الميزات الخاصة، مثل تمتع الذهب أو السلعة المعينة أو العملة المختارة بقدر أكبر من الاستقرار، أو سهولة الربط بالذهب مثلاً على ما عداه، أو تحريم بعض الدول الربط بهذه أو بتلك، لكن كل ذلك لا يؤثر جوهرياً في الحكم الشرعي – كما نعتقد – ومن ثم فحرصاً على عدم التكرار تخيرنا هذا المنهج.
2- معنى الربط بالذهب أو بسلعة أو بعملة. قبل أن ندخل في لب موضوعنا نحب أن نشير إلى ما هنالك من خلاف قوي بين الاقتصاديين اليوم حول تكييف الذهب، من حيث كونه سلعة عادية أم نقداً، فمن الواضح أنه على المستوى المحلي لم يعد نقداً. ولا اعرف أن هناك دولة تجبر أحد المتعاملين على قبوله في بيع أو إجارة… الخ.
لكنه على المستوى الدولي وفي التبادلات الاقتصادية بين الدول وتسوية المدفوعات بينها لا يستبعد الذهب كوسيلة من الوسائل المتبعة عادة وإذن ففي الذهب شبه بالسلع العادية وشبه بالعملات. وسواء أكان هذا أم ذاك فالموقف حيال الربط به لا يختلف من حيث الحكم الشرعي.
وعند التعاقد الآجل يتفق الطرفان على ربط قيمة الالتزام أو الحق أو الدين بمقدار معين من الذهب أو من السلعة أو من العملة في ضوء السعر الراهن لهذه الأشياء.
فيقال مثلاً لي مبلغ ألف ريال عندك، وهو اليوم يعادل عشرين جراماً من ذهب عيار ٢١ أو يعادل خمسين كيلو لحم بقري أو يعادل ۲۰۰ دولار أمريكي. وعليك عند السداد أن تسدد قيمة هذه المقادير من الذهب أو اللحم أو الدولار بالريالات.
3- ما الدافع إلى ذلك؟ عادة ما يلجأ المتعاملان إلى ذلك فراراً من التقلبات العنيفة التي تعتري العملة الوطنية. والتحصن من ذلك بالاعتماد والتعويل على شيء مستقر في قيمته، أو على الأقل أكثر استقراراً من العملة السائدة.
وإذن فالطرفان وإن أجريا العقد بوحدة نقد حقيقية إلا أنهما ربطاها بوحدة للتحاسب تكون هي الحاكمة. ومن ثم فإنه لو أجرى التعاقد من البداية بشيء من هذه الأشياء دون ذكر للعملة السائدة كأن نشتري بالذهب أو نشتري بالقمح أو اللحم أو نشتري بالدولار أو الجنيه الاسترليني، ويكون السداد بها فلسنا عند ذلك أمام ربط. ولا خلاف حول جواز ذلك شرعاً.
4- الرأي حول هذا الحل هناك خلاف بين الفقهاء على وجه الخصوص وكذلك بين الاقتصاديين إلى حد ما، حول العمل بهذا الحل. لكنه خلاف أقل حدة من الخلاف حول الحل السابق الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو الربط القياسي بوجه عام.
فبعض الاقتصاديين الذين يرفضون الربط القياسي لا يرون مانعاً شرعياً ولا اقتصادياً في الربط الراهن وكذلك بعض الفقهاء.
ومعنى ذلك أن الفريق المعارض هناك قلت قوته نسبياً هنا، والعكس صحيح حيال الفريق المؤيد.
ويلاحظ أن من يجيز الربط القياسي يجيز بالأولى الربط بالذهب أو بسلعة أو بعملة، ففي اعتقاده أنه أحكم وأبعد عن الضرر والجهالة، وليست له الآثار الاقتصادية الضارة التي للربط القياسي.
ويلاحظ أيضاً أن هناك من الفقهاء والاقتصاديين من لا يزال على موقفه الرافض للربط مطلقاً، قياسياً كان أو غير قياسي. وظهر هنا رأي ثالث يجيز الربط الراهن فقط.
فمن يرفضه يرى أنه وإن سلم من بعض المثالب التي تلحق بالربط القياسي فإنه لا يسلم من بقيتها، فما زالت في نظره الجهالة قائمة، وما زال الربا قائماً، وما زالت العدالة المنشودة غير متحققة على وجه الدقة.
ومن يجيزه ويجيز الربط القياسي؛ فمبرراته ما سبق ذكره حيال الربط القياسي. ومن يجيزه فقط يعتمد على خلوه من مثالب الربط القياسي. لكن عند التأمل لا نجده يسلم من كل المثالب وإن سلم من بعضها.
وهناك بعض النصوص الفقهية التي يركن إليها، أو على الأقل يستأنس بها من يجيز هذا الربط مثل هذا النص قال ابن رشد: سئل ابن القاسم عمن له على رجل ۱۰ دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين بدينار.
فقال أرى أن يعطيه نصف دينار، بالغاً ما بلغ من الدراهم إذا كان الدين من بيع، أما إذا كان من سلف فلا يأخذ إلا مثل ما أعطاه”، وفسر ابن رشد كلام ابن القاسم بقوله: “إن ذكر (من صرف عشرين بدينار) معناه أنه لم يسم العشرة دراهم إلا ليبين بها الجزء الذي أراد البيع به من الدينار، فله ذلك الجزء “(10).
إن هذا النص صريح في جواز الربط بسلعة أو بعملة أو ذهب، لكن ذلك يقتصر طبقاً للنص على ديون البيوع وما شابهها، ولا يصدق على ديون القروض. فهل خفي على كل من ابن القاسم وابن رشد أن في ذلك ربا وأن فيه غرراً فاحشاً وجهالة كبيرة!
٥- هل الربط بهذه الأشياء يحقق الهدف المقصود وهو استقرار قيمة الديون والحقوق النقدية؟ إن ذلك يتوقف على مدى استقرار قيم هذه الأشياء المربوط بها.
والمعروف في عصرنا هذا أن الذهب يخضع لتقلبات ليست يسيرة في الكثير من الحالات.(11) والمعروف أيضاً أن أسعار العملات تتفاوت من حيث الاستقرار والاضطراب من عملة لأخرى. والمهم أنه بفرض استقرار قيم هذه الأشياء فإن ذلك لا يعني من بعيد أو قريب استقرار قيمة العملة المربوطة، فقد يستقر ثمن الذهب في بلدة ما أو حتى يرتفع، ومع ذلك يكون المستوى العام للأسعار متزايدا، ومعنى ذلك هبوط القيمة الحقيقية للنقود.
والأكثر أهمية من ذلك هو: هل للحكم الشرعي مدخل بهذه المسألة؟ بمعنى إن حقق ذلك استقرار قيمة العملة جاز، وإلا فلا. أقول: لا مدخل لهذا في ذلك، حيث إن المتعاقدين قد ارتضيا الاحتكام بهذه الأشياء، بغض النظر عما يحدث لقيمها فعلاً في المستقبل.
ماذا لو اتفقا على السداد بنفس الشيء المربوط به من ذهب أو سلعة أو عملة؟ ذهب بعض الفقهاء الاقتصاديين إلى جواز ذلك. وغاية ما فيه أنه في بعض صوره هو صرف في الذمة، وهو جائز، والبعض يرى منعه لأنه صرف مؤجل. والمسألة في رأي تحتاج إلى تحرير فقهي، مع أن حديث ابن
عمر يجيز ذلك في بعض رواياته.
هذا الحل معارضته أقل بكثير من معارضة الربط القياسي، ومن ثم فهو يعد من الحلول الأولى برعاية المجمع الموقر. مع ملاحظة ما قد يكون هنالك من أنظمة وقوانين لبعض الدول تمنع. والأمر في حاجة إلى دراسة لمبررات رفض هذه الدولة أو تلك لمثل ذلك، ومدى الاعتداد الشرعي بهذا الرفض الحكومي.
٣- الربط بسلة من السلع أو العملات:
بداية يقع خلط لدى البعض بين الربط بسلة من السلع والربط بمؤشر تكاليف المعيشة، فينظر لهما على أنهما شيء واحد، فكلاهما ربط بمجموعة من السلع، ولو صح هذا لما كان هنا داع لإفراد كل منهما بالحديث واعتبار كل منهما حلاً قائماً بذاته.
والحق – كما نفهمه – أنهما وإن كان بينهما وجه شبه فإنهما متغايران، فالربط بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة هو ربط بمجموعة من السلع محددة من خارج الطرفين، وبلحظة أو زمن أساسي وزمن قياسي محدد خارج اختيار الطرفين.
لكن ما نحن بصدده هنا هو قيام المتعاقدين باختيار نابع منهما لعدة سلع، وبفرض رغبتهما في تكوين رقم قياسي لها فإنهما يحددان يوم الأساس يوم التعاقد ويوم القياس بيوم السداد، كما يحددان ما يرونه حيال الأوزان الترجيحية لها.
فالعملية بكل عناصرها من إنتاج الطرفين، وليست من إنتاج جهات رسمية، لا مدخل لرغبة الطرفين في تحديد أي عنصر فيها، كما هو الحال في مؤشر تكاليف المعيشة.
۱ – معنى الربط بسلة من السلع أو العملات: يمكن أن يجري بأسلوبين؛ الأول أن يقسم الدين أو الحق بين هذه السلع أو العملة المختارة بالنسب التي يرونها، مثل نصفه قمحاً أو دولاراً، وربعه زيتاً أو فرنكاً فرنسياً، وربعه ماركاً أو اسمنتاً.
فإذا كان مقدار الدين محل التعامل هو ألف ريال فيقال نصفه اليوم يساوي ۱۵۰ دولاراً مثلاً، وفي حال السلع يساوي ثلاثة أطنان من القمح ونفس الحال مع ربعه الأول وربعه الثاني. وبالتالي يكون الحق أو الدين مربوطاً بمقادير محددة من هذه العملات الثلاث أو السلع الثلاث.
وعند السداد عليه أن يرد ما يساوي هذه المقادير من السلع أو العملات. وإذن فقد آل الأمر كما لو كان ربطاً بسلعة أو عملة واحدة، وغاية ما هنالك أن عدد السلع والعملات مدعاة لاستقرار قيمي أكبر.
والأسلوب الثاني أن يُكوّن من تلك السلع أو العملات رقماً قياسياً للأسعار، وعند السداد يُعَوَّل على ما يحدث فيه من تغيرات، وتعدل الحقوق والالتزام في ضوء ذلك. وإذن فقد آل الأمر إلى الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، مع بعض التميزات في اختيار سلة السلع وأوزانها وأزمنة الأساس والقياس.
وعلينا أن نلاحظ أنه سواء استخدمنا الأسلوب الأول أو الأسلوب الثاني فإن العقد قد ابرم بعملة معينة، وليس بسلة من السلع أو العملات. وإلا فلو ابرم بذلك لما كان هناك ربط، ولخرجت المسألة عن موضوعنا.
٢ – الرأي حول هذا الحل: من تتبع ما قدم من آراء فإنه يمكن القول إن هنالك من الفقهاء بل وبعض الاقتصاديين من يرفض هذا الحل، من حيث أنه يرفض فكرة الربط مطلقاً، بغض النظر عن المربوط به، ومن يجيز الربط القياسي يجيز هذا الربط، بل إن بعض من لا يجيز الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة يجيز هذا الربط. وفي الجملة يمكن القول أن الرأي حول هذا الربط لا يختلف كثيراً عن الرأي حيال الربط بسلعة أو عملة أو ذهب.
3- وما قيل سلفاً حول إمكانية السداد بنفس هذه العملة أو السلعة أو الذهب بل دخول اشتراط ذلك في العقد يقال نفسه هنا.
4- الربط بعملة حسابية:
العملة الحسابية عملة لا وجود لها بشكل مادي ملموس مجسد في صورة ورقة ما محدد عليها قيمتها الاسمية، مثل أي عملة حقيقية معروفة كالريال والدولار والجنيه… الخ. وإنما هي عملة تظهر فقط في الدفاتر المحاسبية والارتباطات. ولها وجود حالياً يتمثل أساساً في وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وفي الدينار الإسلامي لدى البنك الإسلامي للتنمية وفي الدينار العربي لدى صندوق النقد العربي.
وإذن فهي عملة رمزية وكل وحدة من العملات الحسابية ترتكز على مجموعة من العملات الحقيقية السائدة بنسب معينة. فوحدة السحب الخاصة على سبيل المثال تتكون حالياً من الدولار بنسبة ٣٩٪ والمارك الألماني بنسبة 21% والين الياباني بنسبة ١٨٪ والاسترليني والفرنك الفرنسي بنسبة 11%.
والهدف الرئيسي من وراء إنشاء هذه العملات العمل بقدر الإمكان على استقرار القيمة وعدم تعرضها لهزات عنيفة تلحق الضرر بالتعاملات والالتزامات. ومرجع ذلك ارتكازها على عدة عملات ذات استقرار نسبي لا باس به، وليس على عملة واحدة. ولو اعترى إحدى هذه العملات هزات عنيفة فإن أثر ذلك على العملة الحسابية لن يكون بنفس الدرجة، لارتكازها على عملات أخرى قد تكون مستقرة أو متغيرة في اتجاه معاكس.
۱ – معنى الربط بعملة حسابية: من حيث المعنى لا يختلف تماماً عن الربط بعملة حقيقية. فالحق أو الدين مقداره كذا بالعملة المعقود عليها، وهو يساوي كذا وحدة من العملة الحسابية المختارة، وعند السداد ننظر لعدد وحدات العملة الحسابية المحدد في العقد ونرى – من خلال مكوناتها – كم تساوي حالياً بالعملة التي ثبت بها الحق أو الدين، وما تساويه هو المطلوب تسديده ويلاحظ أن نفس قيمة العملة الحسابية قد يعتريها التقلب، طبقاً لما يعتري العملات المرتكزة عليها (12).
٢ – الرأي حول هذا الحل: عند التمعن في الربط بعملة حسابية نجده من حيث المضمون هو ربط بسلة من العملات بأوزان معينة، غاية الأمر أن الوضوح في الربط بسلة عملات قد يكون أكثر وضوحاً لدى المتعاقدين. لكن ذلك لا يؤثر في الحكم الشرعي. ومن يرفض الربط مطلقاً لا يقر هذا الربط، ومن يجيز الربط القياسي يجيز هذا الربط ، بل إن بعض من يرفض الربط القياسي يجيز هذا الربط ويحبذه.
وأهم ما يرد هنا من إشكالات يدور حول: بأي عملة حقيقية يتم السداد، وهل بكل العملات الداخلة في العملة الحسابية أم بإحداها أم ببعضها ؟ أم أنه يتم بالعملة الوطنية المتعاقد بها؟ وهل يمكن اشتراط شيء من ذلك في العقد؟ أم يترك ذلك للاتفاق حين السداد؟ هذه مسائل يحسمها الفقهاء.
وعلينا أن نلاحظ أيضاً أمراً جوهرياً قد يكون له مدخل في الحكم الشرعي، وهو أن هذه العملات الحسابية لا وجود لها بشكل خارجي مجسد، بحيث يمكن أن تقبض قبضاً فعلياً مثل أي عملة حقيقية.
وهنا يجري التساؤل عن أثر ذلك شرعاً، وهل يمكن القول إن قبض العملات التي ترتكز عليها هو قبض لها؟ ومن الناحية الاقتصادية ينبغي التوضيح الجيد لأهم جوانب اقتصادیات استخدام هذه العملات الحسابية أصلاً، حتى بغض النظر عن مسألة الربط بها، من حيث نظام استخدامها ومشكلاته وأهميته… الخ.
٥- تطبيق مبدأ وضع الجوائح والظروف الطارئة
تحت ضغط الحاجة إلى إيجاد حل يعالج الآثار السلبية على أحد أطراف التعاقدات الآجلة الناشئة عن التضخم وتغير قيمة العملات بما يحقق العدالة ويزيل الضرر، ونظراً لوجود مثالب عديدة، شرعية واقتصادية لطرق العلاج القائمة على فكرة الربط، فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى حل هذه المشكلة من خلال تطبيق مبدأ وضع الجوائح، وما يعرف حديثاً بنظرية الظروف الطارئة، وما أسماه الفقيه المالكي الشهير ابن رشد الحفيد بأحكام الطوارئ.
والفكرة في ذلك اعتبار النقص الذي طرأ على القيمة الحقيقية للعملة من قبيل الجوائح أو الظروف الطارئة، وقد قال جمهور الفقهاء بوضعها عن المشتري والمستأجر وما يلحق بهما.
ويجري العمل بهذا الحل على أساس قيام التعاقد بشكل عادي تماماً، وعند الوفاء ينظر، هل هناك هبوط في قيمة العملة؟ وهل بلغ هذا الهبوط مقدار الثلث عند من يقول بوضع الجائحة إذا بلغت الثلث أو بلغت حداً غير مألوف ومعتاد عند من يقول بذلك في وضع الجوائح ؟ فإن كان، فإن مقدار الحق يزاد بمقدار ما طرأ من نقص على القيمة،
فمثلاً لو قلنا بالثلث، وبلغ النقص في القيمة ثلثها وكان الحق ٦٠٠ جنيهاً فمعنى ذلك أن يأخذ صاحب الحق ٦٠٠ + ۲۰۰ = ۸۰۰ جنيهاً، وذلك جبراً عما لحق قيمة حقه من نقصان، وبذلك نكون قد وضعنا عنه الجائحة، ورغم كثرة من قال بهذا الحل من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين الإسلاميين(13) فإنه بدوره لم يسلم تماماً من الاعتراض من بعض الفقهاء.
ومبنى الاعتراض، أساساً ما هنالك حسب رأيه من فروق جوهرية بين التضخم أو تغير قيمة العملة وبين الجائحة، فالجائحة وردت فقط في الثمار، كما أنها وردت في نقص المقدار وليس نقص القيمة، ولم يقل أحد من العلماء بوضع الجائحة إذا ما أصاب الثمر رخص حتى ولو كان فاحشاً، كما أنها ترجع إلى فعل سماوي وليس إلى فعل بشري.
ثم إن العمل به يتوقف على الربط، حتى نتعرف على مقدار التغير الذي حدث في قيمة النقود، والحل عن طريق الربط مرفوض؛ لما فيه من محاذير شرعية، وأخيراً فإن القائلين بذلك يتحفظون على كون الحكمة من وضع الجائحة هي إزالة الظلم ورفع الضرر، فيقولون: أي ظلم ارتكبه البائع في حق المشتري الذي أصابت السماء ثمره؟ ويقولون: أي ضرر لحق بالمشتري من نقص كمية الثمر؟ والمعروف طبقا للقوانين الاقتصادية أن الأسعار ترتفع عند نقص الكمية المعروضة، وبالتالي فلن يضار المشتري بل ربما يستفيد.
وبالبحث والتقصي فيما قدمه الفقهاء في هذا الموضوع تبين لنا أن الكثير منهم لم يقف بالجائحة عند الثمار، بل عداها إلى كل مال أصيب بأذى بالغ، كما لم يقف بها عند الفعل السماوي، بل أدخل أيضاً الفعل البشري، وكذلك لم يقف بها عند إصابة المقدار أو الكمية بل عداها إلى إصابة القيمة، ولم يقف بها عند البيوع بل عداها إلى الإجارات، وهذه بعض نصوص الفقهاء الصريحة في ذلك، يقول القرافي:
“في الجواهر : قال ابن القاسم: هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به، فلا يكون السارق جائحة على هذا، وجعله في ” الكتاب ” جائحة. وقال مطرف وعبد الملك: هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي، فلا يكون الجيش جائحة، وفي “الكتاب” جائحة .
وفي “الكتاب” الجائحة الموضوعة كالجراد والنار والريح والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم… واختلف إذا أسقطها الريح ولم تتلف، قال ابن شعبان جائحة، وقال عبد الملك ليس بجائحة لبقاء عين الثمرة، وقيل يخير كالعيب، واختلف في الماء يباع يسقى به مدة معينة فينقص عن ذلك، قيل يخصم من البائع قليله وكثيره لأن السقي مشترى، وقيل إن كان أقل من الثلث لم يحط عنه شيء… قال ابن يونس لو مات دود الحرير كله أو أكثره والورق لا يراد إلا له الأشبه أنه جائحة، كمن اکتری فندقاً فخلا البلد، لتعذر قبض المنفعة، قال وكذلك عندي لو أنجلى أهل الثمرة عنها ولم يجد المشتري من يبيعه” (14).
وانظر هذا النص في ” ابن شاس(15)، وأنظره مع شرحه المفصل لدى الباجي (16). وقد نقل ذلك خليل في متنه، ونقل ما هو أوضح حيث يقول: “وتعيبها كذلك”، ويشرح الدردير هذه العبارة بقوله: « أي كذهاب عينها فيوضع عن المشتري إن نقص ثلث قيمتها فأكثر، ولا ينظر إلى المكيلة، فالتشبيه في مطلب الوضع لا يفيد المكيلة، فإن أصابها غبار أو عفن من غير ذهاب عينها، فإن نقصت ثلث القيمة اعتبرت وإلا فلا».
وشرح الدسوقي عبارة الدردير قائلاً: ” يعني أن الثمرة إذا لم تهلك بل تعييت بغبار وشبهه، فإن ذلك جائحة تحط بالشرط السابق … لكن يعتبر هنا نقص ثلث القيمة لا نقص ثلث المكيلة، كما في ذهاب العين. قال في التوضيح فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط كغبار يصيبها أو ريح يسقطها قبل أن يتناهى طيبها فنقص ثمنها، ففي البيان المشهور أن ذلك جائحة، ينظر لما نقص هل ثلث القيمة أم لا؟ وقال ابن شعبان ليس ذلك بجائحة وإنما هو عيب، والمبتاع بالخيار بين أن يمسك أو يرد”(17).
وقد فصل القول في ذلك تفصيلاً شافياً ابن تيمية رحمه الله قائلاً: «مسألة في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤاجرات مما تمس الحاجة إليه، وذلك داخل في قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه (18).
أما عن الضرر والظلم فقد ورد في ذلك نص نبوي صحيح، ففي مسلم ” لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق”.
هذا الحديث الشريف ينص على أن عدم وضع الجائحة هو أخذ لمال الغير بغير حق، ألا يعد ذلك ظلماً؟ حقا إن البائع لم يظلم المشتري في إنزال الجائحة، لكنه ظلمه في عدم وضعها إذا نزلت. وفي ذلك يقول ابن تيمية كلاماً نفيساً: « فقد بين رسول الله “صلى الله عليه وسلم” في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمراً أصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا، ثم بين سبب ذلك وعلته فقال:
بم تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا دلالة على ما ذكره الله تعالى في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ مال بغير حق، بل بالباطل، وقد حرم الله أكل المال الباطل لأنه من الظلم”
ويواصل شرحه لهذا الموقف قائلاً: وذلك أن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه، فكل منهما آخذ معط، طالب مطلوب، فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه لم يجب على المؤجر – أعتقد أنه المستأجر – أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن (19).
إذن مجرد عدم إسقاط ما لحق به من أذى يُعد ضرراً ولا يلتفت بعد ذلك للموقف الاقتصادي، وما إذا كان سيستفيد المشتري من الجائحة أم لا، وبفرض استفادته فإن وضع الجائحة عنه يفيده أكثر، وهو حقه قد حرم منه، ففيه ضرر وظلم.
فهل يمكن في ضوء ذلك إدخال التضخم في نطاق الجائحة أو إلحاقه بها، أو في نطاق الظروف الطارئة، أو بالتعبير الفقهي أحكام الطوارئ ؟ قال بذلك كثير من العلماء، بجامع الضرر وعدم استيفاء أحد الطرفين كامل حقه، وكون الأذى فيها غير مقدور على دفعه، ثم إن هذا الحل لا يعتمد على أسلوب الربط الذي هو محل ملاحظات.
وفي نظري أن هذا الحل يعد من أنسب المخارج لنا مما نحن فيه حالياً، ولا بأس من تقديم ما يراه العلماء من ضوابط تجعله يحقق المقصود منه على أحسن وجه ممكن.
الهوامش
(۱) د. محمود عبد الفضيل: مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي، مرجع سابق، ص ١٩٥. د. مصطفى رشدي: الاقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص ٥٦٨. کروین: مرجع سابق،ص ١٨٥ وما بعدها. درمزي زكي: مشكلة التضخم في مصر، مرجع سابق، ص ٦١٨ وما بعدها.
(۲) ابدجمان: مرجع سابق، ص ٤٢٥ وما بعدها، كروين: مرجع سابق، ص ۱۹۲ وما بعدها.
(۳) جيمس جواريني: مرجع سابق، ص ٤٠٤ وما بعدها، ابدجمان، مرجع سابق، ص ۳۷۹ وما بعدها.
(4) باري سيجل: مرجع سابق، ص ٥٦٥ وما بعدها.
(5) ابدجمان، مرجع سابق، ص ٤٢٦
(6) ابدجان مرجع سابق، ص ٤٣٢ كروين مرجع سابق، ص ٢٠٦، تقرير التنمية،۱۹۸۹
(7) هذا المبحث بكل ما فيه من اطروحات قائم بشكل أساسي إن لم يكن كلياً على الأبحاث القيمة التي سبق أن قدمت في الحلقة الثالثة التي عقدت بالبحرين عام ۱۹۹۹م ممثلة الحلقة الأخيرة في أعمال الندوة التي قرر المجمع إقامتها.
(8) مع أنه في الحقيقة لا يعد قياساً للمستوى العام للأسعار، لأنه بالتعريف لا يعكس أسعار مختلف السلع والخدمات في المجتمع، والتي تعبر عن المستوى العام للأسعار ومن ثم عن قيمة النقود (مايكل ابدجمان الاقتصاد الكلي، ص ٦٢).
(9) من المهم هنا الإشارة إلى أنه في بداية دراستي لهذا الموضوع في بحث بعنوان: «تقلبات القوة الشرائية للنقود في مجلة المسلم المعاصر العدد ٤١ لسنة ١٩٨٥م قد دافعت عن أسلوب الربط القياسي معتقداً آنذاك بأنه أفضل أسلوب لمواجهة آثار هذا الخلل، والآن، وبعد المزيد من البحث والدراسة عدَّلت موقفي، ولم أعد من القائلين به.
(10) البيان والتحصيل ٤٨٧/٦
(11) فلقد ذكرت الإحصاءات أن سعر الذهب تعرض في العام الميلادي ۱۹۹۷م لهبوط كبير وصل في مصر إلى ٣٠٪.
(12) والمعروف أنه حالياً يحدد صندوق النقد الدولي يومياً قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة.
(13) وقد عرض الشيخ عبد الله بن بيه موضوع التضخم والجوائح عرضاً مفصلا قيّماً، تطبيق مبدأ وضع الجوائح، بحث مقدم لحلقة التضخم الثالثة، ۱۹۹۷م، وانظر تعقيب فضيلة الشيخ الكبير محمد المختار السلامي، عليه، د. صالح المرزوقي: ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو بعملة معينة، بحث مقدم للحلقة الثالثة للتضخم، ١٩٩٧م.
(14) القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (١٩٩٤م): ٥ / ٢١٢.
(15) ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (١٩٩٥ م): 2 / 530.
(16) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي، بيروت: ٤ / ٢٣٢ .
(17) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب بالعربية بالقاهرة: .٣/ ١٨٥
(18) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ٢٦٣:٣٠.
(19) نفس المصدر، ٢٦/٣٠ .
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي