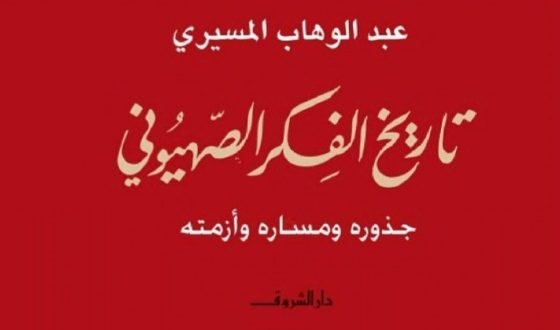الاجتهاد: في هذا الكتاب المهم يتناول الدكتور عبد الوهاب المسيري بالعرض والتحليل تاريخ الفكر الصهيونى والحركة الصهيونية وجذورها فى الحضارة الغربية. وتعد هذه الدراسة استكمالاً وتطويرا للأطروحات العامة التى تناولها المسيري فى دراساته المتعددة عن الظاهرة الصهيونية، و فى مقدمتها موسوعة تاريخ الصهيونية (1997) وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :نموذج تفسيرى جديد (1999).
يتتبع الكتاب تاريخ الفكر الصهيونية قبل هرتزل و بلفور، و المراحل التى مرت بها حتى تبلورها فى مطلع القرن العشرين. ثم يتعرض للجذور الغريبة للفكر الصهيونى، مسلطاً الضوء على علاقة الصهيونية بالاتجاهات الفكرية الغربية ، كالرومانسية و النيتشوية، و بالحركات السياسية الغربية، كالنازية و الفاشية. ثم يستعرض أهم التيارات الصهيونية و أوجه الاتفاق و الاختلاف فيما بينهما قبل أن يناقش وضع الصهيونية فى الوقت الراهن و موقفها من الجماعات اليهودية فى العالم و ملامح أزمتها التاريخية.
مقدمة الكتاب: يعاني الخطاب التحليلي العربي من نقائص كثيرة، لعل من أهمها – في تصورنا – تسرب كثير من المفاهيم والمسلمات والمقولات التحليلية الإنجيلية والعلمانية (انظر الملحق)،
التي يتعامل العالم الغربي من خلالها مع الجماعات اليهودية في العالم، مثل «المنفى» و «الشتات» و «الشعب اليهودي» و «القومية اليهودية». وقد أدى ذلك – بدوره – إلى تسرب كثير من المفاهيم والمقولات التحليلية الصهيونية، لعل من أهمها مقولة التاريخ اليهودي.
ويستند التصور الصهيوني للتاريخ، إلى عنصرين أساسيين:
۱- الحلولية اليهودية (انظر الملحق) التي تمزج بين الخالق والشعب اليهودي وتخلع على اليهود القداسة والمطلقية. وقد ترجمت هذه الحلولية نفسها إلى الرؤية الصهيونية للتاريخ. فتاريخ اليهود – حسب هذه الرؤية – هو تاريخ مقدس بالمعنى العلماني، والشعب اليهودي من ثم جماعة قومية ومقدسة.
وتنطوي هذه الرؤية للتاريخ على رفض عميق له تتبدى بشكل واضح في المصطلح الصهيوني. فعادة ما يستخدم الصهاينة كلمة «تاريخ»، لا للإشارة إلى التاريخ الحي المتعين، وإنما إلى العهد القديم، أو إلى التراث الديني اليهودي المكتوب منه أو الشفوي)، أو إلى التاريخ المقدس.
ولذا، تصبح الحدود التاريخية هي الحدود المقدسة المنصوص عليها في العهد القديم من نهر مصر إلى الفرات»، وهي حدود لم يشغلها العبرانيون في أية لحظة من تاريخهم، ولا حتى أيام داود أو سليمان والحقوق التاريخية هي أيضًا الحقوق المقدَّسة التي وردت في العهد القديم، والتي تؤكد أنهم شعب مقدس ،مختار له حقوق تستمد شرعيتها من العهد الإلهي الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم، وهو عهد يعبّر عن الحلول الإلهي فيهم. وتصبح فلسطين من ثم أرضًا (مقدسة) بلا شعب (مقدس).
٢ – التجربة التاريخية ليهود شرق أوربا كجماعة وظيفية (انظر الملحق). فقد أوهم هذا الوضع المؤرخين الصهاينة بأن لليهود تاريخهم اليهودي المستقل عن التاريخ العام الذي يحيط بهم، وأنساهم أن استقلالية اليهود نفسها هي إحدى سمات المجتمع الإقطاعي في كل من روسيا وبولندا، وأن الجيتو اليهودي المستقل هو في نهاية الأمر نتاج البناء التاريخي الأساسي الروسي أو البولندي، إذ أن الذي يحكم ظهور وسقوط الجيتو أو الأشكال الإدارية اليهودية المستقلة الأخرى ليس الإرادة اليهودية المستقلة، وإنما حركة التاريخ الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر المركبة التي يشكل أعضاء الجماعة اليهودية جزءا منها وحسب.
وقد تسللت هذه المفاهيم والرؤى والمصطلحات إلى مفاهيمنا ورؤانا ومصطلحاتنا، وكي نتخلص، ونخلّص خطابنا التحليلي، منها يصبح من المهم بمكان دراسة الشأن اليهودي والصهيوني دون أن نسقط ضحية لما يسمى «إمبريالية المقولات»، أي أن يتبنى المرء مقولات الآخر التحليلية، عادة دون وعي منه.
لقد أصبح من الواجب دراسة اليهود واليهودية والصهيونية من وجهة نظرنا، وأن نخضع تحيزاتنا ونماذجنا التحليلية في الوقت ذاته، للاختبار المستمر لنرى مقدرتها التفسيرية بالمقارنة بالنماذج التحليلية الأخرى. وهذا ما سنحاول إنجازه في هذا التاريخ الجديد للصهيونية، بإذن الله.
وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب
يحمل الباب الأول منها عنوان «مقدمة لدراسة تاريخ الفكر الصهيوني»، ويتناول الفصل الأول منه المعنون إشكالية التعريف بالصهيونية»، التعريفات المتداولة للصهيونية، التي نرفضها، ونتبع ذلك بتعريفنا الذي نذهب إلى أنه أكثر تفسيرية. أما الفصل الثاني موجز تاريخ الصهيونية» فيتناول عرضًا سريعًا موجزًا لتاريخ الصهيونية. ثم يبدأ بعد ذلك التاريخ التفصيلي للصهيونية.
ويحمل الباب الثاني عنوان «الجذور الغربية للفكر الصهيوني»، وهو يسعى إلى تتبع ملامح الخلفية الفكرية والثقافية التي أنبتت الفكر الصهيوني، فيتناول الفصل الأول مفاهيم «العلمانية الشاملة والاستعمار والدولة المطلقة» من أجل تحديد السياق الاقتصادي والحضاري الغربي للظاهرة الصهيونية. ويتناول الفصل الثاني الصهيونية الرومانسية والنيتشوية» أوجه التشابه بين هذه التيارات الفكرية.
ويعرض الفصل الثالث للعلاقة بين «الصهيونية والفاشية والنازية» مبينا التماثل البنيوي بين الصهيونية والنازية وأشكال التعاون بين الصهاينة والنازيين.
ويتناول الفصل الرابع الفكر الاسترجاعي» نماذج للأحلام والعقائد الألفية والاسترجاعية. وفي مسعى لتأكيد أن تبنى الفكرة الصهيونية ليس مقصورًا على اليهود،
ويتناول الفصل الخامس صهيونية غير اليهود ذات الديباجات الدينية والعلمانية» إسهام مفكرين وساسة من غير اليهود في تبلور الفكرة الصهيونية.
ويلقي الفصل السادس الصهيونية وحملات الفرنجة الضوء على أوجه التشابه بين المشروع الاستعماري للفرنجة، فيما عُرف باسم الحروب الصليبية»، والمشروع الصهيوني. أما الفصل السابع «الصهيونية وبعض الجماعات شبه المسيحية» فيبين الأثر الصهيوني في فكر جماعات مثل «المورمون» و «شهود يهوه».
ويحمل الباب الثالث عنوان التيارات الصهيونية المختلفة»، وهو أكبر أبواب الكتاب حجما، إذ ينقسم إلى إثني عشر فصلاً يتناول كل منها السمات الأساسية لأبرز التيارات الصهيونية. ويبدأ الفصل الأول «المؤتمرات الصهيونية» بعرض لتاريخ هذه المؤتمرات وأهم القضايا التي تناولتها منذ المؤتمر الأول عام ۱۸۹۷ وحتى المؤتمر الخامس والثلاثين عام ٢٠٠٦.
وتتناول الفصول التالية تيارات الصهيونية التوطينية»، التي سعت إلى توطين بعض اليهود في فلسطين دون الاعتماد على قوة إمبريالية والصهيونية التسللية»، التي سعى أنصارها إلى الاستيطان في فلسطين من خلال عمليات تسلل تعتمد بالأساس على الجهود الذاتية والأنشطة الخيرية و الصهيونية الإقليمية» التي كان ممثلوها يرون إمكان بناء وطن قومي لليهود» في مكان آخر غير فلسطين، ومن ثم طُرح في هذا الإطار «مشروع شرق إفريقيا.
وتستمر فصول الباب في عرض التيارات المختلفة وصولاً إلى «تيودور «هرتزل»، الذي يتمثل إسهامه الأساسي في إدراك استحالة تحقيق المشروع الصهيوني دون الاعتماد على قوة استعمارية عظمى ترعاه وترى فيه أداة يمكن توظيفها لخدمة مصالحها الاستعمارية وتلقي فصول أخرى الضوء على تيارات مثل: «الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية»، و«الصهيونية الإحلالية»، و«الصهيونية الإثنية الدينية»، و«الصهيونية الإثنية العلمانية». ويتناول الفصل الأخير في هذا الباب بعض الاختلافات بين التيارات الصهيونية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الدولة الصهيونية.
أما الباب الرابع، وهو بعنوان «الصهيونية في الوقت الحاضر» فيتناول الواقع الحالي للحركة الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد، وذلك للتعرف على طبيعة الأزمة البنيوية والوجودية التي تواجهها الصهيونية. وبالرغم من أن الفصل الرابع يحمل عنوان «أزمة الصهيونية»، فمن الضروري التنبيه إلى أن هذا الموضوع يحتاج دراسة أكثر تفصيلاً، وهو ما سنحاول تحقيقه بإذن الله في كتاب آخر بمزيد من التحليل موضوع «أزمة الصهيونية ونهاية إسرائيل».
ويختتم هذا الكتاب، كما جرت العادة في كتب أخرى، بملحق يضم تعريفًا لأهم المصطلحات المستخدمة في سياق الدراسة.
وبعد – فهذه دراسة مبدئية لتاريخ الصهيونية، نرجو أن يجد القارئ فيها خريطة أولية وجديدة بعض الشيء لتاريخ الصهيونية، وللإشكاليات التي اكتنفت محاولة وضع الفكر الصهيوني موضع التطبيق.
وأحب أن أتوجه بالشكر للدكتور محمد هشام المدرس بكلية الآداب – جامعة حلوان والدكتورة جيهان فاروق المدرس بكلية البنات – جامعة عين شمس لقراءة مخطوطة هذا الكتاب. والأستاذة رحاب محمد بدار الشروق التي قامت بإعدادها للنشر. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للأستاذ فضل عمران، الذي قام بإعداد المخطوطة على الكمبيوتر.
عبد الوهاب المسيري
دمنهور / القاهرة
رابط قراءة كتاب
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي