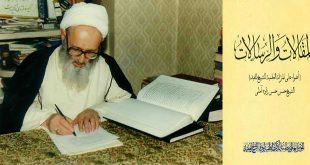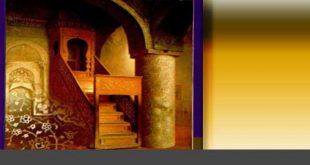الأفكار الخبيثة والمُستحدثة ما تلبث أن تظهر هنا وهناك في محاولة منها لضرب الإسلام من الداخل، وآخرها ما ذهب إليه الكاتب العراقي همام طه في صحيفة العرب اللندنية، من أنّ تحليل وتأويل النصوص الدينية لا يمكن فهمه إلا من خلال العلوم الإنسانية والفلسفية والأدبية، ولن يكتمل التكوين المعرفي والمنهجي لدارسي العلوم الدينية ما لم يدرسوا مسارات في التاريخ والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) ونظرية المعرفة وعلوم اللغة والاجتماع والنفس وتحليل الخطاب والهرمنيوطيقا (فلسفة التأويل)، والاقتصاد والقانون والسياسة أيضا.
خاص الاجتهاد: وأضاف طه أنّه لا يمكن للطلبة والباحثين أن يُموضعوا المعرفة الدينية في سياقها الإنساني الطبيعي ما لم تساعدهم المؤسسات الأكاديمية على توسيع آفاقهم العلمية والبحثية عبر برامج دراسية تحلّق بين التخصصات المتعددة وتشبّك بينها، قوامها التكامل المعرفي والثراء الثقافي والانفتاح على مدارس النقد الأدبي والاجتماعي والحضاري العالمية.
أما المدخل الأكثر علميّة وموضوعية في مقاربة النص الديني وهو المدخل الأكثر نجاعة في إنتاج معرفة دينية ذات معنى وجدوى في هذا العصر بحسب رأي الكاتب هو المنظور العلماني المتحرر من العاطفة الدينية، والعالمي المتحرر من المحليّة الثقافية!.
ويُتابع طه: “هذا لن يتحقق في ظل الصيغة الراهنة المعتمدة في دراسة الدين والشريعة حيث التركيز المكثّف على استخدام المناهج التراثية والفقهية الأصولية في دراسة التراث الديني من دون أي مقاربة نقدية لهذه المناهج، ما يفضي بالضرورة إلى تعذّر تبلور رؤى نقدية في التعامل مع التراث الذي تتم دراسته.
صحيحٌ أن هذه المناهج مؤطرة أكاديميا ومؤسسيا وتُدرّس في جامعات حديثة وبأساليب تدريس عصرية نسبيا؛ ولكن هذا التأطير الأكاديمي والعلمي لم يشمل المحتوى المعرفي والمنهجي للمواد الدراسية بل اقتصر على الشكليات والمظاهر”.
فالدين وكما يقول طه معطى اجتماعي وسلوكي، ولا يمكن فهمه إلا بمقاربته بوصفه “ظاهرة” قابلة للمراقبة والدراسة والتفكيك والشرح بمنطق علمي، والتراث الديني هو نصوص لغوية تاريخية دراستها وتحليلها يحتاجان بصورة أساسية إلى إلمام بعلوم اللغة والتاريخ، بل أبعد من ذلك، إلى التعمّق في فقه اللغة وفقه التاريخ. كما أن محتوى هذا التراث من مفاهيم وقيم ومقولات يحتاج إلى معرفة بعلوم الاجتماع والنفس والفلسفة وغيرها.
ويؤكد طه على أنّ الفقه الإسلامي نفسه يحتاج اليوم إلى فهم جديد من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة، وذلك بدلًا من فهم الإسلام من خلال علم “أصول الفقه” التراثي الذي يبحث في الأدلة الدينية للأحكام الشرعية؛ بمعنى وكما يقول طه احتياجه الإسلام لدراسة “أصول أصول الفقه”؛ أي البحث في الجذور والخلفيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للروايات والمقولات الدينية نفسها والسياقات التاريخية التي تشكّلت فيها وعلاقات القوة وتوازنات السلطة التي أحاطت بعملية ولادة ونمو المحتوى أو السرد الديني المنقول إلينا عبر المدوّنات التراثية، أي الغوص والحفر المعرفي التنقيبي والتشريحي في البنية العميقة للنص الديني (أو النص المنسوب للدين) في محاولة لاستنباط الآلية التي تم وفقها تأسيس الأفكار وانبثاق المفاهيم بحسب ادعائه.
ويؤكد طه على أنّ هذه الانتقالة المنهجية المرجوة في التعامل مع علم الفقه الإسلامي يمكن أن توصلنا لما يسميه الباحث العراقي عبدالجبار الرفاعي “فلسفة الفقه”، والتي يعرّفها بقوله “إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب”.
وبالتالي بحسب تعبير الكاتب فإن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في تجديد الفكر الديني يتطلب تجديد مؤسسات وتقنيات دراسة وتعليم الدين. كما أن إعادة بناء الإدراك الديني في المجتمع وتحديثه يستدعيان إعادة هيكلة المعرفة الدينية وإعادة تشكيل البنية المؤسسية التي تتعامل مع هذه المعرفة.
أنسنة وعلمنة المناهج الشرعية
وفي سياق متصل يقترح طه دمج كليات الشريعة بالكليات الإنسانية على مستوى المناهج والكوادر وبرامج البحث بما يخلق فضاء معرفيا شاملا وتكامليا ويضمن “أنسنة” و”علمنة” المناهج الدراسية الشرعية بحيث تتم دراسة الظاهرة الدينية في سياقها الإنساني والتاريخي والاجتماعي الطبيعي وليس في سياق كهنوتي أو لاهوتي، وهو ما سيفضي لاحقا إلى عقلنة وعصرنة الخطاب الديني وترشيد وتحديث الوعي الديني في المجتمع.
فكليات الشريعة وعموم مؤسسات التعليم الديني بوضعها الحالي وكما يقول الكاتب هي جزء من المؤسسة الدينية التقليدية التي تتعامل مع الدين باعتباره تركة مملوكة لها حصريا تتوارثها أجيال المنتمين لهذه المؤسسة من دون مراجعة أو تجديد لأساليب التلقي والتحليل والتأويل في التعامل مع النصوص الدينية والتراث الإسلامي.
وفي تفسيرٍ غريب ذهب إليه طه فإنّه وكنتيجة لما باتت تحمله كليات الشريعة من رمزية هوياتية دينية وانغلاقها عمليا على فكر أحادي وهوية واحدة؛ لم نعد نرى طالبا مسيحيا أو بهائيا أو لا دينيا يتقدّم للدراسة في هذه الكليات وذلك لأنها لا تقدّم العلم وإنما الأيديولوجيا ولا تخاطب العقول وإنما العاطفة العقائدية!.
ومعيار إصلاح هذه الكليات والمعاهد برأي طه هو الوصول بمحتوى وأساليب التدريس فيها إلى مرحلة من الموضوعية والحياد والتنوع والرصانة العلمية بحيث يُقبل عليها غير المسلمين لدراسة الإسلام من دون أن يخشوا على عقائدهم وهوياتهم من التذويب والاستلاب ومن دون أن يخشوا على عقولهم من القولبة.
ويرى طه أنّه وعلى الرغم من حديث المؤسسة الدينية المتواتر عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وإنسان إلا أن الذي يحصل عمليا أن أساليب ومضامين عملية تدريس الإسلام في كليات الشريعة تنتمي إلى زمان واحد غالبا هو القرون الأولى من التاريخ الإسلامي التي شهدت ظهور وتشكُّل الفقه الإسلامي، ومكان واحد هو المنطقة الجغرافية التي شهدت الانتشار المحدود للإسلام وقتها، ولغة واحدة هي اللغة العربية، وثقافة واحدة هي الثقافة التي أفرزتها محددات الزمان والمكان واللغة.
ويؤكد الكاتب أنّ هذه الطريقة في تدريس الدين باتت مضرّة بالدين نفسه لأنها حبسته في قوقعة العقيدة التي لا يهتم بدراستها إلا أتباعها وربما فئة قليلة منهم فقط، وحالت بينه وبين أن يتحوّل إلى معرفة إنسانية وحضارية يتعاطاها ويتداولها الناس جميعا بحيث تنمو وتتطور بالتفاعل والتكامل مع عموم المعارف الإنسانية والكونية الأخرى.
كما إن إغلاق باب الاجتهاد الفلسفي في الإسلام واعتقال الدين في قلاع عقائدية تسمى الجامعات الشرعية أو كليات الفقه أو المدارس الدينية أدى إلى جمود المعرفة الدينية وركود الفكر الديني؛ وبالتالي حال دون حصول تحوّلات تجديدية حقيقية وذات قيمة ومعنى في المعرفة والفكر الدينيين بحسب ادعائه.
ويشير طه إلى أنّ ما يتم تدريسه في الكليات والمدارس الدينية هو “موروث ثقافي” أحادي محكوم بزمانه ومكانه ووعي البشر الذين أنتجوه وتجربتهم وثقافتهم؛ ولكن المؤسسة الدينية تصرّ على اعتباره حقلا معرفيا وأكاديميا تسميه “العلوم الشرعية” وتفرضه قسرا على الدين والعلم معا، وحتى مع ما يتم ترويجه من أن بعض كليات الشريعة تقدّم لطلبتها محتوى أكاديميا أو نموذجا في فهم الدين يحتفي بالتعددية الفكرية وتنوع الآراء الفقهية في المسألة الدينية الواحدة؛ فإن هذا الاحتفاء يحصل في إطار المنظومة التراثية الأحادية نفسها ولا يسمح برأي ينقد المنظومة ككل أو يحاول تفكيكها.
ويتسائل طه عن سبب تفاخر المسلمين بانتشار الإسلام في الغرب في حين يطلقون على دراسة الإسلام بمقاربات فكرية وفلسفية غربية أوصافا مثل “التغريب” و”الغزو الثقافي”، فإذا كان الإسلام كونيا عالميا وللجميع كما نقول؛ فلماذا نحتكره ونحصره في منظور ثقافي ماضوي محلي واحد وأحادي نريد فرضه على البشرية؟ أليست عالمية الإسلام حجّة معقولة تسوّغ دراسته بمختلف اللغات والمناهج البحثية والمداخل المعرفية؟.
إن أزمة التعليم الديني اليوم وكما يذهب طه هي جزء من أزمة التعليم بصورة عامة في العالم العربي، والإصلاح بات ضرورة ملحة للمنظومة بالكامل، وليس صحيحا أن يتم احتكار عملية تطوير المناهج الدراسية الشرعية من نخب من داخل المؤسسة الدينية نفسها؛ لأن فلسفة التجديد الديني ذاتها، وبضمنها فلسفة تجديد وتطوير المناهج، باتت تحتاج إلى مراجعة وتجديد فهي ليست عملية إدارية بيروقراطية يمكن إنجازها في وقت محدد ثم ينصلح الحال وينتهي كل شيء؛ بل يُفترض بها أن تكون جزءا من عملية فكرية جدلية مفتوحة ومنفتحة وتعددية يشارك فيها بفاعلية وكثافة متخصصون في الفلسفة والاجتماع والأدب واللسانيات والتاريخ والفن والتربية والقانون وسائر العلوم الإنسانية.
ولا يقتصر ضرر احتكار دراسة الدين من قبل الكليات والمدارس الدينية على المعرفة الدينية والدين فحسب كما يقول طه؛ بل يمتد إلى المعرفة والثقافة الإنسانيتين عموما لأن هذه العزلة المفروضة على دراسة الدين أعاقت فهم الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية للظاهرة الدينية،
فكما أن الدراسات الدينية المقولبة والمعزولة في كليات الشريعة عرقلت فهم العقل الديني للعالم من حوله وحبسته في زنزانة الرؤية التراثية الأحادية؛ فإن احتكار هذه الكليات للحق في دراسة وفهم الدين حرم باحثي التخصصات الإنسانية الأخرى من حق وفرصة مقاربته ودراسته، ما أدى إلى الحيلولة دون تطوّر فهم علماني عقلاني وموضوعي للدين والظواهر الفكرية والسلوكية المتصلة به، نتيجة نمو ما يشبه الخصومة أو القطيعة المعرفية بين دراسات الدين ودراسات الدنيا.
ويؤكد الكاتب أنّه لا يمكن اختزال الحل في إصلاح مناهج كليات العلوم الشرعية بشكل ترقيعي، ولا في إلغاء هذه الكليات؛ ولكن ينبغي اتخاذ خطوة مؤسسية تطويرية جريئة بإلغاء برامج بكالوريوس الشريعة فيها وتحويلها إلى كليات للدراسات العليا ذات الطبيعة التكاملية المعمّقة، بحيث يلتحق بها الطالب بعد حصوله على البكالوريوس في تخصص إنساني كالفلسفة أو علم الاجتماع أو التاريخ أو اللغة أو الحقوق أو السياسة لينال منها شهادة الدبلوم العالي أو الماجستير في الدراسات الدينية، ولكن من مدخل علمي إنساني وبمنهجية بحثية مغايرة للمدخل والمنهج التراثي التقليدي.
وهذا الأمر يعني وكما يقول طه دراسة الدين من خلال حقل إنساني كعلم الاجتماع أو علم النفس أو النقد الأدبي أو التاريخي، أو من مداخل متعددة تشمل أكثر من حقل معرفي، لبلورة رؤية علمية مشتركة حول الظاهرة الدينية وفق ما يُعرف في الدراسة الجامعية بمفهوم “الدراسات البينية”.
ويختم طه بأنّ توسيع وتعميق منظور دراسة الظواهر الدينية من أجل أن يشمل توصيف وتوضيح التحولات والإشكاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بها، من خلال دراسات تتيح تلاقح وتفاعل المفاهيم والمعارف بين حقول العلوم الإنسانية المختلفة من جهة وحقل الدراسات الدينية من جهة ثانية، وتسمح بالاحتكاك والمعايشة بين الأساتذة والباحثين من مختلف التخصصات في فهم القضايا الدينية.
ويحصل هذا الأمر بحسب ما يذهب طه من خلاله تثاقف وتعشيق بين المدارس الفكرية التراثية والحديثة بما يؤدي إلى تمازجها وتكاملها في إطار معرفي ومفاهيمي إبداعي وتجديدي يؤسس لمسارات وفضاءات اجتهادية وتنويرية، ويمهّد الطريق للوصول إلى مقاربات فلسفية مبتكرة ومعمّقة في دراسة الظاهرة الدينية المعاصرة وتحليل التراث الديني وتأويل النصوص الدينية ومراجعة عناصر ومكونات المدوّنة الإسلامية من موروثات ومقولات. مثل هذه الدراسات باتت ضرورة معرفية تفرضها التحديات والتحولات والأزمات التي تواجه الدين وحضوره في المجتمع.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي