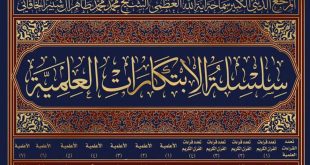الاجتهاد: يمكن الحديث عن مجموعة من المدارس الفقهية والأصولية بالغرب الإسلامي التي اهتمّت اهتمامًا كبيرًا بالفقه من جهة، وأصول الفقه من جهة أخرى. ومن بين هذه المدارس مدرسة طرابلس بليبيا، ومدرسة القيروان بتونس، ومدرسة تلمسان بالجزائر، ومدارس إشبيلية وغرناطة وقرطبة بالأندلس، ومدارس سبتة وفاس ومراكش بالمغرب الأقصى.
وقد قامت هذه المدارس الكبرى بدور مهمّ في تنشيط الحركة العلمية والثقافية بالغرب الإسلامي، ومدّ خيط التواصل بين المشرق العربي والغرب الإسلامي، والمساهمة في إغناء العلوم النقلية والعقلية والاعتقادية والفلسفية والكلامية والأصولية من أجل أن يتبوَّأ الغرب الإسلامي مكانته اللائقة به بين البيئات والمواطن العلمية والثقافية والدينية الأخرى.
إذاً، ما أهم المدارس الأصولية في الغرب الإسلامي؟ وما مميّزات هذه المدارس في مجال أصول الفقه؟ وما رجال هذه المدارس ومؤلّفاتها في هذا المجال بالذات؟ هذا ما سوف نتوقّف عنده في المطالعة.
المطلب الأول: كيف انتقل أصول الفقه إلى الغرب الإسلامي؟
لقد ارتحل كثير من علماء الغرب الإسلامي إلى المشرق العربي، وبالخصوص حيال الحجاز، من أجل الحجّ من جهة أولى، وطلب العلم من جهة ثانية. وقد تعرّفوا إلى مجموعة من المذاهب الفقهية، وانفتحوا على علوم نقلية وعقلية شتّى، وكانت لديهم دراية كبيرة بالنِّحَل والأهواء والفرق الكلامية والفلسفية. بيد أنهم فضَّلوا المذهب المالكي الذي ينسجم مع بيئتهم الجغرافية والعقلية.
ومن هنا، فلقد تلقّى الوافدون المغاربيون العلم عن الإمام مالك مباشرة، ولما توفي (رضي الله عنه) اتّجهت الهجرة نحو تلاميذه كابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وابن عبد الحكم…[1]
ومن ثم، لم يقتصر هذا العلم الذي نقلوه عن علماء المالكية بالمشرق العربي على علم معيّن أو محدّد كالدين، والفقه، والحديث، والتفسير، والقراءات فحسب، بل استفادوا من العلوم العقلية كالمنطق، وأصول الدين، وأصول الفقه…، ولقد أدخل العلماء المغتربون والمرتحلون كتب أصول الفقه إلى مواطنهم بالغرب الإسلامي كـ(الرسالة) للإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي كتب أول مصنّف في علم أصول الفقه، وقد أصبح كتابه بذلك مرجعًا أو منطلقًا للدراسات الأصولية في جميع الأصقاع والبقاع الإسلامية.
كما تعرّفوا إلى المذهب المالكي قبل انتهاء القرن الثالث الهجري في عهد الأدارسة. ومن هنا، يعدّ كتاب (الموطأ) للإمام مالك أول كتاب في الرواية والحديث دخل الغرب الإسلامي[2]، ويتضمّن هذا الكتاب مجموعة من الأصول التي اعتمدها المالكية من كتاب، وسنة، وإجماع، وقياس، وعمل أهل المدينة.
ولقد انبرى العلماء المغاربيون إلى تدريس بعض كتب أصول الفقه في مختلف المدارس المنتشرة بالغرب الإسلامي كإقراء رسالة الشافعي، وتدريس كتابي: (المستصفى من علم الأصول) و(إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي، وتدريس كتابي: ( البرهان في أصول الفقه) و(مختصر التقريب والإرشاد) لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين (ت: 478هـ)، وكتاب (مختصر المستصفى) لابن رشد الحفيد، وتدريس كتب القاضي الباقلاني في أصول الفقه وأصول الدين، وإقراء كتب محمد بن الحسين بن فورك، وتدريس كتب الآمدي…
وإذا لم يكن أصول الفقه بالغرب الإسلامي في بداياته الأولى، واضح المعالم والمبادئ والمرتكزات، فإنه قد انتعش بالغرب الإسلامي بعد ذلك، واستوى على قدميه نظرية وتطبيقًا، بعد أن توافد مجموعة من علماء الغرب الإسلامي على المشرق العربي للاستفادة والاستزادة من علم الباقلاني، والأبهري، وأبي تمام، والشيرازي…[3]
ويبدو ذلك التأثير واضحًا عند بعض التلاميذ من علماء الغرب الإسلامي، كما يتجلّى ذلك عند ابن السهرزوي، والشارقي، وأبي عمران الفاسي الذي «درس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني»[4].
دون أن ننسى المحدّث الفقيه أبا محمد عبد الله الأصيلي (ت372هـ)، من أصيلا المغرب، فقد عرف بكتاب في أصول الفقه بعنوان: (الآثار والدلائل في خلاف مالك وأبي حذيفة والشافعي)، ولقد ارتحل إلى بغداد ليحتكَّ بعلمائها البارزين ومناهجها الأصولية العقلية، ويسمع عن أبي بكر الشافعي وأبي بكر الأبهري.
وقد قال عنه عبد الله كنون: «وحجّ فلقي بمكة سنة 53هـ أبا زيد المروزي، وسمع منه البخاري، وأبا بكر الآجري، وبالمدينة قاضيها أبا مروان المالكي. وحدَّث عن الدارقطني، واضطرب في المشرق نحو ثلاثة عشر عاما، وسمع ببغداد عرضته الثانية في البخاري من أبي زيد، وسمعه أيضًا من أبي حامد الجرجاني وهما شيخاه في البخاري وعليهما يعتمد، ثم انصرف إلى الأندلس فقرأ عليه الناس كتاب البخاري، وانتهت إليه الرئاسة بها، فولي قضاء سرقسطة، وقام بالشورى مدّة في قرطبة وغيرها. وكان من حفّاظ مذهب مالك، ومن أعلم الناس بالحديث وأبصرهم بعلله ورجاله»[5].
وبعد عودة هؤلاء العلماء والمرتحلين والمغتربين من المشرق العربي إلى مواطنهم بالغرب الإسلامي، انبروا جادّين من أجل تأسيس مدارس دينية وعلمية وتربوية في علم أصول الفقه عن وعي أو غير وعي. ومن ثَمَّ فقد كان هذا العلم عند المغاربيين يتأرجح بين التقليد تارة، و الاجتهاد تارة أخرى.
وهكذا، نجد مجموعة من التآليف في علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري ككتاب (في أصول الفقه) لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي (ت: 402هـ)، وكتاب (الوصول إلى معرفة الأصول) لأبي عمر أحمد الطلمنكي القرطبي (ت: 429هـ)، وكتاب (في الأصول) لأبي الفضل بن عمرو بن محمد بن عبيد الله بن أحمد البزار (ت: 452هـ)، ومؤلّفات في الأصول لأبي القاسم خلف بن أحمد بن بطال البكري (ت: 454هـ)، و(الإحكام في أصول الأحكام ) و(مسائل في الأصول)، و(ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل)، و(النبذ في أصول الفقه)، و( الأصول والفروع)، ومنظومة (في أصول فقه الظاهرية)، و( كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس) لابن حزم الأندلسي (ت: 456هـ)، وكتاب (معيار النظر وكتاب سر النظر) لأبي العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي (ت: 493هـ).
ومن مصنّفات القرن السادس الهجري تآليف في الأصول لأبي الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن النحوي، و(المدخل في الأصول) لأبي بكر عبد الله بن طلحة اليابوري، وكتاب (في أصول الفقه) لأبي بكر الطرطوشي (ت: 520هـ)، وكتاب (البيان في شرح البرهان) للفقيه محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي الصقلي المازري (كان حيًّا سنة 520هـ)، و(أسباب الاختلاف في الأصول) لأبي عبد الله محمد بن السيد البطليوسي (ت: 521هـ)، و(التنبيه في الأصول) للشيخ أبي طاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي (كان حيًّا سنة 526هـ)، و(تأليف على أصول ابن السراج) لأبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الباذش الأنصاري الغرناطي (ت: 528هـ)، و(إيضاح المحصول من برهان الأصول) لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي الصقلي المازري (ت: 536هـ)، و(مقدّمة في أصول الفقه) للقاضي عياض (ت: 544هـ)، و(مدارك الحقائق في أصول الفقه) لأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الضحاك الفزاري الغرناطي المعروف بابن المقري (ت: 557هـ)، و(المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى) لأبي الحسن علي بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي قنون التلمساني (ت: 557هـ)، و(العدل والإنصاف في أصول الفقه) ليوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتي الورجلاني (ت: 570هـ)، و(النبراس في الردّ على منكر القياس) لأبي علي حسن بن علي بن محمد المسيلي البجائي (ت: 580هـ)، و(المستوعب في أصول الفقه) لابن أبي بكر عبد الجليل الرفعي المعروف بابن الصابوني المراكشي (ت: 595هـ)، و(مختصر المستصفى) و(تلخيص القياس ) لابن رشد الحفيد، و(أرجوزة في علم أصول الفقه) لأبي عبد الله محمد الفندلاوي الفاسي المعروف بابن الكتاني (ت: 596هـ)، و(رجز في أصول الفقه) لأبي الحسن علي بن عتيق الأنصاري الخزرجي القرطبي (ت: 598هـ)…
ونكتفي بهذه الكتب والتآليف العديدة التي ألّفت في أصول الفقه شرحًا وتقييدًا وتدريسًا وتقليدًا واجتهادًا.
وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على أن علماء الغرب الإسلامي قد اهتمّوا بأصول الفقه اهتمامًا لافتًا للانتباه في عهدي الموحّدين والمرينيين على سبيل التخصيص.
وهناك من يرى أن المرابطين لم يهتمّوا بالأصول اهتمامًا كافيًا، فقد اكتفوا بدراسة الفروع فقط. بيد أن هناك كتبًا في أصول الفقه تبيّن أن لأصول الفقه مكانة محترمة بين العلوم النقلية والعقلية بالغرب الإسلامي في عهد الملثّمين، على الرغم من الشائعات التي تحاول التنقيص من الدولة المرابطية، على أساس أنها دولة فقهية بامتياز.
وفي هذا الصدد، يقول عبد الواحد المراكشي في كتابه (المعجب في تلخيص أخبار المغرب): «ولم يكن يقرب من أمير المسلمين -علي بن يوسف- ويحظى عنده إلَّا علم الفروع، أعني فروع مذهب مالك، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها، ونبذ ما سواها،
وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهما كل الاعتناء، ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام، وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه، وأنه بدعة في الدين، وربما أدّى أكثره إلى اختلال في العقائد»[6].
ويعني هذا أن المرابطين قد رفضوا مجموعة من العلوم كالفلسفة وعلم الكلام وأصول الفقه وأصول الدين…، ومنعوا مدرّسيها من مزاولة التدريس في الدولة المرابطية. وفي هذا الشأن قال الحسين أسكان: «وقف الفقهاء معزّزين بسلطة دولتهم موقفًا معاديًّا لعلوم أخرى، كأصول الفقه وأصول الدين، ومنع مدرّسيها بالمدن المغربية،
كما فعلوا مع ابن النحوي (513هـ) الذي درّس هذين العلمين، فطردوه لأجل ذلك بكل من سجلماسة ومدينة فاس، كما أفتى البعض منهم في نفس الفترة بعدم جواز تعليم علم الكلام للعوام. ومنعت الدولة تداول كتاب الإحياء للغزالي وتدريسه، وتمّت مصادرته وإحراقه بفتوى بعض الفقهاء الأندلسيين. غير أن تضييق الفقهاء بواسطة سلطة الدولة المرابطية على الحياة الفكرية لم يمنع من بروز محدّثين كبار مثل القاضي عياض، وابن العربي، والصدفي، وغيرهم»[7].
ويعني هذا كلّه أن الدولة المرابطية قد وقفت موقفًا سلبيًّا من العلوم العقلية بسبب سطوة الفقهاء؛ ممّا جعل المستشرقين يثورون على الدولة المرابطية، ويعدّونها دولة جمود وتخلّف. ومن هنا، فقد أثبت المستشرق الهولندي دوزي أن الحياة الفكرية والثقافية قد تدهورت بالأندلس في عهد المرابطين بسبب نفوذ الفقهاء وجبروتهم[8].
ويرى المستشرق يوسف أشباخ أن المرابطين قد «اضطهدوا كل ما عُنيت الدول العربية بتشجيعه من قبل، وطاردوا العلوم الفلسفية والكلامية التي تنكرها التعاليم المرابطية، وحظروا قراءة الكتب التي تحتويها وأحرقوها علنًا»[9].
ويضيف الباحث أشباخ: «ظهر المرابطون من بين سكان الصحراء البدو الساذجين، فكانوا أعداء لكل حضارة عربية، ومن ثَمَّ كانت حكومتهم كريح الصحراء اللافح حيث يهب على الغياض النضرة، تعمل لتحطيم جميع العلوم والفنون… وكان أولئك الحكام القساة يمقتون القبائل العربية وثقافتها، ويعملون على سحق هذه الثقافة بكل ما وسعوا، فكانوا يطاردون العلماء الذين ينحرفون عن معتقداتهم ويحرقون كتبهم»[10].
وإذا كانت الدولة المرابطية قد منعت الاشتغال بعلوم الفلسفة والمنطق والاعتقاد والتصوّف، فإن الدولة الموحّدية قد أعطت أهمية كبرى للمواد التي حاربها المرابطون كالفلسفة، والمنطق، وعلم الكلام، وأصول الدين، وأصول الفقه…
ومن هنا، فلقد قاد ابن تومرت في القرن السادس الهجري «حركة فكرية وثقافية تجديدية بالغرب الإسلامي أثرت ضمن ما أثرت فيه المجال التعليمي، إذ أعادت ترتيب الأولويات في لائحة المواد الدراسية السائدة في العهد المرابطي، وساهمت في إثرائها، وأصبحت بعض المواد تحتلّ مكان الصدارة بعدما كانت ثانوية أو مهمّشة في التعليم في العهد السابق وما قبله كالحديث والمنطق وأصول الدين وأصول الفقه والفلسفة، ولو لمدّة محدودة لم تَعْدُ ثلاثين سنة، والتفسير والقراءات والحديث والتصوّف والعلوم الأدبية كالنحو واللغة. وتراجع الفقه الذي كان يحتلّ المكانة الأولى في السابق ليحتلّ مكانة ثانوية، بل تعرّضت كتب الفروع للحرق، في حين شهد القرن السادس الهجري نهضة حديثية كبيرة غير مسبوقة في تاريخ المغرب»[11].
وبما أن هدف المرابطين هو الحفاظ على أمن الدولة المغاربية ووحدتها على جميع الأصعدة والمستويات، فكان من اللازم الدفاع عن المذهب المالكي الذي كان يحمي الناس من الجدل السيئ، ومنعهم من استعمال العقل والرأي، واستخدام المنطق والتفلسف خوفًا من الفتنة والبلبلة وانقسام المجتمع.
وعلى أيّة حال، فالمرابطون، «باعتمادهم على الفقه، كانوا يرفضون العفوية واللاعقلانية، وينظرون للحكم والدولة من خلال تصوّر علمي وتمثّل واعٍ يتجلّيان عندهم في التعاليم الدينية. وابن تاشفين وهو رجل عمل وممارسة أكثر ممّا هو رجل معرفة وتأمّل، كان حكيما حين لم يعتبر نفسه حكيما قويا تغنيه حكمته وقوته عن أي قانون، وحين أراد أن يعطي لحكمه الشرعية الشكلية الموضوعية، وحين احتكم في هذه الشرعية إلى الدين وإلى الفقه المالكي خاصة»[12].
وبهذا، فقد كانت الدولة المرابطية دولة حكمة وممارسة وخبرة واقعية عندما اختارت المذهب المالكي؛ لأن المجتمع المغربي لم يكن مستعدًّا للخوض في المهاترات الكلامية والمنطقية والعقائدية والفلسفية حفاظًا على وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره؛ لأن المهم هو الحفاظ على قوّة الدولة وهيبتها، بدل تعريضها للتشتيت والتفتيت والتمزيق في حالة انتشار الخلاف السيئ، والإكثار من الجدل المذموم، وميل العامة إلى التناحر الفكري السلبي.
أما قضية إحراق كتاب (إحياء علوم الدين) فهي قضية شائكة ومحيّرة، قد تناولها باحثون ودارسون كعبد الله كنون[13] وعباس الجراري[14] بدراسة وافية وكافية.
ومن هنا، فقد كان علم أصول الفقه، إبّان الدولة المرابطية، متوسط الحال، في بداياته الأولى بين الاحتشام والتضييق من جهة، والاستعداد عند البعص الآخر للإقبال عليه من جهة أخرى[15].
المطلب الثاني: المدرسة القيروانية
عرفت مدرسة القيروان بتونس انتعاشًا علميًّا وفكريًّا كبيرًا في شتّى العلوم والمعارف والحقول الفكرية المتنوّعة، وإذا كانت الطريقة العراقية في التدريس تعتمد على المنهج العقلي، فإن الطريقة القيروانية كان «يغلب عليها منهج النقل في التعامل مع النص، إذ تهتمّ بإعراب ألفاظ النص، والوقوف عند دلالاتها اللغوية، ثم نقد الروايات والتعرّض لرجال السند وأخبارهم»[16].
وقد استفادت هذه المدرسة من الاحتكاك العلمي والثقافي الذي تحقّق بين الغرب الإسلامي والمشرق العربي، بفضل الرحلات العلمية إلى الحجاز بصفة خاصة من أجل الحج من جهة، ونيل العلم من جهة أخرى. وكان الهدف من ذلك هو التفقّه في الدين رواية ودراسة، والاستفادة من المذهب المالكي الذي كان المهيمن على بيئة الحجاز وعمل أهل المدينة.
ومن هنا، فقد «نشأت المدرسة المالكية المغربية الأفريقية على يد تلامذة الإمام مالك الذين رحلوا إليه وأخذوا عنه، وعادوا إلى القيروان يبثّون علمه وينشرون فقهه، وقد بلغ عددهم ثلاثين رجلًا، كلهم لقي مالكًا وأخذ عنه، قبل رحلة سحنون بن سعيد إليه، وتذكر المصادر أن علي بن زياد الطرابلسي التونسي (ت: 183هـ) هو المؤسّس الحقيقي للمدرسة القيروانية -التونسية- فهو الذي يرجع إليه الفضل في نشر موطأ مالك ومذهبه الفقهي في البلاد المغربية»[17].
ومن جهة أخرى، لم تبرز مدرسة القيروان إلَّا مع مؤسّسها الذائع الصيت عبد السلام سحنون المعروف بصاحب (المدوّنة) (ت:240هـ)، والفقيه الوزير أسد بن الفرات (ت: 213هـ)، دون أن ننسى باقي العلماء الآخرين الذين ساهموا في توطيد دعائم هذه المدرسة وإثرائها فكرًا، وعلمًا، ودينًا، وثقافةً.
وقبل دخول المذهب المالكي إلى القيروان، فقد كان مذهب الكوفيين النقلي هو المذهب السائد والمهيمن على مناهج التعليم والتدريس إلى أن دخل بعض العلماء بالمذهب المالكي إلى القيروان كعلي بن زياد (183هـ)، وأبي محمد عبد الله بن فروخ (ت: 175هـ)، وعبدالله بن عمر بن غانم الرعيني (ت: 190هـ)، وأبي مسعود بن أشرس، وأبي عمرو البهلول بن راشد (ت: 183هـ)، وأسد بن الفرات (ت: 213هـ)، و سحنون عبدالسلام بن سعيد التنوخي (240هـ)، وغيرهم…، وأصبح المذهب المالكي هو السائد إلى يومنا هذا في دولة تونس.
ويعدّ علي بن زياد (ت: 183هـ)، كما قلنا سابقًا، المؤسّس الفعلي والحقيقي للمدرسة القيروانية الفقهية والأصولية لكل معالمها وأسسها النظرية والتطبيقية.
ومن هنا، فقد قامت مدرسة القيروان على مدارسة كتاب (الموطأ) للإمام مالك. وفي الوقت نفسه، تعرف المدرسة القيروانية بعدّة كتب كثيرة ومشهورة في الفقه المالكي ككتاب: (خير من زنته) لعلي بن زياد التونسي العبسي (ت: 183هـ)، و(رواية علي بن زياد لموطأ الإمام مالك بن أنس)، وكتاب (المدوّنة الفقهية الكبرى) لسحنون بن سعيد (ت: 240هـ)، و(كتاب المجموعة) لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس ( ت: 260هـ)، وكتاب (الرسالة الفقهية) لابن أبي زيد القيرواني (ت: 386هـ)…
و«بذلك، تمكّن المذهب المالكي في القيروان، وأصبحت مركزًا له، بل إن هذه المدرسة استمرت طويلًا بعد مدرسة المدينة التي ضعف شأنها في الطبقة التالية للطبقة الآخذة عن الإمام مالك.
وقد أثّرت هذه المدرسة في مدرستين كان لهما الفضل الكبير في خدمة المذهب المالكي هما: مدرسة الأندلس ومدرسة فاس، ومن أبرز خصوصيات هذه المدرسة ما تميّز به مؤسّسها علي بن زياد الذي كان يتبنّى الفقه التنظيري الفرضي على طريقة أهل العراق، وقد أخذ عنه تلميذه أسد بن الفرات تلك الفكرة، التي نمّاها بدراسته في مدرسة الرأي في العراق، فأثرت فرضيات الأسدية، كما كان سحنون يميل إلى طريقة أهل المدينة، فربط فقه الأسدية بالأثر على طريقتهم، دون أن يهمل ما عليه العمل من ذلك الأثر على طريقة أهل مصر»[18].
ومن هنا، فقد انتعش الفقه وأصوله في هذه المدرسة انتعاشًا كبيرًا، واتّخذ منحى مالكيًّا وسنيًّا منذ المراحل الأولى لتأسيس هذه المدرسة، ولا سيما أن تونس كانت تابعة للمغرب إبّان العصور الوسطى، وكان المغرب يعتمد على المذهب المالكي على مستوى الرياسة والعلم والدين والفقه. ومن الطبيعي أن تتأثّر تونس بصفة عامة، والقيروان بصفة خاصّة، بهذا التوجّه المذهبي والعقائدي. ومن ثَمَّ تكون حاضرة للمذهب المالكي فقهًا، وأصولًا، ومعتقدًا.
هذا، وقد اشتهرت مدرسة القيروان بمجموعة من الوجوه والأعلام البارزة في مجال أصول الفقه كمحمد بن محمد بن وشاح اللخمي بالولاء، أبي بكر بن اللباد (ت: 333هـ) الذي استوطن مدينة القيروان، ويعدّ من الفقهاء النابهين البارزين في معرفة الحديث وأصول الفقه، وتوظيف الاستدلال الحجاجي للبرهنة على الأحكام الفقهية، ويعرف بكتابه: (الرد على الشافعي)، وكانت ردوده لها سند واضح من السنة، وقد عرف أيضا باللغة والتفسير، وقد فلج في آخر عمره.
ومن أهم آثاره العلمية (فضائل مالك بن أنس)، و(فضائل مكة)، و(كشف الرواق عن الصروف الجامعة للأوراق)، و(الحجة في إثبات العصمة للأنبياء)، و(كتاب الطهارة)…
وهناك قاضي القيروان أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن أبي المنصور (ت: 337هـ)، وقد كان متبحّرًا في الفقه وأصول الفقه.
وهناك أيضًا العالم الفقيه أبو الأزهر عبد الوارث بن حسن بن متعب الأزهري (ت: 371هـ)، كانت له دراية كبيرة بأصول الفقه والنوازل، وقد قيل عنه: لا يوجد بأفريقية أفقه منه[19].
وهناك عبد الله بن زيد القيرواني (ت: 386هـ) المعروف باهتمامه بأصول الفقه، ولكنه لم يخلف لنا كتابًا في الأصول إلَّا مناقشته لبعض المسائل الأصولية في كتاب (الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه) «الذي ردَّ به على أحد الظاهرية في زمانه انتقد أصول مالك وفروعه، فناظره في حجية بعض الأصول المعتمدة عند المالكية، غير أن ذلك لا يسعف في تحديد معالم منهجه الأصولي، خاصّة والكتاب لم يتضمّن من القواعد الأصولية سوى النزر اليسير الذي لا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة»[20].
وهناك أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بالقابسي (403هـ) الذي ولد بمدينة قابس، وكان من أهم علماء القيروان البارزين في الفقه، وعلم الكلام، وأصول الفقه، وأصول الدين، والحديث النبوي الشريف… وقد كان القابسي زاهدًا، وورعًا، ورجلًا ضريرًا. كما كان حافظًا للحديث، وعالمًا مبصرًا بالرجال والرواة[21]، من أهم كتبه: (الممهد في الفقه وأحكام الديانة)، و (ملخص الموطأ)، وكتاب (الاعتقادات)، وكتاب (الذكر والدعاء)، و (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين) التي تأثّر فيها برسالة ابن سحنون المعروفة بآداب المعلمين.
وأكثر من هذا فقد كان أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري فقيهًا وأصوليًّا ومتكلّمًا ومناظرًا متميّزًا وبارعًا[22].
كما ارتبطت مدرسة القيروان بأبي عمران الفاسي (ت:430هـ) الذي عرف بدوره غير المباشر في تأسيس الدولة المرابطية بالمغرب الأقصى. ويرى عباس الجراري أن الرجلين اللذين قادا الدعوة الإصلاحية المرابطية هما عبد الله بن ياسين، «وهو فقيه مالكي، وشيخه ودافعه للدعوة هو وجاج بن زلو اللمطي وهو فقيه مالكي كذلك، أما الموجّه الأول فهو أبو عمران الفاسي الذي كان المغراويون قد ضايقوه واضطروه إلى مغادرة فاس، والذهاب إلى القيروان، وكان شيخ فقهاء المالكية في عصره.
إذاً، ليس غريبًا أن يكون المذهب الذي تقوم عليه هذه الدعوة هو المذهب المالكي. هنا أفتح قوسًا: وجود أبي عمران في طليعة الموجّهين، وهو يومئذٍ بالقيروان، وخروج يحيى بن إبراهيم الكدالي في رحلة استطلاعية -كما يقال- إلى المشرق قبل الاتصال بأبي عمران في طريق العودة، أليست هذه عناصر تسمح لنا بأن نوسّع مجال النظر إلى الأمر، وبأن نعتقد أن اعتماد المرابطين على المذهب المالكي داخل في نطاق صراع المذهب السنّي عمومًا مع المذهب الشيعي على مستوى العالم الإسلامي، ولا سيما في الشرق؟
ولست أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكني لا أستبعد ذلك لا سيما حين أرى مساندة العباسيين ليوسف بن تاشفين، وكان بحاجة إلى مثل هذه المساندة، بل إلى مسالمة مع الجانب الشرقي، حتى لا يعزل سياسيًّا وحتى لا يواجه أي تحالف ضدّه، وحتى يتفرّغ للعمل في الداخل، أي في المغرب والأندلس»[23].
ومن هنا، يتبيّن لنا أن أبا عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي قد ولد بفاس، واستوطن بها وقتًا محددًا، ليغادرها تحت ضغط المغراويين ليستقر بالقيروان. وكان عالمًا متبحّرًا في الفقه وأصوله، وكانت له مكانة علمية كبيرة بين أهل القيروان وعلمائها وفقهائها، وقد درس على يد أبي الحسن القابسي، ورحل إلى قرطبة من أجل طلب العلم. وهناك، أخذ العلم عن الأصيلي وأحمد بن قاسم….
ولقد استفاد أبو عمران الفاسي من علم أصول الفقه كما عند أبي بكر الباقلاني صاحب (إعجاز القرآن). ومن مصنّفاته تعليقه على المدوّنة لابن سحنون، وكتاب (الإحكام لمسائل الأحكام المستخرجة من كتاب الدلائل والأضداد).
وهناك مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي (ت: 437هـ) الذي عرف بتمكّنه من الفقه وأصوله، وبراعته في علوم القرآن، ومن أعماله التي بقيت كتابه (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه)[24]، وقد تناول فيه مجمل آراء الأصوليين في قضية الناسخ والمنسوخ.
وهناك كذلك العالم الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي (ت: 443هـ) الذي عرف بأنه الفقيه الحافظ الأصولي، وقد تعلّم على عالمين كبيرين هما: أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي. ومن ثم، فقد تعلّم علم أصول الفقه على الأردي، وله شروح على المدوّنة لابن سحنون وكتاب ابن المواز[25].
ويمكن الحديث أيضًا عن عمر بن صالح القيرواني (ت: 460هـ) درس على أبي عمران الفاسي وأبي بكر الخولاني، وقد قال ابن بشكوال في كتابه (الصلة): «عُني بالأصول والفروع وأخذ عنه الكثير من الناس»[26].
ولا ننسى أيضًا أبا القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي المعروف بالسيوري (ت: 460هـ)، ويعدّ آخر عالم في طبقة علماء القيروان، وخاتمة أئمتها البارزين، درس على أبي عمران الفاسي، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعلماء آخرين كثيرين. و لقد كان موسوعيًّا، ملمًّا بالفقه وأصول الفقه، ويعرف عنه أنه كانت له اجتهادات بارزة داخل المذهب المالكي في بعض المسائل والقضايا الفقهية والنظرية خالف فيها الإمام مالك.
وهناك محمد بن سعدون القيرواني (ت: 485هـ) المعروف بتناوله لأصول الفقه مدارسةً وقراءةً وتعليمًا.
وهناك ابن الصائغ عبد الحميد بن محمد القيرواني (ت: 486هـ) الذي وصفه القاضي عياض بالفقيه الأصولي النضار، أخذ عنه الفقيه المازري وأبو بكر بن عطية وغيرهما[27].
فضلًا عن أبي عبد الله محمد التميمي المازري (ت: 536هـ) المعروف بشرحه التحليلي لكتاب (البرهان في أصول الفقه) لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت: 478هـ)، وسمّاه (إيضاح المحصول من برهان الأصول)[28].
وهناك ابن الصابوني عبد الجليل الدياجي الربعي الذي توفّي في منتصف القرن الخامس الهجري، وأصله من القيروان، تعلّم على يد أبي عمران الفاسي، واشتغل بالتدريس بفاس وقلعة بني حماد، كان يدرس العقيدة وأصول الفقه.
وهناك أبو عبد الله محمد بن راشد البكري القفصي (ت: 736هـ) الذي صنّف كتبًا كثيرة في أصول الفقه منها: (تلخيص المحصول في علم الأصول)، و(نخبة الواصل في شرح الحاصل في الأصول)، والحاصل هو مختصر الأرموي لمحصول الرازي، وكتاب (المذهب في ضبط مسائل المذهب)…
ويعني هذا كلّه أن علم أصول الفقه قد ازدهر ازدهارًا كبيرًا في مدرسة القيروان بفضل علمائها النابهين، وفقهائها البارزين، وأصولييها المجتهدين. ويعني هذا أن المدرسة لم تكن حبيسة النقل والتقليد للمذهب المالكي بطريقة حرفية كلية، بل كان العلماء يجتهدون من حين لآخر كما نجد ذلك عند السيوري. بيد أن هذه المدرسة قد عرفت نهايتها بتفرّق علمائها شذر مذر بين ربوع فاس من جهة، وحاضرة الأندلس من جهة أخرى.
المطلب الثالث: مدرسة تلمسان
عرفت مدرسة تلمسان الجزائرية في عهد المرينيين، وخاصّة في العهد الزياني بالخصوص، عصرها الذهبي بسبب كثرة العلماء والأدباء والفقهاء والمحدّثين الذين أثروا الحياة الفكرية والثقافية على جميع الأصعدة والمستويات. وكانت مدرسة فقهية ومالكية وسنّية بامتياز، وحاضرة عامرة بالنبغاء والنابهين والبارزين في مختلف العلوم الشرعية، سواء النقلية منها أم العقلية، ولا سيما أصول الفقه.
ومن بين أهم علماء أصول الفقه بحاضرة تلمسان أبو الحسن علي بن أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي قنون التلمساني (ت: 557هـ) صاحب كتاب (المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى)، وهو كتاب مفيد في هذا الباب.
وهناك أبو زيد محمد بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني (ت: 656هـ) الذي يعرف بكتاب في أصول الفقه.
وهناك أبو عبد الله الشريف التلمساني (ت: 771هـ) صاحب كتاب (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)، وقد تناول فيه المباحث اللغوية ومصادر التشريع الإسلامي، وبيّن فيه الكيفية التي بها تبنى فروع الفقه على أصولها الاستدلالية. وله تأليف آخر بعنوان (مثارات الغلط في الأدلة)[29]، يتناول فيه القضايا الأصولية في ضوء رؤية اجتهادية متميّزة.
ويتبيّن لنا أن مدرسة تلمسان كانت حاضرة علمية وثقافية متميّزة في الغرب الإسلامي، ولا سيما في وسطها الجزائري. لذا كانت مدرسة تلمسان قبلة لطلاب العلم من كل أصقاع المغرب الكبير وبقاعها المتفرّقة، وكانت معروفة بعلمائها النابغين والنابهين في مختلف العلوم العقلية والنقلية، وخاصّة الفقه وأصوله.
وقد كانت هذه المدرسة الفقهية والأصولية تتفاعل مع باقي المدارس العربية الأخرى كمدرسة العراق، ومدرسة المدينة المنورة، ومدرسة مصر، ومدرسة طرابلس، ومدرسة القيروان، ومدارس المغرب الأقصى كسبتة، ومراكش، وفاس، وسلا، وسجلماسة. فضلًا عن مدارس الأندلس كإشبيلية، وغرناطة، وقرطبة، وطليطلة…
المطلب الرابع: مدرسة قرطبة
من المراكز التي اشتهر فيها تداول علم أصول الفقه مدينة قرطبة بالأندلس، وهي من أشهر المدارس في الغرب الإسلامي، تأسّست في عهود قديمة، ومن أشهر مؤسّسيها الفقيه العالم قاضي القضاة يحيي بن يحيي الليثي توفي سنة 234هـ، ومن أشهر العلماء الذين تلقوا العلم في هذه المدرسة أبي عمران الفاسي، تتلمذ فيها عن الأصيلي، وأحمد بن قاسم…
وقد عرفت مدرسة قرطبة بمدارسة العلوم النقلية والشرعية والعقلية، وكان اهتمامها كبيرًا بالفلسفة كما نجد ذلك واضحًا عند ابن رشد. علاوة على اهتمامها بعلم الكلام، وأصول الدين، وأصول الفقه. ويمكن القول: إن قرطبة كانت سباقة إلى العناية بأصول الفقه، كما يتّضح ذلك جليًّا عند زكريا بن يحيى الكلاعي القرطبي (ت: 300هـ) الذي ألّف كتابًا في أصول الفقه.
وهناك أيضًا أبو محمد بن قاسم بن محمد بن يسار القرطبي (ت: 277هـ) الذي ألّف كتابًا في الردّ على المقلّدة، ويعرف بأنه فقيه أصولي مناظر يستعمل الاستدلال الحجاجي في ردوده الأصولية والمنطقية، وكان يميل إلى مذهب الشافعي، وقد ارتحل إلى الشرق لطلب العلم و تدريسه.
وهناك أبو عمر أحمد الطلمنكي القرطبي (ت: 429هـ) صاحب كتاب (الوصول إلى معرفة علم الأصول). وهناك ابن رشد الحفيد (ت: 595هـ) المعروف بكتاباته الفلسفية والأصولية وشروحه لكتب أرسطو ككتاب (مختصر المستصفى)، ويسمّى هذا الكتاب بالضروري. كما ألّف كتابًا آخر بعنوان (تلخيص القياس)، وكتابًا بعنوان (مناهج الأدلة).
وهناك أبو الحسن علي بن عتيق الأنصاري الخزرجي القرطبي (ت: 598هـ) الذي عرف بمجموعة من الأراجيز في علم الكلام، وأصول الفقه، وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية المعروفة بالأندلس.
ويبدو أنه من الصعب الإحاطة بجميع أصوليي مدرسة قرطبة، فعددهم كبير جدًّا، فهناك من ذكرت مؤلّفاته الأصولية في مصادر أصول الفقه ومراجعه ومقالاته، وهناك من ضاعت كتبه وتصانيفه ومؤلّفاته. وهناك من استقرّ بقرطبة ولازمها طوال حياته يتعلّم ويعلّم، وهناك من انتقل إلى حواضر ومدارس أخرى بالغرب الإسلامي من جهة، أو هاجر إلى المشرق العربي من جهة أخرى إما لأداء فريضة الحج، وإما من أجل طلب العلم، وإما بهدف التدريس من جهة أخرى.
المطلب السابع: مدرسة سبتة
تعدّ مدرسة سبتة أول مدرسة علمية وفقهية بالمغرب الأقصى، وقد قامت بدور تعليمي وثقافي مهمّ، وكنت تنافس المدارس الأندلسية في مدارسة الفقه وعلومه. ومن باب التعريف بهذه المدرسة، توجد مدينة سبتة في شمال المغرب، وتطلّ على البحر الأبيض المتوسط. وقد شهدت سبتة تدخّلات أجنبية عدة كالفينيقيين الذين احتلّوها في القرن السابع قبل الميلاد، وسمّوها أبيلا. ثم احتلّها القرطاجنيون سنة 319 قبل الميلاد، واحتلّها النوميديون في 2011 قبل الميلاد، والرومانيون في 40م.
وقد دخلها المسلمون إبّان العصر الأموي، وكانت منفذًا استراتيجيًّا من أجل فتح الأندلس، وقد أصبحت إمارة أمازيغية في عام 1061م، ودخلها يوسف بن تاشفين، ثم الموحّدون سنة 1147م، وعمرها المرينيون في القرن السابع الهجري، واحتلها البرتغاليون سنة 1415م، ثم سيطرت عليها إسبانيا سنة 1580م، بعد أن أضحت البرتغال تابعة لها. وتتمتّع سبتة المحتلة -اليوم- بنظام الحكم الذاتي منذ 1995م.
وعليه، تعدّ مدرسة سبتة أقدم المدارس التعليمية بالمغرب الأقصى. ولم تكن المدرسة بمفهوم الجامع أو الكتاب، بل كانت مدرسة تعليمية محضة بالمفهوم المشرقي للمدرسة كما كانت موجودة في العصر العباسي. وقد كانت المدارس بالمغرب ملكًا للخواص لتتحوّل إلى مدارس عمومية تباعة للدولة.
ومن هنا فقد «اشتهرت مدينة سبتة بوصفها مركزًا للدراسات النحوية واللغوية، ويشبهها ابن الخطيب ببصرة اللسان، ويعود ذلك إلى قربها من الأندلس والتأثّر بتقاليدها التعليمية التي تهتمّ باللغة والنحو منذ الطفولة في الكتاتيب، وإلى هجرة عدد كبير من الأندلسيين إليها، منذ القرن السابع الهجري، إلى سقوطها في يد الاحتلال البرتغالي سنة 818هـ»[30].
وكانت الطريقة التعليمية المعتمدة في مدرسة سبتة بصفة عامّة، وعند القاضي عياض (ت: 544هـ) بصفة خاصّة، تمزج بين الطريقتين العراقية القائمة على المنهج العقلي، والطريقة القيروانية القائمة على المنهج النقلي.
وكانت مدرسة سبتة ذائعة الصيت في عهد المرابطين، والموحّدين، والمرينيين. وفي هذا الصدد، يرى الحسن السائح، في كتابه (الحضارة المغربية)، أن المرابطين قد شيّدوا عدّة مدارس علمية وفكرية وثقافية وتربوية، ومن أبرزها «مدارس سبتة، ويذكر ابن الآبار عدّة مدارس أخرى كانت بطنجة، وأغمات وسجلماسة، وتلمسان، ومراكش. وكانت هذه المدارس تأوي علم القيروان وثقافة الأندلس المشهورة، حيث نبغ فيها أعلام كبار، منهم في علم الفقه والحديث أبو علي كما نبغ منها القاضي عياض، وأبو الوليد ابن رشد مؤلّف كتاب المقدّمات الأوائل للمدوّنة، والبيان والتحصيل، إلى آخر كتبه القيمة»[31].
وعليه فقد شهدت مدينة سبتة حضارة زاهية إبّان عصر المرينيين شملت جميع الأصعدة والمستويات، ولا سيما في المجالات الثقافية، والفكرية، والأدبية، والفقهية، والعلمية. ويكفي فخرًا أن تكون سبتة موطنًا ومنشأً لمجموعة من العلماء والفقهاء والعلماء النابغين على الصعيدين العربي والإسلامي كالشريف الإدريسي صاحب رحلة (نزهة المشتاق في اختراف الآفاق)، والقاضي عياض المعروف بكتبه المتنوّعة، مثل: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى)، و(إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم)، و(الإعلام بحدود قواعد الإسلام)، و(الغنية)، و(ترتيب المدارك وتنوير المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك)، و(مذاهب الحكام في نوازل الأحكام)، و(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع[32])…، ويعدّ القاضي عياض في كتابه (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) من العلماء السبّاقين إلى وضع قواعد تحقيق النصوص والمؤلّفات والمخطوطات نظريًّا وتطبيقًا[33].
وما يهمنا -هنا- هو المجال الأصولي، فلا بد من التوقّف عند أبي القاسم المعافري السبتي (ت: 502هـ) الذي كان يدرس علم الكلام وأصول الفقه، وقد ذكر القاضي عياض في (الفهرست)[34] أنه تعلّم هذين العلمين على هذا الرجل في مدينة سبتة، وعليه أخذ هذا العلم جماعة من العلماء، وكان الناس يرحلون إليه لدراستهما.
ويعدّ القاضي عياض (544هـ) من أهم علماء مدينة سبتة، فقد كتب في أصول الفقه، ولم يقتصر علمه على الرواية والحديث والسيرة فحسب، بل كان عالمًا متبحّرًا ومتفقّهًا في أصول الفقه، كما يبدو ذلك واضحًا في (مقدمة في أصول الفقه) التي توجد بالجزء الأول من كتاب (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة علماء مذهب مالك)؛ حيث تحدّث عن أصول المالكية، وناقش قضية (إجماع هل المدينة) التي وقع فيها خلاف فقهي وأصولي بين العلماء، وقد استدلّ بقول الشافعي: «إجماع أهل المدينة أحب إليَّ من القياس»[35]. كما ناقش باقي الأصوليين النابهين الآخرين كأبي بكر الصيرفي، وأبي حامد الغزالي، والقاضي عبدالوهاب (422هـ)، والباقلاني (403هـ)، والأبهري (375هـ)، وغيرهم من علماء أصول الفقه.
وهناك ابن خيار علي بن محمد الذي تابع دراسته بالأندلس وسبتة، وقد استقرّ بها إلى أن توفّي سنة 605هـ، وقد عرف بعلم أصول الفقه، وعلم الكلام، والتصوّف.
وهناك ابن الحصار الإشبيلي الفاسي السبتي (ت: 611هـ) المعروف بكتب أصول الفقه، مثل: (البيان في تنقيح كتاب البرهان لأبي المعالي)، و(تقريب المرام في تهذيب أدلّة الأحكام في أصول الفقه)، و(مقالة في النسخ على مآخذ الأصوليين)…
وهناك عبد الله بن علي الأوسي الأنصاري أندلسي الأصل، استقرّ بمدينة سبتة حتى توفّي بها سنة 674هـ، وقد عرف بقوة الاستنباط، وحسن القريحة، والجمع بين الفقه وأصوله وعلم الكلام، ومن بين تلامذته: ابن فرتون وأبو عبد الرحمن بن غالب.
وهناك محمد بن أبي البركات بن السكاك العياضي (ت: 801هـ) الذي يعدّ من أهم علماء الأصول بمدينة سبتة، على الرغم من نشأته بمدينة فاس، وتعلّمه على أيدي علمائها النابغين. وقد مارس هذا العالم الفقيه القضاء بسبتة مرّات متعدّدة، وكان أيضًا قاضي الجماعة بفاس إبان فترة موسى بن أبي عنان المريني، ثم انتقل لمزاولة القضاء بمدينة مرة أخرى.
ويعرف هذا العالم المشهور بباعه الكبير في تفسير القرآن الكريم، وقراءة كتاب (المستصفى من علم الأصول) للإمام الغزالي، وكانت وفاته في محرم فاتح ثمانمائة، وهو في الثمانين من عمره.
وعلى العموم، فقد كانت مدرسة سبتة مدرسة فقه وأصول فقه على مرّ تاريخها، ولا سيما في عهد المرينيين الذين شجّعوا حركة العلم والثقافة بحاضرة سبتة التي كان يزورها كثير من العلماء من داخل المغرب وخارجه لطلب العلم من جهة، والتدريس بها من جهة أخرى.
المطلب التاسع: مدرسة فاس
تتميّز مدرسة فاس بأنها مدرسة فقه بامتياز، ولا سيما في عهد المرابطين والمرينيين. ويعني هذا أن مادّة الفقه هي المادّة الرئيسة التي كانت تدرّس بمدرسة فاس. «وكانت أكبر الحلقات الدراسية بفاس هي تلك المتخصّصة لتدريس الفقه، إذ كان يحضرها ما بين بضع مئات وثلاثة آلاف من الطلبة كما سبق الذكر»[36].
ومن هنا، فقد تأخّرت نشأة مدرسة فاس وازدهارها، وقد جاء في مقدّمة ابن خلدون أن مدرسة القيروان ومدرسة قرطبة قد انتقلتا إلى مدينة فاس، وتمسّك بهما المغرب[37]. وقد عرفت مدينة فاس العامرة بكثرة المجالس العلمية ومنتديات المناظرة، واختلط الفقه بعلم أصول الفقه[38].
ومن أهم علماء مدرسة فاس الذين اهتمّوا بأصول الفقه ابن عمران الفاسي الذي اهتم بمدارسة الفقه وأصوله، وكان يدرسهما في القيروان وفاس على حدٍّ سواء. وقد خلف لنا مجموعة من تلامذته النابهين العارفين الذين اعتنوا بأصول الفقه شرحًا، وتحليلًا، وتدريسًا، وإقراءً.
وهناك ابن الصابوني عبد الجليل الدياجي الربعي الذي توفّي في منتصف القرن الخامس الهجري، وأصله من القيروان، وقد تعلّم على يد أبي عمران الفاسي، واشتغل بالتدريس بفاس وقلعة بني حماد، كان يدرس العقيدة وأصول الفقه.
وهناك أيضًا عثمان بن عبد الله السلالجي الفاسي (ت: 574هـ) الذي كان يدرس علم الاعتقاد (علم الكلام) من جهة، وعلم أصول الفقه من جهة أخرى. ومن تلامذته الذين درسوا عليه الأصول ابن الرمامة محمد بن علي القيسي من قلعة حماد، وقد توفّي بفاس سنة 567هـ، وتلميذه ابن الكتاني محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي (ت: 596هـ) الذي عرف بكونه إمامًا لأصول الفقه وعلم الكلام، وله رجز في أصول الفقه. فصلًا عن ابن نموي الفاسي يوسف عبد الصمد (ت: 614هـ) الذي قال عنه صاحب الذيل والتكملة: «كان مبرّزًا في الفقه والأصول مع مشاركة في الحديث وتضلّع في علم الكلام»[39]. وقد درس علم أصول الفقه بإشبيلية.
وهناك أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الأنصاري الخزرجي المعروف بابن الحصار الفاسي (ت: 610 أو 611هـ)، فقد كان محدّثًا ومفسّرًا وراويةً، وفقيهًا أصوليًّا، وله كتاب في أصول الفقه بعنوان (البيان في تنقيح البرهان)، شرح فيه برهان أبي المعالي الجويني.
ونكتفي بهذه الأعلام الأصولية بمدرسة فاس؛ لأن هناك العديد من علماء أصول الفقه الذين ضاعت كتبهم عبر مرور الزمان، وما وصل إلينا منها إلَّا القدر القليل منها.
المطلب الخامس: مدرسة مراكش
كانت مراكش من أهمّ الحواضر العلمية المزدهرة بالغرب الإسلامي، فقد كانت مدرسة علمية وفقهية متميّزة لكثرة مدارسها وجوامعها وكتّابها وروابطها. وعرفت إشعاعًا لافتًا للانتباه في عهدي المرابطين والموحّدين، وقد وصفت مراكش ببغداد المغرب.
وقد كانت مراكش خلال الموحّدين -عهد المنصور والناصر والمستنصر «حاضرة الخلافة يفد عليها أهل العلم والطلب من الأندلس وغيرها، وكانت تكتظّ بدكاكين الوراقين والكتبيين، وتزخر بالمؤلّفات في كل علم وفن. وغدت لذلك تغني طلبة المغرب عن شدّ الرحال إلى الأندلس أو المشرق»[40].
وقد احتفظت مراكش، خلال القرنين السابع والثامن الهجريين، «بما كان يدرس فيها من العلوم العقلية خلال العصر الموحّدي. وكان من نتائج ذلك ظهور ابن البناء المراكشي (ت: 721هـ) الذي ألّف عدّة مؤلّفات في هذه العلوم»[41].
أضف إلى ذلك أن هناك العديد من المدارس التي شيّدت في العصر المرابطي بمراكش كمدرسة الصابرين التي أسّسها يوسف بن تاشفين.
ويقول عبد الله كنون مشيرًا إلى هذه النهضة التربوية التي قامت على أكتاف المعاهد والمدارس الدينية الإسلامية: «ولا ننسى جامع ابن يوسف وهو بمراكش مثل القرويين بفاس، فهو من منشآت هذا العصر.
ومنذ بناه علي بن يوسف لم يزل المركز الثاني للدراسات العلمية والأدبية بالمغرب. على أن القرويين لم تفتأ تحاط بالعناية الكاملة من الزيادة فيها كلما ضاقت أرجاؤها، وتحديد معالمها التي يتسوّر إليها الدثور. وقد نقض بناؤها في أيام علي بن يوسف وعمل على توسعتها من جميع الجهات فبلغت بلاطاتها من الصحن إلى القبلة عشر بلاطات.
واحتفل في عمل القبّة التي بأعلى المحراب وما يحاذيها من وسط البلاطين المتّصلين بها فصنع ذلك بالجص المقربص الفاخر الصنعة، ونقشت واجهة المحراب بالنقوش المذهبة الجميلة، وركب في شمسياته أنواع الزجاج الملون البديع، إلى غير ذلك من فنون الزخرفة وضروب الزينة. وكان كل ما أنفق في ذلك من تبرّعات المحسنين، إذ لم يزل هذا المسجد العظيم منذ تأسيسه من الشعب وإليه، وذلك هو سرّ عظمته الخالدة.
لكن الذي يلفت الأنظار من اهتمام الدولة بالقرويين وتعزيز مركزها كمعهد دراسي عالٍ هو بناء المدارس التي تتّخذ لإيواء الطلبة، وتدريس بعض العلوم التي يكون المسجد غير مناسب لتدريسها بسبب ما تقتضيه من إجراء بعض التجربات واستعمال بعض الآلات. وقد بدأ ذلك في هذا العصر إذ ثبت أنه كانت هناك بفاس مدرسة من بناء يوسف بن تاشفين تعرف بمدرسة الصابرين ومن الجائز أن يكون هناك غيرها. والغريب هو أن يتوافق المغرب والمشرق في وقت إنشاء المدارس؛ لأن هذا التاريخ هو الذي أنشأ فيه الوزير نظام الملك مدرسته العلمية ببغداد، وهي أول مدرسة في الشرق كذلك»[42].
ولم تقتصر مدرسة مراكش على العلوم النقلية والشرعية فقط، بل كانت تُعنى بالعلوم العقلية كأصول الدين، وعلم الكلام، وأصول الفقه، والفلسفة، والمنطق، والرياضيات، والفلك، والتنجيم…
ومن أهم العلماء في مجال أصول الفقه الذين احتضنتهم مدرسة مراكش ابن الإشبيلي علي بن محمد الذي استقرّ بمراكش، وتوفي فيها سنة 567هـ، وقد كان بارعًا في علم أصول الفقه وعلم الكلام، ومن أهم تلامذته ابن الزبير، وأبو عمر، وعثمان السلالجي.
وهناك ابن أبي بكر عبد الجليل الرفعي المعروف بابن الصابوني المراكشي (ت: 595هـ)، فقد ألّف كتابًا في أصول الفقه بعنوان (المستوعب في أصول الفقه).
وهنك أيضًا ابن الطوير عمر بن محمد السويسي الصنهاجي (ت: 622هـ) الذي درس أصول الفقه في المشرق العربي، وقد أخذ العلم عن عبد الوهاب البغدادي، وقد درس الفقه وأصوله واللغة العربية في كل من المهدية، وإشبيلية، ومراكش. وقد عرف بالورع والزهد والتقوى والتصوّف، وله مذهب خاص في إثبات القياس قد أثار ردودًا عدّة من بينها ردّ أبي الحسن بن القطان من جهة، وردّ العالم الليبي عبد الحميد بن أبي الدنيا من جهة أخرى.
وهناك أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى الكتامي الحميري، ويعرف بابن القطان، فقد ولد بفاس، وإن كان قرطبي الأصل، كان مولده سنة (628هـ)، وقد سكن مراكش، وترأّس طلبة العلم بهذه المدينة.
ولقد اهتمّ بمدارسة الحديث رواية ودراية، وقد صنّف كتبًا في الحديث وعلومه، وفي الفقه وأصوله، ومن أهم كتبه: (بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي، وله كتاب في الردّ على ابن حزم في المحلّى، وله كتاب (البستان في أحكام الجنان)، وله كتاب في شيوخ الدراقطني، وله كتاب في أصول الفقه ردّ به على ابن الطوير الصنهاجي سمّاه (القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس).
ومن أهمّ كتبه ومصنّفاته وتآليفه (مقالة في إعجاز القرآن)، و(الناسخ والمنسوخ)، و(تقريب المدارك في وصل المقطوع من حديث مالك)، و(بيان البيان في شرح البرهان)، و(مقالة في النسخ على مآخذ الأصوليين)، و(تقريب المرام في تهذيب أدلة الأحكام في أصول الفقه)، و(مصنف في علم الكلام)، و(مقالة في الإيمان والإسلام)، وعقيدة سمّاها (تلقين الوليد وخاتمة السعيد)، و(مقالة في الحيض والنفاس)…
وهناك عبد الرحمن بن محمد يخلفتن الغازازي (ت: 627هـ) المتمكّن من علم الأصول وعلم الكلام، وكان ميّالًا إلى الزهد والتصوّف، وقد توفّي بمراكش.
ومن الصعب استحضار جميع الأصوليين الذين زاروا مدرسة مراكش لطلب العلم أو التدريس بها؛ لأن هناك العديد من العلماء الذين ضاعت كتبهم الأصولية منها، وما وصلنا منها إلَّا النزر القليل.
الخاتمة
وخلاصة القول، تلكم هي نظرة مقتضبة إلى أهم المدارس والحواضر الفقهية التي كانت منتشرة وبارزة في الغرب الإسلامي، وقد قامت بدور مهمّ في إرساء دعائم أصول الفقه وتوطيده ونشره وتعميمه عن طريق الإقراء، والتدريس، والبحث، والاجتهاد، بتصنيف أمهات الكتب في هذا المجال في شكل شروح، ومختصرات، ومداخل، وتقييدات، وطرر، وملخّصات، وتحليلات، وردود، ونقود، ومؤلّفات إبداعية جديدة…
وما يلاحظ على هذه المدارس الأصولية كلّها أنها قد تفاعلت فيما بينها تثاقفًا وتلاقحًا وتأثّرًا وتأثيرًا؛ لأن علماء أصول الفقه كانوا ينتقلون من مدرسة إلى أخرى لطلب العلم أو التدريس بها، وقد كانت الدراسات الأصولية تتأرجح في الغالب، بين الاتّباع والإبداع من جهة أولى، أو بين التقليد والاجتهاد من جهة ثانية، أو بين التنظير والتطبيق من جهة ثالثة.
الهوامش
[1] ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة علماء مذهب مالك، الرباط – المغرب: طبعة وزارة الأوقاف المغربية، الطبعة الثانية ، سنة 1983م، الجزء الثاني، ص: 178.
[2] ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس، طبعة الرباط، المغرب، 1956م، الجزء الأول، ص:34.
[3] عبد المجيد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي، تحقيق: عبد الصابون شاهين ومحمد عبد الحليم محمود، بيروت – لبنان: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1986م، ص:72.
[4] عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، الجزء الأول، ص:52.
[5] عبد الله كنون، نفسه، ص:51.
[6] عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، نشر: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، الطبعة السابعة، 1978م، ص:243.
[7] الحسين أسكان، تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، ص:103-104.
[8] -R.Dozy :Histoire des musulmans d’Espagne,Leyde,1932.
[9] يوسف أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة: محمد عبد الله عنان، الجزء الثاني، طبع بمصر سنة 1940م، ص:239.
[10] يوسف أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، الجزء الثاني، ص:250.
[11] الحسين أسكان، نفسه، ص:104.
[12] عباس الجراري، نفسه، ص:88.
[13] عبد الله كنون، نفسه، ص:70.
[14] عباس الجراري، نفسه، ص:94-95.
[15] للاستزادة انظر: أحمد الطاهر، علم أصول الفقه في العصر المرابطي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بإشراف: إدريس أحمد خليفة، الرباط – المغرب: دار الحديث الحسنية، سجلت تحت رقم 17763، صص:41-80.
[16] الحسين أسكان، تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، الرباط: منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الطبعة الأولى سنة 2004م، ص:113.
[17] محمد إلياس المراكشي، تطور المنهج الأصولي عند المالكية وأثره في الاختلاف الفقهي، دبي – الإمارات العربية المتحدة: مسار للطباعة والنشر، بدون تحديد لتاريخ الطبعة، صص:90-91.
[18] محمد إلياس المراكشي، تطور المنهج الأصولي عند المالكية وأثره في الاختلاف الفقهي، صص:91-92.
[19] محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق: عبدالمجيد خيالي، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2003م، ص 95-97.
[20] محمد إلياس المراكشي، نفسه، ص:92.
[21] انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، طبعة 1983م.
[22] محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، صص: 95-97.
[23] عباس الجراري، الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، الرباط: منشورات مكتبة المعارف؛ الدار البيضاء – المغرب: مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية سنة 1982م، الجزء الأول، ص:89.
[24] مكي بن أبي طالب القيسي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، تحقيق: أحمد فرحات، جدة – المملكة العربية السعودية: دار المنارة، الطبعة الأولى سنة 1986م.
[25] محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص:108.
[26] ابن بشكوال، كتاب الصلة، القاهرة: الدار المصرية للتأليف، طبعة 1966م، الجزء الأول، ص:383.
[27] القاضي عياض، ترتيب المدارك، الجزء الثامن، ص:105.
[28] أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، تحقيق: عمار الطالبي، بيروت – لبنان: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (د.ت).
[29] أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومعه: مثارات الغلط في الأدلة، تحقيق: محمد علي فركوس، المكتبة المكية، بيروت – لبنان: مؤسسة الريان، الطبعة الأولى سنة 1998م.
[30] الحسين أسكان، تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، ص:107.
[31] الحسن السائح، الحضارة المغربية، الجزء الثاني، ص:64.
[32] القاضي عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة – مصر، طبعة 1970م.
[33] انظر: جميل حمداوي، منهج تحقيق التراث نظرية وممارسة، تطوان – المغرب: مطبعة الخليج العربي، الطبعة الأولى سنة 2018م.
[34] القاضي عياض، الفهرست، مخطوطة الخزانة العباسية، رقم 3147، صص:50-52.
[35] القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة علماء مذهب مالك، الرباط – المغرب: طبعة وزارة الأوقاف المغربية، الطبعة الثانية ، سنة 1983م، الجزء الأول، ص:58.
[36] الحسين أسكان، تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، الرباط: منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الطبعة الأولى سنة 2004م، ص:105.
[37] ابن خلدون، المقدمة، ص:367.
[38] عبد الله كنون، نفسه، الجزء الأول، ص:77.
[39] ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق: محمد بن شريفة، الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، طبعة 1984م، الجزء الثامن، صص:427-428.
[40] محمد بنشريفة، أول تأليف مغربي في المنطق: أسهل الطرق إلى فهم المنطق للماجري، مجلة المناظرة، المغرب، العدد الثاني، السنة الأولى، ديسمبر 1989م، ص:29.
[41] الحسين أسكان، نفسه، ص:106.
[42] عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ص:75.
الباحث المغربي يوسف اغزيل المجاهد
المصدر: مجلة الكلمة العدد 106
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي