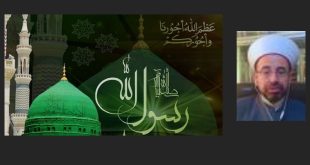خاص الاجتهاد: إن الأمم التي غابت عن التاريخ لم تترك غير أطلال، وصارت أديانها ولغاتها ذكريات، اما الإسلام فما زالت عناصر حضارته باقية حية، فرسالة محمد( صلى الله عليه وآله وسلم) العربي حاربت التراتب الطبقي البغيض واعلنت على لسانه: كلكم لأدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلأ بالتقوى، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله.
في تلك الفترة التي خبت فيها أنوار الحق، وانطمست معالم الهدى، وغشي العالم ظلام الجهل الحالك، وتاهت العقول في مهامه الشرك والضلال.
لمع من جانب البطحاء نور اضاء ما حوله، ثم ما لبث أن تغلغل في احشاء الشام وفارس، ثم عم القارات الثلاث، فبعث فيها حياة جديدة، لايسمع فيها إلأ نداء التوحيد ولا يصاخ الاّ لسلطان الحق، ولا يقام إلاً قسطاس العدل، يستوعبه الغني والفقير، الأمير والحقير، ذلك النور هو نور النبوة المحمدية، الذي انبثق من صميم العرب وأخلص بطونهم.
كان إشراق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي العرب ورسول البشر فجراً صادقاً وضاء، وحدا فاصلاً بین الشرك والتوحيد، والباطل والحق، والغواية والهداية والظلم والعدل، والخوف والطمأنينة.
وکانت شریعته السمحاء، اسمی الشرائع تنزيلاً وأحسنها تبييناً وأعدلها قسطاساً، وأنهضها حجّة واوضحها محجة؛ فاستجابت لها العقول وانقادت لها القبائل، ودخل الناس في دين الله أفواجا.
ظلت شريعته تتنزل عليه تنزيلاً على حسب الوقائع والظروف وظل قيماً عليها إلى أن أكمل الله للمسلمين دينهم، وأفاض عليهم من نعمته ورضي لهم الإسلام ديناً.
وقبض النبي (ص) إلى الرفيق الأعلى والإسلام يترعرع في أحضان صحبه الأبرار وآل بیته الاخیار، وکانت لهم أكبر دولة تمشت على سنن الرسول الأعظم، واتبعت مبادئه العادلة وسننه التي سنها للعالم وللمسلمين.
وكان من الإسلام ابطال لمعت اسماؤهم في التاريخ الوسيط، قدّموا للعالم أكبر مثل فى العدالة الاجتماعية وتمت لهم فتوحات في الشرق والغرب، وكانت حضارتهم تجسيداً للنشاط العقلي، وسجلاً لتطور هذا العقل ومدى فعاليته في مختلف نواحي الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية وحربية وعمرانية
وإنَّ دراسة تاريخ العرب تتناول إلى جانب ذلك وسائل انتاج الإنسان ومستوی معیشته، وفنونه الجميلة، ومعتقداته الدينية، وأساطيره وعلومه، وادابه، ووسائل كفاحه المستمر مع الطبيعة.
وإن تاريخهم لم يعد كما عرفه المؤرخ الانكليزي: « ادوارد فريمان، تاريخ السياسة الماضية، بل إنه أصبح بالذات تاريخ الحضارة، والحضارة هذه فعل تام متحرك كالكائن الحي، تولد ثم تحبو طفلة طريّة العود، حتى إذا اشتد ساقها واينعت بدأ عهدها المزدهر أو شبابها المعطي، فإذا استنفذت طاقتها المخزونة بدأت تنحدر نحو الهرم والشيخوخة، وبدأ عطاؤها يشيخ وينضب الى أن تنقرض .
في كل حضارة بلا شك بذرة بقاء هي الإرث الحضاري الذي تتركه وراءها، وهذا الارث مشاع كالهواء، يمكن لكل أمة أن تفيد منه، كما يمكن لكل حضارة أن تتفاعل معه وتجعله لبنة في بنيانها، فالحضارة المنغلقة على نفسها مبتلاة بالعقم لأن جوهرها يفتقر الى بذرة بقاء، وحضارتنا الاسلامية واحدة من الحضارات المنفتحة على التاريخ، إنها من الحضارات الشاملة التي تأثرت بها شعوب مختلفة، ولعبت دورها المجيد في سير الحضارة البشرية .
ولو لم يكن لحضارتنا الا دور الوسيط الذي حمل الى الغرب أنفس ما في التراثين اليوناني والروماني لكفاها ذلك فخراً، ولجنبها تهمة الشُّحّ في العطاء التي يحاول بعض المتجنين على التاريخ إلصاقها بها .
قال غوستاف لوبون : « لقد انشأ العرب بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت قبلها، و تمکنوا بحسن سیاستهم من حمل أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم وثقافتهم، ولم يشذّ عن ذلك أقدم الشعوب کالمصریین و الهنود الذين رضوا أيضاً بمعتقدات العرب وعاداتهم.
إن الأمم التي غابت عن التاريخ لم تترك غير أطلال، وصارت أديانها ولغاتها ذكريات، اما الإسلام فما زالت عناصر حضارته باقية حية، فرسالة محمد العربي حاربت التراتب الطبقي البغيض واعلنت على لسانه: كلكم لأدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على أعجمي إلأ بالتقوى، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله – وإنه لمن الثابت أن جامعات أوروبية ظلت أكثر من ستة قرون تغتذي بكتب العرب العلمية؛ التي ظلت وحدها مادة التدريس فيها .
وهكذا فإن الإسلام لم يكن ديناً وعقيدة فحسب، بل هو ثورة اجتماعية مستمرة باقية ما بقيت الأرض ومن عليها. ثورة على كل ظلم وفساد ينتشر في الأرض، ثورة عارمة على كل نفسر مريضة، ثورة لا هوادة فيها على كل مشرك بالله الواحد الأحد.
فنبيُّ هذه الأمة لم يكن رسولاً للعرب وحدهم فحسب بل کان رسول محبة وسلام للعالمین، جاهد المشرکین و حارب الضالين وكان له فيما بعد النصر المؤزر، فارتفعت كلمة أشهد أن لا اله الأ الله وأن محمداً رسول الله في كل بقعة من بقاع الأرض نعمت في ظل الإسلام.
ومما تجدر ملاحظته في هذا الظرف بالذات أن الاسلام لم یکن دین تعصب مع أنه كان يقوم في العهد الماضي مقام القومية في الزمن الحاضر وكان في منطق العصور الخالية أن يستقل المسلمون بوظائف الدولة الاسلامية كما يستقل المسيحيون بوظائف الدولة المسيحية، لا حرج عليهم في ذلك ولا لوم ولکن المسلمین رغم ذلک اشرکوا المسیحیین والیهود في دولتهم و کانت هذه المشاركة تشتد أحياناً حتى تكاد تطغى.
قال آدم میتز : من الأمور التي تعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الاسلامية، فكان النصاری هم الذین یحکمون فی بلاد الاسلام. كما أن المسلمين قد ضمنوا الكيان الخاص لكل ديانة، وكان الذميون أحراراً في إقامة شعائرهم وقد عوملوا بالحسنی .
کما أن الخلفاء کانوا یأمرون بصیانة مؤسساتهم وکان للذمیین حرية مزاولة المهن والحرف والأعمال وكانت الدولة الاسلامية تبسط حمايتها علیهم، فإذا تعذر عليها أن تحميهم سقطت عنهم الجزية وأصبحوا في حل منها، كما انه لم يسمع عن محمد أنه قتل نصرانياً لأنه لم يسلم أو انه عذبه و سجنه أو منعه من التعبد علی طریقته، ولم ینقل عنه انه هدم کنیسة.
ولقد صالح نصارى نجران، وقال : لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وكل ما تحت أيديهم من قليل اوكثير.
على انه لابد من الاشارة هنا الى ناحية مهمة وهو أنه اذا كان نفوذ العرب السياسي قد زال نتيجة اسباب عديدة يأتي في طليعتها فساد العقيدة والترف والانقسامات السياسية، واذا كانت حضارة العرب قد اصبحت في ذمة التاريخ فإن ديانة العرب و لغتهم مازالتا حیتین باقیتین فلغتهم بقیت لغة الجمیع من المحیط الى الخليج وديانتهم مازالت تعاليمها السامية مستمرة في تمدين العالم بفضل ما حملته في جوانبها من المکارم.
كانت تحرك العرب في العصور الزاهرة روح الرسالة الاسلامية وفضائلها ومثلها وقد انقلب ذلك في عهد الأتراك الذين بذروا بذور التفرقة بين المسيحية والإسلام وكانوا هم المسؤولین عن ضیاع حضارتنا، وهم المسؤولون عن وجود التعصب الذمیم بین النصاری والمسلمین الذی مازلنا حتی الان نعاني منه اشد العناء فى محاربته والقضاء عليه.
ولهذا يتوجب على المصلحين وذوي النفوذ والسلطان آن یبادروا الی لمّ الشمل و توحید الکلمة بین المسیحیین والاسلام في هذا الصراع الذي أخذ يهدد حريتنا واستقلالنا في بلد تأخينا فيه وتحاببنا ، واذا استمر هذا الصراع الذي نعانيه فسوف تذهب ريحنا وسوف یستبد بنا عدونا المتربص عند حدودنا فنفقد استقلالنا وحریتنا.
المصدر: الفصل الأول من كتاب: الإمام علي الرضا وولاية العهد” للكاتب: إسحق شاكر العشي
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي