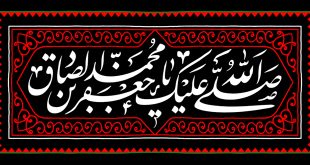خاص الاجتهاد: ارتكزت مدرسة الامام الصادق على أسس معرفية متينة، كانت الأنموذج الأمثل في التعايش السلمي بين المسلمين كافة، فهي كانت ثورة من نوعٍ آخر في تظهير حضارة الاسلام وإعلاء كلمته والاطاحة بالثقافات التجهيلية الجائرة التي ما انفكت في إخضاع شريعة الاسلام لمآربها ومصالحها الدنيويّة./بقلم: الشيخ محمد قاسم الطائي
عصر الازدهار العلمي مرهون بمساحة الحرية المطروحة، الحرية الفكرية تلك المعضلة أمام دكتاتوريات الفكر والسياسة والمال، مساحة الحرية معقودة بحقل التنوع ومصادر التعدد المعرفي الذي يدفع في تجاوز جدل الالغاء والتهميش، عند العودة لعصر الامام جعفر بن محمد الصادق يتضح بشكل لافت أن الفترة التي ازدهر فيها العلم والتصاعد المعرفي الديني هي تلك الفترة بالتحديد التي سادت فيها الانفتاحات المعرفية، والتي امتدت جذورها في رحاب الدور الرائد والأسمى للامام جعفر الصادق في خطوات تأصيلية للتشريعات الفقهية والكلامية والمعرفية والحديثية بالنحو الذي شيد بنيان أركان الشريعة من كافة الجوانب والحاجات، فقد انصبَّتْ جهوده الزاكية (سلام الله عليه) في تربية الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أصحابه وتلاميذه الذي كان يقدر عددهم بالآلاف.
شهد بدايات منتصف القرن الثاني تحولات جمة لمختلف العلوم والمعارف، والتي كانت فيما بعد البذرة الأولى للتأسيس المذهبي المتنوع، كما كانت المحطة للتلاقح والاختلاط المعرفي بين المدارس الاسلامية الفتية بحسب نشوء تلك الفترة، ففي الوقت الذي نجد فيه رواه وفقهاء كبار، نجد كذلك علماء كلام وكتّاب وخطباء وشعراء ونقاد أدب من الطراز الرفيع .
ارتكزت مدرسة الامام الصادق على أسس معرفية متينة، كانت الأنموذج الأمثل في التعايش السلمي بين المسلمين كافة، فهي كانت ثورة من نوعٍ آخر في تظهير حضارة الاسلام وإعلاء كلمته والاطاحة بالثقافات التجهيلية الجائرة التي ما انفكت في إخضاع شريعة الاسلام لمآربها ومصالحها الدنيويّة.
بعد فاجعة الطف نحى أئمة آل البيت منحى آخر في استراتيجية الخطاب والتبيان في مسألة التعامل مع قضايا الأمة ومشكلة الحاكم المستبد رغم كثافة الاقصاء وانتشار سياسات الاضطهاد التي مورست بحقهم وعتمّت عليهم بشدة، لكن ذلك لم يفضِ بهم لطرق الانعزال والابتعاد عن واقع الأمة السياسي والاجتماعي، وعن تلك المسؤوليات والمهام الجسام التي أُنيطت بنهضاتهم وبمشاريعهم الإلهية الحقة.
مدرسة الامام الصادق صلوات الله عليه شقت طريقها في أمواج متتابعة من التقلبات والانشقاقات والصراعات السياسية المحتدمة والمحيطة، خطت مجدها الرسالي قبيل انهيار الدولة الأموية، وبداية طلائع نجم الدولة العباسية، ضمت نهضته آلاف من طلّاب العلم ورواه الحديث والفقهاء والمتكلمين، سادت نشاطات الامام المعرفية ما بين أجواء الكوفة والحجاز، بيد أن الامام الصادق عليه السلام بقى في أرض الكوفة بحدود السنتين يواصل فيوضاته الربانية والعطاء الذي لا ينضب؛ قال محمد بن معروف الهلالي: مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد عليه السلام فما كان لي فيه حيلة من كثرة الناس، فلما كان اليوم الرابع رآني فأدناني… ومضى يريد قبر أمير المؤمنين عليه السلام فتبعته، وكنت أسمع كلامه وأنا معه أمشي.[1]
أدرك الحسن بن علي الوشا تسعمائة شيخ في مسجد الكوفة يتدارسون ويروون الحديث عن جعفر بن محمد وأبيه (عليهم السلام) وهو القائل في حديث له مع بعض اصحابة:« لقد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد،[2] وقد صنف الحافظ أبو العباس بن عقدة الهمداني الكوفي المتوفى سنة “٣٣٣هـ” كتاباً في أسماء الرجال الذين رووا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام فذكر ترجمة (٤٠٠٠) رجل[3] «لقد استفاد الإمام الصادق من ضعف القوى السياسية التي كانت من قبل تضيق عليه، وعلى الائمة من آبائه، بالنظر لأن عصره شهد ضعف وانهيار الكيان السياسي الأموي، ثم نشاط الحزب العباسي، وتأسيس الدولة العباسية وسط خضم من المنازعات والفتن، فانشغل الحكام بأمورهم هذه عنه مما أمكنه من فتح ابوابه لطلاب العلم والحقيقة، وجعله على اتصال مباشر مع الأمة يشحنها بمقومات الفكر والاصلاح والهداية»[4]
والحقيقة أن مدرسة الامام الصادق هي امتداد لأصول مدرسة الوحي الإلهي فهي امتداد طولي لحواضر مدرسة أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد وأبيه الباقر (عليهم السلام) مستمدة قوة مرجعيتها من هذه الينابيع والمعادن الصافية الحرة، سارت مدرسة الامام في إرساء نهضة فكرية عميقة توزعت أبعادها في مديات التأثير على الصعيد المعرفي والقيمي والمجتمعي بشتى التنوعات والمحطات العلاجية .
راج مصطلح التعايش السلمي في منتصف القرن العشرين إبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهو لفظ معاصر وله مدلولاته السياسية والدولية، لكن بطبيعة الحال استعمالنا له أعم من ذلك وفقاً لمؤشرات ومعطيات شامل لمضامين اجتماعية ودينية وفكرية. أن الجذور الحضارية لمدرسة الامام الصادق عليه السلام اتكأت في مساحتها التبليغية والاصلاحية بعدّة أمور:
1- توظيف القيم الأخلاقية، وهذا المعنى كثيراً ما أكد عليه في وصاياه وكلماته الشريفة من قبيل قيم الصدق والأمانة والأحسان والعدل والعفة عن الحرام وغير ذلك، وهذه القيم هي المعيار والمقياس للتدين من غيره، قال عليه السلام( لاَ تَنْظُرُوا إِلَى كَثْرَةِ صَلاَتِهِمْ وَ صِيَامِهِمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ اِعْتَادُوهُ فَإِنْ تَرَكُوهُ اِسْتَوْحَشُوا وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى صِدْقِ اَلْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ)[5] وروي عنه عليه السلام أيضاً :(إنّ الله عز وجل لم يبعث نبياً إلّا بصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر)[6]
بحسب تقسيم فلاسفة الاخلاق المعروف أن أفعال الانسان وسلوكياته يمكن تقسيمها إلى قسمين : افعال طبيعية واعتيادية شأنها شأن افعال الحيوانات الأخرى التي تصدر عن داوفع غريزية وطبيعية بيولوجية كالأكل والشرب والجنس .
وهناك أفعال وسلوكيات تستحق المدح والثناء ويمكن وصفها بالأفعال الأخلاقية، والتي ينظر لها البشر بعين الاعجاب والرضا والاشادة من قبيل- مثلاً- تضحية الجندي المقاتل بنفسه في سبيل وطنه ومعتقده، والانفاق على المعوزين والمحتاجين، والصفح عند المقدرة ونحو ذلك من الأفعال المحمودة التي يحكم بها العقل الأخلاقي بحسن الانبغاء والإتيان، بالتالي هذا المعنى هو الذي يساهم في رقي المجتمع وتقدمه.
2-أساليب مناهضة الظلم رغم أن الامام لم يدخل في صدام مباشر مع السلطة، لكنه اتخذ أساليب علاجية هامة في مواجهة الظلمة وأعوانهم، مرة من خلال نشر العلوم والمعارف الإلهية بين المسلمين ومرة من خلال إيصال رسائل تحذير لشيعته وخواصه في خطورة وحساسية التعامل مع السلطان الجائر، في الوقت ذاته التوصيات الأكيدة بحقن دمائهم من خلال اتباع ارشاداته كالعمل في التقية والمداراة ونحو ذلك، الظلم من أهم الآفات والمهلكات التي فتكت بالمجتمع البشري قديماً وحاضراً، جاء في بعض المروايات أن أحدهم سأل الإمام نفسه قال له:
« إني رجل أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني بذلك داخلاً في أعوان الظلمة؟! قال له الامام : المعين من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم»[7] عنه (عليه السلام):« من عذر ظالماً بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته»[8] وهذا يبرهن بوضوح أن الظلم من أهم العقبات الكؤود التي تقف في طريق الحضارة الانسانية والتعايش السلمي الناهض.
3- المرونة الاجتماعية في التعامل مع الآخر جمعت مدرسة الامام الصادق عدد كبيراً من المسلمين من جميع أنحاء العالم الاسلامي وبمختلف الآراء والانتماءات السياسية والدينية، ومن خلال التدقيق في كلمات أئمة المذاهب المادحة بحقه، يتضح أن جامعة الامام الصادق أكبر مما يتصور في تلك الحقبة بل كانت لها المركزية الأولى في نشر معارف الاسلام، لذلك أن أبا حنيفة – إمام المذهب الحنفي كان يقول:
«لولا السنتان لهلك النعمان» ويقصد بالسنتين اللتين تلمذ بهما على يد الإمام الصادق، كذلك مالك بن انس – إمام المذهب المالكي – أنه قال: « ما رأت عين ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً، وعلماً، وعبادة وورعاً، وكان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد»[9] مضافاً أن الامام حث لزيارة مرضاهم وحضور تشييع جنائزهم، وعدم الذهاب للقطيعة مع الآخر لأسباب عديدة منها أقلية الشيعة في ذلك الوقت الذي قد يعرضهم للخطر والابادة،
مضافاً أن سمات مكارم الأخلاق والإلتزام بآداب الأئمة الهداة، يقود الناس لمعرفة الاسلام الحقيقي الذي حاول الأمويون وحكّام الجور بشتى الطرق والأساليب طمسه وتضييع هويته ومعالمه الرشيدة، حتى جاء عنه عليه السلام: إنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق الحديث، وأدى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري، فيسرني ذلك، ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر.
4- البعد العقلاني المتوازن من جهة الحفاظ على مساحة الغيب للدين، ومن جهة أخرى إعمال العقل في ميدان الحياة والأصول حسب الدستورية العامة التي حددت صلاحيتها الشريعة. والحقيقة هذه المسألة تعد من أكثر الإثارات العلميّة التي وقعت في اواسط القرن الثاني الهجري بخصوص مساحة إدراك العقل وميدان فعاليته التي دارت بين الإتجاهات الإسلاميّة آنذاك تحديداً بين المدارس الكلاميّة ( الاشاعرة والمعتزلة والإمامية) وقد عُرف إتجاه الاماميّة والمعتزلة بــ (العدليّة) جاء تعريف العقل عند الامام الصادق بعدّة صيغ منها قوله:
( العقل مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ)[10] كذلك ورد عنه عليه السلام : ( مَنْ كَانَ عَاقِلًا كَانَ لَهُ دِينٌ ، وَ مَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ )[11] ونحو ذلك، فالامام لم يحدد العقل كقوة مدركة وهبهها الله فحسب، وإنما قوة مزودة بمعدات وإدركات بعدية تقود الانسان للكمال والسعادة الأبدية.
وعلى هذا الأساس ذهب متكلمو العدليّة أن هناك افعالاً يدركها العقل من صميم ذاته من دون الاستعانة بالشرع على أنها حسنة يجب القيام بها، أو قبيحة يجب التنزه منها مثل حُســن العدل وقبح الظلم ما عُرفت بــ”التحسين والتقبيح العقليين ” ومع غض النظر عن تفاصيل إطلاقتها الثلاث المذكورة في ابحاث علم الكلام وأصول الفقه، كذلك مع صرف النظر عن تقسيمات الأَفعال الدائرة بين المتكلمين من حيث الإتصاف بالحُسن والقبح .
مسألة الحسن والقبح العقليين تُعتبر من أهم المسائل التي توزعت عليها مفاصل البحث الكلامي وأخذت موقعاً اساسياً في الفكر والعقيدة، وقد بُنيت عليها شتى المسائل والقواعد، ودخلت بإطارها العقلي في المباحث الأصوليّة لتنجب تلك الصغريات و المسائل المرتبطة ذات الصلة بالعقل سواء ما يتعلق بملاكات الاحكام أو ما يتصل بلوازم الأحكام، محل الشاهد أن الأحكام القيمية والأخلاقية العقلية تحافظ على البنية المجتمعية من خطر الغلاة والمرجئة والزنادقة والملحدين، كما كانت للإمام الصادق مناظرات واحتجاجات عديدة معهم كان أحد أساسياتها توظيف العقل العملي في إبطال معتقداتهم وآرائهم الشاذة، والحمد لله أولاً وآخراً .
الهوامش
[1] تاريخ الكوفة للبرقي ص404
[2] رجال النجاشي ترجمة(الوشا)ص31
[3]تاريخ الكوفة للبرقي ص408
[4] دائرة المعارف الشيعيةج2-ص78-79
[5] الكافي ج2-ص104
[6] المصدر نفسه ص104
[7] كتاب المكاسب ج2-ص58
[8] الكافي ج2- ص334
[9] الامام الصادق ج1-ص142
[10] معاني الأخبار ص240
[11] بحار الأنوار ج1-ص91
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي