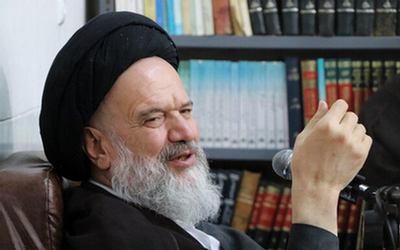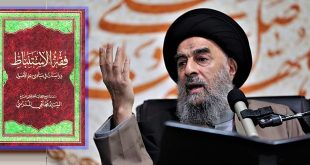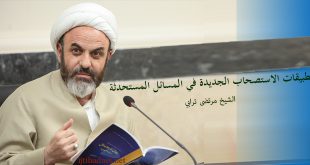خاص الاجتهاد: تنقسم مباحث علم الأصول أساساً إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: يتعلق بمصادر ومنابع التشريع، وهي بالدرجة الأولى الكتاب والسنّة. ثمّ تُضاف إليها أمور أخرى ـ من قبيل: الإجماع، والرأي (الذي يُقصد به القياس)، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع ـ.
وفي خصوص مذهب مالك، يُضاف إلى ذلك إجماع أهل المدينة، بمعنى أنّه إذا اتّفق علماء أهل المدينة في أيّ زمان على حكمٍ ما، فإنّ هذا الاتفاق بحدّ ذاته يكون حُجّة (فأهل المدينة أنفسهم لهم هذه الخصوصية).
ثمّ، بالإضافة إلى الإجماع، تُضاف الشورى، وهي تعني أنّه إذا اجتمعت مثلاً مجموعة من العلماء وأجروا تصويتاً، وكان رأي الأغلبية موافقاً لشيءٍ ما، فإنّ هذا الرأي بحدّ ذاته يُعتبر حُجّة شرعية (أي: يمكنه تخصيص القرآن والإطلاقات). وطبعاً هذه المطالب والبحوث ليست موجودة الآن في الكتب الأصولية التي تدرسونها، وربما لم يوردوها حتى في كتبهم المشهورة، ولكن ابن حزم قد أوردها في كتابه «الإحكام».
القسم الثاني: يتعلق بالأمارات والحُجَج والأصول العملية. جميعه، أي كلّ الأصول التي تبلورت، إنما بُنيت على هذا الأساس.
فقسم منه يتناول مصادر التشريع. ثمّ جرت بحوث مطوّلة حول مصادر التشريع؛ فمثلاً، بالنسبة للقرآن، فمن المحتمل أنّ الشيعة أنفسهم كانوا يمتلكون كتباً في علوم القرآن منذ أواخر القرن الثاني. وبما أنّ القرآن كان المحور الأساسي والركن الجوهري للإسلام، فقد جرى بحثه من زوايا مختلفة:
مباحثه الكُبروية طُرحت في علوم القرآن وفي علم الأصول.
بينما مباحثه الصُغروية طُرحت في الفقه والتفسير.
المبحث الذي ظهر بشكل أكبر في أصول أهل السنّة هو مسألة القياس. ولأنّ القياس لم يكن له وضعٌ واضح، فقد قاموا بالكثير مما يُسمّى “الصقل والتنقيح” عليه لجعله مستقيماً وصحيحاً. [1] كما أنهم عملوا على مسائل الإجماع أيضاً.
[2] وتدريجياً، بدءاً من القرنين السادس والسابع، عندما ألّف القاضي عبد الجبّار وآخرون مجلّدات ضخمة في الأصول، لم يقتصر الأمر على أهل السنّة فحسب، بل إنّ الزيديّة (مثلاً) يملكون أيضاً مؤلفات في الأصول.
1. “الرأي” و”القياس” هما شيء واحد. يعتقد أهل السنّة أنّهم كانوا يُطلقون عليه اسم “الرأي” في القرن الأول في زمن الصحابة والتابعين، بينما سمّوه “القياس” في زمن الفقهاء (القرن الثاني). أمّا ما يُقال عندنا الآن: «إنّ القياس هو ذاته التمثيل المنطقي»، فليس هذا بصحيح.
2. كانت الزيديّة متواجدة في الكوفة حتى حوالي سنة 300 ـ 350 هـ (وهي فترة دخول آل بويه إلى بغداد، ويُقال إنّ هؤلاء كانوا أيضاً زيديّين)، وكان لهم باع طويل في علم الحديث. فشخصية مثل ابن عقدة (ت 333 هـ)، الذي كان محدّثاً كبيراً جداً، وحتى فُرات بن إبراهيم (صاحب «تفسير فرات») ـ الذي من المرجّح بقوة أنّه زيدي ـ كان لهم اشتغال في الحديث.
مع قدوم آل بويه إلى بغداد، انتقل الزيديّة إليها، وهناك انخرطوا في البداية في علم الكلام بشكل كبير، وإلى جانبه دخلوا في علم الأصول أيضاً. وكان انخراطهم الأكبر في الكلام، خاصةً أنّهم كانوا يمتلكون تقارباً كبيراً مع المعتزلة في علم الكلام (حتى إنّ ابن أبي الحديد، الذي هو معتزلي، كان أستاذه أبو جعفر النقيب، من الزيديّة).
واستمر تأثيرهم في المسائل الكلامية ببغداد، بعد انتقالهم إليها من الكوفة، حتى حوالي زوال الدولة العباسية (سنوات 650 ـ 700 هـ). كما أنّ لديهم قدراً من علم الأصول (ولديهم الآن كتب أصولية مفصّلة نسبياً).
بعد ذلك، انتقلوا إلى اليمن، وفي اليمن أصبحوا في عوالمهم الخاصة (أي: انقطعوا عن العالم الإسلامي منذ سنوات 700 هـ تقريباً؛ بمعنى: انقطعت علاقاتهم وتواصلهم).
بينما كانوا في الكوفة، كان لديهم ارتباط وتواصل مع الشيعة والسنّة. وشخصية مثل ابن عقدة، كان يحترمه الجميع من أهل السنّة والشيعة والزيديّة، لأنّه كان محدّثاً كبيراً، فكان الكلّ يستفيد منه. وفي بغداد، كان المعتزلة يتفاعلون مع الزيديّة، لكن بعد انتقالهم إلى اليمن، أصبحوا شبه منعزلين، وإن كان لديهم آثار، فهي متداولة فيما بينهم (آثار تُتلقّى وتُعرف بينهم فقط).
المصدر: آخر دورةدرس البحث الخارج في أصول فقه / الجلسة الأولى / 4 جمادي الأولى 1444 هـ.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي