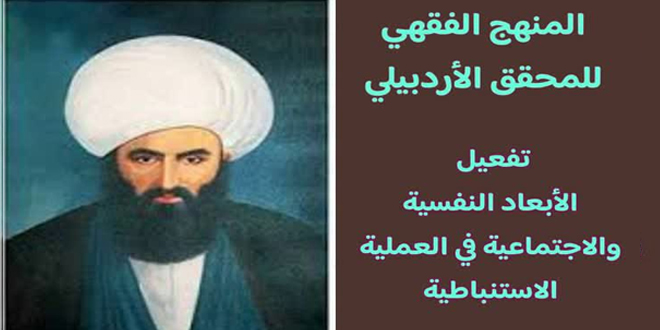الاجتهاد: إنّ من دقائق فقه المحقق الأردبيلي أنّه لم يكتفِ بالظواهر، ولم يُحصر فهمه في مجرّد الألفاظ، بل جعل للنفس نصيباً، وللاجتماع وزناً، في قراءة النصوص وتنـزيل الأحكام.
فهو يقرأ النصّ لا في فراغٍ ميتٍ، بل في فضاءٍ حيّ، حيث يتنفس الإنسان، ويتحرك المجتمع، وتتشابك الأهواء مع المصالح.
وهذه المنهجيّة تبرز بوضوح في موضعين:
١. التمييز بين «البغض» و«الاستثقال»
كم من حالاتٍ تتشابه في ملامحها، وتختلف في جواهرها! كالنهرين يجريان في وادٍ واحد، ومخرجهما من جبلين متباينين. هاهنا يرفع المحقق الأردبيلي قلمه، فيرسم خطّاً فاصلاً بين «الاستثقال» و«البغض».
فالاستثقال ـ عنده ـ ثِقَلٌ عارض على القلب؛ قد يكون من إعياءٍ أو فتور، أو من انشغالٍ وهمومٍ. لا يحمل عداوةً، ولا ينطوي على خصومة. وأما البغض، فهو نارٌ مشتعلة في باطن الاجتماع، جذورها في الشقاق، وثمرتها في العداوة والانقسام.
ومن ثمّ يردّ على من فسّر «بغض المؤمن» بالاستثقال قائلاً بصرامة ودقّة:
«والظاهر أن مجرد الاستثقال ليس ببغض، لا لغةً ولا عرفاً…»
ولو عُدّ كلّ ضيقٍ عارضٍ بغضاً، لتحولت حياة المؤمنين إلى زقاقٍ ضيّقٍ، لا يهنأ فيه عابر، ولا يستريح فيه جار. فكان بهذا التمييز، يضع الفقه على سكة الواقع، ويُبقي النصّ منسجماً مع نبض الحياة.
٢. نقد الاستنباط المجرّد عن الواقع
وحين بلغ إلى أقوال الفقهاء في حرمة الهجر، إذ جعلوا كلّ هجرٍ حراماً، لم يُسلم لهم بالقول ولم يَسْكُن في حصار الحرف، بل ردّ الأمر إلى ميزان الاجتماع. فصرّح قائلاً:
«وإذا كان هجر كلّ واحدٍ حراماً، فلا يشتغل بشيءٍ إلا التزاور…»
وكأنّه يقول: لو كان ترك المعاشرة في كلّ حالٍ ممنوعاً، لغرق الإنسان في طوفان الزيارات، ولم يبقَ له وقتٌ للعمل ولا للعبادة. فجاء بفقهٍ يوازن بين التكليف والإمكان، بين النصّ والواقع، بين الفرد وحاجات الجماعة.
ومن هنا فرّق بين هجريْن: هجرٍ يخرج من رحم البغضاء والعداوة، وهو المذموم الممنوع؛ وهجرٍ يولد من طبيعةٍ فرديةٍ أو شغلٍ دنيويّ، وهو المباح المأذون. فكان بهذا ينسج شبكةً من التوازن، تحفظ وحدة الإيمان، وتترك للفرد فسحةً من حريةٍ وراحة.
٣. الاستشهاد بالتجربة التاريخية
ولم يقف عند النصّ وحده، بل أيّد فهمه بمرآة التاريخ، فاستحضر سيرة الصلحاء والأولياء، بل والأنبياء أنفسهم، إذ قال:
«ولهذا ترى أنه واقع من الصلحاء والأتقياء بل الأنبياء والأولياء…»
ليؤكد أنّ النصّ ليس أسيراً للتجريد، بل هو شاهدٌ على حياةٍ جارية، وتجربةٍ بشريةٍ ماضية، وأنّ ما جرى في سيرة الأخيار شاهدٌ على إمكان الجمع بين النصّ والحياة.
استنتاج منهجی
وما هذه إلا نماذج يسيرة، غير أنّ وراءها حقيقةً كبيرة: أنّ النصوص، إذا كانت تحمل أحكاماً ذات طبيعةٍ نفسية-اجتماعية، فإنّ فهمها من غير مراعاةٍ لهذه الأبعاد خطرٌ على الفقه، وإزراءٌ بالواقع. إذ قد يخرج الحكم يومئذٍ غريباً عن الناس، ثقيلاً على الحياة، عاجزاً عن التطبيق.
فالفقه الحقّ، عند الأردبيلي، ليس أن نُنزِل النصّ على الورق وحده، بل أن نسمع صوته في قلب الإنسان، ونرى أثره في جسد المجتمع، وأن يكون التكليف منسجماً مع الطاقة، والحكم ملتحماً مع الحياة.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي