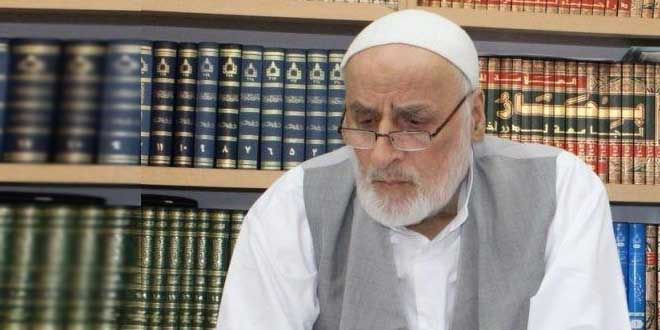إن دعوى: أن معظم اليهود والنصارى وغيرهم، وسائر أهل الملل والنحل، حتى من اختار الشرك، لا يعذبهم الله لكونهم قاطعين، بأحقية ما هم عليه لا يمكن قبولها.. لأن الله تعالى يقول عن هؤلاء: إنهم لا قطع لديهم، وإن ادَّعوا ذلك.. فقد قال تعالى عن المشركين: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. وقال تعالى عن المشركين أيضاً: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾. وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.
الاجتهاد: السؤال: ما حقيقة ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي من قول البعض: إن الكفار معذورون بسبب قطعهم، ولا يعذبهم الله، ولا يعاقبهم، لأن القطع حجته ذاتية، وأن علماء سائر الأديان، بسبب بيئتهم يقطعون بصحة دينهم، وبطلان دين غيرهم، وإنما يعاقب الجاحد فقط، وهؤلاء الذين يتركون الناس ويذهبون إلى صومعتهم، إنما يعبدون الله..
يقول الإمام الخميني في كتاب المكاسب المحرمة ج1 ص133: بل لأن أكثرهم، إلا ما قلَّ وندر جهال قاصرون لا مقصرون.
أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم، وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم، وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم، لأجل التلقين والنشؤ في محيط الإسلام، كذلك عوامهم، من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه، ولا يكون عاصياً وآثماً، ولا تصح عقوبته في متابعته.
وأما غير عوامهم، فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشؤ في محيط الكفر: صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشؤهم، فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له، لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه .
نعم، فيهم من يكون مقصراً لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عناداً، أو تعصباً، كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان كذلك..
وبالجملة، إن الكفار كجهال المسلمين، منهم قاصر وهم الغالب، ومنهم مقصر، والتكاليف أصولاً وفروعاً مشتركة بين جميع المكلفين عالمهم وجاهلهم، قاصرهم ومقصرهم.. والكفار معاقبون على الأصول والفروع، لكن مع قيام الحجة عليهم لا مطلقاً، فكما أن كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه: أنهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين، أم مقصرين، كذلك الكفار طابق النعل بالنعل بحكم العقل وأصول العدلية.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
فإنني أحب أن أشير إلى النقاط التالية:
1 ـ دلت بعض الروايات الشريفة على أن الله تعالى يريد من البشر: أن يعبدوه وفق ما رسم وقرر وأراد، لا وفق ما أرادوه، ومالت إليه قلوبهم، ودعت إليه شهواتهم.. ولا يختلف هذا الأمر بين الواجبات والمستحبات، حتى في مجال الأدعية..
وفي النصوص دلالات على ذلك، فلاحظ ما يلي:
ألف: روي: أن النبيّ «صلى الله عليه وآله» علّم البراء بن عازب دعاءً فيه هذه الكلمة: «..ونبيك الذي أرسلت..». فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، قال: «..ورسولك الذي أرسلت..». فقال له «صلى الله عليه وآله»: «لا، ونبيك الذي أرسلت»([1]).
ب: وعن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله «عليه السلام»: «ستصيبكم شبهة؛ فتبقون بلا عَلَمٍ يرى، ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق.
قلت: وكيف دعاء الغريق؟! قال: تقول: «يا الله، يا رحمان، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك». فقلت: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»([2]).
ج: وروي عن الإمام الباقر «عليه السلام» (وفي الوسائل والمحجة: الجواد)، في حديث فضل الرجل الأكثر أدباً من صاحبه عند الله: أنه «عليه السلام» علّل ذلك بقوله: بقراءته القرآن من حيث أنزل([3])، ودعائه الله من حيث لا يلحن، وذلك أن الرجل ليلحن؛ فلا يصعد إلى الله..
وحسب ما في الوسائل: فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله([4]).
2 ـ قال تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾([5]).
3 ـ إن الأئمة «عليهم السلام» قد عرَّفونا بالمراد من المستضعفين، فلاحظ الروايات التالية:
ألف: عن علي بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة، فاحتبس الجواب علي، ثم أجابني.. إلى أن قال: وسألت عن الضعفاء، فالضعيف من لم ترفع إليه حجة، ولم يعرف الإختلاف، فإذا عرف الإختلاف فليس بضعيف([6])..
ب: وروي بسند صحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله «عليه السلام»: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف([7]). وروي ذلك بسند آخر عن أبي حنيفة، عن رجل من أصحابنا، عن الصادق «عليه السلام»([8]).
ج: روى القمي «رحمه الله» عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي([9])، عن أبي جعفر «عليه السلام» قال: قلت له: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد «صلى الله عليه وآله»، من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولايتكم؟!
فقال: أما هؤلاء، فإنهم في حفرهم، ولا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح، ولم يظهر منه عداوة، فإنه يُخدّ له خدّ إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب، فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة، حتى يلقى الله فيحاسب بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار، فهؤلاء الموقوفون لأمر الله.
قال: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبُله، والأطفال، وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم.
وأما النصَّاب من أهل القبلة، فإنه يخدّ لهم خدّ إلى النار التي خلقها الله بالمشرق، فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان، وفورة الجحيم إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم([10]).
د: وروى سليم عن أمير المؤمنين «عليه السلام» حين قال له الأشعث: «والله لئن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمة غيرك وغير شيعتك!
فقال «عليه السلام»: إن الحق والله معي يا ابن قيس كما أقول، وما هلك من الأمة إلا الناصبين، والمكابرين([11]) [المكاثرين]([12])، والجاحدين، والمعاندين..
فأما من تمسك بالتوحيد، والإقرار بمحمد والإسلام، ولم يخرج من الملَّة، ولم يظاهر علينا الظلمة، ولم ينصب لنا العداوة، وشك في الخلافة، ولم يعرف أهلها وولاتها، ولم يعرف لنا ولاية، ولم ينصب لنا عداوة، فإن ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله، ويتخوف عليه ذنوبه»([13]).
وقد يستفاد من هذا: أنه لا يحكم بالإستضعاف فيما يرتبط بالأمور الثلاثة الأولى.. والإستضعاف إنما يكون في سائر الأمور، وهذا يعطي: أنه لا يوجد أحد من البشر يعذر في إنكاره لهذه الأمور الثلاثة، وهي: التوحيد، والنبوة، والإسلام.. ولأنها مقتضى فطرة البشر، ومقتضى عقولهم.. ولكنهم قد يعذرون إذا كان الإستضعاف بمستوى البداهة والطفولة، حتى لو راهقت البلوغ، فادِّعاء القصور في هذه الأمور لغير المسلمين قلُّوا أو كثروا في غير محله.
هـ: عن الإمام الصادق «عليه السلام»: «إن الرجل ليحبكم وما يدري ما تقولون، فيدخله الله الجنة، وإن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون، فيدخله الله النار»([14]).
قال العلامة المجلسي: «ظاهره المستضعفون من العامة، فإن حبهم للشيعة علامة استضعافهم، ويحتمل المستضعفون من الشيعة أيضاً. أي ما يدري ما تقولون من كمال معرفة الأئمة»([15]).
و: روى الصدوق عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر، قال: سألته عن المستضعفين، فقال: البلهاء في خدرها.
والخادم تقول لها: صلِّي فتصلي، لا تدري إلا ما قلت لها. والجليب الذي لا يدري إلا ما قلت له. والكبير الفاني. والصبي الصغير.. هؤلاء المستضعفون.
فأما رجل شديد العنق، جدل، خصم، يتولى الشراء والبيع، لا تستطيع أن تغبنه في شيء تقول: هذا مستضعف؟! لا ولا كرامة([16]).
ز: سأل زرارة أبا جعفر «عليه السلام» عن هذه الآية ـ أعني قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾([17]) ـ فقال: هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيل الإيمان فيؤمن، والصبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم([18]).
ح: روي عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: ما تقول في المستضعفين؟!
فقال لي ـ شبيهاً بالمفزع ـ: وتركتم أحداً يكون مستضعفاً؟! وأين المستضعفون؟! فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق [إلى العواتق] في خدورهن وتحدث به السقايات بطريق المدينة([19]).
وسيأتي: أن وسائل الإعلام المنتشرة في كل بقاع الأرض تنشر أخبار ما يجري في العالم، بل أوصلت خبر وجود الأديان المختلفة إلى معظم أهل الأرض، فإن وجد من لا يعلم بشيء من ذلك، فهو مستضعف.. ولكن هؤلاء هم مجموعات ضئيلة جداً، والسواد الأعظم ليس كذلك([20]).
والكلام إنما هو في قولهم: إن أكثر الناس معذورون، وإن قطعهم هو سبب معذوريتهم، ونحن لا ندَّعي: أن جميع الناس غير معذورين، بل نقول: هناك معذورون بقطعهم، وهم الغافلون غفلة حقيقية تامَّة، والمستضعفون العاجزون، الذين لا يجدون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً، وهؤلاء هم الأقلون في زماننا هذا.
ط: عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، عن عمر [و] بن إسحاق، قال: سئل أبو عبد الله «عليه السلام»: ما حد المستضعف الذي ذكره الله عز وجل؟! قال: من لا يحسن سورة من القرآن، وقد خلقه الله عز وجل خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن([21]). وهناك روايات أخرى، لا نرى ضرورة لإيرادها.
4 ـ وبعدما تقدم نقول:
نستفيد من هذه الروايات أموراً كثيرة، نذكر منها:
ألف: إن الضعيف هو من يشبه الصبيان في ضعف الإدراك، وعدم الإستيعاب للأمور، وهو ما يسمى في أيامنا هذه بالمتخلف عقلياً، وإن كان يفعل ما يؤمر به، كما أن من لم تصل إليه الحجة يعدُّ مستضعفاً، ويعذر كما يعذر من وصلته الحجة ولم يعقلها.. وهناك من يتمثل ضعفه بعدم معرفته بالإختلاف بين الناس في الأمور الإعتقادية والدينية، إما لظروفه، وإما لضعف إدراكه.. فإذا عرف الإختلاف وجب عليه البحث عن الحق، ولا يكون مستضعفاً، والبحث عن الحق إنما يكون من خلال الحجج والأدلة.
وهناك من يكون غافلاً عن لزوم تحصيل الدليل، واعتمد على ما وصل إليه من محيطه وبيئته.. فهذا إنما يعذر ما دام غافلاً، فإذا وجِّه إليه سؤال عن دليله على صحة ما يعتقده، وبطلان ما يعتقده غيره، وتحيَّر في الجواب، فقد زالت غفلته، ووجب عليه تحصيل الدليل.
ب: إن من يعرف بوجود اختلاف بين الناس في الإعتقادات، ولكنه لا يهتم له، ولا يبحث عنه، فهذا ليس بمستضعف، كما ذكرت الروايات، ويعاقب على اعتقاداته المخالفة للحق.
ج: أما الذين ينصبون العداوة لأهل الحق، وللأئمة الطاهرين «عليهم السلام»، فلا عذر لهم، بل يكون مصيرهم إلى النار، لخروجهم عن دائرة الإستضعاف، لمعرفتهم بأهل الحق وعداوتهم لهم.
د: وقد دلَّ حديث سليم عن أمير المؤمنين «عليه السلام»: على أن المسلم المكابر يدخل النار لانه يرى الحق ولا يخضع له، ويرفض قبول الحجة عليه رغم وضوحها له. والجاحد يدخل النار لجحوده للحق الذي تيقنه في قلبه على قاعدة: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾. أي أعلنوا إنكار الحقائق ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾. وكذلك المعاند، وهو من يُعلم أنه أبصر الحق، ولكنه يرفض قبوله، والإنصياع له، استكباراً وعلواً.
كما أن الناصب يدخل النار، لمعرفته بوجود الخلاف، وهو يساهم فيه، ولكنه لا يريد الحق، بل يحاربه بكل ما أوتي من قوة وحول، انقياداً منه لمشاعره، الناشئة عن خبث باطنه، وحقده، فينصب العداوة لمن يجب عليه أن يتولاهم.
أما المسلم الشاك في الإمامة، ولم ينصب العداوة للإمامة وأهلها وولاتها، فهو مسلم مستضعف في بحثه عن الحقيقة، فإن عاجله أجله يحاسب بما قدَّمه من عمل..
هـ: إن الروايات التي حددت الضابطة التي يكون الإنسان بها مستضعفاً ومعذوراً: بأنه الذي لم يعرف الخلاف، ولم تصل إليه حجة بعضها صحيح السند.
و: إن رواية زرارة المتقدمة عن أبي جعفر في تحديد المستضعف، يريد بها أن عدم القدرة على الإيمان والكفر الذي يجعل الإنسان في دائرة الإستضعاف هو عدم القدرة الناشئ من فقد الحجة، وعدم امتلاكه دليلاً يدله على الإيمان لكي يلتزم به.
كما أنه «عليه السلام» قد جعل القصور العقلي إلى درجة أن يكون عقل رجل أو امرأة من الناس، مثل عقل الصبيان الذين رفع القلم عنهم..
وقد أكدت ذلك رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر أيضاً. حيث ذكرت مثالاً على الإستضعاف عدة أشخاص، مثل: البلهاء، والخادم التي تفعل ما تؤمر به، ولا تدري ما قلت لها، والذي يؤتى به إلى بلاد الإسلام، ولا يعرف إلا ما يقال له، والكبير الفاني، والصبي الصغير..
فأما الرجل المعتدّ بنفسه، الذي يجادل ويخاصم، ويشتري ويبيع، ولا تستطيع أن تغبنه، فليس بمستضعف.
ز: وقد صرَّحت رواية سفيان بن السمط عن الإمام الصادق «عليه السلام» بعدم وجود مستضعف في زمان الإمام «عليه السلام»، فإن الخلاف بين المسلمين كان ظاهراً جلياً لكل أحد، وذلك لنشاط شيعة أهل البيت «عليهم السلام» في طرح الأمور الإعتقادية والخلافية، حتى بلغت أخبار ذلك إلى ربات الحجال في خدورهن، وحتى تحدثت به السقايات بطريق المدينة..
وبعدما تقدم نقول:
هل يسوغ القول في أيامنا هذه ـ بناء على هذه القاعدة التي وضعها الإمام الصادق والإمام الباقر، وسائر الأئمة «عليهم السلام»، وبيَّنوها، وأوضحوها بالشواهد والبراهين ـ: إن المستضعفين هم أكثر الناس، بحيث يكون من عداهم قِلَّة قليلة لا تكاد تظهر، ولا تستحق أن تذكر؟!
وهذه الحروب التي تخاض بين المختلفين في الأديان في الأمة، استناداً إلى هذا الإختلاف، وهذا الهجوم الإعلامي الشرس، بكل هذه الوسائل على شيعة أهل البيت، وتكفيرهم، واستحلال قتلهم، وسبي نسائهم، واغتنام أموالهم، قد طبق الآفاق، وانتشر ووصل إلى كل بيت، وسمع به القاصي والداني.. أفلا يكفي ذلك ليعرف الناس كلهم، أو جلهم بوجود عقائد ومذاهب وأديان متباينة ومختلفة بين الناس؟!
ونحن لا نتكلم عن الحكومات، ولا عن أهل السنة والشيعة، بل نتكلم عن أن جميع المسلمين، إلا ما شذَّ وندر يعرفون وجود مذاهب إسلامية، فعليهم أن يبحثوا عنها، ويتعرفوا عليها، ويأخذوا بما هو فيها.
ومعظم الشعوب الأخرى في العالم تعلم بوجود أديان متعددة، فعليهم أن يبحثوا عنها، ليصلوا إلى دين الإسلام، بعنوانه العام، ثم يصلون إلى التشيع من بين سائر المذاهب الإسلامية.
وعلى كل حال، فإننا نحب الإشارة هنا أيضاً إلى ما يلي:
أولاً: ما دمنا في دائرة النصوص من الآيات والروايات، فإننا نقول:
إن من يقول: بأن قطع الكافر والمشرك، وغير المؤمن ـ بالمعنى الأخص ـ يجعله معذوراً، ولا يعاقب على كفره، أو على ضلاله، فعليه أن يبيِّن لنا كيف يتلاءم قوله هذا مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾؟!([22]).
فإن المشركين حسب قوله، إذا كانوا قاطعين بالشرك لا يعاقبون على شركهم، ولكن الآية صريحة: بأنهم لا يغفر لهم.. الأمر الذي يفتح باب مواجهة المشرك بالعقوبة على شركه، بالرغم من قطعه به.. والكلام إنما هو في مورد القصور والعجز عن الوصول إلى الحق.
إلا أن يدَّعي هؤلاء: أن ما توصل إليه بعض الناس بعقولهم القاصرة ينسخ هذه الآية المباركة، ويلغي مضمونها.. فهل يرضى أحد أن ينسب هذا المعنى إليه؟! وألا يؤدي قبوله بهذا الأمر إلى الكفر والهلاك؟!
ثانياً: إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن الكافرين تعدّ بالمئات، وكذلك الآيات التي تحدثت عن المشركين والمنافقين، وأهل الكتاب، والقتلة للناس، والظالمين، ومن يحادد الله ورسوله، ومن ينكر الآخرة، وغير ذلك.. وقد توَّعدهم الله تعالى بالعذاب، وبالخلود في النار([23])، وذكر أنهم في الدرك الأسفل منها، وأمر بقتلهم، وقتالهم، كما أنه لو كان القاطع معذوراً لم يصح قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾([24])، حيث لم يستثن القاطعين منهم بالكفر والشرك.. بل استثنى الله فقط المستضعفين القاصرين، وهم الذين ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ يوصلهم إلى الهداية، وقد شرح لنا الأئمة «عليهم السلام» معنى هذا الإستضعاف، حسبما تقدم.
والمستضعفون بالمعاني التي بيَّنها الأئمة «عليهم السلام» هم أقل القليل، بل تقدمت الرواية عن الإمام الصادق «عليه السلام»: أنه لم يبق مستضعف في زمانه.
ثالثاً: لو كان قطع الإنسان يمنع من العقوبة الإلهية، فذلك يعني عدم جواز معاقبة من قتله القاطع حتى لو كان المقتول نبياً، أو وصياً، أو من هدم الكعبة، أو أباد أمَّة بأسرها، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، بل تكون عقوبته ظلماً وعدواناً.
ولا معنى لمحاربة الباغي كمعاوية، كما لا معنى لقتال النبي للمشركين.. بل لا معنى لقتال كسرى وقيصر.. ولا يجوز التصدي للمعتدين والغزاة، والبغاة على الإمام، والظالمين، إذا كان يحتمل أن يكونوا قاطعين بصوابية أفعالهم، كما لا يجوز التصدي للساعين لهدم الإسلام، وطمس الحق، لأنهم يفعلون ما هو سائغ لهم..
بل لا بد من البحث عن القاطع في الجيش الغازي، وتمييزه عن غيره، وتحاشي الإساءة إليه، ولو بكلمة، وتكون الحرب ضد الجاحدين، والمقصرين دون سواهم، وهم أقلُّ القليل في ذلك الجمع..
والقول: بأن القاطع المعذور مقيَّد بعدم كونه محارباً، ولا ساعياً في هدم الإسلام غير مقبول، إذ لا دليل على هذا التقييد، ولا شاهد.. وهو يسقط مقولة: أن القطع في نفسه، ومن حيث هو قطع يقتضي المعذورية..
ولنا أن نسأل أيضاً: لماذا لا يعذر أيضاً القاطع بوجوب اللواط، ونكاح الأمهات، ومن يقطع بوجوب قتل من يتبرك بزيارة قبور الأولياء، لقطعه بشركهم، وخروجهم من الإسلام.. وإنما يقتلهم حفاظاً على الإسلام بنظره؟!
ولماذا يقتل من قتل نفساً لأجل مال، أو لعداوة شخصية، إذا كان قاطعاً بلزوم قتله، ولم يكن محارباً للإسلام؟! ولماذا يعذِّب بالنار في الآخرة؟! فلماذا جرَّت الباء هناك، ولم تجرّ هنا، وفي كل مكان لكي يشمل هذا القطع المقيَّد بقيود لا تعد ولا تحصى جميع الموارد.
رابعاً: بل إذا كان القطع موجباً لسقوط العقوبة في الدنيا، وللمعذورية عند الله، فلا معنى للتفريق بين القاصر والمقصر.. فإن المقصر بعد حصول القطع له قد أصبح عصياً على المؤاخذة والعقوبة في الدنيا والآخرة على حد سواء، ولو جاز تعذيب المقصر لم يكن القطع مانعاً من العقوبة، وهذا نقض للدعوى.
خامساً: إن دعوى: أن معظم اليهود والنصارى وغيرهم، وسائر أهل الملل والنحل، حتى من اختار الشرك، لا يعذبهم الله لكونهم قاطعين، بأحقية ما هم عليه لا يمكن قبولها.. لأن الله تعالى يقول عن هؤلاء: إنهم لا قطع لديهم، وإن ادَّعوا ذلك..
فقد قال تعالى عن المشركين: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾([25]). وقال تعالى عن المشركين أيضاً: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾([26]). وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾([27]).
وقال تعالى عن الذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾([28]). وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾([29]).
وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾([30]).
وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾([31]).
فمفاد هذه الآيات: ان اليقين الذي يُدَّعى لأصحاب المعتقدات الباطلة، لأن منشأه مقدمات ظنية، أو حدسيات، وتقليد للآباء والأجداد، وتسليم بلا موجب لقول هذا أو ذاك، أو اعتماداً على امور لا توجب ظناً ولا قطعاً، أو لاستقراءات ناقصة، وحدسيات باطلة، أو غير ذلك..
وكان لا بد لهذا القطع من أن يتزعزع أمام الحجة القاطعة.. ـ نعم، من أجل ذلك كله ـ اعتبر الله أنه لا قيمة لهذا القطع، بل القيمة لخصوص القطع المستند إلى الحجة الواضحة، والأدلة القاطعة..
ولذلك وصف يقين هؤلاء: بأنه ظن، أو تخرص، أو ما لهم به من علم.. وإن ادَّعوا أنهم قاطعون وعالمون..
والآية التي ذكرناها أولاً قد صرحت بأننا نتحدث عن الأكثر، إنما قيّدت بذلك لإخراج القاصرين، الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً، لا المقصرين.. فإن المقصرين لا يعذرون مطلقاً، ومن عرف الخلاف، فليس بمستضعف.
وذمّ الله تعالى الكثير لهؤلاء يشهد: بأن القاطع ليس معذوراً في جميع ما قطع به.. بل يعاقب عليه، ولاسيما إذا كان ناشئاً من المقدمات التي ذكرنا نموذجاً فيها..
وقد ورد النهي عن تعاطي بعض الأمور التي قد يتكون منها بعض القطوعات.. كأمور السحر، والإعتماد على الحساب في تعيين أوائل الشهور، وغير ذلك.. فكيف يقال: إن أكثر الناس قاطعون بمعتقداتهم؟! ولو سلمنا بهذا القول، فلماذا يدَّعى أن كل قطع يوجب المعذورية في الفعل؟!
سادساً: إن الزعم: بأن معظم الناس قاطعون، إذا انضم إلى قولهم: إن القاطع لا يستجيب للأمر أو النهي للزوم التناقض، يؤدي إلى جعل الدعوة إلى الحق وبعثة الأنبياء إليهم عملاً عبثياً، فلا يبقى معنى لدعوة أهل الجاهلية للإيمان والإسلام، وقد جلَّ ربنا وعز عن أن يعمل ما فيه عبث وسفه وجهل.
ولا يبقى لقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾([32]). أي قيمة، لأن هذه الدعوة ستكون كالضرب في حديد بارد، أي بلا أثر ولا فائدة.. ولا تكون لله الحجة البالغة، لأن الحجية تفقد معناها، لعدم إمكان تحققها، فيمن لا يبصر ولا يسمع، ولا يعقل.
كما لا معنى لقوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾([33]).. وإذا كان القطع يقطع الطريق أمام الحجة، فما فائدة قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه﴾؟!([34]).. وهذا يجعلنا نفهم: أن الحجة تزيل ما يُدَّعى أنه قطع..
وهذا هو ما نريد أن نصل إليه، فإن القطع إذا كان يمنع من الردع عن فعل المقطوع به، فإنه لا يمنع العقل عن التمييز والإدراك لمضمون الحجة، والتفاعل معها، والإنصياع لها.. لتكون النتيجة هي: زوال القطع، أو تحويله إلى ظن، أو شك.. وحينئذٍ يبدأ الصراع بين العقل وبين الأهواء والمصالح، والشهوات، والعصبيات، وما إلى ذلك.. فإذا غلب العقل اختار الهدى، وإذا غلب الهوى اختار الجحود، أو العناد.
وبعبارة أخرى:
إن القاطع، وإن كان يحسب أنه يرى الواقع، وعليه أن يأتي به، لكن إذا علم بوجود من يخطِّئه في زعمه هذا، ويقول له: راجع حساباتك، فهناك أدلة تثبت خطأك، فليس له أن يقول: إن قطعه يمنعه من إعادة النظر، ومراجعة الأدلة، والإصغاء للحجج، ولو فعل ذلك لم يأمن من أن يكون مفرِّطاً ومضيعاً لما يحكم عقله بلزوم حفظه.. فإن قطعه لا يمنع من أن يكون عالماً على سبيل الإجمال: بأنه قد جهل بعض الحجج، أو قصِّر في مقدمات تحصيل هذا القطع.
ولأجل ذلك يجب عقلاً على كل مكلف تحصيل اليقين من الأدلة في الأمور الإعتقادية التي يطلب فيها إحراز الواقع على كل حال، ولا يكتفى فيها بالظن، كما دلت عليه الآيات القرآنية المتقدمة، ولا يجوز التقليد فيها، وإنما التقليد يكون فيما هو توقيفي، أو فيما لا يطلب العلم به على كل حال، كما في التفاصيل، والدقائق البعيدة عن متناول الأيدي.
سابعاً: إذا لم تجز محاربة الكافرين والباغين، والمعتدين، والظالمين، فيجب الحكم بسقوط فريضة الدفاع عن النفس، وفريضة الجهاد، وأن يسقط نظام العقوبات الإسلامي كله، لعدم وجود مورد يسوِّغ ممارسته، لأن احتمال أن يكون الطرف الآخر قاطعاً بصحة ما هو عليه، وما يعتقده قائم، فيمنع من عقوبته، وجهاده، ويمنع من دفعه عن عدوانه وظلمه أيضاً.. ومن يفعل ذلك يكون هو المجرم المستحق للعقاب، ويجب ـ والعياذ بالله ـ أن يحاسب الله تعالى نبيه ووصيه، ويعاقبهما في الآخرة على أقل تقدير.
بل إذا كان الله تعالى هو الذي أمر النبي والوصي بذلك، لم يجز له أن يعاقبه أو يحاسبه، لأنه سبحانه شريك له في ذلك، فإنه هو الذي أمره به.. وكيف يأمر الله ويفعل ذلك رسول الله وأوصياؤه بما هو ظلم، أو بلا جدوى؟!
وكيف نفسر حروبهم التي خاضوها، وعقوباتهم التي أجروها على الناس، الذين يحتمل أن يكونوا قاطعين بحليتها بحسب مذاهبهم ومعتقداتهم؟!
ثامناً: بل يجب أن يكون قتل الأنبياء والأوصياء من موجبات دخول الجنة للمشركين والكافرين، والبغاة، والمعتدين، إذا كان القاتل قاطعاً بأن ذلك يجب عليه في دينه، ويتقرب به إلى ربه، فابن ملجم يدخل الجنة، والذي دسَّ السم للنبي يدخل الجنة، وكذلك الذين كانوا يقتلون الأنبياء من بني إسرائيل، والذين قتلوا الأوصياء والأئمة الطاهرين «عليهم السلام»، ولا تجوز معاقبتهم إذا احتمل أن يكونوا قاطعين بجواز ذلك في أديانهم..
تاسعاً: إذا كان الغالب في أصحاب الأديان والنِحَل والمذاهب أنهم قاطعون ومعذورون، وهم يعبدون الله، ولاسيما إذا اعتزلوا في صومعة لعبادة ربهم الذي يدَّعون أنه ثالث ثلاثة، أو لعبادة صنمهم الذي يرون أنه يقرِّبهم إلى الله زلفى، فلا يبقى معنى لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ﴾([35]).
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾([36]). وقوله سبحانه: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾([37]).
أو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾([38]).
عاشراً: إذا كان هؤلاء يُعذرون، وينجون من العذاب بسبب قطعهم، ولا يضرهم كفرهم، ولا يحاسبون على ما يفعلونه بسبب قطعهم، فلماذا لا يبقيهم الله على قطعهم هذا الذي يعذرون فيه، فلا يفرض عليهم تكاليف كثيرة فيها جهد وتعب، وصوم وصلاة وحج، وفيها عقوبات على المخالفات، أو على التقصيرات؟! فقد كان قطعهم يكفيهم لتجنب دخول النار.. فإنه قطع خفيف نظيف، ليس فيه تعب ولا نصب، ولا جهد.. فإذا تكرَّم عليهم وأدخلهم الجنة به أيضاً، فهو نور على نور، يستحق الشكر والسرور.
ولنفترض: أن هذا التكليف المجهد له ثمرات كبرى يريد الله تعالى لهم أن يحصلوا عليها.. وهذا أمر حسن وراجح في نفسه، ولكن الرجحان شيء، والعقوبة على مخالفة الراجح شيء آخر، فإن الرجحان إنما يقتضي جعل المرء بالخيار في أن يختار هو الإستزادة من الخير، أو الإقتصار على تجنب العقوبة بواسطة قطعه، فإذا اختار الإقتصار يكون قد ضيَّع على الخير الكثير، وحرم نفسه.. وهذا التضييع، وإن كان مرجوحاً، ولكن لا ينبغي جعل العقوبة عليه، من خلال الإلزامات، وإنزال العقوبات في الدنيا والخلود في أشد أنواع العذاب في الآخرة.
حادي عشر: لو كان القطع يبرر الأعمال، ويمنع من العتاب والعقاب، وكان معظم الناس إلا ما قلَّ معذورين بقطعهم، ولا يؤثر الأمر ولا النهي لهم عن فعل ما قطعوا به.. فإن أصل وجود دين الإسلام ونزول القرآن يصير بلا معنى، والعمومات القرآنية النبوية والإمامية تصير مستهجنة للزوم تخصيص الأكثر، فإن معظم الكفار والمنافقين والعصاة يخرجون عن دائرة القصد في الآيات والروايات، ويبقى أفراد قليلون.. فمثلاً في قوله «صلى الله عليه وآله» عن الخوارج: «كلاب أهل النار».. يخرج غالب الخوارج، وقد لا يبقى تحت العموم إلا أفراد قليلون، بل قد لا يبقى أحد.. وهذا لا يصدر عن جاهل، فكيف ينسب نظيره إلى الله العليم الحكيم، وإلى النبي الكريم في موارد لا يمكن إحصاؤها؟!
وهذا يعطي: أن القطع بما هو قطع لا عبرة به، بل العبرة بالحجة الإلهية التامة، والإختيار للعباد، بغض النظر عن النتائج.
ثاني عشر: إن هذا القطع المدَّعى يصبح دليلاً على كذب الأنبياء ـ والعياذ بالله ـ، ومبطلاً للرسالات والأحكام، لأن أكثر الناس قاطعون، والباقي، إما قاصرون، فهم معذرون أيضاً، أو مقصرون، أو جاحدون معاندون.. وهؤلاء فقط هم نصيب جهنم.. وهم أقلُّ القليل.
وإذا كان هؤلاء هم الذين يحاسبهم الله بأعمالهم، فلا حاجة إلى كل هذا الصخب واللجب، والقتل والقتال، وسقوط الشهداء، وإشغال الأمم والأجيال بما لا فائدة منه ولا عائدة.
فلا عبرة بالقطع، بل العبرة بالحجة الإلهية التامة، والإختيار للعباد، بغض النظر عن النتائج.
ثالث عشر: هناك أمور يستحيل حصول اليقين بنفيها، فالإصرار على النفي هو تعمد للباطل، وعناد، وهي الأمور المرتبطة بالغيب المطلق، الذي لا يملك الإنسان حيلة أو وسيلة في الوصول إليه، والإطلاع عليه، فكيف يمكنه نفي وجوده؟! هذا في جانب النفي، لكن جانب الإثبات يمكن إثباته من خلال المعجزات، والآثار المرتبطة بذلك الأمر الغيبي، والأدلة العقلية وسواها، كوجود الله ووجود العقاب، والعدل الإلهي، أو من خلال من أثبتت المعجزة معرفتهم بالغيب، كالأنبياء فيما هو توقيفي، كوجود الآخرة، ووجود جنة ونار، وحور عين، ووجود جن وملائكة، ونعيم وعذاب، وحساب القبر، والنبوة، وما إلى ذلك.. فكيف ينفي النافي لأمثال هذه الأمور، ولم يطَّلع على الغيب؟!
وعليه، فإنه إذا علم أحد بتعدد الأديان، ثم بتعدد الفرق في الدين، فليس بمستضعف، وعليه أن يبحث عن الحق، فإن عجز عن الوصول، فهو معذور..
ونحن لا نتحدث عن الغيوب بما هي غيوب، وإنما عن إثباتها بعد العلم بوجودها، والبشر كلهم يدركون وجود أمور لا يعرفونها، فإذا جاءت المعجزات وأثبتتها لهم، فعليهم أن يخضعوا لها.. فإن علم الناس بوجود غيوب بعيدة عن متناول أيديهم لا يحتاج إلى لقاء نبي، ولا وصي.
كما أن أحداً لا يمكنه إثبات جدوى عبادة الأصنام والأشخاص، وسائر الترهات والأباطيل، وما إلى ذلك..
رابع عشر: بالإضافة إلى ما تقدم نقول:
إن أكثر الناس غافلون، ومنصرفون عن التدبّر في الأمور، ولكنهم يتوهمون أنهم قاطعون.
وهذه الغفلة تجعلهم قاصرين، ما دامت موجودة، وهي ترتفع بأحد أمرين:
ـ إما سؤالهم عن دليلهم.. فيعود المسؤول إلى نفسه، وعقله، ووجدانه، وذاكرته.. فلا يجد جواباً مقنعاً على هذا السؤال.. وبذلك يزول هذا القطع الموهوم، وهو الغفلة.
ـ وإما لفت نظر الغافل إلى وجود الإختلاف بين الناس، فلعل الحق مع غيره.
ومن الطريف هنا: أن المدَّعين نجاة كل قاطع قد خلطوا بين هذين الأمرين اللذين هما: القطع، والغفلة.
خامس عشر: بقي أن نشير إلى أن السؤال قد تضمن أموراً عديدة أخرى تحتاج إلى بيان، فلاحظ ما يلي:
ألف: إن التلقين والتربية قد يوجد غفلة وسكوناً إلى ما يغفل عنه.. ويسمى هذا السكون يقيناً واطميناناً، ولكنه يقين ضعيف وهش، ويزول.. ولكن هذه بمجرد لفت النظر إلى وجود اختلاف بين الناس في ما هو غافل فيه، أو ساكن له.
كما أنه يزول بمجرد سؤال الغافل عن مستند قطعه، وبزوال الغفلة، أو هذا القطع المتهالك تزول المعذورية.. نعم، هو معذور في مدة بحثه، شرط عدم التهاون والتسويف.
ب: إن الحكم بوجود القطع لدى أكثر الناس لا ينسجم مع ما روي عن الإمام الصادق «عليه السلام» حول عدم وجود مستضعف في زمانه، فعدم وجوده في زماننا يكون بطريق أولى، فإن معظم الناس، إلا ما شذَّ وندر يدركون وجود الإختلاف في الأديان والمذاهب، فيجب عليهم مراجعة حساباتهم، ولم يدرك ذلك، أو عجز عن الوصول إليه، فهو معذور..
والكلام إنما في دعواهم: أن أكثر الناس معذورون بقطعهم.. ونحن لا ندَّعي ـ في المقابل ـ أن جميع الناس غير معذورين، فليلاحظ ذلك.
كما أن الحكم بوجود القطع عند معظم الناس لا ينسجم مع سائر الروايات التي فسرت المستضعف، ولا مع سائر النصوص القرآنية التي اعتبرت ما يسمونه قطعاً أنه ظن وتخرص، ولا مع العمومات القرآنية، النبوية، التي يلزم منها تخصيص الأكثر، ولا مع سائر ما تقدم.
ج: إن ما ذكر من عدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب ليس المراد به عدم إمكان الإقتناع بتلك المذاهب، بل المراد به عدم خطور ذلك في باله، فلا يحصل لديه دافع للتأمل به.. فإذا علم القاطع بوجود رأي يخالفه، والتفت إلى احتمال مخالفته لما هو عليه وجب عليه ـ بحكم العقل ـ أن ينظر فيه، وفي أدلته ليحصل على الأمن، ولا يكون مفرطاً.
د: إن ما ورد في السؤال، من أن علماء الأديان والمذاهب الباطلة، بسبب التلقينات من زمن الطفولة، والنشوء في بيئة الكفر، يردّون كل ما ورد على خلاف عقائدهم بعقولهم المجبولة على خلاف الحق..
فقد يلاحظ علىه: أنه ينتهي إلى القول بالجبرية للعقل في تكوين أحكامه، وفي إدراكاته، مع أن العقل لا جبر فيه، ولا قهر.. لأنهم لو كانوا مقهورين في عقولهم لم تصح عقوبتهم على أي حال..
إلا أننا نظن أن المراد: أن هذا اليقين الناشئ عن البيئة والنشأة لا ينافي الإختيار، ولأجل ذلك ورد النهي عن عمل القطَّاع بما قطع به، ونهي الحاسد عن حسده، والجبان عن جبنه، والبخيل عن بخله.. وأمر هؤلاء بتغيير هذه الحالات واقتلاعها من نفوسهم.. ومنعهم من فعل ما ينشأ عنها، وعاقبهم عليها، وما إلى ذلك..
كما أن بعض الأمور تؤثر تكويناً في الشخص، كالولادة من الزنا، أو من الحلال، ولكن لأنها لا تنافي اختيار الإنسان، فإن الله تعالى لم يجعلها من موجبات التخفيف في العقوبة على المخالفات، حتى لو انتهت بصاحبها إلى القطع الذي دعا إلى المخالفة.. وذلك لما ذكرناه، من أن القطع لا يمنع من التفكر والتأمل في الحجة، حسبما أوضحناه أكثر من مرة.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطاهرين..
13 شهر رجب 1439هـ ق.
آخر شهر آذار 2018م ش.
عيثا الجبل (عيثا الزط سابقاً) جبل عامل ـ لبنان
جعفر مرتضى العاملي
([1]) راجع: مناهل العرفان ج1 ص182 عن التبيان، والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص104 والبيان لآية الله الخوئي ص198 عن التبيان ص58 وصحيح البخاري ج1 ص67 وج7 ص146 و 147 وعمدة القاري ج22 ص283 والترغيب والترهيب ج1 ص410 والإحكام ج2 ص206 وذم الكلام وأهله ج3 ص217.
([2]) إكمال الدين ج2 ص352 وبحار الأنوار ج92 ص326 وإعلام الورى ص432.
([3]) في وسائل الشيعة: كما أنزل.
([4]) كنز العمال ج2 ص189 عن ابن عساكر، والمحجة البيضاء ج2 ص309 ووسائل الشيعة ج4 ص866 عن عدة الداعي ص10.
([5]) الآيات 97 ـ 99 من سورة النساء.
([6]) بحار الأنوار ج48 ص244 وج75 ص332 وج69 ص162 والكافي ج8 ص124 ومرآة العقول ج25 ص295 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص467 ونور الثقلين (تفسير) ج1 ص539 وكنز الدقائق (تفسير) ج3 ص518 ومجمع البحرين ج5 ص84.
([7]) المحاسن للبرقي ج1 ص277 والكافي ج2 ص406 و 405 ومعاني الأخبار ص201 وبحار الأنوار ج69 ص162 ومرآة العقول ج11 ص213 و 212 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص467 وتفسير العياشي ج1 ص268 والبرهان (تفسير) ج2 ص157 و 159.
([8]) معاني الأخبار ص200 وبحار الأنوار ج69 ص162.
([9]) إن كان المراد به: ضريس بن عبد الملك (كما هو الظاهر)، فالرواية صحيحة.
([10]) تفسير القمي ج2 ص260 وبحار الأنوار ج6 ص286 و 289 وج69 ص158 والفصول المهمة للحر العاملي ج1 ص335 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص467 والبرهان (تفسير) ج4 ص770 ونور الثقلين (تفسير) ج4 ص535 وكنز الدقائق (تفسير) ج11 ص417 وخاتمة المستدرك ج5 ص17.
([11]) كما في اكثر المصادر ككتاب سليم بن قيس، وإرشاد القلوب، وبعض الموارد في البحار.
([12]) كما في البحار في بعض الموارد الأخرى.
([13]) بحار الأنوار ج29ص471 وج69 ص170 و 171 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج3 ص13 وإرشاد القلوب ج2 ص397 وكتاب سليم بن قيس (ط بيروت) ص125 ـ 132.
([14]) بحار الأنوار ج8 ص360 وج27 ص136 وج31 ص657 وج65 ص26 وج69 ص159 والكافي ج8 ص315 وفضائل الشيعة للصدوق ص38 ومعاني الأخبار ص392 ومرآة العقول ج26 ص418 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص111 وج6 ص468.
([15]) بحار الأنوار ج65 ص26.
([16]) بحار الأنوار ج69ص161 و 162 ومعاني الأخبار ص203 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص468 وتفسير العياشي ج1 ص270 والبرهان (تفسير) ج2 ص158 و 160.
([17]) الآية 98 من سورة النساء.
([18]) بحار الأنوار ج69 ص160 و 157 والكافي ج2 ص404 ومعاني الأخبار ص201 ومرآة العقول ج11 ص201 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص468 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج9 ص189 وميزان الحكمة ج2 ص1705 وتفسير العياشي ج1 ص269 وتفسير القمي ج1 ص149 والبرهان (تفسير) ج2 ص156 و 157 و 160 ونور الثقلين (تفسير) ج5 ص340 وج1 ص537 وكنز الدقائق (تفسير) ج3 ص515 وج13 ص277.
([19]) بحار الأنوار ج69 ص160 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص469 والكافي ج2 ص404 ومعاني الأخبار ص201 ومرآة العقول ج11 ص209 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص469 ونور الثقلين (تفسير) ج1 ص539 وكنز الدقائق (تفسير) ج3 ص518 والشهاب الثاقب للبحراني ص191.
([20]) على أن الأنبياء والأئمة «عليهم الصلاة والسلام» كانت لديهم وسائل نشر الدين وإيصال الحقائق للناس، بعضها عادي، وبعضها فوق ذلك، كما أشرنا إليه في كتابنا: المعجزات: رقي وغايات، للبشر في الحياة، فراجع إن أحببت.
([21]) معاني الأخبار ص202 وبحار الأنوار ج69 ص160.
([22]) الآية 48 من سورة النساء.
([23]) راجع مادة «خلد» في المعجم المفهرس.
([24]) الآيتان 6 و 7 من سورة البقرة. وراجع الآيات بعد الآية رقم 20، ولا بأس بمراجعة مادة: «جهنم»، و «النار»، و «الخلود»، وغير ذلك في المعجم المفهرس للآيات القرآنية.
([25]) الآية 36 من سورة يونس.
([26]) الآية 23 من سورة النجم.
([27]) الآية 66 من سورة يونس.
([28]) الآية 148 من سورة الأنعام.
([29]) الآية 116 من سورة الأنعام.
([30]) الآية 24 من سورة الجاثية.
([31]) الآية 32 من سورة الجاثية.
([32]) الآية 125 من سورة النحل.
([33]) الآية 165 من سورة النساء.
([34]) الآية 83 من سورة الأنعام.
([35]) الآية 19 من سورة آل عمران.
([36]) الآية 85 من سورة آل عمران.
([37]) الآية 32 من سورة يونس.
([38]) الآية 153 من سورة الأنعام.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي