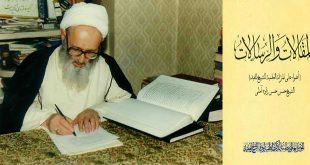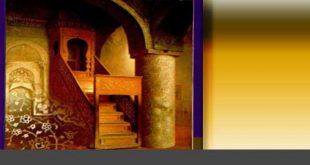الاجتهاد: ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟
بقلم: الشيخ محمد حسين صادق زاده (*) ترجمة: الشيخ علي محسن
يشعر الإنسان بالحاجة إلى أن يعيش حالةً من التكافؤ والتساوي بينه وبين سائر أفراد النوع البشري. وهذا الشعور لديه هو وليد الفطرة النقيّة الصافية التي خلقه الله تعالى عليها.
فالإنسان بفطرته وسجيّته الأوّليّة يرغب بالتكافؤ والتساوي، ولا يكلّ عن المطالبة بهما، وبكلّ ما من شأنه أن يُسهم في تكريس وتطبيق هذين المفهومين الأساسيّين.
وفي المقابل يحارب الإنسان ـ وبشدّةٍ ـ من أجل القضاء على كلّ التصرُّفات أو النوايا التي تدفع باتّجاه تكريس اللامساواة، ويوظِّف في هذا السبيل جميع طاقاته وما أُوتيه من قوّة، ويسخِّر هذه الطاقات وهذه القوّة التي لديه للقيام والثورة في وجه كلّ المحاولات الرامية إلى تكريس المفاهيم التي تنتمي إلى مقولة اللامساواة وعدم التكافؤ، والتي هي ـ بحَسَب فطرته ـ مقولة مشؤومة تستحقّ أن تُواجَه بكلِّ البغض والكراهية.
ويبقى الإنسان يعيش حالة الأمل والترقُّب، بانتظار أن يأتي ذلك اليوم الذي يتمكَّن فيه من الظفر بهذه الجائزة، جائزة المساواة والتكافؤ.
وما دامت فطرة الإنسان سليمةً لم تنحرف عن مسارها المستقيم، وما دامت لم تتلوّث بشيءٍ من الملوّثات التي تكدّر صفوها ونقاءها، فإنّ هذه الفطرة تملك الشجاعة الكاملة لأن ترفع صوتها بنداء التكافؤ والمساواة، وهي ليست على استعدادٍ أبداً لأن تتنازل ولو عن ذرّةٍ واحدة من هدفها المقدَّس هذا.
لكنْ وبالرغم من ذلك كلّه نصطدم أحياناً بعددٍ من النفوس المظلمة، من ذوي الفطرة الملتوية والضمائر الميتة، ممَّنْ يسخِّرون الفكر ويوجِّهون دفّة أقلامهم باتّجاه أهدافهم غير المقدّسة، كما نجد كثيراً من أصحاب القلم والبيان ممَّنْ يكتبون ويحرِّكون أقلامهم دون علمٍ ووعي، فيضعون النظريّات، ويسوِّقون التوجيهات التي تبرِّر الأطماع التي لديهم.
هذه الأقلام الجاهلة، التي وبسبب جهلها وقلّة وعيها تتلطَّخ بالسواد، وتلوّث صفحات الفكر النقيّة البيضاء بنقاط سوداء مظلمة.
إنّ للإجحاف واللامساواة لوناً أسود داكناً، لكنْ عندما تسطع شمس الفطرة المنيرة فإنّها تكشف وتعرّي كلّ هذا السحاب الداكن الذي تثيره الأفكار غير الأصيلة في سماء الفكر والمعرفة.
إنّ التكافؤ والمساواة هما من أهمّ القِيَم والأهداف المقدَّسة عند الإنسان، على العكس من اللامساواة، التي هي دائماً أمر يمقته الإنسان وينفر منه. ولكنْ يحدث أحياناً أن نجد بعض مَنْ يتصدّى لتفسير القانون الإسلاميّ يعمد ـ عن غير وعيٍ والتفات ـ إلى التنظير للامساواة، وتبريرها، وإضفاء الصبغة القانونيّة عليها. وهذا ما يؤدّي إلى فرض مبدأ اللامساواة وعدم التكافؤ، وتحميله قسراً على فطرة الإنسان الصافية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الإنسان أسيراً للظلم والإجحاف بكلِّ ما فيهما من القسوة والمرارة.
ومع أنّ الإنسان يمكن أن يعتاد على الأمور المريرة القاسية، إلاّ أنّ المرارة تبقى مرارةً إلى الأبد، تماماً كما أنّ السواد يبقى سواداً إلى الأبد.
يقول الشهيد الشيخ مرتضى مطهّري: إنّ أصل التكافؤ والمساواة ونبذ التمييز والتفرقة هو من الحقائق التي يمكن أن نعدّها واحداً من الأركان التي تقوم عليها الأيديولوجيا الإسلاميّة([1]). ويقول الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: إنّ الكتاب العزيز صريحٌ في وحدة البشرية جنساً وحَسَباً، ومساواتهم في الإنسانية ومسؤوليّاتها، مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم([2]).
ويؤكِّد القرآن الكريم بوصفه كتاباً أُنزل لبناء المجتمع الإنسانيّ على لزوم إقامة القسط والعدل([3])، مذكِّراً الناس جميعاً بأنّهم أبناء أبٍ واحد وأمٍّ واحدة([4])، ناسفاً بذلك جميع المفاهيم والمعايير الموهومة، كتلك التي ترجع إلى العِرْق أو النسب أو القوميّة أو نحو ذلك، حاكماً بالبطلان على كلِّ هذه المعايير الزائفة.
ما نشاهده دائماً في المجتمعات التي تهيمن عليها التيّارات الفكريّة غير التوحيديّة أنّ الامتيازات التي يتميَّز بها البشر، من القوّة والثروة وسائر ما لديهم من استعدادات ذاتيّة وفطريّة، تمّ اعتمادها لتكون هي المعيار في تقييم الأفراد. فيما نجد في المنطق التوحيديّ الذي يطرحه القرآن الكريم أنّ المعيار الحقيقيّ الوحيد لتقييم الإنسان هو التقوى، قال تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).
وفي منطق القرآن الكريم أيضاً أنّ العزّة والعظمة منحصرة في الله سبحانه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ للهِ جَمِيعاً﴾ (يونس: 65). وهذه العزّة الإلهيّة ينعكس نورها وشعاعها في مرآة رسوله، ثمّ في مرآة المؤمنين([5]). وعلى هذا الأساس إنّ المؤمنين جميعاً هم أصحاب عزّة، ولا يمكن إدخالهم في تصنيفات غير متكافئة، وتقسيمهم إلى: عزيزٍ وذليل، وعالٍ وسافل، وشريف ووضيع.
مثل هذا المنطق القرآنيّ العادل، والذي يدعو إلى الإنصاف والتكافؤ، هو ما دفع بالإمام السجّاد زين العابدين× إلى أن يقول في مناجاته لربّه، الذي من عنده نزل القرآن العظيم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ…، وَاعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِذِي عَدَمٍ خَسَاسَةً، أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلاً، فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ، وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ»([6]).
لكنّ ما يُثير الاستغراب والدهشة أن نجد جملةً من الفقهاء بعد القرن السابع الهجريّ يغفلون تماماً هذا المعيار القرآنيّ، ويقسّمون المجتمع الإسلاميّ من ناحية تكافؤ المنزلة أو عدم تكافؤها إلى قسمين، أحدهما: «أهل العزّ والكرامة والشرف»؛ والآخر: «الوضيع والمهين والذليل». وفي هذا التقسيم يُوصف جمعٌ من المؤمنين بصفة الذلّة والضعة، ثمّ يُجعل هذا الشرف وتلك الذلّة والضعة أو المقام والمنزلة الاجتماعيّة شرطاً في جملةٍ من الأحكام، ثمّ صار هؤلاء بصدد استنباط أحكامٍ تعود بالنفع على الذين وصفوهم بأنّهم شرفاء، وتعود بالضرر على الذين وصفوهم بأنّهم أذلاّء.
ومن النتائج التي تترتَّب على هذا التقسيم ـ على سبيل المثال ـ: لو افترضنا أنّ شخصاً فقيراً من غير ذوي الجاه والمنزلة الاجتماعيّة أراد أن يحفظ كرامته، ويتعامل بالتعفّف ـ الذي هو أمرٌ مرغوب ومندوب إليه في القرآن الكريم([7]) ـ، وسعى ضمن هذا الإطار إلى تأمين احتياجاته الأساسيّة التي تحفظ له ماء وجهه، فإنّه يُتَّهم بالتورّط بالإسراف المحرَّم، ويُحْكَم على ماله الذي استعمله في رفع هذا النوع من الاحتياجات الأوّليّة بأنّه مالٌ يتعلَّق به الخمس والزكاة. هذا في وقتٍ يُتَعامَل مع الأموال التي تُنْفَق من قِبَل أصحاب رؤوس الأموال، لا بعدم اعتبارها إسرافاً فحَسْب، بل يُقال: إنّ من شأن هذا الغنيّ أو المتموِّل أن تكون له مثل هذه النفقات. وهذا «الشأن» هو في معرض التزايد والاتّساع يوماً بعد يوم؛ بفعل تضخُّم ثروته واتِّساعها بشكلٍ يوميّ، ما يؤدّي بشكلٍ تلقائيّ إلى ارتفاعٍ في منزلته ومقامه الاجتماعيّ.
ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟
مدخليّة الشأن في الخمس
الخمس واحد من الواجبات الماليّة. وهو واجبٌ يتعلَّق بالمال الذي يزيد على ضرورات المكلَّف واحتياجاته. فبعد أن يحسب المكلّف مقدار ما يحتاج إليه من المؤونة والنفقة يُخرج من ماله ما زاد عليها بعنوان الخمس. وقد ذهب كثيرٌ من الفقهاء المتأخّرين إلى أنّ الشأن والمنزلة الاجتماعيّة للشخص لهما دورٌ مؤثّر على مقدار نفقات الأفراد وحاجاتهم الضروريّة سعةً وضيقاً، معتقدين أنّه لا يمكن بشكلٍ من الأشكال الفصل بين الشأن الاجتماعيّ للأفراد وبين احتياجاتهم على المستوى الفرديّ. فللشأن مدخليّةٌ في تحديد حجم هذه الاحتياجات.
ومن هنا ذهب السيّد محمد كاظم اليزديّ([8])، وغيره([9])، إلى القول بأنّ «المراد بالمؤونة ـ مضافاً إلى ما يُصْرَف في تحصيل الربح ـ: ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة، من المأكل والملبس والمسكن… ولو زاد على ما يليق بحاله، ممّا يُعَدُّ سَرَفاً وسَفَهاً بالنسبة إليه، لا يُحْسَب منها».
وما يمكن استنتاجه من كلمات هؤلاء المحقِّقين في الفقه، في بيان وجه مدخليّة الشأن في حسابات الخمس، هو أنّ الروايات في باب الخمس تحدَّثت عن ضرورة دفع الخمس بعد استثناء المؤونة، ما يجعل موضوع الخمس الواجب عبارةً عن المال الزائد على المؤونة، المفسَّرة بـ (ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه). والمرجع في تحديد المؤونة، وفي تشخيص موارد احتياجات الفرد، هو إلى العُرْف الذي لا يَسَعه أن يتجاهل ما لهذا الفرد من الشأن والمكانة الاجتماعيّة. وبهذا تكون المنزلة والموقعيّة الاجتماعيّة للأفراد ذات دخالةٍ وتأثير في تحديد مستوى احتياجاته ونفقاته اللازمة([10]).
وفي هذا السياق يقول الشيخ الأنصاريّ: «والأصل في ذلك أنّ إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل غير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه. فيُستثنى لأداني الأغنياء من حيث الغنى والشرف الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل: بناء المساجد…» ([11]).
وفي التعليق على هذه العبارة للشيخ لا بُدَّ من طرح السؤال التالي: هل أنّ حاجة الشخص ومؤونته منحصرة في حاجاته المادّيّة أم أنّ حصرها في الاحتياجات المادّيّة ليس صحيحاً ـ كما ربما يُستفاد من العبارة المذكورة ـ، بل ينبغي تعميم مفهومها بحيث يكون شاملاً لمصاديق الحاجات الدنيويّة والأُخرويّة (نظام معاشه ومعاده)؟ فلا بُدَّ لنا من توسعة هذا المفهوم، بحيث نفترض أنّ المكلَّف إذا أراد أن يُخرج من ماله الصدقات المستحبّة، أو أن يدفع ماله في أسفار الزيارة إلى العتبات والمراقد المقدَّسة، بما لا يتنافى مع شأنه وشرفه ومكانته الاجتماعيّة، فهل يُعدّ هذا إسرافاً بحيث إنّ ما يدفعه من ماله في هذا المجال يتعلَّق به الخمس أم لا؟
وفي مقام الجواب عن هذا السؤال ذهب جملة من المحقِّقين([12]) إلى أنّ مراعاة الشأن في الأمور الدينيّة الحَسَنة والممدوحة التي ورد الحثّ عليها في الشريعة؛ بوصفها أموراً مستحبّة، ليس على ما ينبغي؛ لأنّ الشارع المقدّس جعل المستحبّات مطلوبةً من كلّ مسلم، وهذا الأمر الاستحبابيّ المتعلِّق بها عامّ، فهو لم يجعلها مختصّةً بطائفةٍ معيّنة من المؤمنين، وبالتالي فإنّ صرف مقدارٍ من المال في المستحبّات، مهما بلغ، لا يمكن أبداً أن يندرج تحت عنوان الإسراف. وعلى هذا الأساس فإنّ تقسيم المستحبّات إلى: مستحبّاتٍ مناسبةٍ للشأن؛ ومستحبّاتٍ غير مناسبة له، لا يُعدّ تقسيماً صحيحاً.
وقال السيّد الخوئي أيضاً([13]): «فإنّ شأن كلّ مسلم التصدّي للمستحبّات الشرعيّة، والقيام بالأفعال القربيّة؛ امتثالاً لأمره تعالى وابتغاءً لمرضاته، وطلباً لجنّته. وكلّ أحد يحتاج إلى ثوابه، ويفتقر إلى رضوانه. فهو يناسب الجميع، ولا معنى للتفكيك بجعله مناسباً لشأن مسلمٍ دون آخر. فلو صرف أحدٌ جميع وارداته بعد إعاشة نفسه وعائلته في سبيل الله؛ ذخراً لآخرته، ولينتفع به بعد موته، كان ذلك من الصرف في المؤونة؛ لاحتياج الكلّ إلى الجنّة. ولا يُعدّ ذلك من الإسراف أو التبذير بوجهٍ بعد أمر الشارع المقدَّس بذلك.
وكيف يعدّ الصرف في الصدقة أو العمرة ولو في كلّ شهر أو زيارة الحسين× كلّ ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط والخروج عن الشأن بعد حثّ الشريعة المقدَّسة المسلمين عليها حثّاً بليغاً؟! فالإنصاف أنّ كلّ ما يصرف في هذا السبيل فهو من المُؤَن، قلَّ أم كثر».
لكنْ خالف في ذلك جماعةٌ آخرون، كالشيخ الأنصاريّ([14]) والسيّد محمد كاظم اليزدي([15]) والسيّد الحكيم([16])، حيث ذهبوا إلى أنّ ملاحظة الشأن في الاحتياجات الأُخرويّة أمرٌ لازم وضروريّ.
وقد حاول هؤلاء الدفاع عن رأيهم هذا بالقول بأنّ عنوان اللّياقة والشأنيّة لم يرِدْ في لسان الدليل، وإنّما الوارد فيه هو استثناء المؤونة. والمؤونة متقوِّمة عُرْفاً بأن يكون الصرف محتاجاً إليه بمرتبةٍ من الاحتياج واللّزوم والأولويّة العُرْفيّة، وإلا لم يكن مؤونة. فهذا المفهوم على حدّ سائر المفاهيم العُرْفيّة لا بُدَّ أن يكون الاحتياج الملحوظ فيه ممّا يراه العُرْف ويفهمه، ولو في طول كون الإنسان متديِّناً وملتزماً بشريعةٍ ودين. ومجرّد كون شيء راجحاً شرعاً أو حسناً في نفسه لا يكفي لصدق الاحتياج العُرْفيّ والمؤونيّة على ذلك الفعل ما لم يكن بحَسَب المناسبة وحالة الفرد لازماً، وأَوْلى بشأنه وحاله([17]).
نقدٌ ومناقشة
ما يمكن أن يُقال في مناقشة دعوى دخالة الشأن في ما يحتاج إليه الإنسان في حياته هو أنّ مراعاة الشأن في الحاجات الضروريّة للإنسان في نظام معاشه وحياته لا يستند إلى رواياتٍ خاصّة واردة في هذا المجال، حتّى يتعيَّن على الباحث القبول بها من باب لزوم الأخذ بهذه الروايات، بل الدليل الوحيد على هذا المدَّعى هو تحكيم العُرْف في تحديد دائرة المؤونة واحتياجات الفرد.
ورغم أنّ العرف في تحديده للمؤونة ولدائرة احتياجات كلّ فرد لا يسعه أن يتجاهل ما لهذا الفرد من شأن ومنزلة اجتماعيّة، وإنّما هو يحدِّد الحاجات على أساس موقعيّة الأفراد، إلاّ أنّ الاحتكام إلى موقعيّة الفرد وتحكيمها لا ينبغي أن يكون إلى درجةٍ تُنقض معها الأهداف العامّة للشارع المقدَّس.
وإذا أردنا أن نؤيّد هذا المدَّعى، ونقدِّم له مزيداً من التفسير والبيان، فلا بُدَّ لنا في البداية من الالتفات إلى هذه القاعدة العرفيّة، وهي أنّ كلّ متكلِّمٍ يأتي بكلامٍ ويبيّن به فكرةً ما فهو عرفاً لا يكون بصدد نقض سائر كلماته، وإبطال أفكاره الأُخرى التي كان قد بيّنها في مناسباتٍ أُخرى. ومن هنا فليس من حقّ المخاطَب بالكلام أن يفهم كلام المتكلِّم كيفما شاء، ودون أن يأخذ بعين الاعتبار سائر مقاصده، والمطالب التي يتبنّاها، بحيث يَنسب إليه ما يعارض ما عُلم له أنّه من أفكار المتكلِّم ومتبنّياته. وليس له أن يتعمَّد حمل كلامه على ما يُعارض آراءه المعلوم انتسابها إليه. اللّهمَّ إلاّ أن يتوفّر له القرائن الكافية لمثل هذا الفهم، فحينئذٍ لا يُبالي بكون ما فهمه من كلامه معارضاً ومناقضاً لسائر أفكاره وآرائه.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّ هناك قرينةً لبّيّة لا بُدَّ من إعمالها عند تفسير كلام أيّ متكلِّمٍ، وهي لزوم عدم حمل كلامه على ما يناقض سائر كلماته وأفكاره. ويمكن أن يُقال: إنّ هذه النكتة تشكِّل قرينةً لبِّيّة لا يُستغنى عنها في مقام فهم كلام أيِّ متكلِّم.
وعلى سبيل المثال: لو قال المولى: إنّ إدخال السرور على قلب المؤمن أمرٌ حسن فلا يمكن لأحدٍ أن يقول: إنّ كلامه هذا مطلقٌ، وهو يشمل بإطلاقه جميع مصاديق إدخال السرور، حتّى لو كانت من قبيل: المصاديق المحرَّمة، ليَنتج عن ذلك حصول التعارض بين إطلاق الأمر بإدخال السرور وبين النهي عن ذلك المصداق المحرَّم. بل من أوّل الأمر ما يفهمه العُرْف من مثل هذا الخطاب أنّ إدخال السرور الذي طلبه المولى واستحسنه هو خصوص إدخال السرور الذي لا يكون مبغوضاً له، ومحرّماً منهيّاً عنه من قِبَله.
وفي محلِّ كلامنا، أعني دخالة ولزوم مراعاة الشأن في المؤونة وفي ما يحتاج إليه الإنسان في نظام معاشه، تُطبَّق هذه القاعدة العُرْفيّة بعينها، فيُقال: إنّ الحاجات التي تُعدّ من المؤونة واحتياجات الإنسان في حياته، وبالتالي تكون مستثناةً من الخمس الواجب، إنّما هي الحاجات التي لا تكون لَغْواً بنظر الشَّرْع، أو مبغوضةً من قِبَله.
ولأجل أنّ هذه النكتة ثابتة بالارتكاز العُرْفيّ فإنّ الفقهاء قيَّدوا الاحتياج والمؤونة بأن لا يكون من الاحتياج السَّفَهيّ، وأن لا يصدق عليه أنّه من الإسراف المحرَّم. مع أنّ الأفضل، بل اللازم، هنا هو أن يُقال: إنّ الاحتياج الذي يُستثنى من الخمس الواجب من أوّل الأمر لا يكون شاملاً للاحتياج الذي يكون مورد نهيٍ مباشر من الشارع، كالاحتياج إلى الخمر وشربه، أو الاحتياج الذي يكون مبنيّاً على أمرٍ مبغوض للمولى.
وملخَّص القول: أنّ الاحتياجات التي تكون ناشئةً من شأن الأفراد وموقعيّتهم الاجتماعيّة إنْ كانت من نوع الاحتياجات التي تبتني على أمورٍ مبغوضةٍ للمولى ومحلاًّ لكراهته فلا يمكن القول باشتراطها في احتياجات المكلَّف المستثناة من الخمس؛ لأنّ هذا الاشتراط، لا محالة، لا يكون اشتراطاً عُرْفيّاً.
ومن هنا أيضاً يمكن الحدس بأنّ أولئك الذين أنكروا وجود فرقٍ بين المكلَّفين على صعيد الحاجات الأُخرويّة إنّما استندوا إلى هذه النكتة الارتكازيّة، وهي أنّ الشارع لم يُثبت فَرْقاً بين المكلَّفين، على الأقلّ في مجال الأمور الأُخرويّة. وعلى هذا الأساس فمراعاة الشأن في الحاجات المرتبطة بالأمور الأُخرويّة لا تكون أمراً عُرْفيّاً مقبولاً.
مدخليّة الشأن في الزكاة
أـ من الواجبات الماليّة أيضاً: الزكاة. والشخص الذي له الحقّ في أخذ هذا الواجب الماليّ هو الشخص الذي لا قدرة له على أن يوفِّر لنفسه الحاجات الضروريّة التي هو بحاجةٍ إليها. فمَنْ كان على هذه الصفة ينطبق عليه عنوان «الفقير»، ويُعدّ مستحقّاً للزكاة، ومصرفاً لها. ومن هنا يُقال: إنّ مَنْ كان يملك الدار والمنزل الذي هو لائقٌ بشأنه، أو الخادم، أو المركب، الذي ينسجم مع شرفه ومنزلته الاجتماعيّة، لكنّه في الوقت عينه لم يكن قادراً على تأمين الحاجات الضروريّة المناسِبة لشأنه، فهو أيضاً يكون مستحقّاً للزكاة.
وفي هذا يقول السيّد محمد كاظم اليزدي في كتابه «العروة الوثقى»: «دار السكنى والخادم والفرس المركوب المحتاج إليها بحَسَب حاله ـ ولو لعزِّه وشرفه ـ لا يمنع من إعطاء الزكاه وأخذها… فلا يجب بيعها في المؤونة… نعم، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته ـ بحَسَب حاله ـ وجب صرفه في المؤونة، بل إذا كانت دارٌ تزيد عن حاجته، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته، وجب بيعه»([18]).
ويرى الشيخ محمد حسن النجفيّ صاحب الجواهر أنّ بالإمكان دعوى الإجماع في هذه المسألة([19]).
لكنْ على تقدير صحّة هذا الذي ذكره فإنّ هذا الإجماع محتمل المدركيّة؛ إذ قد ورد في هذه المسألة أدلّة أُخرى، فيُحتمل قويّاً استناد المجمعين في الفتوى إلى هذه الأدلّة.
وعلى هذا الأساس يمكن أن يُقال: إنّ عمدة الدليل في هذه المسألة هو أنّ هؤلاء الأشخاص لمّا لم يكن لديهم ما يفي بالمؤونة اللازمة لهم بحَسْب حالهم فإنّ تعريف الفقير يصدق عليهم، وبهذا الاعتبار يمكن دفع الزكاة إليهم([20]).
وهذه النكتة العرفيّة مؤيَّدة بالروايات الواردة في هذا المجال. ونشير هنا ـ على سبيل المثال ـ إلى واحدةٍ منها، وهي صحيحة ابن أُذينة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله’، أنّهما سُئلا عن الرجل له دار أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إنّ الدار والخادم ليسا بمال([21]).
وينبغي الالتفات هنا إلى أنّ شيئاً من الروايات الواردة في هذه المسألة، كصحيحة ابن أُذينة المتقدِّمة، لم تتضمَّن أيّ إشارة إلى لزوم ملاحظة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة للأشخاص. فلم نجد فيها أنّها تفرض مثلاً ـ وهو ما فرضه السيّد الخوئي بالفعل([22]) ـ أنّ الشخص إنْ كان له شأنٌ وموقع اجتماعيّ رفيع، كما لو كان من رجال الدين مثلاً، وكان المناسب لشأنه وموقعه هذا أن تكون له دار مرتفعة القيمة، فإنّ امتلاكه لمثل هذه الدار لا تُخرج مثل هذا الشخص المذكور عن كونه فقيراً. كما أنّه لو كان رجلاً عاديّاً، وكانت دار سكناه في موقعيّةٍ زائدة على مقدار شأنه، كما لو كانت هذه الدار في منطقة الأعيان والأشراف، فإنّ غلاء هذه الدار حينئذٍ وارتفاع قيمتها يُعَدّ زائداً على مؤونته، ولذا فهو يخرج عن عنوان الفقير بمقدار غلاء هذه الدار.
نعم، ثمَّة رواية واحدة في هذا الباب يُحتمل فيها أن يكون الإمام× قد لاحظ في الغنيّ والفقير شأن كلٍّ منهما ومنزلته الاجتماعيّة، وهي روايةٌ ضعيفة، رواها إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، قال: دخلْتُ أنا وأبو بصير على أبي عبد الله×، فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقاً، وهو رجلٌ صدوق يدين الله بما ندين به، فقال: مَنْ هذا، يا أبا محمد، الذي تزكّيه؟ فقال: العبّاس بن الوليد بن صبيح.
فقال: رحم الله الوليد بن صبيح، ما له يا أبا محمد؟ قال: جُعِلْت فداك، له دارٌ تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كلَّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة، سوى علف الجمل، وله أن يأخذ الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه، أو ببيع خادمه الذي يقيه الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجَمَله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة، فهي حلالٌ له([23]).
وقد تمسَّك بعض الفقهاء بقوله×: وهي عزّه ومسقط رأسه، فقالوا: إنّ هذه العبارة صريحةٌ في أنّ الشأن والشرف الاجتماعيّ لا بُدَّ من لحاظهما في صدق عنوان الفقر([24]).
نقدٌ ومناقشة
لكنْ يبدو لنا أنّ رواية إسماعيل بن عبد العزيز لا تماميّة لها من جهة الدلالة لإثبات مدَّعى القائلين بالشأن؛ إذ ليس لها ظهور كافٍ في ذلك. والسرّ في ذلك أنّه لو كانت مراعاة الشأن لازمةً وضروريّة في تشخيص وجود الفقر لدى المكلَّف لما كان الإمام× ليحكم على الشخص المشار إليه في الرواية بأنّه مستحقٌّ للزكاة من دون أن يعرفه باسمه وشخصه ـ كما هو صريح الرواية ـ، بل كان الإمام× سيسأل عن أحواله وأوضاعه ومقامه ومنزلته الاجتماعيّة، ليرى بعد ذلك أنّ داراً كهذه، أو خادماً ومولىً كهذا، هل هو مناسبٌ لشأن هذا الرجل أم غير مناسب له؟
ومن هنا لا يمكن حمل العلّة المذكورة في الرواية على كونها تعليلاً لمسألة لحاظ الشأن واعتباره.
أضِفْ إلى ذلك أنّ التعليل بـ «تصون وجهه ووجه عياله» يجري ويصحّ في كلا الموردين، سواء كان من ذوي الشرف والمنزلة الاجتماعيّة أم لم يكن. ولا يمكن القول باختصاصه بمَنْ كان من أهل الشرف والمنزلة والمقام.
وفي هذه المسألة لا ينحصر الأمر بالرواية المذكورة، بل يوجد ـ بالإضافة إليها ـ ظهور عُرْفيّ يُستدلّ به لاعتبار الشأن في صدق عنوان الفقر، بأن يُقال: إنّ المكلّف الذي لا يتمكَّن من تأمين احتياجاته الضروريّة واللازمة يصدق عليه عرفاً عنوان الفقير، ولذا كان من المتعيِّن حمل عنوان الفقير المأخوذ موضوعاً في أدلّة الزكاة على الفقير بمعناه العرفيّ.
ولكنْ يُستثنى من ذلك ما لو كان الذي يحتاج إليه المكلَّف مورداً للنهي المباشر من قِبَل المولى، كما لو فُرض احتياجه إلى القمار، أو كان ما يحتاج إليه ناشئاً من منطلقاتٍ مبغوضةٍ للمولى؛ إذ من الواضح جدّاً أنّ مَنْ كانت لديه احتياجات غير شرعيّة كهذه لا يمكن أن يُطبَّق عليه عنوان الفقير الشرعيّ.
وكما ذكرنا فإنّ احتياجات المكلَّف التي ترجع إلى مقامه ومنزلته الاجتماعيّة هي من الأمور المنافية للشَّرْع، الأمر الذي يعني أنّه لا يمكن اعتبار الشأن شرطاً في فقر المكلَّف.
ب ـ إذا كان المكلَّف قادراً على التكسُّب والعمل واكتساب المال، لكنّ هذا العمل والتكسّب لم يكن مناسباً لشأنه ودرجته، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يشتغل بهذا العمل، ويمكن له الارتزاق من مال الزكاة.
وفي هذا يقول السيّد محمد كاظم اليزديّ([25])، ومعه آخرون([26]): «إذا كان يقدر على التكسّب، لكنْ ينافي شأنه، كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله، يجوز أخذ الزكاة».
ويقول الآغا ضياء الدين العراقيّ: «حينئذٍ فلا مجال لإلزام الشرفاء ـ من ذوي الفضل والاحترام، وكذا أهل العلم من الطلاّب المحصِّلين في طريقة الاجتهاد والاستنباط ـ على اختيار الكسب فوق استعداده ولياقته»([27]).
وما قالوه في دليل هذه المسألة هو أنّ الفقير الذي لديه حرفة يشتغل بها لا يجوز له أن يأخذ الزكاة؛ لأنّ عنوان الفقير ليس منطبقاً عليه؛ إذ هو عرفاً مالكٌ بالقوّة لمؤونته وما يحتاج إليه في نظام معاشه. ومن هنا ورد في الروايات أنّ صاحب الشغل ليس له أن يأخذ الزكاة، كمثل: صحيحة زرارة، التي جاء فيها: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ولا لذي مرّةٍ سويّ، ولا لمحترف»([28]).
لكنْ في المسألة التي هي مورد بحثنا هنا، وهي أن يكون هناك شغلٌ له، لكنّه ليس مناسباً لشأنه، لا يصدق عليه عنوان الفقير، ومعه تكون الروايات المذكورة منصرفة عن أن تكون شاملةً لمثله([29]).
يقول السيّد الخوئي: «فإنّ المتمكّن من الاكتساب وإنْ لم يجز له أخذ الزكاة، إلاّ أنّ تلك الأدلّة منصرفة عن مثل المقام، ممّا كانت نوعية الاكتساب غير لائقةٍ بشأنه ومقامه، مثل: الاحتطاب أو الكنس في الطرقات، ونحو ذلك ممّا يتضمَّن الذلّ والمهانة، مع كونه من أهل العزّ والكرامة»([30]).
وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكروا دليلاً آخر في المقام، وهو أنّ أدلّة نفي العسر والحرج تنفي لزوم اتِّخاذ شغلٍ له يكون دون شأنه. ومن هذه الجهة يجوز له أخذ الزكاة.
يقول المحقِّق آقا رضا الهمداني في كتابه «مصباح الفقيه»، في بيان العسر والحرج الحاصلين من تكسُّبه بشغلٍ يقلّ عن شأنه: «أمّا القدرة على الكسب والصنعة غير اللائقين بحاله، فليست مانعةً عن تناولها جَزْماً. فلا يُكلّف الرفيع ببيع الحطب والحرث والكنس وخدمة مَنْ دونه في الشرف وأشباه ذلك ممّا فيه مذلَّة في العرف والعادة؛ فإنّ ذلك أصعب من بيع خادمه وداره الذي قد سمعْتَ في خبر إسماعيل بن عبد العزيز المتقدِّم [وقد نقلنا نحن هذه الرواية آنفاً] التصريح بعدم لزومه، مع ما فيه من الحَرَج المنفيّ بأدلّتها»([31]).
وقد ذكر شبيه هذا المضمون ابن فهد الحلّيّ في «المهذّب البارع»([32]).
كما قال الشيخ الأنصاريّ أيضاً: «…إنّ منعَ المؤمن عن الزكاة، وإلجاءَه إلى ما لا يليق به من المكاسب، أشدّ إذلالاً»([33]).
نقدٌ ومناقشة
ما ذُكر من الوجه لاشتراط لحاظ الشأن في هذه المسألة دليلان:
أـ الظهور العرفيّ: بأن يُقال: إنّ المكلّف الذي أُتيح له شغل غير لائق بشأنه، ثمّ لم يشتغل به، يصدق عليه عرفاً أنّه فقير. ولذلك لا يمكن حرمان مثل هذا الشخص من الزكاة؛ برواياتٍ من قبيل: صحيحة زرارة؛ إذ إنّ ما يفهمه العرف من هذه الروايات هو أنّ الشخص الذي له شغل لائق بشأنه ومناسب لحاله ليس له أن يأخذ الزكاة، وليست ناظرةً أصلاً إلى الشخص الذي يكون له شغلٌ دون شأنه ومقامه.
وهنا، وبالنظر إلى الملاحظات التي قدَّمناها، نقول: إنّ هذه الروايات شاملة بإطلاقها لكلّ شخصٍ أُتيح له شغلٌ يتكسَّب به، ولا يخرج عن هذا الإطلاق إلاّ الأشخاص الذين يشتغلون شُغْلاً نهى عنه الشارع مباشرةً، أو كان شُغْلهم ناشئاً عن أمرٍ غير شرعيّ.
لكنْ بما أنّ مثل هذا الشخص يُعدّ فقيراً بنظر العُرْف فلا يمكن القول بأنّه يكون فقيراً أيضاً بنظر المولى؛ إذ إنّه بسبب مراعاة الشأن، الذي هو أمرٌ مبغوض لدى المولى (كما ذكرناه آنفاً)، قد تسبَّب إلى جعل نفسه عاطلاً عن العمل، مع أنّه يُعَدُّ في نظر المولى إنساناً قادراً على رفع احتياجاته بالتكسُّب والعمل. ومع هذا كيف يُترقّب أن يكون مراد المولى من عنوان الفقير الذي ورد في كلماته شاملاً لمثل هذا الشخص؟!
ب ـ قاعدة لا حرج: إنّ حرمان المكلَّف من الزكاة لأجل عدم اشتغاله بالشغل الذي لا يتناسب مع شأنه ومقامه يصدق عليه أنّه إيقاع له في الحَرَج. والعسر والحرج عبارة عن أن يرتطم الإنسان بحالةٍ مضادّة لإدراكاته ومشاعره الداخليّة.
لكنّ هذه الإدراكات والمشاعر إذا كانت مخالفةً للشارع، وكانت بنظر الشارع إدراكات ومشاعر كاذبة وغير صحيحة، لا يمكن أن يُقال: إنّ المولى يرفع بقاعدة نفي العسر والحَرَج حتّى الحَرَج والعسر اللّذين هما بنظره مرتفعان أو باطلان.
وكما بيّنّا في بداية الكلام فإنّ الشارع يرى بطلان لحاظ الشأن والمنزلة الاجتماعيّة للأفراد. وعلى هذا الأساس فإنّ الحرج الذي ينشأ من إدراكٍ يبتني على أمرٍ منهيٍّ عنه من قبل الشارع؛ لكونه موجباً للتمييز بين الأشخاص، لا يمكن لنا أن ننفيه بإجراء قاعدة لا حَرَج.
مدخليّة الشأن في الحجّ
أـ اشترط الفقهاء في وجوب الحجّ شرطاً لا يتحقَّق الوجوب إلا به، وهو شرط الاستطاعة الماليّة. وفُسِّرت الاستطاعة بأنّها عبارة عن الزاد والراحلة (متاع السفر والوسيلة اللاّزمة له)؛ وذلك أوّلاً: لأنّ الاستطاعة لا تتحقَّق ولا تصدق على المكلّف إذا كان فاقداً للزاد والراحلة؛ وثانياً: لورود الروايات التي اشترطت وجود الزاد والراحلة في تحقّق عنوان الاستطاعة([34]).
لكنْ ما هو مقدار الزاد والراحلة كمّاً وكيفاً؟
1ـ الزاد والراحلة اللّذان يُشترطان في صدق الاستطاعة هما ما يكونان مناسبين لشأن المكلّف ومنزلته الاجتماعيّة؛ إذ العرف لا يُدرك شرطيّة الزاد والراحلة مطلقاً وكيفما كان، بل إنّه يرى شرطيّة خصوص الزاد والراحلة اللائقين بشأن المكلَّف وحاله([35]).
نقدٌ ومناقشة
هذا الفهم والاستنتاج المنسوب إلى العرف يمكن التشكيك فيه؛ فإنّ الدليلين المذكورين الواردين في إثبات شرطيّة الزاد والراحلة في السفر مطلقان من ناحية تحديد كيفيّة المتاع الذي يجب توفُّره في السفر، وكمّيّته، ومدخليّة شأن الأفراد ومنزلتهم فيه.
هذا بالإضافة إلى ما تقدّم منّا في المناقشات السابقة من أنّ العرف إذا كان يرى مدخليّة الشأن في تحديد الزاد والراحلة، وإذا كان لا يفهم من كلمتي الزاد والراحلة إلاّ ما هو لائق بالشأن والمنزلة الاجتماعيّة للأشخاص، فإنّه لا يمكن لنا أن ندَّعي أنّ هذا الفهم العرفيّ هو نفسه مقصود الشارع؛ إذ إنّ هذا الفهم إنّما يكون حجّةً وقابلاً للتطبيق والبناء عليه فيما لو لم يكن بصدد نفي شيءٍ من أحكام الشارع الأُخرى، والحال أنّ الشارع ـ كما بيّنّا سابقاً ـ لا يرضى بملاحظة الشأن والمقام الاجتماعيّ.
2ـ في كيفيّة الراحلة خلافٌ بينهم: فهل يُشترط في تحقُّق الاستطاعة وجود راحلة لائقة بشأنه ومقامه ومنزلته الاجتماعيّة أم أنّه لا يُشترط ذلك؟
2ـ أـ ذهب جماعة منهم، كالشهيد الأوّل([36]) والشيخ النراقي([37]) وآخرين([38])، إلى أنّه لا يُشترط في الاستطاعة وجود الراحلة المناسبة واللاّئقة بشأنه؛ وذلك لأدلّةٍ ثلاثة، هي:
1ـ الآية الكريمة التي دلّت على أصل شرطيّة الاستطاعة، وهي قوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، بتقريب أنّها مطلقة من ناحية تحديد كيفيّة الراحلة.
2ـ الروايات التي دلّت، إمّا بالصراحة أو بما هو قريبٌ منها، على نفي لزوم مراعاة الشأن في الراحلة. فهذه الدلالة الصريحة تقيِّد أدلّة نفي العسر والحَرَج. ومن هذه الروايات: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله×: مَنْ عُرض عليه الحجّ ولو على حمارٍ أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيعٌ للحجّ([39]).
3ـ السيرة العمليّة والسلوكيّة للأئمّة المعصومين^، حيث كانوا لا يبالون في السفر إلى الحجّ بالشأن والمقام الاجتماعيّ، فكانوا يركبون أيَّ دابّةٍ، من حمار أو بغل أو غير ذلك. وهو شاهدُ صدقٍ واضح على عدم لزوم مراعاة الشأن في اختيار الراحلة.
وقد أُجيب عن هذه الأدلّة الثلاثة:
1ـ إنّ آية شرطيّة الاستطاعة لا إطلاق لها كما قيل؛ إذ الاستطاعة في الحالات التي يكون السفر إلى الحجّ فيها موجِباً للذلّة والمنقصة والإهانة لا يصدق عليها عرفاً أنّها استطاعة على الحقيقة([40]). وعلى تقدير التسليم بأنّ للآية الكريمة إطلاقاً فإنّ أدلّة نفي العسر والحَرَج تكون حاكمةً على هذا الإطلاق المزعوم([41]).
ومن هنا قال السيّد البروجردي في تعليقته على العروة الوثقى: «الظاهر عدم الإطلاق؛ إذ لا يكون عرفاً ممَّنْ استطاع إليه سبيلاً، مع فرض توقُّفه على ما يكون له فيه مهانة وذلّ بحَسَب حاله»([42]).
وقال السيد الكلبايكاني أيضاً: «لا يبعد عدم صدق الاستطاعة في ما يتوقَّف الحجّ على ما فيه هدمٌ لشرفه»([43]).
2ـ إنّ الروايات وإنْ كانت مطلقةً من جهة تعيين المبذول له، بمعنى أنّه يُستفاد من إطلاق هذه الروايات أنّ الحجّ واجبٌ على كلِّ مكلّفٍ بُذل له الحجّ، ولو على حمارٍ أجدع، سواء كانت هذه الراحلة لائقة بشأنه ومناسبة لحاله أم لم تكن، إلاّ أنّ هذه الروايات ـ مع ذلك ـ ليس لها صراحة في نفي الشأن الذي يكون موجباً للوقوع في العسر والحَرَج، حتّى يُقال بأنّها ـ أي هذه الروايات ـ تكون موجبةً لتقييد أدلّة نفي العسر والحَرَج([44]). هذا بالإضافة إلى أنّ لسان أدلّة نفي العسر والحَرَج لسانٌ آبٍ عن التخصيص والتقييد([45]).
3ـ ليس من الصحيح أن يُقال: إنّ الأئمّة المعصومين^ بركوبهم على دوابّ من قبيل: البغل والحمار كانوا يوقعون أنفسهم في الذلّة والمهانة، بل لعلّ الركوب على مثل هذه الراحلة لم يكن في ذلك الزمان منافياً للشَّرف، أو موجباً للذلّة والمنقصة. أضِفْ إلى ذلك أنّه لم يُعلم أنّ ركوبهم^ على مثل: البغل والحمار كان في حجّة الإسلام حتّى يُقال: إنّ الأئمّة^ بامتلاك راحلةٍ من هذا القبيل، وبامتلاك المركب الذي ينافي شأنهم ومقامهم، بلغوا حدَّ الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحجّ([46]).
2ـ ب ـ ذهب العلاّمة الحلّي([47]) وآخرون([48]) إلى أنّ الحاجّ إنْ لم تكن له راحلة أُخرى إلاّ الراحلة التي هي منافية لشأنه ومقامه فإنّ الحجّ لا يكون واجباً عليه. لكنْ في المقابل ذهب جماعة، منهم: الشيخ الأنصاري([49]) والسيّد محمد كاظم اليزدي([50]) والإمام الخميني([51]) والسيّد الخوئي([52])، إلى تقييد عدم وجوب الحجّ بما لو كانت الراحلة غير اللاّئقة بشأنه موجبةً لوقوع المكلّف في العسر والحَرَج.
قال السيّد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى: «المراد بالراحلة مطلق ما يُركَب، ولو مثل: السفينة في طريق البحر، واللاّزم وجود ما يناسب حاله بحَسَب القوّة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف، كمّاً وكيفاً، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة، بحيث يُعدّ ما دونها نقصاً عليه، يُشترط في الوجوب القدرة عليه، ولا يكفي ما دونه»([53]).
وأدلّة هذا القول، أعني القول بوجوب رعاية الشأن في الراحلة والمحمل، عبارة عن الوجوه التالية:
1ـ وجود انصرافٍ في الآية الكريمة التي دلّت على شرطيّة الاستطاعة، وفي الأخبار المفسّرة لمعنى الاستطاعة الواجبة، حيث يُستفاد من هذا الانصراف أنّ الاستطاعة لا تتحقَّق لدى المكلّف إلاّ إذا امتلك الراحلة العرفيّة، وهي ليست إلاّ الراحلة التي تكون مناسبةً لشأنه ولائقةً بحاله([54]).
٢ـ الحجّ الذي يكون حجّاً حَرَجيّاً؛ بسبب عدم مراعاة الشأن، يُمكن أن يُنفى وجوبه بأدلّة نفي الحَرَج([55]).
٣ـ دلَّتْ موثَّقة أبي بصير ـ وهي: مَنْ مات وهو صحيحٌ موسر لم يحجّ فهو ممَّنْ قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾([56]) ـ على أنّ الحجّ غير واجب على غير الموسِر، وأنّ المكلّف المبتلى بعُسْرٍ وضيق لا يكون مشمولاً للآية الكريمة: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، حتّى لو كان هذا العسر والضيق من جهة عدم مراعاة الشأن. وعلى هذا الأساس فإنّ المكلّف الذي يقع في ضيقٍ؛ بسبب عدم مراعاة شأنه الذي لا يليق به، لا يكون موسراً، وبالتالي لا يكون الحجّ واجباً عليه([57]).
نقدٌ ومناقشة
بالنظر إلى الأدلّة التي دلَّتْ على أنّ الشأن دخيلٌ في الراحلة، وبالنظر أيضاً إلى فتاوى الفقهاء القائلين بذلك، يمكن لنا أن نقسِّم القائلين بلزوم مراعاة الشأن في اختيار الراحلة التي تكون لائقةً بشأنه إلى مجموعتين:
أـ القائلون بلزوم مراعاة الشأن في خصوص الحالات التي يلزم فيها الحَرَج، وأمّا حيث لا يلزم الحَرَج فلا.
ب ـ القائلون بلزوم مراعاة الشأن مطلقاً، سواءٌ كان يلزم منه الحَرَج أم لم يكن.
وتشترك المجموعتان معاً في القول بلزوم تقييد الروايات التي استدلّ بها المخالفون لاعتبار الشأن ودخالته، وهم يقولون بعدم كون هذه الروايات صريحةً في ما ادُّعي من عدم لزوم الاعتناء بالشأن والمقام في اختيار الراحلة، وبأنّ هذه الروايات لها إطلاقٌ من ناحية تعيين الراحلة كمّاً وكيفاً، وهذا الإطلاق يؤول أمره إلى أن يكون مقيّداً بالأدلّة الأُخرى.
لكنّ الذي يبدو لنا أنّ مثل هذا الكلام من شأنه أن يُخرج هذه الرواية عن معناها المعقول. ويبقى بوسعنا أن نسأل كلا هذين الفريقين عن معنى السؤال والجواب الواردين في بعض الروايات، من أمثال: صحيحة محمد بن مسلم، وهي: «قلْتُ لأبي جعفر×: فإنْ عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممَّنْ يستطيع الحجّ. ولِمَ يستحيِي، ولو على حمارٍ أجدع أبتر؟! فإنْ كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ». فلماذا يسأل الراوي هنا عن حياء هذا الحاجّ وخجله؟ وهل يوجد في الذهاب إلى الحجّ خجلٌ أصلاً؟ ولماذا اعتبر الإمام× خجله هذا خجلاً لا داعي له؟ وهل علّة الحياء والخَجَل شيءٌ آخر سوى أنّه لم تتوفَّر له الراحلة التي تتناسب والشأن والمقام الذي هو له؟
يُضاف إلى ذلك ما ذكرناه في مناقشة القول بمدخليّة الشأن في الزكاة، من أنّ كلَّ حكمٍ من الأحكام كان فيه عسر وحَرَج على المكلّف فهو يكون منفيّاً بأدلّة نفي العسر والحَرَج، إلاّ أن يكون من قبيل: الحَرَج الذي يحصل للمكلَّف بفعلٍ من إدراكاتٍ وانطباعات لديه هي في حدِّ نفسها منهيّ عنها من قِبَل الشارع؛ فإنّ قاعدة نفي الحَرَج لا تنفي مثل هذا النوع من الأحكام الذي يكون العسر والحَرَج فيه مسبّبين عن إدراكات ومشاعر يراها الشارع كاذبةً وغير صحيحة.
وقد ذكرنا أيضاً أنّ مثل هذا الحَرَج الذي يقع فيه المكلَّف؛ نتيجةً لعدم مراعاة شأنه ومنزلته الاجتماعيّة، هو بنظر الشارع حَرَج كاذب، وغير واقعيّ. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يُقال بأنّ قاعدة لا حَرَج تنفي لزوم لحاظ الشأن في الراحلة.
ومن هنا، فبالنسبة إلى موثَّقة أبي بصير، التي استدلّ بها القائلون بالشأن، يمكن أن نقول أيضاً: إنّ كلّ مَنْ يقع في عسر وحَرَج في ذهابه إلى الحجّ فهو ليس بمستثنى من هذه الرواية، بل المستثنى منها هم خصوص الأشخاص الذين لم يقعوا في حَرَجٍ يكون من الحَرَج الكاذب بنظر الشارع. فهؤلاء فقط هم الخارجون عن الرواية، ولا يكون الحجّ واجباً عليهم.
ب ـ الإنسان الذي يبيع الوسائل التي يحتاج إليها في حياته اليوميّة لكي يتمكّن من السفر لا يُعدّ مستطيعاً بحسب العُرْف، وهذا يعني أنّ المكلَّف إنّما ينطبق عليه عنوان المستطيع إذا كان قادراً ـ علاوةً على توفير الزاد والراحلة ـ على تأمين احتياجاته الضروريّة في حال حضره([58]).
وقد استنتج الشيخ الأنصاري من هذه المسألة ما يرتبط بالمسألة التي هي محلّ بحثنا، أعني البحث عن لزوم مراعاة الشأن في الاستطاعة، حيث قال: «ثمّ إنّ ظاهر ما ذكرنا من الأدلّة اعتبار الرجوع إلى الكفاية في مَنْ يحتاج إليها بحَسَب عادته. فلو اتّفق لفقيرٍ معيشتُه من الأخماس والزكوات أنّه أُعطي الزكاة فأُغني دفعةً واحدة، فاستطاع، فالظاهر أنّه لا يُستثنى في حقِّه مقدارٌ من المال يكون له بضاعةً، ليرجع ويعمل بها لمعيشته، بخلاف التاجر الذي بيده مثل هذا المال، فإنَّه لا يُكلَّف إنفاقه في الحجّ»([59]).
نقدٌ ومناقشة
بعد أن عرفنا عدم وجود دليل على مدخليّة شأن الأشخاص ومنزلتهم في الأحكام يمكن لنا أن ننفي مثل هذا الاستنتاج. يُضاف إلى ذلك أنّ المكلّف وإنْ كان لا يُعدّ مستطيعاً بنظر العرف إلاّ إذا كان قادراً بعد العَوْد من سفر الحجّ على تأمين حوائجه الحياتيّة، فإنّ الفقير الذي صار قادراً على الحجّ بأخذ الزكوات، لكنّه بعد العَوْد من الحجّ لا يزال في حاجةٍ إلى الأخذ من الزكوات ومن بيت المال، مثل هذا الفقير لا يمكن عدُّه عُرْفاً مستطيعاً. وبهذا يظهر أنّ دليل هذه المسألة (وهو الفهم العرفيّ لعنوان المستطيع) لا يمكن تطبيقه في هذا الفرع الذي استنتجه الشيخ الأنصاري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا الفرع يُعدّ شاهداً على صدق مدَّعى هذه المقالة، ودليلاً واضحاً على التمييز الذي قد يقول به البعض بين الفقير والغنيّ على مستوى الأحكام.
مدخليّة الشأن في النفقات
في باب النفقات الواجبة يتعيَّن على المكلَّف أن ينفق بحسب شأن المنفَق عليهم وبحسب مقدار حالهم، كمّاً وكيفاً، فإنْ لم يتمكَّن المكلَّف من دفع النفقة فالواجب عليه أن يدفع النفقة الواجبة، بأيّ وسيلةٍ تكون ملائمةً لحاله، كأنْ يتكسّب بعملٍ لائق بشأنه.
ومن هنا يقول الإمام الخميني ـ وغيره أيضاً([60]) ـ في تحرير الوسيلة([61]): «لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللاّئق بحاله وشأنه، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل: الاستيهاب والسؤال… لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان، كما في نفقة الزوجة».
ودليل هذا القول هو أنّ مفهوم النفقة ليس حقيقةً شرعيّة، بل هو مفهوم موكول إلى العُرْف. وعلى هذا الأساس فما يعدّه العُرْف شرطاً فهو يكون شرطاً في مفهوم النفقة. وبالعودة إلى العُرْف نجد أنّه يشترط في النفقة أن تكون مناسبةً للشأن([62]).
ففي مسألة شراء الجارية (الخادمة) للزوجة، والذي قد يكون جزءاً من النفقة الواجبة، يقول العلاّمة الحلّيّ في تحرير الأحكام([63])، والفاضل الهندي في كشف اللّثام([64])، والشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام([65])، ما نصّه: «المرجع فيه العرف؛ فإنْ كانت من أهل بيتٍ كبير ولها شرف وثروة، لا تخدم بنفسها، فعليه إخدامها، وإنْ تواضعت في الخدمة بنفسها».
نقدٌ ومناقشة
ولكنْ بالنظر إلى عدم انسجام مثل هذا الفهم مع كلمات الشارع يظهر وجه الخلل في هذا الاستدلال العُرْفيّ. وإنْ كان لا بُدَّ من التنبيه هنا على أنّ مثل هذا الفهم إنّما يكون صحيحاً فيما إذا كان العُرْف يعتبر في النفقة أن يُراعى فيها شأن وحال المنفَق عليهم.
موقعيّة الشأن في الإسراف والسَّفَه
التجاوز والتعدّي عن حدِّ الوسطيّة والاعتدال يُعَدّ ـ بنظر العرف والشَّرع معاً ـ إسرافاً. ومن هنا فإنّ قيام شخصٍ ما بصرف المال في الموارد التي لا تكون مناسبةً لشأنه ومقامه يُعدّ بنحوٍ من الأنحاء نوعاً من تجاوز الحدّ والخروج عن الاعتدال، فيصدق عليه حينئذٍ عنوان الإسراف. وأمّا السَّفه فهو سببٌ من الأسباب المؤدّية إلى تحقّق الإسراف، وهو أيضاً يصدق على صرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة، التي تكون لائقةً بشأنه ومناسبةً لحاله.
يقول المحقِّق النراقي: «أمّا الصرف في ما لا يليق بحاله فهو أن يصرفه في ما يترتَّب عليه فائدة دينيّة أو دنيويّة، ولو مجرَّد الزينة التي أباحها الله تعالى لعباده، ويعدّها العقلاء فائدةً، ولكنّها كانت غير لائقةٍ بحاله عند أهل العُرْف، متجاوزةً عن حدّه وشأنه، كصرف السوقيّ الذي ليس له كلَّ يومٍ درهمان مالاً في تزويق بيته بالذهب أو اللاّجورد»([66]).
ويقول الشهيد الثاني أيضاً، مبيِّناً المقصود من الأغراض غير الصحيحة: «المراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرُّفات العقلاء غالباً، كتضييع المال…، وصرف المال في الأطعمة النفيسة، التي لا تليق بحاله بحَسَب وقته وبلده وشرفه وضعته. ومثله شراء الأمتعة الفاخرة. واللّباس كذلك»([67]).
نقدٌ ومناقشة
ذكرنا سابقاً أنّه بنظر الشارع لا مدخليّة أصلاً للشأن والمقام والمنزلة الاجتماعيّة في معرفة وتحديد حدّ الوسط والاعتدال بالنسبة إلى الأشخاص، ولا في تحديد الأغراض الصحيحة من غير الصحيحة. ومن هنا نقول: إنّ الشارع يخطِّئ العرف في تشخيصهم لهذا الحدّ، وفي ما حدَّدوه من ملاكٍ لتصحيح الأغراض أو تخطئتها. ولذا لا يمكن أن يُقال: إنّ شأنيّة الأفراد ومنزلتهم دخيلة في تحقُّق عنوانَيْ: الإسراف؛ والسَّفَه، بنظر الشارع، كما هي دخيلةٌ أيضاً في تحقُّقهما بنظر العُرْف.
مدخليّة الشأن في الديون
يجب على المديون إذا كان دَينه حالاًّ، وطالبه الدائن بالأداء، أن يعمل على تلبية طلبه وردّ الدَّيْن إليه بأيّ وسيلةٍ كانت، لكنْ لا يجب عليه أن يبيع أمتعته الضروريّة اللاّزمة له وما يحتاج إليه في حياته؛ لكي يؤدِّي دَيْنه منها.
وكذلك لا يجب على المفلس الذي لا قدرة له على أداء ديونه أن يبيع ما يحتاج إليه من ضروريّات المتاع ولوازم العيش في سبيل أداء هذه الديون التي عليه.
ففي هذين الموردين يُقال بلزوم مراعاة شأن المديون ومكانته الاجتماعيّة في تشخيص الاحتياجات الحياتيّة اللاّزمة له، والتي هي مستثناةٌ من وجوب البيع.
يقول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة([68])، والسيد الخوئي في منهاج الصالحين([69]): «يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إنْ قدر عليه، ولو ببيع سلعته… وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللاّئق بحاله والأداء منه؟ الأحوط ذلك. نعم، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، و ثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل، وخادمه، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه ولو بحَسَب حاله و شؤونه.
والضابط هو كلّ ما احتاج إليه بحَسَب حاله وشرفه، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد و المتعدِّد، فلو كانت عنده دور متعدِّدة واحتاج إلى كلٍّ منها لسُكْناه، ولو بحَسَب حاله وشرفه، لم يبِعْ شيئاً منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه».
والمستند في هاتين المسألتين الروايات الواردة في هذا المجال. ومن هذه الروايات: حسنة الحلبيّ، وهي: «لا تُباع الدار ولا الجارية في الدَّيْن؛ وذلك لأنّه لا بُدَّ للرجل من ظلٍّ يسكنه، وخادمٍ يخدمه»([70]).
فالإمام× في هذه الرواية يعلِّل بتعليلٍ عامّ يشمل كافّة موارد احتياج المديون. ومن هنا يُستثنى أيضاً جميع احتياجاته المناسبة لشأنه ومقامه؛ وذلك أنّه من الواضح أنّ من جملة موارد الاحتياج مورد ما لو كان المديون بحاجةٍ إلى الإبقاء على أمواله؛ للحفاظ على مقامه ومكانته الاجتماعيّة([71]).
قال صاحب الجواهر: «إنّ ما احتاج إليه من حيث الشرف أشقّ على النفوس من الضروريّات»([72]).
وفي مورد المفلس قال العلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء([73])، والسيد البجنوردي في القواعد الفقهيّة([74]): إنّ الواجب مراعاة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة بعد إفلاس المفلس، لا شأنه ومنزلته قبل صيرورته مُفْلِساً. وهذا نصّ كلام السيد البجنوردي، قال: «لوازم الحياة والمعيشة لها درجات متفاوتة.
والمستثنى منها ما هو لائقٌ ومناسب لحال هذا الشخص في حال إفلاسه، لا في حال ثرائه؛ وذلك لأنّ المناسب واللاّئق بحاله بحَسَب الحوادث الواردة عليه والأحوال الطارئة له تختلف جدّاً. فالشخص الواحد في حال ثرائه وسعة غنائه يختلف مع نفسه في حال إفلاسه، من حيث سعة الدار وضيقها، ومن حيث أمتعة الدار وفرشه ووسائله وبسطه وظروفه وأكله وشربه وألبسته وألبسة أهله وخدّامه ومركوبه وكتبه العلميّة وقرآنه وكتب أدعيته وأغطيته وآلات طبخه وحمّامه.
وخلاصة الكلام: إنّ التاجر الذي يقدّر ثروته بالملايين أو البلايين في حال الثروة والرخاء له شأنٌ من جميع هذه الجهات التي ذكرناها، ليس له ذلك الشأن في حال انكساره وإفلاسه، فلا بُدَّ من مراعاة هذه الجهة في مقام الاستثناء».
نقدٌ ومناقشة
وفي هذه المسألة أيضاً نقول: بعد أن ثبت لدينا أنّ الشارع لا يعتني بحالات الأشخاص من حيث الشأن والمنزلة والمقام الاجتماعيّ، ولا يرى صحّة ذلك، فإنّ مراعاة شأنهم ومقامهم، والحفاظ على منزلتهم ومكانتهم، لا يكون داخلاً في حساب احتياجات المكلَّف والأمور الضروريّة بالنسبة إليه. وعليه لا يمكن أن يُقال: إنّ الشارع من خلال هذا التعليل العامّ ـ الذي ورد في الرواية المتقدِّمة ـ يكون ناظراً إلى استثناء جميع ما يحتاج إليه المديون، بما في ذلك حاجاته الشأنيّة؛ إذ هو لا يرى هذه الحاجات حاجاتٍ للمكلَّف أصلاً.
مدخليّة الشأن في كَفَن الميت
يجب إخراج قيمة الكَفَن بالمقدار الواجب منه من التركة والأموال التي يتركها الميت قبل أداء ديونه وإنجاز وصاياه. وكذا يجب إخراج مؤونة تجهيزه من التركة مقدَّماً على ذلك كلّه.
وقد استُدلّ لهذه الفتوى بالتسالم الفقهيّ، وقيام سيرة المسلمين عليه، ووجود روايات ثلاث، هي: رواية الفضل، ورواية السكوني، ورواية زرارة([75]).
وقال الفقهاء في ذلك: لمّا كان إخراج قيمة الكَفَن ظاهراً في الكَفَن المتعارف فلا بُدَّ من مراعاة ما للميت من الشأن والمقام والمنزلة الاجتماعيّة؛ فإنّ ذلك كلَّه معتبر في الكَفَن الواجب له([76]).
ومن هنا قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة([77]): «يخرج الكفن ـ عدا ما استُثْني ـ من أصل التركة، مقدَّماً على الديون والوصايا و الميراث. والظاهر خروج ما هو المتعارف اللاّئق بشأنه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب، مع التحفّظ على عدم إهانته».
وقال السيد الخوئي أيضاً: «هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف وعدم التكفين بالأفضل هَتْكاً، وإلاّ فيجب إخراج الأفضل، كما لو كان من الأشراف أو العلماء ونحوهم»([78]).
نقدٌ ومناقشة
لو قبلنا أنّ العرف يرى أنّ الشأن والمقام الاجتماعيّ دخيلٌ في كون الكفن متعارفاً فإنّنا مع ذلك نقول: إنّ الشارع حيث كان لا يعتني بشأن المكلّف ومقامه وما له من المنزلة فهو لا يرى الشأن دخيلاً في الكفن المتعارف. وعلى هذا الأساس لا يصحّ لنا أن نحمل كلامه على معنىً هو لا يرتضيه، ولا يقبل به.
مدخليّة الشأن في القضاء
إذا اشتكى مدَّعٍ على شخصٍ ما، فللقاضي أن يحضر الشخص المدَّعى عليه إلى مجلس القضاء؛ من أجل أن يسائله في الشكوى التي أوردها المدَّعي في حقِّه.
لكنّ العلاّمة الحلّي([79]) ـ تبعاً لابن الجنيد ـ قال في مختلف الشيعة: «فإنْ كان المستَعْدى عليه من أهل الشرف والمحلّ عند السلطان وجَّه الحاكم إليه مَنْ يعرّفه الحال؛ ليحضر أو وكيلٌ له، أو ينصف خصمه ويغنيه عن معاودة الاستعداء عليه».
نقدٌ
لكنّ هذه الفتوى في هذا الفرع الفقهيّ ليست سوى نتيجةٍ لتحكيم هذين العلَمَيْن للذهنيّة العرفيّة غير الشرعيّة، وبالتالي هي لا تعدو أن تكون استحساناً مَحْضاً.
الهوامش
(*) باحثٌ في الجامعة والحوزة العلميّة. من إيران.
([1]) مجموعه آثار 2: 250.
([2]) بحوث في علم الأصول 7: 334.
([3]) ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 1).
([4]) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ (النساء: 1).
([5]) المنافقون: 8.
([6]) الصحيفة السجّاديّة: 158.
([7]) ﴿لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 273).
([8]) العروة الوثقى 4: 285.
([9]) تحرير الوسيلة 1: 357؛ منهاج الصالحين 1: 463.
([10]) البروجردي، رسالة في الخمس: 409؛ موسوعة الإمام الخوئي 25: 252.
([11]) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 202.
([12]) موسوعة الإمام الشهيد الصدر 13: 486.
([13]) موسوعة الإمام الخوئي 25: 253.
([14]) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 90.
([15]) العروة الوثقى 4: 285.
([16]) مستمسك العروة الوثقى 9: 539.
([17]) الشاهرودي، الخمس 2: 249.
([18]) العروة الوثقى 4: 101.
([19]) جواهر الكلام 15: 319.
([20]) الشاهرودي، الزكاة 2: 454.
([21]) الكافي 3: 561.
([22]) موسوعة الإمام الخوئي 24: 30.
([23]) الكافي 3: 562.
([24]) الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 270؛ المستمسك 9: 225؛ المرتقى إلى الفقه الأرقى 2: 234.
([25]) العروة الوثقى 4: 103.
([26]) الخوئي، منهاج الصالحين 1: 431.
([27]) الآقا ضياء، شرح تبصرة المتعلِّمين 3: 6.
([28]) وسائل الشيعة 9: 234.
([29]) الشاهرودي، الزكاة 2: 458؛ المرتقى إلى الفقه الأرقى 2: 236.
([30]) موسوعة الإمام الخوئي 24: 30.
([31]) مصباح الفقيه 13: 495.
([32]) المهذّب البارع 1: 530.
([33]) كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 270.
([34]) موسوعة الفقه الإسلاميّ 11: 400.
([35]) تفصيل الشريعة 1: 93؛ التهذيب في مناسك الحجّ والعمرة 1: 65.
([36]) الدروس 1: 312.
([37]) مستند الشيعة 11: 32.
([38]) كشف اللّثام 5: 96؛ مجمع الفائدة والبرهان 6: 52 ـ 53؛ الشاهرودي، الحجّ 1: 104.
([39]) تهذيب الأحكام 5: 4.
([40]) مصباح الهدى 11: 320.
([41]) العروة الوثقى 4: 365؛ معتمد العروة 1: 88.
([42]) العروة الوثقى 4: 365 (حاشية البروجردي).
([43]) العروة الوثقى 4: 365 (حاشية الكلبايكاني).
([44]) موسوعة الإمام الخوئي 26: 70.
([45]) تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 95.
([46]) جواهر الكلام 17: 256؛ مستمسك العروة الوثقى 10: 75 ـ 76.
([47]) التذكرة 7: 52.
([48]) التهذيب في مناسك الحجّ والعمرة 1: 65.
([49]) كتاب الحجّ (تراث الشيخ الأعظم): 28.
([50]) العروة الوثقى 4: 365.
([51]) تحرير الوسيلة 1: 341.
([52]) معتمد العروة 1: 89 ـ 90.
([53]) العروة الوثقى 4: 365.
([54]) التهذيب في مناسك الحجّ والعمرة 1: 65.
([55]) تفصيل الشريعة 1: 96؛ العروة الوثقى 4: 365.
([56]) الكافي 4: 269.
([57]) موسوعة الإمام الخوئي 26: 69؛ مستمسك العروة الوثقى 10: 76.
([58]) تعليقة البروجردي على العروة الوثقى 4: 370.
([59]) كتاب الحجّ (تراث الشيخ الأعظم): 35.
([60]) هداية العباد 2: 384.
([61]) تحرير الوسيلة 2: 321.
([62]) المسالك 8: 455؛ الحدائق 25: 119؛ رياض المسائل (جماعة المدرّسين) 10: 546؛ الشيخ فاضل اللنكراني، كتاب النكاح: 588؛ فقه الإمام الصادق 5: 314.
([63]) تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة 4: 31.
([64]) كشف اللّثام 7: 566.
([65]) جواهر الكلام 31: 335.
([66]) عوائد الأيّام: 634.
([67]) مسالك الأفهام 4: 152.
([68]) تحرير الوسيلة 1: 617.
([69]) السيّد الخوئي، منهاج الصالحين 2: 172.
([70]) الكافي 5: 96.
([71]) البجنوردي، القواعد الفقهيّة 7: 203؛ السبزواري، مهذّب الأحكام 21: 25.
([72]) جواهر الكلام 25: 336.
([73]) تذكرة الفقهاء 15: 59.
([74]) البجنوردي، القواعد الفقهيّة 7: 204.
([75]) موسوعة الإمام الخوئي 9: 138 ـ 139، 142.
([76]) المصدر نفسه.
([77]) تحرير الوسيلة 1: 73.
([78]) موسوعة الإمام الخوئي 9: 142.
([79]) مختلف الشيعة 8: 428.
المصدر: نصوص معاصرة
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي