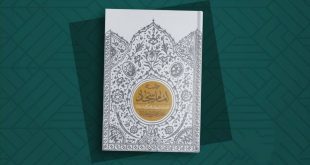الاجتهاد: رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي العالم السّلفيّ ربيع بن هادي المدخلي، وهو من الرّموز السّلفيّة المعاصرة، والّذين أحدثوا ضجيجا داخل التيار السلفي ذاته في العقود الثّلاثة الماضية عموما، وبعد التّشظيّ الّذي حدث داخل التّيار السّلفيّ بوفاة علمائه الثّلاثة:
ابن باز وابن عثيمين والألباني (1999- 2000م)، وكان للجاميّة والمدخليّة شيء من الانتشار والتّمدّد بعد حادثة جهيمان العتيبيّ (حادثة الحرم) 1979م، ثمّ ازداد حضورها بعد التّمدّد الأفقيّ للتّيارات السّلفيّة الصّحويّة (حرب الخليج والاستعانة بالقوات الأجنبيّة 1990 / 1991م – وثيقة النّصيحة 1992م – انتفاضة بريدة 1995م)، وقد سبق وأن كتبت أكثر من مقالة في بعض التّحولات في السّلفيّة المعاصرة، والّتي لها علاقة بمقالنا هذا، لكني لا أريد تكرار ذلك، وإنّما أرشد القارئ منها إلى مقالين لي: أولاها في جريدة عُمان بعنوان: “الحدّاديّة بين الجاميّة والحركات الجهاديّة المتطرّفة”، والثّاني في موقعي على الشّبكة العالميّة بعنوان: “عبد الرّحمن عبد الخالق رحلة مع السّلفيّة الحركيّة الدّعويّة”.
السّلفيّة مصطلح متأخر نسبة إلى السّلف أي الآباء الأوائل بالمصطلح الكنسيّ، وفي النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر استخدمته أكثر من جماعة ومنها الاتّجاه الإصلاحيّ في مصر، واستخدام الجماعات السّلفيّة التّقليديّة لهذا المصطلح إشارة إلى ما عليه النّبيّ محمّد – صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه – كما في الرّواية، أو القرون الثّلاثة الخيريّة كما في رواية أخرى، ويرى بعضهم هم أهل الحديث في مقابل أهل الرّأي، ولذا كان متقدّموهم لا يترضون على أبي حنيفة (ت: 150هــ) إمام أهل الرّأي، أو هم الصّفاتيون في مقابل الجهميّة والمعتزلة والماتريديّة والأشاعرة، أو المعدّلون لجميع الصّحابة والمترضون عليهم في مقابل الخوارج والشّيعة، أو الوسط في الوعيد بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، أو القائلون بوجوب طاعة وليّ الأمر وعدم جواز الخروج عليه إلّا إذا ظهر كفرا بواحا، ووجوب طاعة المتغلّب في مقابل الاتّجاهات المجيزة للخروج حال وقوع ظلم، وارتفاع العدل، ومع هذا لا يوجد معايير محدّدة في تحديد مفهوم السّلفيّة، ولهذا كثيرا ما يصيبها التّشظيّ بسبب المصاديق المرتبطة بالتّغيرات السّياسيّة والاجتماعيّة.
وفي نظري هذا الاتّجاه مرّ في تأريخه بخمس تحولات كبرى، التّحول الأول ارتباطه بأهل الحديث وخصوصا الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241هـ)، وما ارتبط به من جدل مع المعتزلة خصوصا في قضيّة خلق القرآن وقضايا الصّفات، والتّحول الثّاني التّشكل الفقهيّ والكلاميّ، وظهور طائفة المطوعة أو المحتسبة والّتي أثارت شغبا في بغداد خصوصا بعد عام 323هـ، وجدلهم مع الشّيعة ثمّ الأشاعرة والمتصوفة، وظهور رموز لهم كالبربهاريّ (ت: 329هـ)، وابن بطّة العكبريّ (ت: 387هـ)، وهنا عاشوا تقلّبات سياسيّة، فخلفاء بني العبّاس منهم من مال إلى الاعتزال، ومنهم من مال إلى التّشيّع والتّقرب من آل البيت، ومنهم من مال إلى أهل الحديث، أو استخدموا هذه الاتّجاهات كورقات لهم، وفي هذه المرحلة بدأ الاتّجاه الشّيعيّ والصّوفي يتمدّد بشكل أكبر كما عند الفاطميين والمماليك، وفي المقابل تأثر من المالكيّة في الأندلس بالصّفاتيّة وأهل الحديث،
ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد المعافريّ القحطانيّ الأندلسيّ (ت: 379هـ) المنسوبة إليه نونيّة القحطانيّ، والتّحول الثّالث التّحول التّيميّ أي نسبة إلى ابن تيميّة (ت: 728هـ)، وهو تحول معرفيّ حيث استخدم الأدوات الكلاميّة والفلسفيّة، ظهر أثرها فقها عند تلميذه ابن القيّم (ت 751هـ)، وتأريخا عند ابن كثير (ت: 774هـ)، وحديثا عند الذّهبيّ (ت: 748هـ)، وابن تيميّة مدرسة فلسفيّة لها تأثيرها الإيجابيّ والسّلبيّ سوف يظهر لاحقا بشكل أكبر عند التّحول الرّابع مع مجيء محمّد بن عبد الوهاب (ت: 1206هـ)؛ لأنّ ابن تيميّة عاش في فترة الدّويلات وهذه غلب عليها الأشاعرة والتّشيّع والتّصوّف،
ثمّ جاءت بعدها الدّولة العثمانيّة وهي حنفيّة ماتريديّة أشاعرة متصوّفه، وهنا خفت بشكل كبير اتّجاه الصّفاتيين/ أهل الحديث/ السّلفيّة، ومن فقهاء الحنابلة أصبحوا أشاعرة وتأثروا بالتّصوّف أيضا، إلّا أنّ مرحلة ابن عبد الوهاب يمكن اعتبارها المرحلة الذّهبيّة لارتباطها بالسّياسة، وبدأت في صراع مع أهل البدع خصوصا المتصوفة أو من يسمونهم القبوريّة، وظهر فيها تحولات من إخوان بريدة وإخوان من طاع الله، وحتّى المفتي محمّد بن إبراهيم (ت: 1391هـ)، وهؤلاء غلب عليهم التّشدّد والتّقليد، والتّمسك بأصول الدّعوة النّجديّة، وتقليد الفقه الحنبليّ، إذا ما استثنينا مثلا الشّيخ عبد الرّحمن السّعديّ (ت: 1376هـ)، وكان أكثر انفتاحا مذهبيّا وعلى تغيرات العصر، ممّا واجه شيئا المعارضة في القصيم وفي بلدتي عنيزة وبريدة خصوصا، وهؤلاء منهجا أقرب إلى التّحولين الأول والثّانيّ، مع الاهتمام بالتّراث التّيميّ وتراث تلامذته،
ومع تأسيس الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة 1961م يبدأ تحول آخر، يبرز فيه ابن باز (ت: 1420هـ) وهو تلميذ محمّد بن إبراهيم، والألبانيّ (ت: 1420هـ)، والاثنان يجمعهما مذهب الدّليل، والألبانيّ أكثر توسعا ممّا أحدث جدلا فقهيّا في الجامعة الإسلاميّة والمدينة المنورة عموما، وأدّى إلى خروجه من المملكة، بينما ابن باز كان أقرب إلى أصول الحنابلة مع انفتاحه على مذهب الدّليل، مع حفاظه على أصول الدّعوة النّجديّة، كما ورث ابن عثيمين (ت: 1421هـ) مجلس ابن سعديّ في جامع عنيزة، وهو أقرب إلى المدرسة التّيميّة خصوصا فقه تلميذه ابن القيّم، وكان أقرب إلى التّعليم والتّربية.
في هذه المرحلة الخامسة بدأ التّمدّد السّلفيّ معرفيّا ودعويّا بشكل كبير جدّا، وتجاوز التّمدّد العسكريّ كما في الدّعوة النّجديّة في المرحلة الرّابعة، وهنا فتحت الجامعات الدّينيّة في المملكة، واستقبلت مئات الطّلاب من العالم، ودعمت ماليّا، كما فتحت فروعا لها في سائر أقطار العالم، ودخل منهجها إلى جامعات أعرق كالأزهر، وأصبح لها مجلّاتها ومنشوراتها بلغات مختلفة، وفي الوقت ذاته استقبلت المضطهدين من رموز الإخوان في مصر وبلاد الشّام، فظهرت القطبيّة والسّروريّة تحت مسمى الصّحوة، وكان ابن باز جامعا للجميع، يراه الكلّ إماما روحيّا لهم، لما يملكه من قدرة إداريّة فارقة مع كونه ضريرا، بيد أنّه كان جامعا لمن كان سلفيّا وفق التّقليد الكلاسيكيّ في محاربة أهل البدع.
في هذه المرحلة أيضا مرّت بتحولات من ظهور المطوّعة (المحتسبة الجدد) في المدينة المنورة 1964م، وتطوّرها إلى حادثة جهيمان العتيبيّ (حادثة الحرم)، وبروز الصّحويّة، وتمدّدها كما عند سفر الحواليّ في مواجهة التّشيّع والحدّ من تمدّد ثورة الإمام الخمينيّ (ت: 1406هـ)، ثمّ مواجهة المدّ اليساريّ والقوميّ والنّاصريّ، والحركات العلمانيّة واللّبراليّة، وتشجيع المشاركة في الجهاد الأفغانيّ، بيد أنّها بعد حرب الخليج 1990 – 1991م بدأت المواجهة مع الدّولة ذاتها، كما بدأ تشكّل الحركات الجهاديّة (القاعدة)، وحركات التّكفير والهجرة، وهنا بدأ تيار جديد يظهر، لم يختلف عن المراحل السّابقة، إلّا أنّه رأى أنّ منهج الجرح والتّعديل لا يتوقف عند منهج أهل الحديث في توثيق الرّواة كما في المرحلة الأولى، بل هو باق إلى يوم القيامة.
قاد هذا الاتّجاه بداية محمّد أمان الجاميّ (ت: 1416هـ)، والّذي ينسب إليه الجاميّة، “والّذي يوجب طاعة وليّ الأمر، وعدم جواز الخروج عليه ما لم يظهر كفرا بواحا، كما لا يجوز النّصحية لولا الأمر في العلن، لما فيه من فتنة بين النّاس، وحرمة تشكل الأحزاب السّياسيّة والدّينيّة”، فشنّ تجريحا للصّحويين والحركيين والجهاديين، واعتبرهم خارج السّلفيّة، وخارج أهل السّنّة والجماعة، وطبيعيّ أن يعمّ ذلك المذاهب الإسلاميّة الأخرى (المبتدعة)، وعلى نهجه كان ربيع المدخليّ، وأحدث في ذلك تأصيلا معرفيّا، وردّ على خصومه داخل النّهج السّلفيّ والّذين رفضوا التّوسع في الجرح والتّعديل، وما يفعلونه – أي الجاميّة والمدخليّة – لا يخرج عن دائرة الغيبة، والفرقة داخل الخطّ السّلفيّ، مع اتّفاق الاتّجاهين على رفض الحركات الصّحويّة والحركيّة الجهاديّة، ومحاربة أهل البدع،
لهذا قام المدخليّ بنقض هذا الاتّجاه كما في رسالته “النّقد منهج شرعيّ”، ويرى فيها أنّ الغيبة لاشكّ أنّها حرام، وأنّ أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم محرّمة … ولكن لمصالح ومقاصد إسلاميّة، ولحماية هذا الدّين، وللحفاظ عليه؛ أباح الله تبارك وتعالى أمورا قد تكون صورة منها غيبة، ولكنّها ليست من الغيبة”، وردّ على الصّوفيّة الّذين “كانوا يعترضون على أئمّة الحديث لماذا تقولون: فلان سيئ الحفظ، وفلان كذّاب، أنتم تغتابون النّاس؟! فقال لهم أهل الحديث:
هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، هذا بيان للنّاس وليس من الغيبة في شيء”، ويرى ذلك قائما حتّى اليوم، إلّا أنّهم واجهوا مشكلة الحدّاديّة أي أصحاب محمود الحدّاد، والّذي توسع في تبديع الأموات كالنّوويّ وابن حجر والألبانيّ، وقال فيهم المدخليّ في رسالته “في الرّد على أبي الحسن المصريّ المأربيّ: “الحدّاديّة الأولى كانوا يبدّعون ابن حجر والنّوويّ، ويبدّعون من لا يبدّعهم، وهؤلاء لا يستبعد منهم تبديع من ذكر إلا أنّهم يستخدمون التَّقية، ثمَّ إِنَّ هؤلاء يُبدّعون من لا يبدّع من وقع في بدعة، يبدّعون علماء المدينة من أهل السّنّة، وعلماء مكّة السّلفيين، والشّيخ النّجميّ، والشّيخ زيد، بل ويكفّرون بعض علماء السّنّة [أي السّلفيّة]، ويحاربون علماء اليمن، ولا يذكرونهم بخير، ويحاربون علماء الجزائر وشبابهم”.
التّحولات الخمس في تأريخ أهل الحديث/ السّلفيّة، والتّشظيّ الّذي حدث داخل التّيار بعد 1960م، وتحولاته الصّحويّة والحركيّة الجهاديّة، ثمّ التّشظيّ بعد وفاة ابن باز 1999م، والصّراع الدّاخليّ نتيجة ظهور التّيار الجاميّ/ المدخليّ/ الحدّاديّ، فأصبح هذا يبدّع/ يفسّق الآخر، وقد يصل إلى التّكفير، ممّا ألف عبد المحسن العبّاد كتاب “رفقا أهل السّنّة بأهل السّنّة”، فقد توسعوا في تبديع المختلف عنهم والتّحذير منه، كما يرى ابن بطّة في كتابه الإبانة أنّه “من علامات النّفاق أن يجلس الرّجل مع صاحب بدعة”، وأنّ “النّظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحقّ من القلب”، وأنّه “من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة”، ويرون المبتدع هنا من هو خارج دائرة الصّفاتيين/ أهل الحديث/ السّلفيّة التّقليديّة، وبهذا التّشظيّ، وعدم انضباط مصطلح السّلفيّة، أصبحوا يسقطون ذلك على من انتسب إليهم تبديعا وتفسيقا وتضليلا وتحذيرا.
هذا التّحول هو ما نراه من جدل بعد وفاة ربيع المدخليّ، ومن داخل التّيار السّلفيّ ذاته، في التّناقض بين المغالاة في حبّه، وأنّه الإمام القامع للبدع، النّاصر للسّنّة، وبين المغالاة في تضليله وعدم التّرحم عليه، ودعوى “مستراح منه”، كما رأينا أثره في الجدل في ثورات الرّبيع العربيّ، وبعد أحداث 7 أكتوبر، فلا أدري ما مستقبل هذا التّشظي، ليس داخل المدرسة السّلفيّة فحسب، بل داخل المذاهب الإسلاميّة ككل، وما يحدث في المنطقة من تحولات فكريّة أوسع، ومن انفتاح معرفيّ، فهل نحن أمام نشوء سلفيّة لبراليّة تنفتح على هذه التّحولات، بما في ذلك تشكّل تيارات إسلاميّة لبراليّة منفتحة على بعضها، وتعيد قراءة أدبياتها وتراثها، أم سندور في ذات التّناقضات التّراثيّة، والّتي كثيرا ما يصاحبها تسييس في إسقاطها واستغلاها في اللّحظة الرّاهنة، ليعيش العقل الجمعيّ في صراعات وهميّة نتيجة تقديسه للشّخوص باسم المذهب أو الإسلام.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي