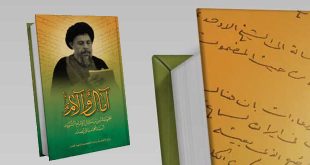الاجتهاد: إن لم يكن الفكر تسبيحا فهو احتفال بالذات، والمفكر الشهيد محمد باقر الصدر (رض) من أفضل من جسد هذه المقولة، فقد كان عقله مسجده، وتعليمه محرابه، وعمله علامة سجوده. تقرؤه فترتفع أمامك قامة عقلية صارمة ودقيقة تقيس الألفاظ والأفكار بميزان الذهب، وتفتتح عوالم لم يسبقه اليها أحد. ثم تسمعه وهو يلقي درسه فكأنه يلقي روحه ويفرش قلبه لطلابه، ونادرا ما اجتمعت تلك الدقة مع هذه الرقة. أمّا في وجه الطغاة فطود شامخ ، وصرخة حق لا تلين.
في مثل هذه الأيام من العام 1980 خسرنا نهراً من المعرفة، ونبعاً من العطاء العلمي، عندما أقدم جلاد العراق على اغتيال الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رض) وأخته السيدة بنت الهدى (رض). وبعد الفاجعة التي أدانها كل صاحب ضمير وعقل حي في هذا العالم، ومنهم الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود الذي قال: إن إعدام مفكر ساهم في تنمية العقل العربي الإسلامي تثير لدينا مشاعر التقزز والاشمئزاز, فالدول المتقدمة تكرم أفذاذها, اما العراق فيعدم مفكريه.[1]
أقول بعد استشهاد السيد الصدر بتلك الطريقة الأليمة، التي أعادت إلى الأذهان كل تاريخ الطغاة، وكانت مشهداً مكثفاً لمظلومية آل البيت عليهم السلام عبر التاريخ، ومن سار على نهجهم من كبار الصحابة والأولياء والعلماء، تحركت الهمم العلمية في دراسة تراث السيد الشهيد فأصبح موضوعا لأكثر من دراسة أكاديمية، ومؤتمر، فيما كانت كتبه قد أصبحت في حياته منهجا تدريسياً في أكثر من جامعة في العالم الإسلامي. وقد استفدنا من مخطوطة للباحث الحاج علي عبد الهادي جابر لم تنشر بعد، عن المغيب الإمام موسى الصدر، أن الإمام الصدر أهدى مجموعة من كتابات السيد الشهيد للرئيس جمال عبد لناصر، ولنخبة من المثقفين السعوديين، طلبت بعدها وزارة المعارف السعودية 500 نسخة من كتاب اقتصادنا.[2]
ولا يخفى ما لهذه الخطوات من دلالة أولاً : على اعتزاز الإمام موسى الصدر بنتاج السيد الشهيد، وثانياً: استخدام هذا المحتوى القيم للترويج للفكر الإسلامي الشيعي حتى في مواطن يسودها العداء التكفيري للشيعة، وتهيمن عليها الوهابية كما هو الحال في السعودية.
أمام هذا البحر الذي كان يغرف من بحور كلمات الله (عز وجل)، بإمكانك دائماً أن تقارب هذه الشخصية المجددة من زاوية لم تحظ بعد بالاهتمام اللازم، أو أن الباحثين أشاروا إليها، ولكن لم يحيطوا بأبعادها كافة… وما يهمنا في هذه المقاربة، أن نسلط الأضواء بحدود هذه الورقة، على جوانب نعتقد وجوب التركيز عليها لتصويب منهج البحث في مدرسة الصدر التي لا تزال تزود العاملين والمجاهدين والمفكرين بمعين لا ينضب من الأفكار الإسلامية والإنسانية، فمروحة اهتمام السيد الشهيد من البداية كانت أوسع حتى من العالم الإسلامي، ومع شدة تركيزه على تلامذته كما سنرى، ظهر له تلامذة عرفوه من روح زرعها في كتبه فاضاءت عقولهم وقلوبهم في مختلف أرجاء العالم.
_ المبحث الأول: المشروع التربوي مدرسة “الحب المحور”.
كانت محاضرة “حب الدنيا وحب الله” الشهيرة، آخر محاضرة القاها السيد الشهيد قبل استشهاده لتلامذته في الحوزة، وتسمع في الشريط ضجيج التأثر بأفكاره وصوته الشجي، حتى قال أحد الطلبة الكبار : الكل تأثر في المحاضرة بما فيهم عناصر الأمن الذين كانوا يراقبون الحدث. وهي بالفعل خلاصة سيره وسلوكه العلمي والفكري والعبادي، وكما كانت أدعية الأئمة ومواعظهم مليئة بالرسائل العميقة فإن السيد أرادها رسائل تحرك العقول والضمائر من القلوب. وانطلاقاً من تلك الموعظة المؤثرة نريد أن نستكشف معالم المشروع التربوي للإمام الشهيد، التي تبرهن عن مقدار الصدق والتكامل بين عقل هذا الحكيم وقلبه وعمله ومشروعه.
قال (رض): إنّ كل حبّ يستقطب قلب الإنسان يتخذ إحدى درجتين: الدرجة الأولى: أن يشكّل هذا الحب محوراً وقاعدة لمشاعر وآمال وطموحات هذا الإنسان. قد ينصرف عنه أحياناً في قضاء حاجة في حدود خاصة، قد ينشغل بحديث، بعمل، ولكن، سرعان ما يعود إلى القاعدة لأنها هي المركز، وهي المحور، يبقى ذلك الحب هو المحور، هذه هي الدرجة الأولى.
والدرجة الثانية من الحب المحور، أن يستقطب هذا الحب كل وجدان الإنسان، بحيث لا يشغله شيء عنه على الإطلاق، أينما توجه يرى ذلك المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحب هذا التّقسيم الثّنائي ينطبق على حب ّالله وينطبق على حب الدنيا[3].
وبعد أن يبين مساوىء هيمنة حب الدنيا على قلب الإنسان يقول:”كل إنسان يستولي حب الدنيا على قلبه سوف يهلك، أما نحن الطلبة إذا استولى حب الدنيا على قلوبنا سوف نهلك ونهلك الآخرين، لأننا وضعنا أنفسنا في موقع المسؤولية … وسوف نتحول إلى قطاع طريق الله..”.[4]
1_ الإسلام يقود الحياة يعني أن الحوزة تقود الناس
يدخل بنا هذا البحث إلى ما يسمى أزمة التوفيق بين التجديد والأصالة، فيظهر أن الأمر محسوم عند السيد الشهيد ، وهو أن التجديد في الفكر والممارسة الإسلاميين يجب أن يتم من داخل “البراديغم” أو “النموذج الإرشادي” التقليدي _ إذا استخدمنا تعبير توماس كون_ ويتطلب هذا الأمر حتى ينتج أثره ويحدث ثورته شكلا من أشكال “المتحد العلمي” الذي يحمل لواء الأفكار الجديدة ويروجها في الوسط المحافظ والجديد. والمكان الأنسب لإنشاء هذا “المتحد العلمي” المجدد هو الحوزة العلمية، التي تمثل بأصالتها معقد الأمل، فيما قد يمثل الجمود في بعض أوساطها بؤرة الأزمة.
أدرك السيد مبكراً جداً أهمية التغيير المدروس في المنهج وطريقة التنشئة المعتمدة في الحوزة، وجعل من كل طالب من طلابه مشروعاً، ليخرج بهم في مواجهة التغريب والإستبداد، علماء شهداء أبرار أتقياء، وبالفعل كان إذا استشهد منهم أحد يبدو عليه التأثر الشديد، حتى يفقد القدرة على الحركة والكلام.
2_ واقعية الهدف
ككل مخطط استراتيجي حاذق، انطلق السيد الشهيد من واقع الحوزة والعراق وسخر كل ما يملك من رصيده الشخصي، للوصول إلى أهدافه التي تتجاوز في أبعادها ساحة العراق إلى العالم الإسلامي بل والعالم أجمع.
وفي هذا الإطار كانت أهدافه وخياراته تتلاءم مع خصوصيات يهدد فقدان واحدة منها بفشل المشروع، وهي تتعلق من جهة بشخص القائد المؤسس والمبادر، وقد كان رضوان الله عليه على تواضعه يشعر بضيق الوقت، وأن وجوده فرصة نادرة لا تتكرر بسهولة، ومن جهة أخرى بالدور الذي أراده للحوزة العلمية، وما كرسته البيئة النجفية من مناهج وتقاليد وأعراف.
أولاً: خصوصية الشخص الذي يحمل لواء التجديد في الحوزة العلمية، حيث يجب أن يكون مجتهداً أو مرجعاً أثبت جدارته في المسار التقليدي، لا شك يعتري خلفياته الإسلامية ولا أصالة أفكاره. وإلا فإن الثورة العلمية لن تحدث أبدا من خارج الحوزة، ومن قبل علماء لا يتمتعون بتلك النشأة التي تجعل آراء العالم الجديدة لا تمثل تحديا لهالة القداسة التي تضفى على بعض الأراء العلمية التقليدية .
ثانياً: خصوصية الحوزة التي رأى السيد الشهيد أنها يجب أن تقود وتتجدد في الآن نفسه، فلا غنى عن هذه البنية التي نجحت في حفظ الإسلام والدفاع عنه في أحلك الظروف، ولكن التحديات أصبحت تهدد حتى التدين التقليدي مهما تعفف عن مواجهتها. ولم تعد أثار التغريب وسلطة الإستبداد تقف محايدة تجاه الدين والتدين والإسلام خصوصاً، بل تسلحت بأساليب الدعاية والحروب الناعمة والتكنولوجيا لتصبح أكثر عدوانية وشراسة، وأقدر على محاصرة الحوزة وحجبها عن الشأن العام.
ثالثاً: خصوصية النجف الأشرف، الذي شكل عبر التاريخ منهجه الخاص في الفقه والأصول بعيدا عن الفلسفة الإجتماعية، وأنتج فطاحل المجتهدين والمراجع في هذا المجال، مما رسم سلفاً ملامح ومقومات الشخصية التي يخرجها المنهج النجفي، بسلطة قيمية ومعرفية ليس من السهل اختراقها.
3_ أركان المشروع التربوي
من هنا كانت أركان المشروع التربوي للسيد الشهيد تتأسس على تجديد مناهج الحوزة، وبناء جيل جديد من العلماء يتميز بالقدرة على تسخير المعرفة الدينية في خدمة المشروع الأكبر عبر علاقة قل نظيرها:
أولاً_ تجديد مناهج الحوزة في المحتوى ما أمكن، وفي الطريقة دائماً، حتى لا يبقى تعقيد العبارة معياراً لعلميتها، خصوصاً أن بعض الكتب المعتمدة لمرحلة السطوح العالية وبحث الخارج لم تكتب أصلا للتعليم بل لعرض آراء العالم المؤلف. وكثيرا ما كان السيد يستغل أوقات العطل لتقديم محاضرات في الأخلاق وتفسير القرآن وفلسفة التاريخ والكلام الجديد بالإضافة إلى دروسه المنتظمة في الفقه والأصول أسبوعياً. وفي كل مجال من هذه المجالات كان يفتتح أطروحة تحتاج إلى تضافر جهود علمية كبيرة لمتابعتها. ولعل أهم من كشف عن التجديدات المعرفية في مجال أصول الفقه، هما السيد محمود الهاشمي في تقريراته للأبحاث الأصولية للسيد الصدر، والسيد كاظم الحائري في تقريراته أيضاً.
ولا شك في أن هذين العالمين بحكم صلتهما القريبة والطويلة بالسيد الصدر ودرسه الأصولي، هما الأقدر من الناحية العلمية، والأكثر موثوقية من الناحية النفسية في الكشف عن طبيعة هذه التجديدات، وتحديد مدى اختلافها وتميزها، وأين تشترك وأين تفترق عن الأفكار والنظريات السائدة والمطروحة في ساحة أصول الفقه.
وفي نظر السيد كاظم الحائري، إن هذه التجديدات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي:
القسم الأول: التجديدات الجديدة التي لم تُبحث من قبل في الفكر الأصولي. ومن هذا القسم في نظر السيد الحائري، ما جاء به السيد الصدر «من البحث الرائع لسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، فقد تكرر لدى أصحابنا المتأخرين (قدس سره) التمسك بالسيرة لإثبات حكم ما، ولكن لم يسبق أحد أستاذنا (رحمه الله) فيما أعلن في بحثه للسيرة، وإبراز أسس كشفها، والقوانين التي تتحكم فيها، والنكات التي ينبني الاستدلال على أساسها، بأسلوب بديع، ومنهج رفيع، وبيان متين…
القسم الثاني: التجديدات المغايرة لما اختاره الأصحاب في الفكر الأصولي. ومن هذا القسم في نظر السيد الحائري، ما جاء به السيد الصدر في «بحثه البديع في حجية القطع، الذي أثبت فيه أن رأس الخيط في البحث، إنما هو مولوية المولى وحدودها، وانحدر من هذا المبدأ إلى الآثار التي تترتب على ذلك، وانتهى إلى إبطال ما بنى عليه المحققون جيلاً بعد جيل من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وآمن بمنجزية الاحتمال، وأن البراءة التي نؤمن بها هي البراءة الشرعية، أما البراءة العقلية فلا…
القسم الثالث: التجديدات المعدلة لما اختاره الأصحاب في الفكر الأصولي. ومن هذا القسم في نظر السيد الحائري، ما جاء به السيد الصدر في «بحثه الرائع عن حقيقة المعاني الحرفية، حيث يوافق فيه على أصل ما اختاره المحققون المتأخرون، من كون المعاني الحرفية هي المعاني النسبية والمغايرة هوية للمعاني الاسمية، ولكن مع إدخال تعديل وإصلاح جوهريين على ما أفاده الأصحاب، ومن هذا القبيل بحثه الذي لم يسبق له نظير عن الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، حيث اختار نفس ما اختاره المحققون من إمكانية الجمع بينهما، وعدم التنافي والتعارض فيما بينهما، ولكن مع التعديل الجوهري لطريقة الاستدلال وكيفية الجمع”.
وإلى جانب هذه التجديدات، أضاف السيد الحائري ما وصفه بالأبحاث البديعة للسيد الصدر، كأبحاثه عن الترتب، والتزاحم، وقاعدة لا ضرر.
يضيف الأستاذ زكي الميلاد: ومع أهمية هذه التجديدات المعرفية وقيمتها، إلا أن التجديد الأهم في نظري عند السيد الصدر ليس التجديد المعرفي وإنما التجديد المنهجي، وهو التجديد الذي يحسب له، ويسجل إليه، ويكاد يتفرد به عن غيره تقريباً.[5]
ثانياً_علاقة مدهشة وغير مسبوقة مع الطلبة، يسودها دفق من الحب والتواضع، وأمل في التمدد المستقبلي علميا وعمليا عبر الطلاب، لخلق ذلك “المتحد العلمي” الذي سيحمل هم الترويج للأفكار الجديدة ، ويعيد تجسير العلاقة بين العلوم الإسلامية كافة، ومنها الفلسفة الإسلامية والكلام الجديد، ثم ينطلق من هذه المنظومة المتماسكة علمياً وفكرياً وسلوكياً نحو إعادة ربط الإسلام وقياداته العلمية بالتحديات الإجتماعية والسياسية التي تواجه الأمة، أو قل نحو الإشتباك الواثق مع قوى التغريب والإستبداد.
توجد شواهد كثيرة على تلك العلاقة العجيبة بين عالم مرجع وفيلسوف كبير، وبين طلابه، أبرزها ذلك الإهداء الذي قدمه للمرحوم السيد عبد الغني الأردبيلي (رحمه الله) في مقدمة حلقات الأصول، والذي يبرز تأثره الشديد بوفاة السيد الأردبيلي والآمال التي كان يعلقها على شخصه ومشروعه في افتتاح حوزة تعتمد حلقات الأصول كمنهج تدريسي وها هي الحروف تنطق بما هو أخفى:
إهداء: بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي وربي يا عليما بضري وفاقتي يا موضع أملي ومنتهى رغبتي، بعينك أي رب وتقربا إليك بذلت هذا الجهد المتواضع في كتابة الحلقات الثلاث لتكون عونا للسائرين في طريق دراسة شريعتك والمتفقهين في دينك، فان وسعته برحمتك وقبولك وأنت الذي وسعت رحمتك كل شئ، فاني أتوسل إليك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج أن توصل ثواب ذلك هدية مني إلى ولدي البار وابني العزيز السيد عبد الغني الأردبيلي ، الذي فجعت به وانا على وشك الانتهاء من كتابة هذه الحلقات فلقد كان له قدس الله روحه الطاهرة الدور البليغ في حثي على كتابتها واخراجها في أسرع وقت، وكانت نفسه الكبيرة وشبابه الطاهر الذي لم يعرف مللا ولا كللا في خدمة الله والحق الطاقة التي أمدتني وأنا في شبة شيخوخة متهدمة الجوانب بالعزيمة على أن أنجز جل هذه الحلقات في شهرين من الزمن، وكان يحثني باستمرار على الاسراع لكي يدشن تدريسها في حوزته الفتية إلي أنشأها بنفسه، وغذاها من روحه من مواطن آبائه الكرام وخطط لكي تكون حوزة نموذجية في دراستها، وكل جوانبها الخلقية والروحية. ولكنك يا رب دعوته فجأة إليك فاستجاب طائعا… وإذا كنت قد فجعت به وأنا في قمة الاعتزاز به وبما تجسدت فيه من عناصر النبل والشهامة والوفاء والايثار، وما تكاملت فيه من خصال التقوى والفضل والايمان، وإذا كان القدر الذي لا راد له قد أطفأ في لحظة أملي في أن أمتد بعد وفاتي وأعيش في قلوب بارة كقلبه وفي حياة نابضة بالخير كحياته، فإني أتوسل إليك يا ربي بعد حمدك في كل يسر وعسر أن تتلقاه بعظيم لطفك وتحشره مع الصديقين من عبادك الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن لا تحرمه من قربي ولا تحرمني من رؤيته بعد وفاته ووفاتي بعد أن حرمت من ذلك في حياته وأرجو أن لا يكون انتظاري طويلا للاجتماع به في مستقر رحمتك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. [6]
و يؤكد موقع الصدرين ما أشرنا إليه من أسلوب متميز في تربية الطلبة، بالقول: كان السيد الصدر قد بدأ في إلقاء دروسه ولم يتجاوز عمره خمس وعشرون عاماً، فقد بدأ بتدريس الدورة الأولى في علم الأصول بتاريخ 12 / جمادى الآخرة / 1378 هـ وأنهاها بتاريخ 12 / ربيع الأول / 1391، وشرع بتدريس الدورة الثانية في 20 رجب من نفس السنة، كما بدأ بتدريس البحث الخارج في الفقه على نهج العروة الوثقى في سنة 1381هـ.
وخلال هذه المدة استطاع سيدنا الأستاذ أن يربي طلاباً امتازوا عن الآخرين من حيث العلم والأخلاق والثقافة العامة، لأن تربية السيد الصدر لهم ليست منحصرة في الفقه والأصول، بل أنّه يلقي عليهم في أيام العطل والمناسبات الأخرى محاضراته في الأخلاق، وتحليل التأريخ، والفلسفة، والتفسير لذا أصبح طلابه معجبين بعلمه وأخلاقه، وكماله إلى مستوىً منقطع النظير، ولهذا حينما يجلس السيد بين طلابه يسود بينهم جو مليء بالصفاء والمعنوية.[7]
يضيف سماحة الشيخ حسن عبد الساتر في مقابلة مع موقع الإجتهاد: كان السيّد شديد التأثّر إذا ما أصاب أحداً أيّ ضرر أو أذى، لدرجة أن يبكي. وعندما استشهد أربعة من الطلبة، ما عاد السيّد يملك قدرة على الحركة وعلى الكلام! … وكان يتفقّدنا نحن الطلبة، بشكل يوميّ، في الأمور كافّة: في المأكل، والمشرب، والمسكن، والملبس، والراحة، والتعب، والوفاة، وولادة طفل، وغيرها الكثير من التفاصيل. فالسيّد الشهيد كان لا يترك هذه المفردات تغيب عن باله، وأنا لمست ذلك بنفسي[8].
هي مدرسة “الحب المحور” حيث يرى المعلم في خدمة طلابه سبيلا لله سبحانه، يكمل تغذيتهم العلمية وبناءهم الأخلاقي والمعنوي، ويجعل من كل واحد منهم مشروعا قائما بذاته، بعفوية العاشق الذي يرى معشوقه في كل زوايا الوجود.
_ المبحث الثاني : المشروع النهضوي العام
لو كنا أمام شخصية عادية لكان المشروع العلمي والتربوي وحده كافياً لاستهلاك كل طاقة المعلم المخلص والحكيم، ولكن السيد الذي كان يكرس في بداية حياته 20 ساعة لطلب العلم، ثم 16 ساعة للبحث والتدريس والتأليف ، و كان ينتهز فرصة المسافة بين البيت والمسجد لتحضير الدرس في السيارة، طالباً من مرافقيه إعطاءه هذه الدقائق القليلة للتفكير … قد وجد بين مشاغله العديدة فسحة لغزو العالم بمشروعه النهضوي الفكري والسياسي والفلسفي. وهو باختصار شديد إعادة طرح الإسلام كخيار سياسي وحضاري بديل عن التجربتين الرأسمالية والإشتراكية ، وتزويد الحكومة الإسلامية بالأفكار والإجتهادات التأسيسية لدستورها واقتصادها واجتماعها، ومصالحة الفلسفة بأحدث اتجاهاتها ومذاهبها الفكرية مع الإيمان بالله سبحانه من خلال :” البرهنة أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الإستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة، هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم.”[9]
1_ الإنجاز الفلسفي
في السياق التاريخي الإسلامي، برزت الحاجة إلى دقة الفقه وعمق الفلسفة ورحابة العرفان في منظومة إحيائية متكاملة ، وكان الفصل بين الفقه والفلسفة من مآسي العلم وأسباب ظهور تيارات التكفير الناشئة عن الإستغلال السياسي للمذاهب الفقهية. أما الروحانية الإسلامية الصافية من الزهد إلى التصوف إلى العرفان فقد نأت بنفسها عن ذلك الصراع وحلقت في سماء العزلة، وكأنها هجرة من الواقع الأرضي إلى رحاب السماء… ونتج عن ذلك خسارة الأمة ما بإمكان الروحانية أن توفره من زخم للجهاد العلمي والعملي.
مع السيد الشهيد رأينا الفلسفة تعود إلى مضمارها الإجتماعي إلى جانب الفقه، ورأينا الزهد والروحانية والحب تتحرر من النخبوية الصوفية لتتحول إلى روابط وجدانية وقلبية بين الله سبحانه والفقيه الفيلسوف، ثم تشتعل بركانا من الطاقة يدفع مسيرة الثورة العلمية بين الأستاذ والطلبة.
لقد اشتمل كتاب فلسفتنا على نقد إجمالي للرأسمالية وتفصيلي للماركسية، لأنه كتب في أوج أستعار المد الشيوعي في العالم العربي والإسلامي، أما الآن وقد انهار المشروع الشيوعي، وأدعت الرأسمالية، والأشكال المتوحشة من النيو ليبرالية أنها نهاية التاريخ، فإن الصراع الفلسفي يجب أن يستكمل لانقاذ العالم الإسلامي من التحالف الخطير بين الديمقراطيات الرأسمالية الغربية وحكومات الإستبداد في العالم الإسلامي، المتحالف بدوره مع السلفيات التكفيرية لتشويه الدين وقمع الفكر وإجهاض فرص التنمية بالحروب الإرهابية التدميرية.
على الفلسفة أن تكمل ما بدأه السيد الشهيد من توظيف للعمق الفلسفي في حل المشكلات الإجتماعية، ولعل من أولى مهامها تحرير الحرية نفسها من مفهومهاالغربي، والتخلص من أشكال الوثنية المعاصرة الناشئة عن المغالاة في تصنيم القيم، هذا المستوى الخطير من الشرك الذي عبر عنه السيد الشهيد “بتحويل “النسبي إلى مطلق” والذي يتشارك مع الإلحاد في إعاقة مسيرة البشرية.
فتحت عنوان “الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدين” كتب يقول:
قد يجد الملاحظ – وهو يفتش الأدوار المختلفة لقصة الحضارة على مسرح التاريخ – ان المشاكل متنوعة والهموم متباينة في صيغها المطروحة في الحياة اليومية، ولكننا إذا تجاوزنا هذه الصيغ ونفذنا إلى عمق المشكلة وجوهرها استطعنا ان نحصل من خلال كثير من تلك الصيغ اليومية المتنوعة على مشكلة رئيسية ثابتة ذات حدين أو قطبين متقابلين، يعاني الانسان منهما في تحركه الحضاري على مر التاريخ، وهي من زاوية تعبر عن مشكلة:
الضياع واللا انتماء وهذا يمثل الجانب السلبي من المشكلة، ومن زاوية أخرى تعبر عن مشكلة: الغلو في الانتماء والانتساب بتحويل الحقائق النسبية التي ينتمي إليها إلى مطلق، وهذا يمثل الجانب الايجابي من المشكلة. وقد أطلقت الشريعة الخاتمة على المشكلة الأولى اسم: الالحاد، باعتباره المثل الواضح لها، وعلى المشكلة الثانية اسم: الوثنية والشرك، باعتباره المثل الواضح لها أيضا. ونضال الاسلام المستمر ضد الالحاد والشرك هو في حقيقته الحضارية نضال ضد المشكلتين بكامل بعديهما التاريخيين.
وتلتقي المشكلتان في نقطة واحدة أساسية، وهي: إعاقة حركة الانسان في تطوره عن الاستمرار الخلاق المبدع الصالح، لان مشكلة الضياع تعني بالنسبة إلى الانسان انه صيرورة مستمرة تائهة لا تنتمي إلى مطلق، يسند إليه الانسان نفسه في مسيرته الشاقة الطويلة المدى، ويستمد من اطلاقه وشموله العون والمد والرؤية الواضحة للهدف، ويربط من خلال ذلك المطلق حركته بالكون، بالوجود كله، بالأزل والأبد، ويحدد موقعه منه وعلاقته بالإطار الكوني الشامل. فالتحرك الضائع بدون مطلق تحرك عشوائي كريشة في مهب الريح، تنفعل بالعوامل من حولها ولا نؤثر فيها. وما من ابداع وعطاء في مسيرة الانسان الكبرى على مر التاريخ الا وهو مرتبط بالاستناد إلى مطلق والالتحام معه في سير هادف.
غير أن هذا الارتباط نفسه يواجه من ناحية أخرى الجانب الآخر من المشكلة، اي مشكلة الغلو في الانتماء بتحويل النسبي إلى مطلق، وهي مشكلة تواجه الانسان باستمرار، إذ ينسج ولاءه لقضية لكي يمده هذا الولاء بالقدرة على الحركة ومواصلة السير، الا ان هذا الولاء يتجمد بالتدريج ويتجرد عن ظروفه النسبية التي كان صحيحا ضمنها، وينتزع الذهن البشري منه مطلقا لاحد له، ولاحد للاستجابة إلى مطالبه، وبالتعبير الديني يتحول إلى إله يعبد بدلا عن حاجة يستجاب لاشباعها. وحينما يتحول النسبي إلى مطلق إلى إله من هذا القبيل يصبح سببا في تطويق حركة الانسان، وتجميد قدراتها على التطور والابداع، وإقعاد الانسان عن ممارسة دوره الطبيعي المفتوح في المسيرة: ” لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ” الاسراء (22).
وهذه حقيقة صادقة على كل الآلهة التي صنعها الانسان عبر التاريخ، سواء كان قد صنعه في المرحلة الوثنية من العبادة، أو في المراحل التالية فمن القبيلة إلى العلم نجد سلسلة من الآلهة التي أعاقت الانسان بتأليهها، والتعامل معها كمطلق عن التقدم الصالح. نعم من القبيلة التي كان الانسان البدوي يمنحها ولاءه باعتبارها حاجة واقعية بحكم ظروف حياته الخاصة، ثم غلا في ذلك، فتحولت لديه إلى مطلق لا يبصر شيئا الا من خلالها، وأصبحت بذلك معيقة له عن التقدم.
إلى العلم الذي منحه الانسان الحديث – بحق – ولاءه، لأنه شق له طريق السيطرة على الطبيعة، ولكنه غلا أحيانا في هذا الولاء فتحول إلى ولاء مطلق، تجاوز به حدوده في خضم الافتتان به، وانتزع الانسان المفتون بالعلم منه مطلقا يعبده، ويقدم له فروض الطاعة والولاء، ويرفض من اجله كل القيم والحقائق التي لا يمكن قياسها بالأمتار أو رؤيتها بالمجهر. فكل محدود ونسبي إذا نسج الانسان منه في مرحلة ما مطلقا يرتبط به على هذا الأساس، يصبح في مرحلة رشد ذهني جديد قيدا على الذهن الذي صنعه بحكم كونه محدودا ونسبيا.
فلا بد للمسيرة الانسانية من مطلق. ولابد ان يكون مطلقا حقيقيا، يستطيع ان يستوعب المسيرة الانسانية ويهديها سواء السبيل مهما تقدمت وامتدت على خطها الطويل، ويمحو من طريقها كل الآلهة الذين يطوقون المسيرة ويعيقونها.[10]
لاحظ أنه رضوان الله عليه اختار مثالين على الشرك المعاصر : القبيلة التي هي رمز البداوة العربية، والعلم الذي تحول إلى صنم الحداثة الغربية، وهاهو صنم الحداثة يتحالف مع صنم البداوة لينتج المنظمات الإرهابية التكفيرية المسلحة بأحدث التقنيات، لتدمير فرص التنمية في كل العالم الإسلامي، وانتاج صورة مشوهة للإسلام بغية تنحيته من طريق الوحش الإستعماري الذي عاد يجتاح عالمنا وينهب مواردنا ناشرا الموت والخراب في كل مدينة وقرية.
وفقا لهذه المقاربة ينبهنا السيد الشهيد إلى أن التوحيد ليس عقيدة فحسب، إنه عملية تحطيم مستمرة لأوثان البداوة والحداثة، من أجل مجتمع وحضارة قائمة على التوحيد تطلق طاقة الإنسان إلى ما لا نهاية…” فالسير نحو مطلق، كله علم، وكله قدرة، وكله عدل، وكله غنى يعني ان تكون المسيرة الانسانية كفاحا متواصلا باستمرار، ضد كل جهل، وعجز وظلم، وفقر.
وما دامت هذه هي أهداف المسيرة المرتبطة بهذا المطلق، فهي اذن ليست تكريسا للإله، وانما هي جهاد مستمر من اجل الانسان وكرامة الانسان وتحقيق تلك المثل العليا له، (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين) ” سورة العنكبوت (6) “، (فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) ” الزمر 41 ” وعلى العكس من ذلك المطلقات الوهمية والآلهة المزيفة، فإنها لا يمكن ان تستوعب المسيرة بكل تطلعاتها، لان هذه المطلقات المصطنعة وليدة ذهن الانسان العاجز، أو حاجة الانسان الفقير، أو ظلم الانسان الظالم . فهي مرتبطة عضويا بالجهل والعجز والظلم ولا يمكن ان تبارك كفاح الانسان المستمر ضدها”.[11]
مع الأسس المنطقية للإستقراء يتضح أن للمشروع الفلسفي عند السيد الشهيد جناحين: نهضة فلسفية للعالم الإسلامي على قاعدة الإسلام، ونهضة فلسفية عالمية على قاعدة الإيمان. إذ لم يسبق لفيلسوف مسلم أن تصدى لحل مشكلة أرقت الفلاسفة على مدى الفي عام ، وفشل في حلها أجيال متعاقبة من الفلاسفة من أرسطو إلى راسل. وكان تمكن السيد من المنطق الرياضي وحساب الإحتمالات وسيلة اثبات واكتشاف منطقة اليقين في المنهج الإستقرائي، وبالتالي وضع العلم بمفهومه التجريبي والإيمان على أرض استدلال واحدة. وقد كانت الفلسفة الإسلامية قبل هذا الإنجاز تعتبر المنهج التجريبي عدواً وتؤثر البراهين العقلية وفق المنهج الأرسطي التقليدي.
وقبل ذلك كان السيد قد استعان بنظرية الحركة الجوهرية لصدر المتألهين[12]، لحل مشكلة العلاقة بين الروح والجسد بعيدا عن نظرية المثل الأفلاطونية والتوازي الديكارتية، وأظهر تفوق الفلسفة الإسلامية بعدما بين أن الحركة الجوهرية هي الصلة بين الروح والجسد…
والآن هل يمكن تطبيق الحركة الجوهرية على حركة الفهم، فنمنح كل فهم جديد للإسلام الحق في الوجود، فهل الإسلام الذي هو روح التاريخ مخلوق ساكن أم كل يوم هو في شأن؟ مع رعاية جواز الإتحاد في الحركة الإشتدادية أو بلغة الشيرازي: صيرورة موجود بحيث يصدق عليه مفهوم عقليّ أو ماهيّة كليّة بعد ما لم يكن صادقاً عليه أولاً، لاستكمال وقع له في وجوده، وهذا ليس يَستحيل بل هو واقع”.[13]
2_ الإقتصاد: معركة النماذج
أفضل أن أطل على كتاب اقتصادنا الذي ألف في ستينيات القرن الماضي، من نافذة الأحداث التي تعصف بالعالم الإسلامي اليوم، ونحن في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين بعد ستة عقود من صدور الكتاب.
لقد تحول الإقتصاد إلى سلاح إخضاع له تأثيره العميق في هندسة المجتمعات، وتغيير الأنظمة، وفرض الأجندات الخارجية. وأصبح انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، والتحكم بندرة الموارد الحياتية الضرورية والسلع الإستراتيجية، ضمن برامج عقوبات مستمرة ، من الأساليب المكررة والمألوفة التي تستخدمها الولايات المتحدة والغرب تجاه أي دولة تبدي رغبة في التخلص من نظام الهيمنة المكرس بعد الحرب العالمية الثانية.
وإذا تأملنا العوامل التي تضعف مناعة الدول والمجتمعات أمام العقوبات، فسنجد أنها تعتمد أولاً: على الظلم وسوء إدارة الموارد والفساد، وثانياً: على اعتماد نماذج غربية جاهزة مبنية على الديون الربوية مهمتها تعميق تبعية الدول والأنظمة والاقتصاد المحلي للدول الكبرى.
ومع ذلك فإن الدعاية الأميركية تقول بصراحة أن مشروع مارشال لإعمار ألمانيا بعد الحرب الثانية، والمشروع الآخر المماثل الذي نفذ في اليابان، يشكلان جزءا من الحرب الناعمة على حد تعبير كولن باول: إن الولايات المتحدة قد احتاجت إلى قوة صلبة لتكسب الحرب العالمية الثانية، وما الذي أعقب القوة الصلبة مباشرة ؟ هل سعت الولايات المتحدة للسيطرة على أمة واحدة في أوروبا؟ كلا. فقد جاءت بالقوة الناعمة في خطة مارشال، وقد فعلنا الشيء نفسه في اليابان.[14]
ثم يعرف جوزف ناي القوة الناعمة فيقول: إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق “الجاذبية بدلاً من الإرغام أو دفع الأموال”. وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما، ومثله السياسية، وسياسته…فعندما تتمكن من جعل الآخرين يعجبون بمثلك ويريدون ما تريد، فإنك لن تضطر إلى الإنفاق كثيرا على العصي والجزرات( أي على عوامل الإرغام والإغراء) لتحريكهم باتجاهك فالإغراء أكثر فاعلية من الإرغام على الدوام، وكثير من القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص للأفراد لها قدرة عميقة على الإغراء. وكما قال الجنرال ويسلي كلارك فإن القوة الناعمة قد أعطتنا تأثيراً أبعد بكثير من الحافة الصلبة لسياسات ميزان القوى التقليدية، ولكن الجاذبية يمكن أن تنقلب إلى نفور إذا تصرفنا بغطرسة ودمرنا الرسالة الحقيقية لقيمنا الأعمق.[15]
الحرب الناعمة إذاً ليست غزواً ثقافياً يستلزم ممانعة أو مقاومة تصده ، إنها حرب “نماذج”، إذ لا يكفي أن تظهر في هذه الحرب بشاعة العدو، إذا لم تقدم نموذجاً بديلاً يتمتع بجاذبية منافسة لما يقدمه في السياسة والثقافة والإقتصاد والإجتماع… وهذا بالضبط ما فعله وسعى إليه السيد الشهيد منذ أكثر من نصف قرن، وعلى عدة مستويات ، ابتداء من شخصه رأينا كيف كان نموذجاً جاذباً لطلابه وكل من رآه، وصولاً إلى الحوزة التي تصورها وسعى لبنائها مع المرحوم السيد الأردبيلي، ولم يكتف في كتابيه اقتصادنا والبنك اللاربوي بنقد النموذج القائم بل رسم معالم الإقتصاد البديل والبنك البديل.
والآن بعد أكثر من نصف قرن أعتقد أن الأحداث التي يشهدها العالم زادت من جاذبية المذهب الإقتصادي الإسلامي كما بينه السيد سواء لناحية أشكال الملكية في الإسلام حيث: مبدأ الملكية ذات الأشكال المتنوعة بدلاً من مبدأ الشكل الواحد للملكية ، الذي أخذت به الرأسمالية والإشتراكية. فهو يؤمن بالملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة. ويخصص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلاً خاصاً تعمل فيه، ولا يعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءاً، أو علاجاً مؤقتاً اقتضته الظروف.[16]
ثم يأتي مبدأ الحريةالمقيدة بالدافع الذاتي، أو بالتدخل الموضوعي بقوة الشرع كمنع الربا والإحتكار، للحؤول دون إساءة استخدام الحرية: وقد كان للتحديد الذاتي الذي وضع الإسلام نواته في تجربته الكاملة للحياة، دوره الإيجابي الفعال ، في ضمان أعمال البر والخير، التي تتمثل في اقدام الملايين من المسلمين بملء حريتهم، على دفع الزكاة وغيرها من الحقوق، والمساهمة في تحقيق مفاهيم الإسلام عن العدل الإجتماعي…
أما الركن الثالث في الإقتصاد الإسلامي فهو مبدأ العدالة الإجتماعية التي جسدها الإسلام، فيما زود به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات، تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلامية..[17]
هذه مقدمة مختصرة جداً لصورة النموذج الإقتصادي الإسلامي كما قدمها السيد الشهيد: فلا تأميم قصري يجبر أصحاب رؤوس الأموال على الهجرة، ولا تغول لرأسمال نتيجة إساءة استخدام الحرية، ولا سلطة تتعدى حدود العدل في تدخلها ، ولا تفاوت طبقي فاحش…إنه اقتصاد يحمل في داخله بذور نشاطه وقوته واستمراره، ويتقوى بتنوع أشكال الملكية وطرق توزيع الثروة فيه، وفي مثل هكذا نموذج اقتصادي لا شك أن سيادة الدولة تزداد منعة وقوة ، وبالتالي فإن مناعتها السياسية تزداد كلما طبقت مبادىء الإسلام الإقتصادية.
ويكمل البنك اللاربوي حل مشكلة احتكار رأس المال واعتباره قيمة بحد ذاته، ويحول البنك من مؤسسة تشغل أموال الناس لصالحها، إلى شريك في أشكال العقود الشرعية المباحة، مما يؤدي إلى دورة مالية ونقدية نشطة تحد من تحكم السلطات بالسيولة النقدية والمالية خلافا للمصلحة العامة للمجتمع أو الخاصة للمواطن. والبنك اللاربوي نموذج آخر، من المؤسسات المالية البديلة لما هو قائم، من بنوك التحكم بأموال الناس ومصائرها وسلمها وحربها وتنميتها وتخلفها.
من الدول والنظم السياسية إلى أصغر المؤسسات لا يوجد أرقى وأصعب من المواجهة بالنموذج البديل، وقد تتطلب فكرة بديلة واحدة جهودا قانونية وإدارية وعملية من أجهزة كفوؤة ، ولكن إذا تحولت إلى مؤسسة فإنها تعزز البنيان المجتمعي والسياسي، وتغنيه عن التبعية في مجالها. “حرب النماذج”، أدركها السيد الشهيد باكراً وقدم مساهمات حاسمة فيها، لا تزال تحتاج بلا شك إلى من يتبناها ويسعى إلى تجسيدها في الواقع.
تبقى ملاحظة لا بد منها : وهي أن النماذج الجذابة ليست أبداً تامة وكاملة، بل هي تلك التي تملك قدرة على حل مشكلاتها وتنمية قدراتها وفعاليتها من داخلها، فنحن نتحدث هنا عن نماذج واقعية وليست أبدا مثالية فوقية وطوباوية، وهذه ميزة أخرى نراها فيما يطرحه السيد الشهيد حيث يظهر الإقتصاد الإسلامي مثلا أكثر واقعية وملاءمة للطبيعة البشرية من تلك النظم الإقتصادية التي تمثل إسقاطاً ايديولوجياً أو تمجيداً لصنم المصلحة الذاتية.
_ المبحث الثالث: الدولة والحكومة الإسلامية
لم يكن خافيا على مفكر بقامة السيد الشهيد أن الدفع الذي تعطيه الدولة لأي مشروع حضاري عالمي، لا يقاس بأي مؤسسة أخرى، لا من ناحية الفرص ولا الإمكانيات. ولذلك تعددت مساهماته في هذا المجال وقدم كالعادة أهم ما يتطلبه المشروع من عدة معرفية، ومنهجيات عمل ..
وكانت البداية في تغيير موقف الإسلاميين من الدولة كمؤسسة، ولفت النظر إلى أنها مؤسسة أسسها الأنبياء عليهم السلام: تعتبر الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. ظاهرة إجتماعية أصيلة في حياة الإنسان ، وقد نشأت على يد الأنبياء عليهم السلام ورسالات السماء، ومن ثم اتخذت صيغتها السوية ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم اجتماعي قائم على أساس الجهد والعدل الذي يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في مسارها الصحيح.[18]
من الشورى إلى ولاية الفقيه وأطروحة المرجعية الصالحة ، كان الفكر السياسي عند السيد يقدم في كل مرحلة إضاءة جديدة لما يجب أن يكون عليه السعي لإقامة الحكومة الإسلامية المعاصرة.
وفي مجال عرض الأهداف التي سعى الشهيد الصدر لتحقيقها يقول موقع الصدرين:
1 ـ كان السيد الصدر يعتقد بأهمية وضرورة إقامة حكومة إسلامية رشيدة، تحكم بما أنزل الله عز وجل، تعكس كل جوانب الإسلام المشرقة، وتبرهن على قدرته في بناء الحياة الإنسانية النموذجية، بل وتثبت أن الإسلام هو النظام الوحيد القادر على ذلك، وقد أثبت كتبه (اقتصادنا، وفلسفتنا، البنك اللاربوي في الإسلام، وغيرها) ذلك على الصعيد النظري.
2 ـ وكان يعتقد أن قيادة العمل الإسلامي يجب أن تكون للمرجعية الواعية العارفة بالظروف والأوضاع المتحسسة لهموم الأمة وآمالها وطموحاتها، والإشراف على ما يعطيه العاملون في سبيل الإسلام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي من مفاهيم، وهذا ما سماه السيد الشهيد بمشروع (المرجعية الصالحة).
3 ـ من الأمور التي كانت موضع اهتمام السيد الشهيد (رضوان الله عليه) وضع الحوزة العلمية، الذي لم يكن يتناسب مع تطور الأوضاع في العراق ـ على الأقل ـ لا كماً ولا كيفاً، وكان أهم عمل في تلك الفترة هو جذب الطاقات الشابة المثقفة الواعية، وتطعيم الحوزة بها[19].
لقد اختار السيد الإنحياز إلى قيادة المرجعية بعد تجربة حزبية قصيرة، على أن يتم تطوير أساليب عمل المرجعية بما يتناسب مع مسؤولياتها من أسلوب الحاشية إلى اسلوب المؤسسة، وانعكس ذلك على طريقة تعيين الوكلاء الذين كان يتم اختيارهم بناء على معايير محددة، والتكفل بكل مصاريفهم، ومنعهم من تحصيل حصة كانت متعارفة من الحقوق لهم من الناس مباشرة، لتغيير الموقف النفسي من وكلاء المرجع، وبناء علاقة تحظى باحترام الناس وتقديرهم. كل المؤشرات تدل على أنه كان يتصورها مرجعية على رأس دولة. وهذا ما أسميه الأسلوب التوحيدي في مقابل الأسلوب النخبوي في التغيير.
ففي حالة العمل الحزبي، يترسخ شعور كوادر الحزب بالنخبوية، ويصبح تأثيرهم على الناس مطوقاً بالذاتية الشخصية، فلا تتسع الدائرة إلى مستوى تجييش الأمة في مشروع الدولة، وتميل الأحزاب إلى الفرز والتصنيف بمعاييرها الخاصة تحت عناوين الحفاظ على “نقاء” وهمي لصفوف الحزب، بينما يطرح الأسلوب التوحيدي أوسع إطار ممكن لحشد طاقات الأمة بكل تنوعاتها، عن طريق الصلة المباشرة بين المرجع القائد والناس. النخبة في الأسلوب الحزبي محددة سلفاً، بينما هي في الأسلوب التوحيدي حصيلة التجربة والمخاض العسير الذي يعيد ترتيب الصفوف بمعيار التضحيات ، ويظهر الطاقات التي ما كانت مرئية بعين المعايير النخبوية.
ومع الوقت يتحول الحزب بذاته إلى غاية بينما هو في المفهوم الإسلامي وحتى السلطة والدولة وسائل لبناء مجتمع إسلامي إنساني تسوده العدالة وتكافؤ الفرص.
ربما لذلك رأينا السيد الشهيد يؤثر أن يكون مرجعاً لأمة ، لا زعيماً لحزب، ورأينا كيف عمد الإمام الخميني (قدس سره) إلى حل الحزب الجمهوري بعد أن قام الحزب بوظيفته التنظيمية في ترسيخ أركان الدولة، مع أن كوادر الحزب الجمهوري كانوا من مدرسة “سحق الأنا” على الطريقة العرفانية، ولكن مهما علا شأنهم وصفت نياتهم تبقى مهمتهم هي الذوبان في صفوف الأمة والنهوض بها نحو تجربة حضارية إسلامية جديدة.
ولما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، اعتبر السيد الشهيد أن حلمه قد تحقق، وكان سفيره إلى دولة الإسلام سماحة السيد محمود الهاشمي الشهرودي (قدس سره) الذي تحول إلى ركن من أركان الدولة، ولو قدر أن تكشف مراسلات السيد الشهيد مع السيد الهاشمي لعلمنا مقدار انخراط السيد الصدر في مراحل بناء الدولة، فقد كان معروفا ً أنه وضع كل إمكانياته في سبيل نجاح هذه التجربة التاريخية.
فسلام عليك يا سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً
الهوامش
*مدير المركز العالمي للتوثيق، باحث في الشؤون الفكرية والفلسفية.
[1] feather.blogspot.com/2019/01/blog-post.html
[2] علي عبد الهادي جابر : مخطوطة إمام النهضة والإصلاح والمقاومة، وقد ورد الخبرين كالتالي: الأول عن الأستاذ عدنان نجيب فحص / الإمام موسى الصدر – السيرة والفكر / ص35، والخبر الثاني عن سماحة السيد محمد الغروي / أيام مع الإمام موسى الصدر / ص174.
[3] https://baqiatollah.net/article.php?id=152
[4] صوتية: https://www.youtube.com/watch?v=Gg3i2tD0Uw0
[5] موقع الإجتهاد: بحث الأستاذ زكي الميلاد حو التجديد المنهجي عند السيد الشهيد.
[6] أصول الفقه: الحلقة الأولى، ص5_6.
[7] http://www.alsadrain.com/sader1/
[8] http://ijtihadnet.net: مقابلة مع سماحة الشيخ حسن عبد الساتر.
[9] الأسس المنطقية للإستقراء: ص 419.
[10] محمد باقر الصدر : نظرة عامة في العبادات، دار التعارف، بيروت، ص21-23
[11] المصدر نفسه: ص 28-29
[12] فلسفتنا: ص 334 وما بعدها…
[13] عبد الرسول عبوديت: النظام الفلسفي للحكمة المتعالية، مركز الحضارة، ج2، ص 114.
[14] جوزيف س. ناي: القوة الناعمة، وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ترجمة محمد توفيق البجيرمي، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط1، 2007م، ص 9
[15] المصدر نفسه: ص10
[16] اقتصادنا: ص 280
[17] اقتصادنا 283_286 بتصرف
[18] محمد باقر الصدر: نظرية الدولة في الإسلام، منشورات نون، ص 9
[19] http://www.alsadrain.com/sader1/
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي