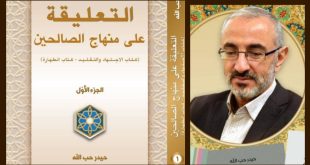الاجتهاد: لا شك أنّ للسياسة دوراً في التقريب، لكن أن يكون التقريب سياسيّاً فقط ينتج عنه ربط مسألة التقريب بأمر متغيّر، والتابعُ للمتغيّر متغيّرٌ، كما أنّه يجعل علاقة المذاهب مع بعضها بيد السلطات السياسيّة، وليس بيد أبناء هذه المذاهب أو الاتجاهات الدينيّة داخل هذه المذاهب.
هل يمكن تفادي عَلْمَنة العلاقات بين الطوائف والمذاهب؟

مدخل التقريب، سياسيٌّ أو ديني؟ (إشكاليّة البحث)
ربما يكون العنوان الذي تمّ اختياره هنا «الوحدة الإسلاميّة سياسيّة أو دينيّة» موهماً للوهلة الأولى؛ إذ يبدو وكأنّه يضعنا أمام خيارين، وأنّ علينا أن نختار واحداً منهما، في عمليّة تأطير فكري:
إمّا أن نقول بأنّ التقريب أو الوحدة أو التعايش بين أبناء المذاهب([2]) يجب أن يكون سياسيّاً فقط أو يجب أن يكون دينيّاً فقط، لكن ليس هذا هو المقصود بالعنوان، بل يمكن أن تكون الوحدة سياسيّةً وفي الوقت نفسه دينيّة.
إنّما الفكرة الأساسيّة المطروحة هي: هل نتّجه إلى التقريب بين أبناء المذاهب نتيجة عنصر سياسي فقط، أو ثمّة رؤية وقراءة دينيّة خلف مشروع التقريب بين المذاهب، بصرف النظر عن وجود العناصر السياسيّة الضاغطة التي تدعو للتقريب بين المذاهب أو عدم وجودها؟
لماذا نهتمّ بهذا السؤال في لحظتنا الراهنة؟
يهمّني جداً أن نجيب عن هذا السؤال؛ لأنّ هناك توجّهاً يسري في بعض الأوساط، يقول: لا يمكن تحقيق تقاربٍ بين المسلمين من منطلقٍ ديني، ومن ثمّ لكي نحقّق تقارباً بين المسلمين، يجب أن ننطلق من منطلق خارج ـ ديني. واُسمّي هذا التوجه بـ«عَلمَنَة التقريب»،
أي لكي يتقارب المسلمون يجب أن يخرجوا من فكرة أنّ علاقاتهم ببعضهم قائمة على الإسلام، بل لابدّ أن تقوم على معايير أخرى، مثل المواطنة بالمفهوم الوضعي الحديث والإنسان والعلاقة مع الآخر البشري..، ومعنى ذلك أنّه يجب حذف المفهوم الإسلامي أو الخلفيّة الدينيّة التي يتحدّث عن أنّها يمكن أن تقف خلف التقريب.
وهذا بالضبط ما حصل في أوروبا المسيحيّة، إذ بعد تصارع دام سنواتٍ وسنوات بين المذاهب المسيحيّة، توصّلوا إلى هذه النتيجة: لا يمكن أن نعيش بسلامٍ إلا أن نُبعد الدين عن الحياة العامّة.
هنا يكمن مركز الخطورة في هذا الموضوع، ونصبح مضطرّين اليوم أن نبحث في أنّه هل يمكن العثور على خلفيّة دينيّة حقيقيّة فاعلة للتقارب بين المسلمين، أو يجب أن نبحث عن ذلك خارج إطار الرؤيّة الدينيّة، فنُعَلْمِن التقريب، ونقارب بين المسلمين بعد التحرّر من المفاهيم الدينيّة تماماً؛ لأنّ الدين غير قادر على أن يحقّق التعايش السليم والطبيعي بين الناس؟
أرجو أن ننتبه إلى خطورة الموقف؛ لأنّ مآلات التصارع المذهبي بين المسلمين اليوم، تصبّ في مصلحة من يذهب إلى القول بأنّ حلّ مشاكلنا لا يكون إلا بالتخلّي عن المدخل الديني، فإذاً نحن مضطرّون أن نبحث في جواب هذا السؤال:
هل يوجد في الدين إمكانيّة لكي نؤكّد وجود التفاهم بين أبنائه أو أنّ البحث عن وجود خلفيّة دينيّة للتفاهم بين المسلمين بحثٌ في سراب، ومن ثمّ لن تُحلّ هذه المشكلة إلا بترك المفاهيم الدينيّة؟
هنا تكمن أهميّة هذا السؤال في هذه اللحظة بالذات التي يتّجه فيها العالم العربي والإسلامي إلى نوعٍ من العلمانيّة التي تستند إلى فشل التجربة الإسلاميّة هنا أو هناك، وعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجدّ، لكي نفكّر فيه بجدّية وتأمّل.
لكن، ما الفرق بين أن نجعل المدخل للتقريب بين المذاهب هو المدخل السياسي أو المدخل الديني؟ ثمّة فرق جوهري كبير.
إذا جعلنا المدخل للتقريب بين المذاهب هو المدخل السياسي، فنحن أمام حقيقتين:
الحقيقة الأولى: إنّنا أوكلنا التقارب بين أبناء المسلمين إلى أمر متغيّر؛ إذ السياسة دائماً فعل الأمر المتغيّر، وبالتالي أيّ تحوّل في المشهد السياسي يمكن أن يطيح بتقارب المسلمين مع بعضهم، وسيكون ما يسمّى بالعلاقات الإيجابيّة بين المسلمين مجرّدَ لحظة زمنيّة سياسيّة.
الحقيقة الثانية: إنّ قرار تقارب المسلمين مع بعضهم لن يكون قراراً دينياً، ولن ينشأ من تديّن الناس، بل سينشأ من مرجعيّة سياسيّة فقط، ومن ثمّ فالمتحكّم في مصير علاقات المذاهب الدينيّة مع بعضها، ليس أهل الدين، وإنّما السلطات السياسيّة أو السياسيّون.
إذن، نحن أمام حقيقتين موضوعيّتين، تنجمان عن اعتبار مشروع التقريب سياسيّاً فقط.
لا شك أنّ للسياسة دوراً في التقريب، لكن أن يكون التقريب سياسيّاً فقط ينتج عنه ربط مسألة التقريب بأمر متغيّر، والتابعُ للمتغيّر متغيّرٌ، كما أنّه يجعل علاقة المذاهب مع بعضها بيد السلطات السياسيّة، وليس بيد أبناء هذه المذاهب أو الاتجاهات الدينيّة داخل هذه المذاهب.
إذا أردنا أن نحلّل القضيّة بالمصطلح الفقهي، فإنّ الفرق بين أن نقول: إنّ المدخل إلى التقريب هو مدخلٌ ديني أو مدخل سياسي، هو:
إذا قلنا هو مدخلٌ ديني، فهذا يعني أنّنا اعتبرنا العلاقات الإيجابيّة بين أبناء المذاهب جزءاً من الأحكام الشرعيّة الأساسيّة في الدين بالعنوان الأوّلي، وجزءاً من البرنامج الثابت في أصل الشرع أن تكون علاقات المسلمين في ما بينهم علاقات ممتازة، حتى لو اختلفوا في قراءتهم للتاريخ أو العقيدة أو الشريعة أو غير ذلك، فالتقريب من الثوابت في الشريعة الإسلاميّة فلا نخرج عنه إلا لضرورة.
بينما إذا جعلنا مدخل التقريب سياسيّاً، فهذا معناه أنّ التقريب بين المذاهب ليس جزءاً من الشريعة بالعنوان الأوّلي، ولا يوجد شيء اسمه التقارب بين أبناء المسلمين في نصوص الكتاب والسنّة، وإنّما الضرورة هي التي فرضت علينا أن نتقارب ونلتقي، ولولا فعلُ الضرورة ما التقينا؛ إذ لا يوجد شيءٌ في أعماقنا دينياً يدفعنا للتقارب والتلاقي والتعايش في ما بيننا تعايشاً سلميّاً واندماجياً وصحيحاً.
إذن، هناك فرق جوهري بين أن نرى العلاقات الإيجابيّة بين المسلمين قائمةً على العنوان الأوّلي لا يُخرج عنها إلا بدليل، وبين أن نرى هذه العلاقات قائمةً على العنوان الثانوي، فلولا هذا العنوان الثانوي والضرورات، لكان مقتضى الأصل الانفصالَ والتباعد فيما بيننا، ولو لم يكن الصراع والحرب.
منطلقات المشروع الديني في التقريب
نحن نعيش فكرة التقريب منذ مئة وخمسين سنة تقريباً، منذ السيد جمال الدين، إلى الشيخ محمّد عبده، مروراً بأجيالٍ من العلماء الذين نادوا بالتقريب وصولاً إلى اللحظة الحاضرة، وفكرة التقريب من منطلقٍ سياسي مرحلي زمني كانت حاضرة دوماً، ودعا إليها كثيرون ونظّروا لها بل حاولوا تطبيقها.
لكن هل قدّمت هذه الأجيال من العلماء مشروعاً يؤصّل للتقريب بوصفه مشروعاً دينياً، وينظّر له من زاوية اجتهاديّة فقهيّة في الرؤية الإسلاميّة أو لا؟
والجواب هنا: نعم، فقد بذل العلماء المسلمون التقريبيّون خلال المئة وخمسين سنة، جهوداً مشكورة للتنظير للتقريب بوصفه أصلاً دينيّاً بالعنوان الأوّلي، مستندينَ في ذلك عادةً إلى أمرين:
الأمر الأول: النصوص الدينيّة في الكتاب والسنّة التي أصّلت لقواعد عامّة، تتّصل بعلاقات المسلمين فيما بينهم، مثل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10).
وهناك الكثير من هذه المبادئ في الكتاب والسنّة، اتّخذها علماء التقريب بين المسلمين وأضاؤوا عليها، وركّزوا النظر عليها وتأمّلوا فيها، وأخرجوا منها قواعد عامة في علاقات المسلمين فيما بينهم، وهي أنّ المبدأ هو العلاقات الطيّبة إلا ما خرج بالدليل، وتوجد دراسات كثيرة في هذا الموضوع.
الأمر الثاني: التجربة التاريخيّة، وقد ركّزوا بالخصوص على التجربة النبويّة. وأبرز مستند في التجربة النبويّة يمثّل قمّة الأداء التاريخي النبويّ في تقارب المسلمين، هو ما يعرف بـ«حادثة المؤاخاة»؛ إذ مثّلت هذه الحادثة أنموذجاً رائعاً لتقاسم المسلمين أموالهم فيما بينهم،
فالذي عنده مالٌ أعطاه للثاني، وأمّن له فرصَ العمل، وتعايشوا مع بعضهم بعضاً، وكأنّه لا يوجد مهاجرٌ ولا أنصاري، وإنّما هم جسم واحد.
وكذلك بعد النبي‘ أيضاً التقط التقريبيون كثيراً من التجارب المتفرّقة في سيرة أهل البيت^، وفي علاقاتهم ببعض الصحابة والتابعين، وبعض تابعي التابعين، كما التقطوا أيضاً تجارب لبعض العلماء عبر التاريخ، كان لها دورٌ في تقارب المسلمين فيما بينهم.
إذن، ثمّة ركنان أساسيّان يقام عليهما التقريب من الزاوية الدينيّة، هما:
1 ـ النصوص الأصليّة التقعيديّة في الكتاب والسنّة.
2 ـ التجربة التاريخيّة وعلى رأسها التجربة النبويّة.
عوائق التقريب
رأينا أنّ جماعةً من كبار العلماء والمجتهدين في المذاهب الدينيّة المختلفة، قدّموا رؤية دينيّة أصّلوا من خلالها لمبدأ العلاقات الطيّبة بين المسلمين، لكن لماذا لم يقتنع الآخرون من العلماء والباحثين من أهل المذاهب بهذه الأدلّة؟
ما الذي حصل أنّ الفريق الآخر لم يقتنع بهذه الأدلّة، وهي أدلّة قوية، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الحجرات: 10)، وهي آية قرآنية لا يمكن النقاش فيها تصدح بصراحة عالية بمبدأ الأخوّة بين المؤمنين وهي من أوثق العلاقات بين البشر،
وتستخدم أداة الحصر، أي المسلمون ليسوا إلا إخوّة، وكأنّما ليس لهم هويّة إلا هويّة الأخوّة، وكما يعبّر الشيخ جعفر السبحاني: لم يستخدم القرآن الكريم هنا علاقة «الأبوّة» أو «البنوّة» مع أنها أيضاً علاقة وطيدة؛ ليجعل العلاقات فيما بينهم متساوية.
إذاً التعبير القرآني جميلٌ وصريحٌ في تأسيس هذا المبدأ الإسلامي، فلماذا لم تقتنع الأطراف الأخرى في الساحة الإسلاميّة بهذا التنظير الديني لمسألة التقريب بين المذاهب؟
ثمّة عوامل كثيرة، سأكتفي بالإشارة إلى عاملين أساسيّين منها، وأرجو أن نتأمّل فيهما، خاصّة الثاني منهما:

أوّلاً: تفريغ القاعدة عبر فكرة التكفير والابتداع
هذه النصوص على أهمّيتها وقرآنيّتها، تمّ تفريغها من مضمونها الاستدلالي بواسطة فكرة التكفير والابتداع، فعندما نحكم بكفر شخص، فهذا يعني أنّه خارج من دائرة الإيمان، إذاً كلمة «المؤمنون» في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..﴾ لم تعد تشمله، فينتهي الموضوع.
ومن الواضح أنّ عمدة الأدلّة التي يقيمها أنصار التقريب بين المذاهب تقوم على عنوان «الإسلام» أو «الإيمان»، فعندما يقوم الطرف الآخر بافتراض أنّ عنوان الإسلام أو الإيمان لم يعد شاملاً لهذا الفريق من الأمّة، فلن تقدر القاعدة على استيعابه.
بل بعض العلماء في الساحة الشيعيّة يرى ـ وهو اجتهادٌ محترم ولو اختلفنا معه ـ أنّ كلمة «المؤمن» حتى في القرآن الكريم تطلق على معنى خاص، وهو ما يسمّى في المصطلح بـ«المؤمن بالمعنى الأخص»، وهو الشيعي الإمامي الإثنا عشريّ، فإذا كانت كلمة «المؤمن» وفق هذا الاجتهاد تُطلق في القرآن الكريم، فضلاً عن السنّة،
على المؤمن بالمعنى الأخص، إذاً ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..﴾، ستعني: إنّما الشيعة الإمامية الإثنا عشريّة إخوة، ومن ثمّ يتمّ تحرير الآية من أن تدلّ على العلاقات الإسلاميّة ـ الإسلاميّة.
هذا موضوعٌ طويل، يرتبط ببحث التكفير ومبرّراته الكلاميّة، وكذلك يرتبط ببحث الابتداع والبدعة، كما يتعلّق بمصطلح المؤمن في التراث الإمامي، لا نخوض فيه الساعة، وننتقل إلى العامل الثاني الذي أراه مهمّاً، وهو موضوع كلمتي هنا.
ثانياً: الازدواجيّة بين النظريّة الكليّة والمفردات التفصيليّة
السبب الثاني الذي أدّى إلى عدم اقتناع الأطراف الأخرى في الساحة الدينيّة بمثل هذه الأدلّة الممتازة، هو الازدواجيّة بين الكلّيات العامّة التي أصّلها علماء التقريب، والأحكام الجزئيّة المتبعثرة في الفقه الإسلامي المتنافية جزئيّاً مع تلك القواعد العامّة، فالتقريبي إنّما نظّر للكلّيات العامّة،
حيث أسّس لقواعد عامة مثل الأخوّة بين المؤمنين، منطلقاً من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..﴾ ومن مبدأ الولاية المتبادلة في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ..﴾ (التوبة: 71)، وغير ذلك من القواعد العامّة.
لكن يجب أن لا نبقى مع القواعد العامّة هذه، إذ البقاء معها قد يغرّ الإنسان ويغشّه، بل يجب أن ننزل ونذهب في جولة مع المفردات التفصيلة المتبعثرة في الفقه الإسلامي عند المذاهب،
وهناك سنجد مشهداً لا يتوالم مع تلك القواعد العامّة، وبمقتضى قانون «التخصيص» و«التقييد» تقدَّم تلك المفردات التفصيليّة على القواعد العامّة وإن كانت مستفادةً من القرآن الكريم، فإنّ علماء المسلمين في اجتهاداتهم عموماً يخصّصون ويقيّدون القرآن بالروايات.
ولكي أقرّب الفكرة، أذكر بعض النماذج من هذه المفردات التفصيلية عند علماء المسلمين، وكلّها تقف خلفها اجتهادات، وليس مجرّد شعارات سياسيّة أو حماسيّة..، ومن ثمّ يجب أن نحترمها ونخوض حواراً معها في نهاية المطاف، وهي:
المثال الأوّل: تجويز غيبة المخالف بل بهتانه ولعنه..
ثمّة بعض الروايات والفتاوى تجوّز غيبة وبهتان ولعن أبناء المذاهب الأخرى، هذه حقيقة موضوعيّة موجودة في المذاهب الإسلاميّة المختلفة، فإذا بقي التقريبي ينظّر في القاعدة، ونسي أنّ هناك مفردات تشكّل بيئة حاضنة لنقيض القاعدة، فسوف يُصاب بالإحراج في نهاية المطاف، فهو مضطرّ أن يحلّ مشكلة هذه التفاصيل.
أيّ أخوّةٍ هذه، والأخ يغتاب أخاه ويفتري عليه ويلعنه؟! كيف يمكن إقناع الطرف الآخر بالقاعدة الكلّية حينئذٍ؟
لقد أصّل علماءُ التقريب القواعدَ العامّة، لكنّهم تركوا التفاصيل المعارِضة لهذه القواعد ولم يكملوا الطريق، وعندما نذهب إلى أرض الفقه وندرس الأحاديث المتناثرة المتعلّقة بهذا الموضوع أو ذاك، سنجد فضاءً مختلفاً تماماً، فهناك نصوصٌ في السنّة، تخالف هذه القواعد العامّة في دوائر خاصّة، ممّا يوجب تضييق وتخصيص هذه القواعد الكلّية.
إنّ هذه النقطة ـ في قراءتي المتواضعة ـ غابت عن التقريبيين، فلم ينزلوا من التأصيل القاعديّ العام إلى التفاصيل، ليروا أنّ هناك نصوصاً وفتاوى في التفاصيل المتعلّقة بهذا الموضوع،
تنقض القاعدة أو تضيّقها أو تجعلها بحكم المجهَضة، ومن ثمّ أوجب ذلك وقوع التقريبيّين في مأزق، حيث تمّ تعويم هذه التفاصيل من قبل الطرف الآخر فأحرجت القاعدة الكلّية هذه.
المثال الثاني: عدم جواز الصلاة خلف المخالف في المذهب
في أكثر من مذهب إسلامي، لا يمكن أن يكون إمام الجماعة من أبناء المذاهب الأخرى، ونعرف أنّه في غير مؤتمر من مؤتمرات التقارب بين المسلمين، كان أنّه بعد الانتهاء من الخطب التي تدعو إلى التقارب، وعندما يحين موعد الصلاة، ويؤذّن المؤذّن، يذهب فريقٌ يصلّي جماعة هنا، وآخر يصلّيها هناك في القاعة نفسها، فما هذا المشهد الديني الذي يقدّمه التقريبيّ؟!
عندما يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..﴾ فهذا ليس شرحاً لعلاقات نَسبيّة تكوينيّة، بل معناه ـ بالدلالة العرفية الاجتماعيّة ـ أنّ هناك علاقات اجتماعيّة ممتازة بين المؤمنين، فلا يمكن أن نقول: المؤمنون إخوة بالعنوان العام، لكن في المقابل لا نترجم هذه الأخوّة في العلاقات الاجتماعيّة،
وعندما يريدون ممارسة شعيرة دينيّة مثل صلاة الجماعة نجدهم منقسمين فيما بينهم، ولا يمكن أن يمارسوها باشتراك! أيّ وحدة اجتماعيّة يتكلّمون عنها؟!
المثال الثالث: عدم قبول شهادة المخالف المذهبي في المحكمة
وهذا أيضاً موجود في أكثر من مذهب إسلامي، حيث لا يقبلون بشهادة المخالف في المحكمة، فإذا كانت هناك قضيّة في زواجٍ أو طلاقٍ أو إرثٍ أو قتلٍ أو جناية، ويريد القاضي أن يستمع إلى الشهود،
فلا يستطيع أن يأخذ بشهادتهم إذا لم يكونوا من أبناء مذهبه! فأيّ مواطَنة هذه؟! وأيّ تساوٍ في الحقوق؟! أيّ أخوّة هذه إذا بقيت هذه الازدواجيّة بين النظريّة الكليّة والمفردات التفصيلية والمصاديق الخارجيّة؟
المثال الرابع: اختصاص مصارف الخمس والزكاة بالموافق المذهبي
لا يُعطى غير أبناء مذهبي من أموال الخمس والزكاة شيئاً، إلا من سهم «المؤلّفة قلوبهم»، وكأنّهم كفّار! أو من سهم «سبيل الله»، وكأنّك تصرف على منشأة عامّة أو على شارع عام، كيف يمكن أن تكون أكبر ضريبتين ماليّتين في الإسلام، خاصّتين بفئة معيّنة من المسلمين، وأنت تتكلّم عن الأخوّة والتقارب بين المسلمين وعن المجتمع الواحد؟!
أنت تريد أن تقنعني بأنّ الأخوّة الإسلاميّة هي المحكّمة في علاقات المسلمين مع بعضهم بعضاً، ثمّ لا تقبل بالتساوي في عالم التوزيع المالي، فيأخذ أبناء مذهبك أموال الخمس والزكاة،
ولا يُعطى أبناء مذهبي منها شيئاً إلا بعنوانٍ يكاد يصنّفهم في دائرة الكفر في بعض الأحيان، وكأنّ الفقير السنّي لا قيمة له من حيث هو فقير، والفقير الشيعي يملك تلك القيمة والعكس صحيح!
المثال الخامس: اشتراط سلامة الاعتقاد في تحقّق «العدالة»
وهذا في غاية الخطورة وقد ترك أثراً كبيراً على تراثنا، حيث إنّ «العادل» موضوع لحجيّة الخبر الواحد عند كثيرٍ من العلماء. إنّ مفردة «العادل» في الثقافة الإسلاميّة تدلّ على صلاح العبد، وحسن حاله وتقواه، لكنّ كثيراً من علماء المسلمين من المذاهب المتنوّعة، ذهبوا إلى أنّ سلامة الاعتقاد جزءٌ مقوّم للعدالة،
فلو أنّ شخصاً ترك جميع المحرّمات، وأتى بجميع الواجبات وفعل المستحبات وترك المكروهات، ولا نعرف عنه إلا سلامة قلبه، لكنّه لم يكن على العقيدة الصحيحة من وجهة نظرنا، ليس فقط لا تقبل أعماله ـ وهذا بحثٌ أخروي ـ بل إنّ شخصاً مثل هذا لا يصنّف عادلاً، فلا يمكن أن نرتّب عليه آثار شخصٍ عادل، وهذه النتيجة تترك أثراً ضخماً في التراث الإسلامي.
لقد اتّجه أغلب علماء الإماميّة بين القرن السابع والعاشر الهجريّين، إلى حجيّة خبر العادل، فما كانوا يأخذون بخبر إلا إذا كان رواته جميعاً من العدول، واشترط كثيرٌ منهم سلامة الاعتقاد في تحقّق العدالة، ولذلك ردّوا جميع الروايات التي ورد في أسانيدها رواتٌ من غير الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة، وضحّوا ربّما بما يزيد عن عشرة آلاف حديث،
وجاء الإخباريّون فيما بعد وانتقدوا هذه الطريقة، منطلقين من خلفيّة معيّنة لا نخوض فيها الساعة، وهذا ما يُخبر عن خطورة هذا الموقف إذ يوجب طرد آلاف من الأحاديث بحجة أنّ أسانيدها تشتمل على أشخاصٍ ليسوا من مذهبي، الأمر الذي يؤدّي إلى تشكيل حاجز كبير بين أبناء المذاهب، إضافةً إلى خسرانهم كمّاً كبيراً من المعارف التي وردت في التراث الإسلامي عموماً.
إذن، نحن أمام تحدّي التفاصيل، ولا يمكن الحديث عن التقارب بين المسلمين مكتفين بالقواعد الكليّة التي وردت في الكتاب والسنّة، بل علينا أن نواصل مسيرة البحث في المصاديق والتفاصيل الجزئيّة، لنرى هل تسلم هذه القواعد الكليّة من التخصيص والتقييد أو لا؟ وكما يقال: «الشيطان يكمن في التفاصيل».
هذه التفاصيل اجتهاداتٌ تقف لجانبها أدلّة، فكيف يمكن وضع حلٍّ في هذا السياق؟
لقد سبق لي أن اقترحتُ في مقالةٍ صغيرةٍ، فكرةَ فقه «الخلاف والوفاق»، حيث ذكرتُ أنّ علينا أن نجمع جميع هذه التفاصيل الجزئيّة التي توحي بعدم وجود علاقات طيّبة وطبيعيّة بين أفراد المسلمين،
ونبحثها كلّها في مكانٍ واحد، ويجلس الفقيه ويقوم ببحثها واحدةً واحدةً ويعيد النظر فيها ويتأمّل فيها بدون تكلّف ولا تأويل، محترماً النصوص وآليات الاجتهاد، هذا أمرٌ ضروري جداً، لكن إلى اليوم لا نجد هذه العمليّة إلا قليلاً هنا وهناك.
حلولٌ للخروج من إشكاليّة التفاصيل المانعة
هل يمكن حلّ مشكلة التفاصيل هذه، والتي تشكّل مأزقاً اليوم؟
ثمّة إمكانيّات لحلولٍ متعدّدة سأكتفي بفرضيّتين منها، وفي اعتقادي الشخصي المتواضع، أنّ الجمع بين الفرضيّتين ربما يكون من أفضل الوسائل:
أ ـ حكومة القواعد العامّة على التفاصيل
وهي المحاولة التي طرحها العلامة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين (2001م)، من حكومة القواعد العامّة التي لا تقبل التخصيص على التفاصيل الجزئيّة، ومنهج شمس الدين هذا يخالف منهج السيد محمد باقر الصدر (1980م) في فقه النظريّة.
طرح السيد الصدر في أكثر من كتاب، لا سيما في كتابه الماتع «إقتصادنا»، شيئاً سمّاه بـ«فقه النظريّة» و«فقه النُظم»، وكان هذا إبداعاً رهيباً في التفكير الفقهي الإمامي الذي كان يتوقّع أن يتطوّر بعده.
ينطلق الصدر في فقه النظريّة من فقه المسألة، فيجتهد الفقيه في كلّ المسائل المتعلّقة بالاقتصاد مثلاً، واحدة تلو الأخرى مثل أيّ اجتهاد آخر، ثمّ يجمعها ويجعل منها صورةً كاملة،
مثل أجزاء الفسيفساء التي تجعل بعضها إلى بعضٍ لتكوّن صورةً كاملة، والفقيه أيضاً يجمع التفاصيل الفقهيّة المتّصلة بموضوع معيّن، لتنهض عنده النظريّة الفقهيّة العامّة فيه، وهذا ما أسمّيه بـ«منهج الصعود من الأدنى إلى الأعلى».
أمّا الشيخ شمس الدين فقد طرح فقه النظريّة بمنهج معاكس، حيث قال: إنّ النصوص على نوعين: نصوص صغيرة تفصيليّة محكومة، ونصوص تأصيليّة عليا حاكمة، وسمّاها «أدلّة التشريع العليا»،
وهذه النصوص تمثّل القواعد الدستوريّة، فلا تقبل التخصيص أو التقييد، فإنّ القواعد الدستوريّة لا تقبل التخصيص إلا بتعديل الدستور نفسه، وبالتالي هذه القاعدة هي التي تحكم على التفاصيل وليس العكس.
وعلى سبيل المثال، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..﴾ قاعدة عامّة، ومن ثمّ يجب أن تحتكم إليها كلّ التفاصيل، فإذا رأينا النصوص التي تدلّ على جواز الغيبة والبهتان و.. فنقول: إنّ القاعدة هي التي تحكم على النصوص هذه، وليست هذه النصوص هي التي تخصّص القاعدة العامّة.
وهذا يشبه ما فعله السيّد علي السيستاني عندما تعرّض للرواية التي تتحدّث عن «باهتوهم»، حيث قال بأنّ البهتان في مثل هذه الحال يعارض قانوناً قرآنياً، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقرب لِلتَّقْوَى واتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 8)،
فنَكِل علمَ هذه الرواية إلى أهلها، فلا نعمل بها، رغم أنّها رواية صحيحة الإسناد، لكن في رأي السيد السيستاني ـ على ما جاء في بعض تقريرات أبحاثه ـ تصنّف مخالفةً للقرآن الكريم.
إذن، على أساس هذه النظريّة، القواعد العامّة التي أصّلها التقريبيّون تكون حاكمةً على هذه التفاصيل، وهي التي تقوم بتفتيتها لا العكس.
ب ـ القراءة التاريخيّة للنصوص التفصيليّة المعاكسة
الفرضيّة الثانية التي يمكن أن تجيب عن بعض هذه النصوص التفصيليّة، هي إعادة النظر فيها مع نظرة تاريخيّة، وهذا ما اختاره بعض العلماء في بعض التفاصيل من أمثال الشيخ حسين علي المنتظري (2010م)، حيث كان يسمّي هذا النوع من الأحكام بـ«الأحكام الموسميّة»، وهي أحكامٌ كان يصدرها النبي| والأئمة^ من موقع ولايتهم على الأمّة،
ونعتقد بأنّ لها مدى زمنيّاً معيّناً، وليس من موقع كونهم مبلّغين لأصل الشريعة، فهذه الأحكام تنتهي بأزمنتها التي فرضتها، وليست جزءاً من أصل الشريعة.
وعلى سبيل المثال، اعتبر بعض العلماء المعاصرين في بحوثه في الحجّ، وهو السيّد محمّد رضا السيستاني، أنّ اختصاص مصرف الخمس والزكاة بالشيعة، حكمٌ تاريخيّ زمني، فهذه النصوص التي صدرت عن الأئمة^ كانت بسبب التوزيع غير العادل عند السلطات الحاكمة آنذاك،
حيث كانوا يمنعون الشيعة من حقوقهم الماليّة، فطلب الإمام× من الشيعة أن يوزّعوا الأخماس والزكوات ما استطاعوا فيما بينهم، حتى يجبروا عجز بعضهم بعضاً في ظلّ تلك الظروف العصيبة. إذاً هناك اجتهادات تحاول أن تحلّل مثل هذه الأمور بهذه الطريقة.
وعليه، فالحلّ يكون إما من خلال الفرضيّة الأولى، أي اعتماد النصوص المهيمنة على هذه النصوص التفصيليّة المقلقة، خاصّةً إذا كانت نصّاً قرآنيّاً يُحتكم إليه، أو عبر الفرضيّة الثانية التي يمكن جمعها مع الأولى، وهي إعادة قراءة هذه النصوص التفصيليّة بشيء من النظرة التاريخية.
وأرجو أن ننتبه هنا، فنحن لا نريد أن نخترع نظريّة لكي نفرضها على النصوص، هذا تأوّل وتكلّف وتحكّم في الكتاب والسنّة، وإنّما نريد أن نجدّد النظر في مقاربة هذه النصوص وفق المرحلة الزمنيّة التي نعيشها، لنرى هل يمكن إيجاد حلّ وفق القواعد أو لا؟ لا أن ننعت كلّ رواية لا تعجبنا مثلاً بأنّها تاريخيّة، كما يفعل بعضٌ اليوم.
خلاصة
خلاصة ما أريد أن أصل إليه هو أنّ القراءة التقريبيّة التي حاولت أن تنطلق من الدين لا من خارجه، اصطدمت ـ بعد أن نجحت في التنظير العام ـ بمشكلتين:
مشكلة التكفير والابتداع التي حاولت أن تفرّغ القواعد العامّة من مضمونها.
ومشكلة التفاصيل الجزئيّة التي يمكنها أن تُربك تلك القواعد العامة القادرة على إيجاد حال من العلاقات الإيجابيّة بين المسلمين.
وهناك حلان مفترضان للمشكلة الثانية بالخصوص، يمكن للجمع بينهما أن يخفّف من حجمها كثيراً:
1 ـ اعتماد نظريّات تحكيم الكليات الدستورية على التفاصيل.
2 ـ مقاربة التفاصيل ـ بعد تقرير الكلّيات ـ بعيون زمكانيّة.
ونأمل إن شاء الله تعالى أن تتظافر جهود العلماء والباحثين والفقهاء والمشتغلين في مجال الشريعة والعلوم الدينيّة، للوصول إلى قراءة أنضج لا نحكّم فيها ما نريد على الكتاب والسنّة، وإنّما نكون مطيعين مسلّمين لما جاء فيهما، إنّه وليّ قدير.
___________________________
([1]) اُلقيت هذه المحاضرة في القائمة الإسلاميّة ـ جامعة الكويت، في دولة الكويت، بتاريخ 4 ـ 3 ـ 2017م، وقد قام الشيخ سعيد نورا بتقريرها وتحريرها، ثم راجعها المحاضرُ (الشيخ حبّ الله)، مجرياً عليها بعض التعديلات والإضافات والتوضيحات.
([2]) إنّما أستخدم هذه التعابير؛ لأنّني في ضيق من اللغة، فكلّ تعبير له معنى سلبي وإيجابي، ولا نحتاج أن نكرّر أنّ الوحدة الإسلاميّة أو التقريب بين المذاهب، لا تعني بحالٍ من الأحوال تخلّي أيّ فريق عن مذهبه وعقيدته، وإنّما هي نوع من المعايشة والتفاهم والإنصاف، وإعطاء الحقوق المتبادلة بشكل طبيعي، والاندماج الحقيقي في الكلّ الكبير الواحد والاُسرة الجامعة التي هي الأسرة المسلمة.
تحرير وتنظيم: الشيخ سعيد نورا
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي