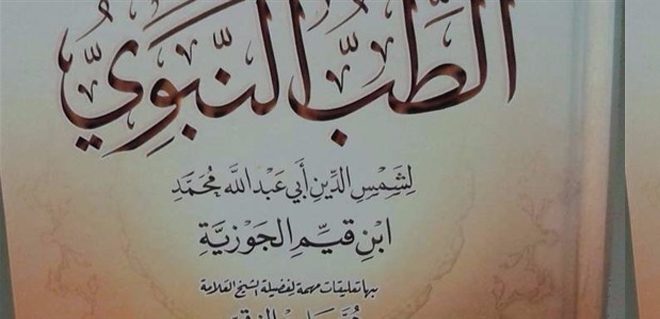مشكلة من كتب في موضوع الطب النبوي أنه حشد كمّاً هائلاً من الآيات القرآنية العامة والأحاديث النبوية واستعان بشرحها والتدليل لها بآراء أطباء اليونان والرومان والعرب، ثم قدم لمعاشر الأتباع توليفة سمّاها بالطب النبوي،, والأكثر عجباً أن أغلب من ألّف في هذا العلم لم يُعلم عنه ممارسة كلينيكية للطب كالسيوطي وابن القيم والذهبي الذين كانت إصداراتهم لا تتعدى علوم العقيدة والفقه والحديث، لم أدرك جدوى اهتمام ابن القيم بنقل كلام أطباء العالم القديم في علاج الأمراض،
فموضوع الكتاب هو الطب المنسوب إلى النبي عليه السلام وليس المنسوب إلى فلاسفة العرب واليونان والرومان، فتراه ينقل مرة عن أبقراط ومرة عن جالينوس ومرة عن الرازي ومرة عن ابن سينا، وكثير من هذا الكتاب هو سرد لأقوال الأطباء في الأمزجة والأدوية وعلم الأمراض، وأحياناً يرد عليهم ويحاججهم كما فعل مع مرض الطاعون (plague) حين زعم أن سببه هو الأرواح الشريرة.
استهل ابن القيم كتابه ببداية تعبر عن صرامة في منهجه حيث قال: (فهذه فصول نافعة في هديه عليه السلام في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، نبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكبر الأطباء عن الوصول إليها)، ثم تحدث عن طب القلوب وطب الأبدان، ثم انتقل إلى تقسيم الطب النبوي الذي اعترف أن مبلغ علمه فيه قاصر ومعارفه متلاشية وبضاعته فيه مزجاة، ونحن نوافقه على ما اعترف به على نفسه.
ذكر المؤلف فصلاً سماه (في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم)، وحجم هذا الفصل قريب من ربع الكتاب، خلط فيه المؤلف بين الأشياء القليلة التي نصح رسول الله باستخدامها وبين الأشياء الكثيرة التي وردت على لسانه بشكل عرضي ولا تدل على أثر شفائي لا من قريب ولا بعيد، وتم استخدام هذه الأسماء لتضليل القارئ وتشعيب الموضوع،
فذكر رسول الله للأترجة في حديث (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب) لا يعني أن نضعها في كتاب اسمه الطب النبوي لأنها ليست من الطب النبوي وإنما اسُتخدمت كمثال توضيحي، فلماذا يسرد ابن القيم منافع الأترجة مبتدئاً بقشرها ولحمها ومنتهياً بحماضها وبزرها وكأنها أحد أفراد الأدوية النبوية، وعلى هذا المنوال جرى أغلب الكلام في هذا الربع من الكتاب.
مما لم استطع فهمه هو كون ابن القيم يرى الطب النبوي طباً يقينياً إلهياً قطعياً، إلا أنه في مواضع عديدة يقول أن بعض هذه العلاجات النبوية خاصة لأهل الحجاز فقط، فهو يعطي للمكان عاملاً مؤثراً في جدوى الدواء النبوي من عدمه والذي من المفترض أن يكون صالحاً لكل زمان ومكان تبعاً لمبدأ الشمولية المطلقة، فمثلاً يعلق على حديث البخاري (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)
فيقول إن هذا خطاب خاص لأهل الحجاز لأن أكثر الحمى عندهم حمى عرضية ناتجة عن ضربة الشمس (heat stroke، فمفهوم كلامه أن الماء ليس علاجاً شاملاً لأنواع الحمى الأخرى المتولدة من أمراض أخرى كالالتهابات والسرطانات وأمراض الروماتيزم، ويذكر ابن القيم بابا اسمه باب (من أصيب فؤداه) وهو ما نسميه اليوم بالاكتئاب، نصح الرسول ص المصاب بهذا المرض أن يأكل سبع تمرات من عجوة المدينة،
و يعلق ابن القيم الخطاب بأنه خاص بأهل المدينة ومن جاورهم، ثم يصرح أن (كثير من النبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولاً وفي بعضها سماً قاتلاً، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين، وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها وأدوية لأهل البلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم) وصنيع ابن القيم هذا هو ضد فكرة إلهية الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان.
وفي علاج عرق النسا (sciatica ) يذكر المؤلف العلاج المنسوب للنبي ص وهو تذويب إلية شاة ثم تجزئتها ثلاثة أجزاء ثم يشرب جزءاً على الريق لمدة ثلاثة أيام، ثم يعلق أن هذا الخطاب خاص لأهل الحجاز ومن جاورهم لأنه أنفع لهم لحصول هذا المرض من يبس، لكننا نعرف اليوم أن عرق النسا يصيب الحجازيين وغير الحجازيين فلماذا لا نعمم علاج إلية الشاة على الجميع؟ ولماذا نكتفي بتقييد ابن القيم الذي هو الآخر لا دليل عليه سوى التجربة الشخصية؟
وصنيع ابن القيم هذا هو ضد فكرة إلهية الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان، يقول ابن القيم أن (الدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب الصحة وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليها أهلها والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر)، هذا أيضاً يعزز الفكرة التي طرحناها في خصوصية الأدوية النبوية لأمكنة معينة والتي يجب أن تمتد أيضاً إلى خصوصية الأزمنة أيضاً، فلكل زمان أدوية وأطباء وطب وأمراض.
يقول ابن القيم إن العلاج النبوي موافق لعادة العليل وأرضه وما نشأ عليه، فلو سقينا عسلاً من تعود تناول أشياء حارة لم يضره العسل، ومن تعود تناول الأشياء الباردة أضره العسل، فالعلاج النبوي هو إجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والأدوية كما يقول المؤلف،
والإشكال هنا ماذا لو كانت هذه العلاجات المنسوبة للنبي ص اليوم غير ملائمة لأجسامنا وعاداتنا الصحية والغذائية التي لا شك أنها تغيرت عن الوضع الصحي في القرن الأول هجري، هل يُحتم العقل السليم هجرها ووضعها في سياقها التاريخي تماماً كما استبدل الإنسان ممارسات حضارات الأمس بممارسات حضارة اليوم؟
* الكاتب والطبيب الإماراتي
المصدر: © 24 للدراسات الإعلامية
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي