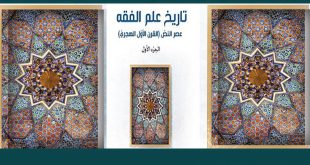الاجتهاد: قدمنا في محاضرتنا الأولى بضع ملاحظات على الطريقتين الشرقية والغربية لدرس تاريخ الفقه الإسلامي ، وأبدينا الكلام عن بعض مسائل متعلقة بعصرين هامين من تاريخ الشريعة: العصر التمهيدي وهو ما قبل الإسلام، والعصر الأساسي وهو زمن فقهاء المدينة السبعة. وتتناول محاضرتنا هذه دوراً ثالثاً: الدور الذي تكونت فيه المذاهب.
فأول من أسس مدرسة في تاريخ الشرع الإسلامي هو – كما نعلم الآن – محمد بن إدريس الشافعي. وكونه المؤسس لعلم حقيقي في الفقه أمر يظهر بجلاء من كتابه الموسوم بالرسالة في أصول الفقه الذي بحث فيه عن طريقة هذا العلم،
كما يبدو من النظام الباهر الذي وضع عليه الشريعة في كتابه الكبير المسمى (بالأم) وفضله هو أنه بعث اليقظة في الفكرة الفقهية الإسلامية، وأنه لا يبرهن عند الحاجة إلى الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج عملية فقط، بل يبرهن دائماً ومبدئياً، وأنه يبحث أيضاً عن شروط الاحتجاج التشريعي وطرقه بوجه عام.
وكتابه العظيم يتيح لنا إدراك طبيعة فكرته الفقهية وعناصرها إدراكا تاماً ويمكننا من مقابلتها بآرائه في طريقة علم الفقه المعروضة في كتاب الرسالة،
وخاصتها البارزة هي الدقة والجلاء اللذان يحملانه على مخالفة كثير مما كان مسلماً به قبله دون أن يضيق بهذا أفق تفكيره، ودون أن يحصر نفسه في دائرة مخصوصة، فأن اجتهاد الشافعي ليتجه على الأخص إلى تنظيم الفقه؛ ونراه يعمل بلا انقطاع على إيجاد تماسك بين الأحكام المنفردة وعلى التحاشي عن أي تناقض بين نتائجها الأخيرة؛
ومهما يكن من أمر السابقين واللاحقين في هذا الشأن فإن الشافعي كان له أعمق الأثر في تنشئة طريقة القياس التي ظلت من مميزات علم الفقه؛ ونقصان التعريفات والتحديدات القانونية الفنية في الشرع الإسلامي يتصل مباشرة بالدور الحاسم الذي يقوم به القياس.
من الطبيعي جدا أن ذلك النجاح العظ الذي لم يسبق له مثيل، والذي افتتح في تاريخ الشرع الإسلامي عصراً جديداً قد أحدث ضجة واسعة، وأفضى إلى تأسيس المذهب الشافعي.
ولكن كل هذا لا ينطبق على المذاهب التي سبقته: وعلى الأخص المذهبين الحنفي والمالكي؛ والأرجح أنها نزعات عامة كانت قد بدت في نواح مختلفة، وما بينها من الخلاف يرجع قبل كل شيء إلى أسباب جغرافية ومدنية عامة: إما بتنوع القوانين العرفية المندمجة في الفقه؛ وإما باتحاد العمل والعلم في نواح متماسكة؛ أما اختلاف الأساليب والطرق الفقهية فليس له إلا المقام الثاني،
كذلك مذهب الحجاز لم يكن تقليدياً من حيث المبدأ بل من حيث أنه يمثل السنة المدنية؛ ومذهب العراق لم يكن أوسع حرية من ذلك بل كل ما هنالك أنه متفق وتطور حياة العراق المادية والفكرية التي تعرضت لكثير من التأثيرات الخارجية، وامتزجت بكثير من العناصر الأجنبية.
كان هذان المذهبان في مرحلتهما القديمة يحتاجان إلى تنظيم محكم، فهما لم يرتبا صفوف أتباعهما إلا بتأثير المذهب الشافعي وعلى غراره،
فاختار كل واحد منهما شخصاً ممتازاً ينتسب إليه، جديراً بتمثيله، والأدلة كثيرة على هذه الطريقة من النظر في نشأة المذاهب الفقهية: فلقد ظلت التسميتان الأصليتان من (أهل العراق) و (أهل الحجاز) تطلقان على أصحاب هذين المذهبين حتى بعد عصر مؤسسيهما المزعومين أبي حنيفة ومالك،
في حين أن أصحاب الشافعي كانوا ينعتون بهذا الاسم منذ أول الأمر؛ وأنه لا يزال موضع شك في عدد كبير من الفقهاء أن يعتبروا أعضاء للمذهب المالكي، وخصوصاً للمذهب الحنفي أو يعتبروا فقهاء مستقلين، على حين أن مسئلة كهذه لا تلحق الشافعية.
أما مالك فأن الشهرة الشخصية العظيمة التي ظل يستمتع بها طوال حياته لابد أن تكون قد ساعدت على اختياره رئيساً ناسبا لمذهب الحجاز؛ بيد أن هذه الشهرة قد عزتها إليه المصادر المتناهية في القدم لنقده الدقيق للأحاديث ولرجالها لا لاجتهاده التشريعي البحت.
وكون الشافعي قد ميزه بين أهل المدينة بأن ألف كتابا صغيراً فيما خالف فيه مالكا من المسائل ليس بعجيب لأن الشافعي أخذ العلم منه.
ونفس النجاح العظيم الذي لقيه الكتاب الموّطأ لمالك وحده بين عدد من الكتب المماثلة له يمكن أن يعلل أبسط تعليل إذا لم نعده كتاباً مبتكراً ذا آراء شخصية بل عددناه كتابا يعبر عن إجماع المدنيين في عصر المؤلف ملتزماً الطريقة الوسطى مجتنباً التطرف في المسائل المختلف فيها.
ولدينا ما يحملنا على الاعتقاد بأن مالكا قد توخا الغرض وهو شاعر بذلك كل الشعور. أما في المذهب العراقي فواضح أن أبا حنيفة يشغل من حيث تطوّر آرائه مكاناً أقل شأناً بكثير من مكانة أصحابه أبى يوسف وزفر ومحمد بن الحسن الشيباني.
وإنما يرد ذكرهم كثيراً على هذا الترتيب في الكتب الأقدم عهداً؛ وانمحاء ذكر زفر وثبوت ثالوث أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وكذلك وضع قواعد للإيثار عند الاختيار بين آرائهم المختلفة – كل هذا يرجع تاريخه إلى عهد متأخر نسبياً.
وليس لأبي حنيفة فيما عدا الفقه الأكبر – وهو عقيدة وجيزة ذات روايات مختلفة بعضها موضوعة ولكن واحدة منها صحيحة – ليس له فيما عدا ذلك كتاب صحيح من تأليفه؛ لأن مسانيد أبي حنيفة قد جُمعت فيما بعد من أحاديث وردت في كتب أصحابه؛ والأقوال الواردة عنه في مؤلفات تلاميذه لا يتجاوز غالبها المراجعات العامة، يسندون بها إليه آراءهم الشخصية، وهذا يحمل على افتراض أنه لا يرجع إلى اجتهاد أبي حنيفة الشخصي من تفاصيل المذهب الحنفي إلا شيء قليل
وعلى الرغم من ذلك فأن المصادفة السعيدة قد مكنتنا من أن ندرك على الأقل ناحية من شخصيته التشريعية.
فقد حكى محمد ابن الحسن الشيباني في كتابه المسمى بالمخارج في الحيل ما يأتي: (سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين فزفت كل واحدة منهما إلى زوج أختها ولم يعلموا حتى أصبحوا فذكر ذلك لأبي حنيفة وطلبوا الحيلة فيه فقال أبو حنيفة (ليطلق كل واحد من الأخوين امرأته تطليقة ثم يتزوج كل واحد منهما المرأة التي دخل بها مكانها فيكون ذلك جائزاً لأنها منه في عدة ولا عدة عليها من الزوج الأول).
قال محمد وقد جاء في هذا حديث عيبناه). ولا يسع أحداً أن يزعم أن هذه الحكاية ليست إلا افتراء موضوعا أريد به تعظيم حكمة أبي حنيفة، لأن عين ذلك الجواب موجود أيضا في كتاب الآثار لنفس المؤلف مروياً عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي.
وأما الحديث الآخر الذي عابه الشيباني نفسه فقد احتفظ به شمس الأئمة السرخسي في كتاب المبسوط قال فيه (ذُكر لهذه المسألة حكاية أنها وقعت لبعض الأشراف بالكوفة، وكان قد جمع الفقهاء رحمهم الله لوليمته وفيهم أبو حنيفة رحمه الله وكان في عداد الشبان يومئذ، فكانوا جالسين على المائدة إذ سمعوا ولولة النساء،
فقيل ماذا أصابهن، فذكروا أنهم غلطوا فأدخلوا امرأة كل واحد منهما على صاحبه ودخل كل واحد منهما بالتي أدخلت عليه، فقالوا إن العلماء على مائدتكم فسلوهم عن ذلك فسألوا، فقال سفيان الثوري رحمه الله: فيها قضى عليّ رضي الله عنه: على كل واحد من الزوجين المهر وعلى كل واحدة منهما العدّة فإذا انقضت عدّتها دخل بها زوجها، وأبو حنيفة رحمه الله ينكت بإصبعه على طرف المائدة كالمفكر في شيء،
فقال من إلى جنبه أبرز ما عندك، هل عندك شيء آخر، فغضب سفيان الثوري رحمه الله، فقال ماذا يكون عنده بعد قضاء عليّ رضي الله عنه، يعني في الوطء بالشبهة.
فقال أبو حنيفة رحمه الله: عليّ بالزوجين، فأتي بهما فسأل كل واحد منهما: هل تعجبك المرأة التي دخلت بها؟ قال نعم، ثم قال لكل واحد منهما طلّق امرأتك تطليقة فطلّقها، ثم زوّج من كل واحد منهما المرأة التي دخل بها، وقال قوما إلى أهلكما على بركة الله تعالى.
فقال سفيان رحمه الله: ما هذا الذي صنعت. فقال: أحسن الوجوه وأقربها إلى الألفة وأبعدها عن العداوة، أرأيت لو صبر كل واحد منهما حتى تنقضي العدّة أما كان يبقى في قلب كل واحد منهما شيء بدخول أخيه بزوجته. . . فعجبوا من فطنة أبي حنيفة رحمه الله وحسن تأمله).
والفرق بين المسألة الفقهية في الأولى والقصة الروائية في الثانية واضح. ومن المهم أن نعرف أن مثل هذه الحكايات الرامية إلى تعظيم أبي حنيفة قد استطاع معاصرو الشيباني من إذاعتها حتى يعيبها هو. وليست الحكاية هذه الحكاية بالوحيدة من نوعها، بل توجد أخرى تشبهها كل الشبه.
فالشيباني يروي في كتابه المذكور ما يلي:
(حدثني حفص بن عمر أن رجلا أتى أبا حنيفة ليلا فقال إني كنت مع امرأتي. . . إذ تغضبت علي. . . فأبت أن تكلمني فقلت لها أنت طالق لئن لم تكلميني الليلة. . . فأبت أن تكلمني. . . وأخاف أن يطلع الفجر ولم تكلمني فتذهب مني.
فقال أبو حنيفة ما أجد لك من حيلة إلا في خصلة واحدة. . . اذهب فقل لها تذكرين أنك عربية وأني إنما خرجت الساعة فسألت عن أبويك فإذا أمك نبطية.
فأتاه فقال: يا عدوة الله الخ. فقالت: كذبت والله.) وهاهو ذا السرخسي أيضاً يورد لهذه الحكاية صورة روائية محضة: (أنه قال للرجل ارجع إلى بيتك حتى آتي بيتك فأتشفع لك فرجع إلى بيته وجاء أبو حنيفة رحمه الله في أثره وصعد مئذنة محلته وأذّن فظنّت المرأة أن الفجر قد طلع.
فقالت: الحمد لله الذي نجاني منك. فجاء أبو حنيفة رحمه الله إلى الباب وقال قد برت يمينك وأنا الذي أذنت أذان بلال رضي الله عنه في نصف الليل). ولا يسعنا أن نشك في أن الصيغة الأولى لهذه تاريخية والأخرى خيالية.
والمغزى أن أبا حنيفة كان فقهياً عملياً كثير الحيل حتى أن الجيل الذي تلاه بالغ في وصفه بتلك الصفة التي لابد أن تكون بدت له من خصائص أبي حنيفة الشخصية بالحكايات الموضوعة: ومن الغريب أن نلاحظ أنه في زمن متأخر صار أبو يوسف هو الذي اشتهر عند القصاص بأنه مثال الفقيه المبتكر للحيل العملية
والشيباني أحرى من أصحابه بأن يشغل بين الحنفية مكاناً يشبه المكان الذي يشغله مالك بين المالكية. ومن سوء الحظ أنه ليس بين أيدي الجمهور إلى الآن من كافة كتب الشيباني إلا موجزان وهما كتاب الجامع الصغير المطبوع في بولاق وكتاب المخارج في الحيل السالف الذكر الذي نشرناه نحن (وطبعات مؤلفين من مؤلفاته الأخرى طبعت في الهند نادرة جداً فهي كأنها غير موجودة)
وليس كتاب المخارج في الحيل إلا في موضوع محدود، وبناء الجامع الصغير على مسائل منفردة – وهو ترتيب تطرف فيه الشيباني في هذا الكتاب تسهيلا للحفظ – لا يسمح لنا باستخراج المبادئ التي تقوم عليها الأحكام إلا من طريق الاستنتاج غير المؤمن.
ومؤلفات الشيباني الرئيسية موجودة مع ذلك في مخطوطات قديمة صحيحة موجود منها قسم عظيم جداً في مكاتب استانبول.
أتيح لي أنا شخصياً أن أنشر في مؤلف ذي ثلاث أجزاء فهرستاً لتلك المخطوطات ولغيرها تهم مؤرخي الفقه، وتسمح هذه الفهارس لمن أراد، أن يطلع عليها بسهولة ويتولى طبعها. والحاجة قبل كل شيء إلى تعريف كتاب الأصل الذي هو أوسع مؤلفات الشيباني وكتاب الجامع الكبير.
ومع كل منهما يوجد عدد كبير من شروح وتلخيصات وحواش الخ تسهل دراستهما. ويكاد لا يقل عن هذين الكتابين أهمية كتاب الزيادات وقد شرح أيضاً مراراً كثيرة، وكتاب زيادة الزيادات، يدل عنوانهما على غرضهما أي إتمام ما في المؤلفين الكبيرين، ثم كتاب الآثار، ثم كتاب الحجج.
وهذا الكتاب، ومعه مسانيد أبي حنيفة التي لا يزال أقدم رواياتها غير مطبوعة أيضاً، يعلمنا الأساس السني لا للمذهب الحنفي فحسب، بل للمذهب العراقي في العصر السابق له أيضاً. وكتاب الحجج هو أول مثال لما ألف في اختلاف المذاهب، وصاحبه يعنى بوجه خاص بأنواع الخلافيات بين أهل الكوفة وأهل المدينة، فأنه يسمي الحنفية والمالكية على هذا النحو.
ولكي نقدر أصول المذهب الحنفي حق القدر ينبغي أن نطلع على نصوص هذه الكتب بعينها. ذلك أن مذاهب الفقه المختلفة لا تميزها مبادئ أحكامها فحسب بل تميزها أيضاً قائمة المسائل التي تدرس في كل واحد منها، مع طبيعة هذه المسائل.
ففي باب الغصب مثلا يتناول مالك بالبحث قبل كل شيء الحالات التي يكون فيها الشيء المغضوب مثلياً، فيحمله هذا على الميل إلى مصلحة الغاصب حتى لا يكون عليه إلا أن يعوض من الشيء المغضوب كمية مماثلة.
أما الشافعي فعلى النقيض من ذلك يعنى بالحالات التي يُدخِل فيها الغاضب تعديلا على الشيء المغضوب، فيميل بذلك إلى تحميله التبعة عن كل ضرر قد ينشأ عن ذلك التعديل بحيث يصبح موقعه عند الشافعي أسوأ بكثير مما هو عند مالك. أما مبادئ مذهب الشيباني فنحن عاجزون عن الحكم عليها إلى الآن لانتفاء النصوص.
وطبع هذه النصوص لازم أيضاً باعتبار أنها المبدأ للبحث عن تطور الأحكام داخل المذهب الحنفي، والقاعدة العامة هي أن المسائل التي قررتها الكتب السابقة تنضم صراحة أو على الأقل إضماراً إلى الكتب اللاحقة التي تكون من جنسها، فالمسائل التي ترد في كتاب لأول مرة تمثل على وجه الإجمال النتائج التي استحدثتها المباحثات وتطور الأقوال بين هذا الكتاب والكتب التي سبقته. وهذه الطريقة التي تنطبق بطبيعة الحال على كافة المذاهب الفقهية ستسمح لنا بأن نتبع عن كثب تاريخ أحكامها وأقوالها
ونحن إلى الآن لم نذكر المذهب الحنبلي. وكثير من الفقهاء المسلمين وفي جملتهم ابن جرير الطبري قد آخذوا أحمد بن حنبل الذي يعتبره الجمهور مؤسساً لهذا المذهب بأنه محدث فقط وليس بفقيه، ولم يكن من الميسور لنا إلى الآن أن نقرر ألهذا الرأي ما يبرره أم لا.
ولكن كتاب المسائل الموجود منه ثلاث روايات لم يطبع منها إلا واحدة طبعة خاصة يصعب الحصول عليها – أقول إن كتاب المسائل هذا الذي يشتمل على أجوبة الإمام أحمد بن حنبل على المسائل التي وجهت إليه في كافة أبواب الفقه كما يشتمل كتاب المدونة الكبرى على أجوبة مالك ابن أنس يسمح لنا بأن نؤكد أن الإمام أحمد نفسه أراد أن يكون فقهياً لأنه كان يعلم مذهباً فقهياً مفصلا لا يقتصر على شرح الأحاديث.
ولهذا ينبغي ألا نعتبر مجموع أحاديثه الكبير المشهور بالمسند كأنه مؤلف قائم بذاته فحسب، بل نعتبره أيضاً كتاباً يضع الإمام أحمد فيه الأساس لمذهبه الفقهي.
ولا يعني هذا أنه أسس المذهب السني السلفي في الفقه بنفس المعنى الذي أسس الشافعي مذهبه على مقتضاه، لأننا نجد قبله وبعده فقهاء عديدين ذوي صبغة سنية سلفية، ومذهبهم مستقل عن مذهب الإمام أحمد. ويلوح مع ذلك أن دائرة تلاميذه بمذهبهم كانت الوحيدة التي بقيت من تلك الطريقة السنية السلفية المصبوغة بالأخذ بالأحاديث قبل كل شيء في الشرع الإسلامي
وإني لأختتم هذه المحاضرة الثانية متمنياً أن تنشر الكتب الحنفية العظيمة الشأن التي أسلفنا الإشارة إليها أقرب ما يمكن، فأن هذا الميدان ميدان خصب للتعاون بين العلماء الشرقيين والأوربيين، ذلك التعاون الذي ألمعت إليه في بدء حديثي الأول، فأن فقهاء اليوم باشتراكهم في تحقيق هذا الغرض سوف يعودون بفضل إحياء ماضي علمهم كما قد فعلوا بطبع كتاب الأم للإمام الشافعي
المصدر: العدد 143 من مجلة الرسالة (وهي مجلة ثقافية ترأس تحريرها الأديب المصري أحمد حسن الزيات باشا (المتوفى: 1388هـ) عدد الأعداد: 1025 عددا (على مدار 21 عاما) وكتب فيها معظم المقالات عن رموز الأدب العربي آنذاك من مثل: زكي نجيب، محمود العقاد، سيد قطب، أحمد أمين، علي الطنطاوي، محمد فريد أبو حديد، أحمد زكي باشا، مصطفى عبد الرازق، مصطفى صادق الرافعي، طه حسين، محمود محمد شاكر والشابي.)
جوزف شاخت
جوزف شاخت
أثار شاخت حفيظة العلماء المسلمين لأنه يشكك في صحة الأحاديث النبوية ويرى أنها وضعت أو “لفقت” خلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث هجري.
ولد شاخت في مدينة راتيبور الواقعة في ألمانيا (حاليا ً بولندا). حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة بريسلاو وانتقل بعدها للعمل في جامعة ليبزيغ ثم في جامعة فرايبورغ الشهيرة.
تمت ترقيته إلى منصب أستاذ كامل عن عمر 25 عاماً فقط. وعام 1932 تبوء شاخت منصب رئيس دائرة الدراسات الشرقية في جامعة كونينسبورغ حيث بقي هناك لحوالي السنتين قبل أن يستقيل بعد وصول الحكم النازي إلى السلطة في ألمانيا.
غادر شاخت بعد ذلك إلى مصر حيث عمل في جامعة القاهرة كأستاذ زائر وعام 1939 استقر في بريطانيا حيث عمل مع وزارة الإعلام لمدة خمسة سنوات، عاد بعدها للتعليم في جامعة اوكسفورد حتى عام 1954.
وخلال هذه الفترة وضع شاخت أشهر كتبه “أصول الفقه المحمدي” عام 1950. وعام 1954 انتقل شاخت إلى جامعة لايدن حيث شغل منصب رئيس دارة العربية قبل أن يغادر إلى جامعة كولومبيا عام 1959 حيث أمضى بقيت حياته.
توفي شاخت عام 1969 بجلطة دماغية في نيويورك. يعتبر شاخت من أكثر الوجوه الإشكالية في مجال الدراسات الإسلامية. رغم إتقانه اللغة العربية وسفره إلى عدد كبير من العواصم والمدن العربية والإسلامية كالقاهرة والجزائر وفاس وتونس وإسطنبول، فإن البعض يعتبره مستشرقا ً بامتياز بسبب مواقفه المشككة بركائز الفقه الإسلامي.
أما البعض الآخر فيعتبر أن معرفته الواسعة بالتاريخ الإسلامي سنحت له بتقديم مقاربة جيدة ونقدية لنشأة الإسلام. بدأ شاخت حياته الأكاديمية بالعمل على عدد من المخطوطات العربية لا سيما تلك منها الموجودة في القاهرة.
وفي هذا الإطار قام بتحقيق مخطوطة كتاب “الحيل والمخارج” للخصّاف في الفقه الإسلامي عام 1923. وفي منتصف العشرينات بدأ اهتمام شاخت بالفقه الإسلامي حيث استغل موقعه في جامعة فرايبورغ وعمل على تطوير معرفته بالقانون ومصطلحاته التقنية.
وفي مطلع الثلاثينيات كتب شاخت مقالات أكاديمية عدة في الفقه وعالج مسائل معاصرة في مقالته “الشريعة والقانون في مصر المعاصرة” 1936. غير أن اهتمام شاخت عاد ليتركز على نشوء الفقه حيث قام بدراسة مستفيضة حول محمد إدريس الشافعي تضمنها كتابه الأشهر “أصول الفقه المحمدي.”
ويعتبر شاخت في هذا الكتاب أن معظم الأحاديث النبوية تم “تأليفها” أو وضعها مع نهاية القرن الثاني هجري / بداية القرن الثالث. ويشكك بصحة عدد كبير من الأحاديث النبوية ويقول أنها وضعت لدعم حجج وأراء الفقهاء في ذلك الوقت.
ويرى شاخت أن الشافعي لعب دورا ً محوريا ً في ذلك لأنه كان في مواجهة أهل الرأي من جهة وأهل الأثر من جهة ثانية.
ومن هنا يعتبر شاخت أن الحاجة لإعطاء سلطة مطلقة غير قابلة للنقض أدت إلى إرجاع جميع الأحاديث إلى النبي محمد. وفي عام 1954 وضع شاخت كتابه “مقدمة للفقه الإسلامي” الذي مثل خلاصة فكره.(المصدر: أبجد)
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي