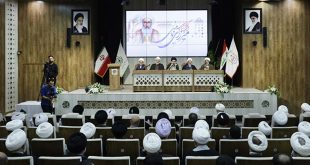الاجتهاد: أتقدم بالتحية والإكبار والإجلال لكل من حضر هذا المؤتمر (المؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، والذي أقيم في مدرسة الإمام الكاظم (عليه السلام) العلمية) في بلد كريمة أهل البيت (عليهم السلام) وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، ويدفع شرّ الأعداء عن الإسلام والمسلمين.
إن الغرض الأقصى هو التعرف على تاريخ الحوزة العلمية في قم المحمية مستهل القرن الرابع عشر. وبما أنّ هذه المدينة كانت أيضاً مركزاً للفقه والحديث في ثالث القرون وما بعده، اقتضى ذلك أن نشير إليها وإلى المعاهد العلمية المتقدمة عليها.
***
المدينة المنورة
المركز الأول للحديث والفقه
تعد المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنطلق الأول للعلوم والمعارف، التي تفجرت ينابيعها من آي الذكر الحكيم، ومن بين شفتي الرسول الكريم، ثمّ من أخيه ووصيه أمير المؤمنين (عليه السلام) وجماعة من أصحابه، في طليعتهم: سلمان المحمدي، وأبوذر الغفاري، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس.
ثمّ انحسر النشاط العلمي فيها في ظل الظروف السياسية التي سادت آنذاك، والتي كان من نتائجها تلك الجريمة البشعة المتمثلة بسفك دم الإمام الحسين (عليه السلام) ودماء أهل بيته وأصحابه في ملحمة الطف الخالدة، ولم تكد تجف الدماء الطاهرة لأولئك الأبرار حتى أقدم الحكّام على ارتكاب أفظع الجنايات في وقعة الحَرَّة، التي استباح فيها الجيش الأموي المدينة ثلاثة أيام، وانتهك فيها الأعراض.
ثم أخذت تنشط الحركة العلمية في أيام الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، الذي تولى الإمامة بعد رحيل والده الإمام علي زين العابدين (عليه السلام) في سنة 94هـ، وذلك بعد أن خفّت نسبياً وطأة الضغوط السياسية في بعض فترات ذلك العصر، حيث قصدها أهل العلم ووجوه العلماء (وما زار أحد المدينة إلا عرّج على بيته يأخذ عنه) (1) ، وممن أخذ عنه: سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وسليمان الأعمش، والحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي.(2)
وكان ( عليه السلام) يُفيض العلم على طلابه في المسجد النبوي، في شتّى فروعه من الحديث والتفسير والفقه والكلام والسيرة، ويُعنى بتأهيل أصحابه للإفتاء واستنباط المسائل من خلال استنطاق الكتاب والسنة، وبث الحديث الشريف، حتى نبغ منهم جماعة، في مقدمتهم: زرارة بن أعين، وأيان بن تغلب ومحمد بن مسلم الثقفي، ويُريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار النهدي، وغيرهم ممن حضروا أيضاً على ولده الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، الذي تولى الإمامة بعد رحيل والده في سنة 114 هـ فتسارعت بجهوده عجلة الحركة العلمية والمعرفية والفكرية، لا سيما في ذلك المقطع الزمني الذي امتد من أواخر الحكم الأموي الذي اعتراه الضعف ثمّ آلَ إلى الانهيار، إلى بداية قيام الحكم العباسي الذي كان أحوج ما يكون إلى إرساء قواعده، حتى لقد غدت حلقات الدرس التي كان يعقدها الإمام (عليه السلام) في المسجد النبوي بمنزلة «جامعة كبرى» استقطبت الجمّاء الغفير من بغاة العلم(3) على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الدينية والفكرية، للتزوّد من العلوم والمعارف الإسلامية وغيرها من العلوم كالطب والكيمياء والنجوم، حتى ملأ الدنيا علمه وفقهه)(4)، وغدا جبلاً فنداً في العلم والمعرفة،
كما شهد له بذلك الأعلام (فقد كان أبو حنيفة يروي عنه ويراه أعلم الناس، وأوسع الفقهاء إحاطة، وكان الإمام مالك يختلف إليه دارساً راوياً، وكان له فضل الأستاذية على أبي حنيفة ومالك، وحسبه ذلك فضلاً)(5).
***
«مسجد الكوفة»
المركز الثاني للحديث والفقه
وفي أثناء القرن الثاني كان العراق ونخص بالذكر مسجد الكوفة يزدحم بمئات المحدثين الذين تلقوا أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ووصيّه وسائر الأئمة من بعده وتناقلوها عصراً تلو عصر.
ويشهد على ذلك قول الحسن بن علي بن زياد الوشاء – وكان من أصحاب الرضا (عليه السلام)- وهو يخاطب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ويقول: «إنّي أدركت في هذا المسجد – يعني مسجد الكوفة – تسعمائة شيخ كلّ يقول: حدثني جعفر بن محمد».(6) ونحن نقتصر على هذا المقدار حذراً من الإطناب.
***
المشرق الإسلامي.. خراسان وما وراء النهر
المركز الثالث للحديث والفقه
لما استقدم المأمون العباسي الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) إلى طوس وأقام الإمام سنتين في هذه البقعة صارت مرتعاً للحديث والفقه في ظل الإمام (عليه السلام)، حتى انتشر نور العلم وبلغ بلاد ماوراء النهر وسمرقند وكش و خوارزم وما حولها، فقد كان لمحدثي الشيعة هناك نشاط ملموس، أدى إلى انتعاش الحركة العلمية فيها، لا سيما في عصر أبي النضر العياشي (المتوفى نحو 320هـ)، الذي يُعتبر بحق قطب الرحى لتلك الحركة، يدل على ذلك قول النجاشي: إنّ أبا النضر أنفق على العلم والحديث تركة أبيه سائرها، وكانت ثلاثمائة ألف دينار، وكانت داره كالمسجد، بين ناسخ، أو مقابل، أو قارئ، أو معلق، مملوءةً من الناس. (7)
وقال النجاشي في ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالله القزويني القاضي: إنّه قدم بغداد سنة ست وخمسين وثلاثمائة ومعه من كتب العياشي قطعة، وهو أول من أوردها إلى بغداد ورواها عن أبي جعفر أحمد بن عيسى العلوي الزاهد عن العياشي.(8)
***
مدينة قم المحمية
المركز الرابع للحديث والفقه
إن المركز الرابع لدراسة الحديث والفقه والتفسير، هو مدينة «قم» بعد انتشار الإسلام فيها، خصوصاً في الأوقات التي هاجر إليها الأشعريون – هرباً من بطش الحجاج وعماله وجواسيسه – عام 83 هـ، وقد سعوا في بنائها وعمرانها فصارت قبلة لأن يهاجر إليها غيرهم، فزاد عدد سكانها، إلى حدّ صارت مدينة كبيرة.
وقد ألف الشيخ حسن بن محمد بن حسن القمي كتاباً في تاريخ قم، عام 378 هـ باللغة العربية وشرح فيه نواحيها وقراها واشتمل الكتاب على عشرين باباً، بين في أولها خصوصيات الكتاب، ولكن مما يؤسف له أن الكتاب عبثت به يد الزمان فلم يصل إلينا منه إلا الأبواب الخمسة الأولى من أبوابه بواسطة حسن بن علي بن حسن بن عبدالملك القمي، حيث نقله إلى الفارسية عام 805 هـ، فمن أراد أن يقف على عظمة هذه المدينة فليرجع إلى هذا القسم من الكتاب الذي طبع بتصحيح الاستاذ السيد جلال الدين الطهراني، ففي مطالعة فهرست الكتاب وديباجته كفاية في الوقوف على عظمة المدينة في تلك الازمنة من حيث الثقافة والعمران.
ومع ذلك فلنا طريق آخر لمعرفة عظمة هذا المركز من حيث العلم والثقافة، وهو وجود محدثين وفقهاء كبار في ثالث القرون وما بعده، وإليك الإشارة إلى اسماء هؤلاء الفطاحل من كبار الفقهاء والمحدثين:
1. محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري (المتوفى حدود 280هـ) مصنف نوادر الحكمة.
2. سعد بن عبدالله بن أبي خلف (المتوفى 301 هـ أو 299 هـ) شيخ الأشعريين الذي لقي الإمام الحسن العسكري(عليه السلام).
3. محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (المتوفّى 343هـ) مؤلف الجامع، شيخ القميين وفقيههم.
4. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (القرن الثالث) شيخ القميين وفقيههم، صنّف أربعاً وتسعين كتاباً.
5. أحمد بن أبي عبد الله خالد البرقي (المتوفى 274 هـ) صاحب كتاب المحاسن، وقد أكثر الرواية عنه الشيخ الكليني بواسطة محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس.
6. إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم. انتقل من الكوفة إلى قم ونشر أحاديث أهل البيت(عليهم السلام) فهو أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم، وقد روى عنه المشايخ العظام.
7. علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي. روى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة 274 وغيره وأخذ عنه محمد بن يعقوب الكليني، وكان من اعلام الفقهاء والمحدثين، وكان حياً سنة 307 هـ .
8. أنفذ الشيخ الحسين بن روح النوبختي وكيل الناحية كتاب «التأديب» للشيخ الشلمغاني إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها، وقال لهم: انظروا في هذا الكتاب، فيه شيء يخالفكم؟ فكتبوا إليه أن كله صحيح وما فيه شيء يخالف، إلا قوله: «في الفطرة نصف صاع من طعام…»(9)، وبهذا نرى أن وكيل الناحية يرجح فقهاء قم على سائر النواحي، وهذا يكشف عن عظمة المقدرة العلمية فيها.
وقد كان بين البلدين: قم والري صلة وثيقة في أخذ الحديث وروايته، والشيخ الكليني وإن كان خريج مدرسة الري لكنّه يروي عن علي بن إبراهيم القمي كثيراً، كما أن الصدوق وإن كان خريج تلك المدرسة، ولكن كانت بينه وبين المشايخ القميين صلة، كُلّ ذلك يُعرب عن وجود مركز حديثي فقهي في القرن الثالث، بل أواخر القرن الثاني، بشهادة أن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا (عليه السلام) شُقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ قال: «من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا»،(10) ومن المعلوم أن الإمام الرضا ( عليه السلام) قد استشهد في اوائل القرن الثالث.
وهذه إلمامة لدراسة مكانة قم في نشوء ودراسة العلوم الإسلامية.
***
كانت الحركة العلمية سائدة منتشرة في البلاد الإسلامية لكنها مختلفة الأحوال من حيث القوة والضعف، غير أنّ زحف المغول اوائل القرن السابع قد تسبب في خراب كل المعاهد والمدارس في طريقه من الشرق الإسلامي إلى بغداد.
إن التاريخ يحكي لنا أن هجوم المغول كان بليّة عظيمة أحرقت كل أخضر ويابس، ولكن لم يطل هذا الحال كثيراً، ولم يستمر على هذا المنوال، فبعدما اعتنق أحد ملوكهم الإسلام، عاد النشاط العلمي إلى كل البلاد الإسلامية، وإلى مدينة قم خاصة.
ومن أراد التعرّف على كيفية سير العلم والحديث بعد تلك الثورة التي حدثت داخل الحكم المغولي إلى عصر الحكم الصفوي فليرجع إلى موسوعة طبقات الفقهاء، خصوصاً الأجزاء 8 و 9 و 10، فسيجد في غضون تلك القرون أسماء الكثير من العلماء والمحدثين ممن عاش ودرس ودرّس في قم المقدسة. فلنرجع إلى دراسة مسيرة العلم في قم المحروسة في العصر الصفوي إلى القرن الرابع عشر الهجري.
الحوزة العلمية في العصر الصفوي وما بعده
من طالع كتب التراجم يجد فيها أسماء لامعة لعلماء وفقهاء وغير ذلك من أصحاب التخصصات المختلفة، وكانت لهم نشاطات قيمة في هذه الفترة الزمنية، وسنشير إلى بعض ما يرشدنا إلى ذلك:
1. هذا هو الشيخ بهاء الدين العاملي، يقول في نهاية كتابه “مشرق الشمس”: اتفق الفراغ من تأليفه في اليوم الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من السنة الخامسة عشرة بعد الألف بدار المؤمنين قم المحروسة في جوار الحضرة القدسية المطهرة الفاطمية. (11)
2. هذا هو صدر المتألهين (المتوفى عام 1050 هـ) يقول : سكنت خمسة عشر سنة في قم وألفت خلال تلك السنين الأسفار الأربعة. (12)
3. هذا هو العلامة الكاشاني الملقب بالفيض صهر صدر المتألهين، صاحب المؤلفات الغزيرة، منها «الوافي» الذي هو المرجع لاستنباط الأحكام الشرعية الواردة في الكتب الأربعة. وكانت الصلة بين الحوزتين في قم وكاشان مؤكدة وقوية، والمدرسة الفيضية التي هي المدرسة الكبرى من آثار الفيض الكاشاني (رحمه الله) في مدينة قم.
4. صهر صدر المتألهين الملقب بالفياض المشهور بـ «الحكيم عبدالرزاق اللاهيجي»، صاحب کتاب “شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام” وكان من مدرسي الحوزة العلمية في قم. (13) وقد توفي في قم عام 1072 هـ، ودفن فيها.
5. العارف الرباني القاضي سعيد بن محمد بن المفيد القمي، مؤلف شرح توحيد الصدوق. توفي عام 1107 هـ .
6. المحقق ابوالقاسم القمي، مؤلف «القوانين». توفي عام 1231 هـ .
وكان النشاط العلمي في عصره قد بلغ حداً فوق ما يتصوّر، ولذلك قام الميرزا بتأليف كتب كثيرة تتعلق بالفقه والفقاهة. يشهد على ذلك كتابه: «جامع الشتات».
وهكذا كان الأمر على هذا المنوال حتى دخل القرن الرابع عشر.
الحوزة العلمية في القرن الرابع عشر
دخل القرن الرابع عشر محتضناً لحوادث جمة، مفرّقاً للمجتمع ومشوشاً للأذهان، ومقسماً للبلاد الإسلامية، فمن جانب ظهرت الثورة الدستورية من الغرب عام 1324 هـ فانقسم المجتمع إلى موافق و مخالف، وسرى الاختلاف إلى حوزة النجف وعلمائها، وكان الاختلاف هناك على قدم وساق.
ومن جانب آخر اندلعت الحرب العالمية الأولى وطالت عدة سنين إلى أن انتهت بتقسيم البلاد الإسلامية بين الدول الغربيّة، وكانت إيران من نصيب بريطانيا.
وفي خضم هذه الأوضاع لم تخلُ مدينة قم من الشيوخ الكبار، نذكر أسماء بعضهم:
1. الشيخ ابو القاسم بن محمد تقي القمي، الفقيه الزاهد، المتوفى عام 1353هـ .
2. العالم نافذ الأمر والحكم ميرزا محمد المعروف بـ «أرباب» الذي توفي عام 1342 هـ .
وغيرهما من العلماء، ورغم وجود هذين العلمين في قم، فلم تكن مسيرة الدراسة العلمية بالشكل المرضي، بل كان الركود هو السائد عليها وكانت المدارس خالية من الطلاب.
وفي هذه الظروف انبرى رجل العلم والفقاهة ومنار التقوى والتدبير آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري فقام بتأسيس حوزة علمية عام 1340 هـ – وهذا هو بيت القصيد في مقالنا هذا – ، فيجب علينا أن نشير إلى جوانب حياته العلمية والسياسية.
***
آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، العارف بزمانه
مولده ونشأته العلمية
ولد شيخنا الجليل عام 1274 هجرية في يزد، وانتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1355 هـ، وقد ترك تراثاً علمياً تقصر الأقلام عن بيان عظمته، ونكتفي بإشارة موجزة.
لما فرغ شيخنا من دراسة المقدّمات في مسقط رأسه هاجر إلى سامراء التي كانت آنذاك تزدحم بمئات من المجتهدين العظام والاستاذة ويرأسها السيد الكبير محمد حسن الشيرازي (قدس سره) فأخذ يستفيض من نمير علمه متى بلغ مبلغاً علميّاً راقياً ولما انتقل الزعيم الشيرازي إلى رحمة الله تعالى عام 1312 هـ حصلت هزّة في حوزة «سامرّا» حتى فرضت على الاستاذ الأكبر السيد محمد الفشاركي الانتقال إلى النجف الأشرف، فتبعه تلميذه الأعظم الشيخ الحائري، وبقيا هناك إلى سنة 1315 هـ،، ولما توفي السيد الفشاركي، بدا للحائري أن يترك النجف متوجهاً إلى مدينة أراك بعد وصول رسائل من علمائها إليه، فلبّى دعوتهم، فنزل تلك المدينة وأسس حوزة علمية وبقي فيها إلى عام 1324هـ.
العودة ثانياً إلى العراق
لكن بسبب طروء الفكرة الخاصة – أي الحكومة الدستورية التي أضرت بوحدة الكلمة وصار المجتمع بين مؤيد ورافض – ترك شيخنا مهجره قاصداً العراق قاطناً في الحائر الشريف وظل هناك ثمان سنين، لكن توالت عليه الرسائل مرة أخرى من مهجره الأول، فلبي دعوتهم مرة ثانية ونزل أراك مدرساً محققاً مرتياً، إلى سنة 1340 هـ .
ولما مر بمدينة قم في تلك السنة، في طريقه إلى زيارة الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدس، اجتمع حوله علماؤها وفضلاؤها مصرين عليه أن يقيم في قم المقدسة وأن ينقل الحوزة العلمية من أراك إلى قم.
فأرجأ الجواب إلى ما بعد العودة من الزيارة، وعندما عاد إلى قم من مشهد الرضا قرر الإقامة فيها، ودعا الفضلاء والطلاب للانتقال من أراك والاستقرار في قم، ثم توالت جموع الطلاب من أطراف البلاد بالقدوم.
ولما كانت المدارس قديمة وبحاجة للعمارة وتجديد البناء، بدأ بتجهيز المدارس وإسكان الطلاب فيها مع إجراء أرزاقهم حسب المكنة والقدرة.
ومن حسن الاتفاق أن الحكومة العراقية آنذاك، أبعدت المراجع العظام كلاً من آية الله النائيني والإصفهاني والشهرستاني، فقام المؤسس (رحمه الله) بترك التدريس إكراماً لهؤلاء العلماء واحتراماً لهم، فأوكل أمر الدرس والتدريس إليهم، ماداموا مقيمين في قم.
ولم تطل مدة إقامتهم أكثر من سنة، فرجعوا إلى العراق، وبعد أن انتشرو وذاع خبر الحوزة العلمية في قم في شتى أنحاء البلاد، تواتر إليها العلماء والفضلاء، فجاءوا لينصروا الشيخ المؤسس ويقفوا إلى جانبه، ومنهم السيد الحجّة الكوهكمري والشيخ الشاه آبادي والسيد أبو الحسن القزويني وغيرهم من أقطاب الفقه والعلوم العقلية.
وبمجيء هذه الكواكب صارت هذه الحوزة حوزة مكتملة تُدرّس فيها أنواع العلوم فقهاً وأصولاً وفلسفة وكذا العلوم الرياضية.
وكل هذا التطور قد حصل في وقت أن الحكومة آنذاك كانت غير مرتاحة للحوزة، لأنها كانت كالشوكة في عين الحكومة.
وكان الشيخ المؤسس عارفاً بزمانه ورغم الضغوط العظيمة بقيت الحوزة إلى عام وفاته مكتملة الأركان، فصارت شجرة طيبة تؤتي ثمارها كل حين، حتى وافاه الأجل في شهر ذي القعدة الحرام عام 1355 هـ، يقول السيد صدر الدين الصدر مؤرخاً لوفاته:
دعاه مولاه فقُل مؤرخاً *** لدى الكريم حلّ ضيفاً عبده»
خصائص الشيخ الحائري وروحياته
إن دراسة روحيات الشيخ المؤسس وفضائله الأخلاقية، رهن مقال مبسوط، إلا أننا نقتصر على ذكر شذرات من ذلك.
الأول: زهده في زخارف الدنيا
كانت حياة الشيخ تجسد لنا زهد من لم يتعلق قلبه بزخارف الدنيا و طيباتها، وكانت حياته حياة الزاهدين المقتصرين على أقل ما يحتاجه الإنسان للاستمرار بحياته وأداء تكاليفه.
الثاني: معرفته بشرائط زمانه
من أبرز ميزاته الشخصية أنّه جسد قول الإمام الصادق ( عليه السلام): «العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس» فقد شخص (رحمه الله) الداء وقدم الدواء، فأسس الحوزة العلمية في قم في أحلك الظروف، و كان حاكم إيران يعاديه حتى يقضي على حوزته، ومع ذلك كله أقام دعائم الحوزة برعاية الله تعالى، وكانت مصونة إلى زمن وفاته رحمه الله، وكان عدد من يدرس في حوزته آنذاك في بعض السنوات (1353) 900 طالب، وكان يُجري عليهم أرزاقهم بتدبير خاص.(14)
ويذكر في مكان آخر مشاهداته وانطباعاته من المؤسس الحائري ويقول نزلنا في داره سنة 1353هـ) في قم، وأنا بنا في صلاة الجماعة في الصحن الشريف مدّة مقامنا بقم، وكان في مدرسته في قم (نحو 900) طالب يجري على أكثرهم الأرزاق، وقد انحصرت الرئاسة العلمية فيه في وقته في بلاد إيران وقُلد فيها، وكانت الأموال تُجبى إليه من أقاصيها فيضعها عند بعض التجار ويصرفها على الطلبة بواسطة ذلك التاجر، ويأخذ كنفسه معاشاً معيناً منها، وهذا دليل على وفور عقله عاشرناه مرة مقامنا عنده فوجدناه رجلاً قد ملئ عقلاً وكياسة وعلماً وفضلاً. ومن وفور عقله ما مرّ ذكره، وكان إذا سُئل عن مسألة أو جرى البحث بحضرته في مسألة لا يتكلم حتى يتفكر ويتأمل»(15)
ومن عنده إطلاع بالظروف التي عاشها الشيخ المؤسس والضغوط التي تعرض لها، يوقن أن تدبير أمور هذا العدد من الطلاب في هذه الظروف هو نتيجة رعاية الله تعالى و توفيقه.
الثالث: آثاره العلمية
صنف الشيخ الحائري كتباً منها كتاب الصلاة ((مطبوع)، كتاب النكاح، كتاب الرضاع، كتاب المواريث، درر الفوائد (مطبوع) في أصول الفقه. وله تقريرات بحث أستاذه الفشاركي في أصول الفقه.
ثم إن لشيخنا المؤسس آثاراً علمية وحواش على بعض الكتب، لكن نحن نركز على كتابين من كتبه:
1. كتاب الصلاة
وهو دورة كاملة لأحكام الصلاة وينتهي بصلاة المسافر وهو في مجلد كبير واحد، ولكنّه في اختصاره يشتمل على تحقيقات قيمة، وقد سمعت من استاذي الكبير السيد البروجردي أيام تدريسه كتاب الصلاة نقل كلاماً عن الشيخ المؤسس وقال: ما هذا مثاله: لم أر بين المعاصرين كتاباً مثل كتاب الصلاة للشيخ الحائري حيث إنّه في وجازته يشتمل على مطالب كثيرة بأقل العبارات.
2. درر الأصول المعروف بـ «درر الفوائد»
يحتوي الكتاب على دورة أصولية كاملة وهو في اختصاره كتاب علمي غزير الفوائد وكفى في حقه أن المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني له اهتمام بما في هذا الكتاب حيث نقل في غير مورد من مباحث الاصول معبراً عن المؤلف بـ «بعض الأجلة».
الكلام في آثاره الاجتماعية ومشاريعه الخيرية
إن لشيخنا المؤسس خدمات اجتماعية إلى جانب خدماته العلمية، ونحن نشير إليها بالإجمال:
1. تأسيس مكتبة كبيرة في المدرسة الفيضية.
2. تأسيس مستشفى السهامية سنة 1353 هـ .
3. تأسيس مستشفى الفاطمية.
4. عمارة المدارس الحوزوية.
إلى غير ذلك من الآثار التي تكفلت ببيانها المجلات والكتب الصادرة عن الحوزة العلمية.
إلى هنا يتم كلامنا حول حياة شيخنا المؤسس على نحو الإجمال والاختصار.
وهناك جوانب أخرى جديرة بالبحث نقتصر على ذكر عناوينها، ويراد بها المراحل التي مرت بها الحوزة العلمية بعد رحيل الشيخ المؤسس:
1. الحوزة العلمية بعد رحيل الشيخ الحائري، وإدارة الحوزة بأساطين ثلاثة، أعني:
أ. السيد محمد الحجة.
ب. السيد محمد تقي الخوانساري.
ج. السيد صدر الدين الصدر.
2. الحوزة العلمية بعد إقامة السيد البروجردي في قم المشرفة عام 1364هـ .
3. الحوزة العلمية بعد ارتحال السيد البروجردي عام 1380هـ .
4. الحوزة العلمية بعد انتصار الثورة الإسلامية، إلى يومنا هذا.
فهذه المواضيع بحاجة إلى دراسة مفصلة قام بها عدد من المحققين والباحثين، شكر الله مساعي الجميع.
عشية يوم الأربعاء
ثاني ذي القعدة الحرام
من شهور عام 1446 هـ
جعفر السبحاني
الهوامش
1 . الشيخ محمد أبوزهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية: 639.
2 . ابو الحجاج المزّي، تهذيب الكمال: 136/26، برقم 4578.
3 .أحصى الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (ابن عُقدة تلامذة الإمام الصادق (عليه السلام) فبلغوا أربعة آلاف رجل. ينظر الإرشاد ،271 ، رجال النجاشي: 94، برقم 233.
4 . رسائل الجاحظ: الرسائل السياسية: 452
5 . الشيخ محمد ابوزهرة، الإمام الصادق: 3.
6 . رجال النجاشي: برقم 8
7 . رجال النجاشي: برقم 944.
8 . رجال النجاشي برقم 693.
9. الذريعة: 210/3 برقم 775: الغيبة للطوسي: 390.
10. الوسائل 146/27، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
11 . مشرق الشمسين: 271.
12 . أعيان الشيعة: 114/24.
13 . ريحانة الأدب: 144/4.
14 . لاحظ: أعيان الشيعة: 139/1
15 . أعيان الشيعة: 46/12
المصدر: شفقنا
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي