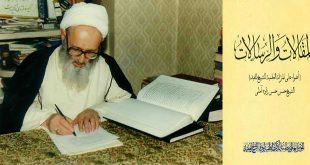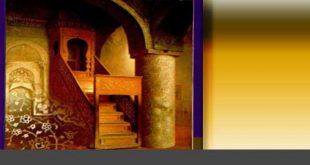بدأت النواةُ الأولى لفقه المياه – بمفهومه الموسع- في مجال المعاملات المدنية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما حث أصحابه للمبادرة بعمل خيري للنفع العام هو «وقفُ بئرِ رومة» بالمدينة المنورة في السنة الأولى لهجرته إليها، وكانت تلك هي السابقة الأولى لربط فقه المياه بمقاصد الشريعة، ومنها «مقصد حفظ النفس». بقلم: إبراهيم البيومي غانم
الاجتهاد: سامح الله فقهاءنا المعاصرين الذين حصروا فقه المياه في أحكام الطهارة والوضوء وغسل الموتي؛ حتى بات حضور المياه في الوعي الإسلامي المعاصر مقتصراً على تلك الأحكام دون بقية أحكامها التي تطال جوانب حيوية لا يمكن تصور وجود العمراني الحضاري بدونها، ولا يمكن بقاء الوجود الإنساني بعيداً عنها، كيف وقد قال الله تعالى في محكم آياته:”وجعلنا من الماء كل شيء حي”.
هناك فقه حضاري للمياه نجده متغلغلاً بغزارة في مختلف جنبات الفقه الإسلامي القديم. ولا يقل هذا الفقه أهميةً عن فقه المياه في العبادات والطهارة بحال من الأحوال. وما اضمحلال أو غياب هذا الفقه عن الواقع المعاصر إلا أثر من آثار عهود التدهور التي عانت منها مجتمعات أمتنا الإسلامية، ولا تزال تعاني سلبياتها على أكثر من صعيد.
بدأت النواةُ الأولى لفقهِ المياه- بمفهومه الموسع- في مجال المعاملات المدنية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما حث أصحابه للمبادرة بعمل خيري للنفع العام هو «وقفُ بئرِ رومة» بالمدينة المنورة في السنة الأولى لهجرته إليها، وكانت تلك هي السابقة الأولى لربط فقه المياه بمقاصد الشريعة، ومنها «مقصد حفظ النفس».
فقد رُوي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، وكانت لرجلٍ من بني غفارة، وكان يبيع منها القربة بمدٍ». (و «المد» نوع من المكاييل، وكان يساوي في فجر الإسلام، وخاصة في المدينة ربع صاع، وعند أبي حنيفة يتسع المد لرطلين بغداديين. والمد يساوي الآن 812.5 جرام قمح؛ أي إنه يساوي سعة 1.5 لتر تقريباً)، فقال «تبيعينها بعينٍ في الجنة؟ فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلتَ له؟ فقال نعم”.
وكان الدرسُ من تلك المبادرة واضحاً وهو أن «الماءَ» يجبُ أن يكون متاحاً بلا تكلفة للناس أجمعين لارتباط الحياة به وجوداً وعدماً، فإن تعذر ذلك، فإن مبادرات أهل الخير بوقفه، أو بالوقف عليه تتكفلُ بتوفيره مجاناً حتى يسهم في تلبية احتياجات الناس من المياه التي يتوقف عليها تحقيقُ كثيرٍ من مصالحهم، ومنها وأولها «حفظ حياتهم»؛ وحفظ الحياة الإنسانية مقصدٌ أساسي من مقاصد الشريعة.
ومع تطورِ الحالة الحضارية في المجتمعات الإسلامية، زادَ ارتباطُ الماء بالعمران المدني- مثلما حدث في أغلبِ التجارب الحضارية الكبرى- فقد أدركَ مؤسسو المدن والأمصار الإسلامية أهمية الماء كشريان للحياة المدنية المستقرة. وكان توجيهُ النبي صلى الله عليه وسلم بوقف بئر رومة نموذجاً استلهمه المسلمون في مختلف بقاع الأرض، وعلى مر العصور.
وسجلت كتب الحكمة السياسية الماءَ على رأس قائمة تضم ستة شروط ضرورية لعمارة المدن هي: سعةُ المياهِ المستعذبة، وإمكان الميرة المستمدة، واعتدال المكان الموافق لصحة الهواء والتربة، والقرب مما تدعو الحاجة إليه من المراعي والأحطاب، وتحصين المنازل من الأعداء والزعار، وأن يحيط بالمدينة سواد(أرض زراعية خصبة) تعين أهلها بموادها»، على ما جاء في كتاب الماوردي (تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك و سياسة الملك ، نشرة رضوان السيد. بيروت: 1989. ص219) .
وقد رافق «الفقهُ» تلكَ التطورات في علاقة الماء بالحياة المدنية؛ بل إن التاريخ المعرفي للفقه الإسلامي يوضح لنا أن اجتهاداتِ كثيرٍ من أعلام الفقهاء في شأن «الماء» عموماً، قد سبقت تلك التطورات المدنية والحضارية، وكانت سبباً من أسبابها، وذريعةً أدت إلى تغذيتها بالقوة المعنوية، وبالحجج الشرعية؛ الأمر الذي جعلها تحظى بقبول اجتماعي واسعٍ. وما استنتجناه من استقراء أبواب فقه المياه هو أن معايير المقاصد قد أسهمتْ بدورٍ كبير فيما توصل إليه الفقهاء من اجتهادات مرتكزة في وسط من التعقل والتبصر في مسائل المياه وقواعد تملكها وآدابِ استعمالها.
بيَّن الفقهاءُ أن للماء من حيث إمكانية تملكه حالتان: الأولى، أن يكونَ مملوكاً ملكية عامة، وخاصة في جميع مصادره السطحية (الأنهار والبحار وفروعها والبحيرات). وأكدوا على أن الملكية العامة للماء هي الأصلُ؛ لقول رسول الله: الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار»، والشركة العامة تقتضي الإباحة . والثانية، أن يكون الماءُ ملكية خاصة، وذلك بحيازته، ويكون مصدر الحق في التصرف فيه كملكية خاصة هو ما بذله حائزه فيه من عملٍ وجهدٍ، وما يقتضيه ذلك من نفقات لجلبه أو استخراجه، أو تخزينه، أو تنقيته، ونقلهِ، وتوزيعهِ، وصيانة مستلزماتِه وأدواته…إلخ.
في العصر الوسيط من تاريخ حضارتنا، كانت المصادرُ الجوفيةُ أكثر مصادر المياه قابلية للتملك ملكية خاصة بهذا المعنى. ولا تزالُ المياهُ الجوفيةُ حتى وقتنا الحاضر هي أهمُّ أنواعِ المياه القابلة للتملك ملكية خاصة، والتصرف فيها كسلعةٍ تخضع لقوانين السوق. أما بقيةُ أنواع المياه فلا تزالُ ضمن دائرة الملكية العامة، مع فرضِ تسعيرةٍ جبرية على استخدامها في المنازل والمنشآت الخاصة والعامة، بهدف تغطية بعض نفقات توفيرها وتوصيلها للمستفيدين منها.
بيَّن الفقهاء أيضاَ أنه بثبوت ملكية الماء أو مصدرٍ من مصادره- السطحية أو الجوفية- فإنه يعتبر: إما حقاً من حقوق الملكيةِ الأصلية العينية في بعض الحالات؛ وذلك عند حيازته ولو من مصدرٍ عام للماء كنهر جارٍ أو سيل سارٍ، أو عند حيازة مصدرٍ من مصادره الجوفية مثل بئر معين أو عين عذبة. وإما يصبح حقاً من حقوق الارتفاق، أو مادةً لحقٍ من حقوق الارتفاق.
وسواء كان الماء ملكاً عينياً، أو كان حقاً من حقوق الارتفاق، فقد اعتبره الفقهاء مالاً، وأجازوا وقفه للانتفاع به وتخصيصه للمنفعة العامة إسهاماً في تحقيق مقصد «حفظ النفس» الذي لا يتحقق دون مياه صالحة للشرب ومتاحة للجميع، إلى جانب ما تحققه المياه من منافع اقتصادية أخرى.
وأياً كانت نوعية ملكية المياه(ملكية عينية أصلية، أو ملكية انتفاع عيني كحق من حقوق الارتفاق)، فقد نظر الفقهاءُ إليه على أن له ثمناً في أغلب الأحوال، وأنه يعتبر سلعة اقتصادية داخلة في التداول السوقي وليست خارجة عنه. وبما أن له ثمناً مقدراً بتكلفة توفيره، أو بأكثر قليلاً أو أقل قليلاً من تلك التكلفة، فلا بد من طرف يدفع هذا الثمن مقابل الحصول عليه.
وقد ألقى الفقهاء على الدولة المسئولية الأولى في توفير المياهِ والتكفلِ بجميعِ نفقاتها، أو بأغلبها، حتى تكون متاحة لمواطنيها بالقدر المناسب لاحتياجاتهم، وبالنوعية التي تحقق مصالحهم، وتحافظ على بيئتهم وصحتهم العامة. وكان هذا الاتجاه أيضاً مؤسساً على إدراك فقهي عميق لمسئولية السلطة عن توفير ضروريات تحقيق المقاصد العامة للشريعة ومنها «حفظ الأنفس» من الهلاك، أو على الأقل أن تضمنَ السلطةُ وصولَ المياه لمن لا يقدرون على الوصول إليها بأن تتحمل هي تكلفتُها.
وقد يكون دافعُ تكلفة الماء هو المستهلك(الهيئاتُ والأفرادُ) وذلك في حالات مخصوصة ونادرة، أو قد يكون دافعُ التكلفةِ طرفاً وسيطاً يوفر الماءَ مجاناً لمن يحتاجه، وهذا الطرف الوسيط لم يكن في التجربة التاريخية الإسلامية سوى الوقف، إلى جانب بعض أعمال الصدقات والتبرعات التي خصصها الواهبون لتقديم المياه لذوي الحاجة إليها سواء كانوا آدميين، أو ذوات أرواح من الدواب والبهائم، والطيور، أو نباتات ومزروعات، أو لأغراض الزينة والترفيه العام من خلال تزويد المتنزهات بنوافير المياه وصنابير الشرب.
ولا نخال تلك الاجتهادات وما يشبهها إلا أنها كانت تهدف للتمكين من نفاذ كل منْ/وما يحتاجُ إلى الماء بيسرٍ وسهولة؛ نظراً لأن الماء وسيلة لمقاصد عالية تتوقف عليها حياة ومصالح الآدمي وغير الآدمي ومنها مقصد «حفظ النفس» من جهة توفير المتطلبات المادية لهذا الحفظ.
ونسوق فيما يلي ثلاثةَ نماذجَ من اجتهاداتِ الفقهاء: الأول ورد في الأم للإمامِ الشافعي، والثاني ورد في بدائع الكاساني، والثالث ورد في مبسوط السرخسي.
أ- قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: «كل ماء ببادية يزيد في عينٍ، أو بئرٍ، أو نهرٍ؛ بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته، وزرع إن كان له؛ فليسَ له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع. وليس لغيره أن يسقي منه زرعاً ولا شجراً؛ إلا أن يتطوعَ بذلك مالكُ الماء. والله أعلم».(كتاب الأم للإمام الشافعي، ج/3 ص 272.)
ب- افتتح الكاساني «كتاب الشرب في الجزء السادس من كتابه «بدائع الصنائع « بتقسيم المياه إلى أربعةِ أنواع : الأولُ الماءُ الذي يكون في الأواني والظروف، والثاني الماءُ الذي يكونُ في الآبار والحياض والعيون، والثالثُ ماءُ الأنهارِ الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين، والرابعُ ماءُ الأنهارِ العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها.
أما بيانُ حكمِ كل نوع منها فالأول مملوكٌ لصاحبه لا حق لأحد فيه؛ لأن الماءَ وإن كان مباحاً في الأصل لكن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره؛ كما إذا استولى على الحطب والحشيش والصيد فيجوز بيعه كما يجوز بيع هذه الأشياء».( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية، 1406هـ 1986م ، ج6/189.) ثم يبحرُ صاحب البدائع في أعماق مكشلات المياه ويطرح لها حلولاً أصيلة وعملية ونافعية في آن واحد، ومن أرادها فليلتمسها هناك في البدائع.
ج- قالَ السرخسي في «كتاب الشِّرب» في كتابهِ المبسوط بالجزء 23/162:»اعلَمْ بِأَنَّ الشِّرْبَ هو نَصِيبٌ من الماءِ لِلْأَرَاضِيِ كانتْ أَوْ لغَيْرِهَا قَال اللَّهُ تَعَالَى {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشعراء: 155] وقال تَعَالَى {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} [القمر: 28] وَقِسْمَةُ الماءِ بين الشُّرَكَاءِ جَائِزَةٌ «. ثم يستطرد في تفصيل أحكام المياه ومكشلاتها في عصره بما يشعرك أنك بالفعل تقرأ كتاباً في علم «الحضارة والعمران» وليس فقط في أحكام فرعية تخص استعمالات المياه وكيفيات التصرف فيها.
وكلما تأملت في تفاصيلِ الاجتهادات الفقهية الخاصة بالماء وجدت أن ثمة توافقاً بين أغلبية الفقهاء على أن أول حقوق استعمال المياه هو»حق الشِّفَّةِ»؛ وقصدوا به حق بني آدم والدواب في شرب الماء لدفع العطش، وحفظ النفس من الهلاك، وكذلك الحق في استخدامه للطبخ، أو التطهر والوضوء، أو غسل الثياب ونحوها، وكلها أمور متعلقة بمقصد «حفظ النفس».
والحق الثاني في المياه هو «حق الشِّرب»، وقصدوا به «النوبة من الماء لسقي الأرضِ والزرع» وإعمارِ الأرض. وهذه الاستعمالات وغيرها لا يمكن الوفاء بها لكل بني آدم على الوجه المطلوب إلا إذا روعي فيها: مبدأُ الاستخدام الآمن وهو: أن تكون المياه صالحة للغرض المستعملة فيه، ومبدأُ الاستدامةِ؛ وذلك بالمحافظة على موارد المياه وصونها، وباستحداث الجديد منها.
المصدر: الحياة
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي