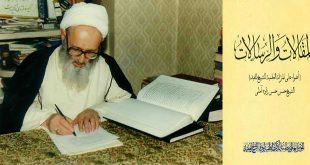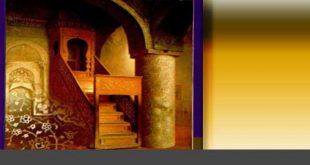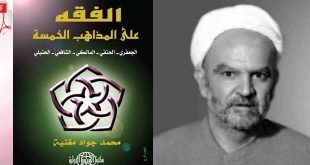هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة لكلّ وقائع الحياة ؟ أسئلة يحاول الدكتور الشيخ حيدر حبّ الله الإجابة عنها في هذا البحث مع بيان رأيه فيه في النهاية.
الاجتهاد: منذ قديم الأيّام كان هناك سؤالٌ أقلق المجتهد المسلم، وهو: كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ (راجع: الشهرستاني، الملل والنحل 1: 199).
وقد دفع ذلك ـ أحياناً ـ لتبنّي خيارات مكمّلة تسدّ النقص البادي بسبب هذا السؤال؛ فاختار بعض الفقهاء المسلمين القياس ـ مثلاً ـ؛ لكي يردموا من خلاله ثغرة تناهي النصوص، فيقومون باستنساخها في المتشابهات؛ كي يستوعب الدِّينُ تمامَ الوقائع؛
فيما لجأ فريقٌ آخر من الفقهاء والأصوليّين إلى نظريّة الثنائية التي تعتمد تارةً مبدأ العموم والإطلاق في النصوص؛ وأخرى مبدأ الأصول العمليّة، مثل: أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير، حيث قالوا بأنّ الأصول العمليّة تحدّد الوظيفة العمليّة للمكلّف في ظلّ غياب المعرفة بالوظيفة الواقعيّة القائمة في أصل الشرع، وإنّ هذه الأصول العمليّة الأربعة لها قدرة استيعاب تمام الوقائع؛ لأنّ تمام الوقائع تخضع لتقسيم عقلي حاصر تشتمله هذه الأصول الأربعة، يمكن مراجعته في كتب أصول الفقه الإمامي بالخصوص. (انظر: مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول 1: 2).
لكنّنا لو تأمّلنا قليلاً سنجد هذا السؤال (حكم المتناهي على غير المتناهي) مبنيّاً على جوابٍ محدّد عن سؤالٍ آخر افتُرض مسلَّماً واضحاً في الخلفيّات المعرفيّة للمفكِّر المسلم، وهو: هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟
إذن، فنحن أمام سؤالين جوهريّين: أصل الاستيعاب؛ وكيفيّته. وما لم نجِبْ عن هذين التساؤلين فلن نستطيع الدخول في اجتهادٍ إسلامي يغطّي الحياة الإنسانيّة، بل سيكون الفقه الفردي والمجتمعي وفقه النظريّة و.. أمام تحدٍّ كبير.
والذي يظهر من ممارسة الفقيه والمفكّر المسلم أنّ شمول الشريعة لكلّ وقائع الحياة عبارة عن مصادرة قبليّة مفروغ منها بل افترضت مسلّمة معروفة بديهية (انظر: محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن: 230؛ والصدر، المدرسة الإسلاميّة: 144). لكنّ الملفت أنّنا لم نجد دراسةً مستقلّة لهذه القاعدة المتردّدة في الكتب أو على الألسن: «ما من واقعةٍ إلاّ ولها حكم»، لم نجد لها دراسةً مفردة تُذكر، لا في علم الكلام الإسلامي، ولا في علم أصول الفقه الإسلامي، ولا في الفقه نفسه، وإنّما كان يُشار إليها هنا أو هناك، مع أنّها من الأمور التي تحتاج إلى درسٍ واع في أصول الاجتهاد الإسلامي.
ومن الغريب أن لا تُفرد مسألةٌ من هذا النوع بالبحث، مع أنّ نمطيّة علم الأصول والفقه تقوم عليها. وخاصّة أنّ هناك قولاً منسوباً بإنكار هذه القاعدة، بل يرى المحقق العراقي أن القول بالمعنى الواسع للتصويب يقوم على إنكار هذه القاعدة في الجملة (انظر: نهاية الأفكار 4 (القسم الثاني): 229 ـ 230).
ومن الضروري بدايةً أن أنبّه لأمرٍ مهمّ، وهو أنّ هناك فرقاً نسبيّاً بين موضوعين هنا: أحدهما: شموليّة الدين وتشريعاته؛ وثانيهما: ضرورة الدين والوحي والنبوّة. فقد تقول بضرورة الوحي، لكنّ هذا لا يعني شموليّته التشريعيّة، وقد يكون الوحي موجوداً وشاملاً، لكنّه لا توجد ضرورةٌ قهريّة له عقلاً، بل هو أمرٌ حَسَنٌ، لكنّه لو لم يقع لما ألحق ضرراً بشيء، ولما لزم من ذلك قبح على الله سبحانه. فهاتان المسألتان ينبغي التمييز جدّاً بينهما، وإنْ تداخلتا في بعض الحالات، فليُتنبَّه لهذا الأمر.
قاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»، رصدٌ موجز لبعض المنطلقات الاستدلاليّة
تفيد هذه القاعدة أنّ كلّ واقعةٍ أو حدث أو حالة أو أمر من أمور الحياة الإنسانية والبشريّة لها جوابٌ شرعي ديني، وهناك موقفٌ شرعي واقعي منها يشكِّل أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة، ومعها ـ أحياناً ـ أحكامٌ وضعيّة، كالصحّة والبطلان و..
ونودّ هنا أن نتناول بالبحث المختصر جدّاً هذه القاعدة، من زاوية بعض المنطلقات العقلية والعقلانية والقرآنية التي نشأت منها. وسأشير بنحو العجالة إلى عيِّنات استدلاليّة من ذلك، وهي:
1ـ شمول الدين وخاتميّته، واستدعاء التقنين التفصيلي المستوعب
أوّل الأدلّة هنا هو ما ذكره بعض العلماء من أنّ الدين الإسلامي دينٌ شاملٌ، على خلاف الديانات الأخرى، ومقتضى شموليّته أنّ كلَّ حدثٍ في الحياة فله فيه موقفٌ إيجابيّ أو سلبيّ، سواء كان هذا الحدث مما تقتضيه الطبيعة البشريّة، كالأكل والشرب، أم لم يكن كذلك (انظر: محمد تقي الحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: 230؛ وعبد الله نصري، الدين بين الحدود والتوقُّع: 72)، بل إن الخاتميّة تستدعي مفهوم الشمول التشريعي (انظر: جعفر السبحاني، مقدمة المهذب 1: 6؛ والصافي، مجموعة الرسائل 1: 174؛ ومكارم الشيرازي، مجلة فقه أهل البيت، العدد 4: 71 ـ 73).
إلا أنّ هذا الدليل ـ لو قصد قائلُه الاستدلالَ به ـ ليس سوى مصادرة على الموضوع؛ لأنّ كون الدين شاملاً تعبيرٌ آخر عن استيعاب أحكامه ومنظوماته لتمام وقائع الحياة، فما هو الدليل على شموليّته بهذا المعنى؟ فإنّ هذا هو محلّ التنازع في الموضوع. ولهذا أعتقد أنّ هذه المحاولة لا تعبِّر عن استدلالٍ أساساً، بل هي المسلَّمةُ المفروضة سَلَفاً.
2ـ حكم العقل بعدم خلوّ الوقائع، محاولة المحقِّق النراقي
ثاني الأدلّة على شمولية الشريعة هو ما ذكره المحقِّق النراقي، من أنّ العقل حاكمٌ بعدم تحقُّق واقعة إلاّ ولها حكمٌ (النراقي، عوائد الأيّام: 365؛ وأياد المنصوري، نظريّة التزاحم الحفظي: 77 ـ 79).
ولم يشرح لنا النراقي تقريب حكم العقل بذلك! وكيف كانت عملية الحكم العقل هنا! ولعلّ مراده أنّ أيّ حدثٍ من الحوادث لا يخلو إما أن يكون حَسَناً أو قبيحاً؛ أو يتساوى حُسْنه وقبحه، ولنقل: لا يخلو أيّ فعلٍ إمّا أن يكون راجحاً؛ أو مرجوحاً؛ أو تتساوى فيه الجهات، فلا هو بالراجح ولا بالمرجوح:
أـ وعلى الأوّل (رجحان الفعل) إمّا أن يكون رجحانه شديداً، بحيث يكون تركه قبيحاً، فهو الواجب، أو لا يكون كذلك، فهو المستحبّ.
ب ـ وعلى الثاني (مرجوحيّة الفعل) إمّا أن تكون مرجوحيّته شديدة، بحيث يكون الإتيان به قبيحاً، فهو الحرام، وإلاّ فهو المكروه.
ج ـ وعلى التقدير الثالث والأخير (التساوي) فهو المباح.
ولا توجد حالةٌ أخرى في علم الله تعالى. فلا بُدَّ من فرض موقفٍ إلهيّ في البَيْن، وليس إلاّ هذه، ومعه يكون الموقف الإلهيّ بالضرورة أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة.
وهذا الدليل رغم وجاهته، بَيْدَ أنه يُغفل أمراً بالغ الأهمّية، وهو أنّنا لا نبحث في واقع صفة الفعل الخارجيّ، من حيث كونه راجحاً أو مرجوحاً أو غير ذلك، ولا في علم الله تعالى بالرجحان هذا أو المرجوحيّة، وإنّما في جعل الشارع سبحانه ـ بعد هذا العلم ـ تشريعاً يتعلَّق بعهدة المكلَّفين. فليست مرحلة الثبوت، بمعنى الملاك والإرادة، كافيةً هنا، دون أن يجعل الشارع حكماً نتيجتها، فمصبّ التنازع إنّما هو في وجود حكمٍ مجعول من قبل المولى، لا في علمه وحبّه فحَسْب.
ولتقريب الفكرة نأخذ الأحكام العقليّة العملية، حيث وقع خلافٌ بين علماء أصول الفقه الإسلامي في أنّه بعد حكم العقل بحُسْن العدل هل يجب أن يحكم المولى سبحانه بوجوب العدل أو لا؟ فذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، بل إلى عدم وجود داعٍ ومبرِّر لهذا الحكم الشرعي بعد محرِّكيّة العقل نفسه؛ فيما ذهب آخرون إلى خلاف ذلك (انظر ـ لمزيدٍ من الاطّلاع ـ: الصدر، دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة، القسم الأوّل): 429)، وهذا معناه أنّ العبرة ليست في حُسْن الشيء في ذاته بقدر ما هي في صدور حكم شرعي متعلّق به، بعد كونه حَسَناً أو قبيحاً.
ومن ثمّ فمن الممكن أن يرى الله الفعل حَسَناً، لكنّه لا يُشرِّع فيه حكماً، بل يترك للبشر أن يُحاولوا اكتشاف هذا الحُسْن وهذا الرجحان في هذا الفعل، والانقياد لعقولهم فيه.
3ـ مفهوم كمال الدين، محاولة السيد السيستاني
الدليل الثالث هنا هو ما يلوح من كلمات مثل: السيّد السيستاني، من الاستناد إلى أدلّة كمال الشريعة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (المائدة: 3)، فإنّه لو لم يكن لهذه الشريعة قدرة الشمول لتمام وقائع الحياة لم تكن كاملة، وهذا ما يقع على النقيض من نصوص كمالها. (السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 292).
وكان الدكتور عابد بن محمد السفياني قد استند بشكل مركّز على آية إكمال الدين هنا في كتابه الذي طبع قبل عقود (انظر له: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية: 136 ـ 147).
ولكنّ الاستدلال بكمال الشريعة هنا يعاني هو الآخر من مشكلة، وذلك أنّ كمال الشريعة مفهومٌ له معنيان:
المعنى الأوّل: أن تكون الشريعة مغطيةً لجميع وقائع الحياة، فيكون كمالها بالنسبة إلى الواقع، فهي كاملةٌ لأنها تستوعب الواقعَ كلَّه، وهذا هو الكمال الذي ينتج هنا ـ أوّلياً ـ قاعدةَ: ما من واقعةٍ إلاّ ولها حكم.
المعنى الثاني: أن يراد وصولها إلى نقطة الغاية المرادة لها، فتكون قد كمُلت، بمعنى أنّ هناك مجموعة عناصر تكوِّن هذه الشريعة وهذا الدين، فعندما تلتئم بأجمعها يحصل كمالُ الدين، سواء كان الدين هذا يغطي كلَّ وقائع الحياة أم أُريد له من البداية أن يغطّي مساحةً محدَّدة منها؛ لمصلحةٍ في ذلك.
ولو نظرنا إلى الآية القرآنيّة المشار إليها وأمثالها لم نجد لها دلالةً واضحة على المعنى الأوّل، بل هي أقرب إلى المعنى الثاني؛ لأنّها ظاهرة في إكمال الدين، فهي تريد أن تقول: إنّني أكملت اليوم لكم الدين، فالدين بالأمس لم يكن قد كمُل بالنسبة إليكم، واليوم قد حظي بكماله، لا أنّه لم يكن قد كمُل في ذاته بالنسبة لوقائع الحياة واليوم قد كمُل بهذه الملاحظة.
وبعبارةٍ أخرى: لو فرضنا أنّ الدين الإلهيّ يغطّي مساحة 90% من مجموع وقائع الحياة، والقرآن والسنّة كانا يبرزانه ويظهرانه، ثمّ نزلت هذه الآية تفيد أنّنا أكملنا لكم الدين، فإنّ معنى ذلك أنّ التسعين في المائة هذه قد كمُلت لكم، فتصدق الآية الكريمة في هذه الحال أيضاً، ومعه لا يكون فيها ظهور في الكمال بالمعنى الأوّل المطلوب.
هذا، وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين ـ وهو الباحث الأستاذ مصطفى كريمي ـ، تَبَعاً للشيخ صادق لاريجاني، تقديمَ صيغةٍ استدلاليّة أخرى؛ للانطلاق من مفهوم كمال الدين الوارد في الآية الكريمة إلى مفهوم شموليّة الشريعة والدين، نؤجِّل التعرُّض له ومناقشته بصورة مستقلّة إنْ شاء الله تعالى.
إكمال الدين، ومقاربة الأستاذ مصطفى كريمي
هذا، وقد ذكر بعض الباحثين هنا أنّ الكمال يمكن فرض تفسيرين له، هما:
التفسير الأوّل: أن يُراد بكمال الشيء استكماله لأجزائه وأصوله وفروعه، أو هو بلوغه لهدفه النهائي. وفي هذه الحال لا يمكن فرض درجات ومراتب للكمال؛ لأنّ الشيء له حالتان: إما لا تكتمل أجزاؤه أو لا يصل إلى هدفه، وإمّا أن تكتمل أجزاؤه ويصل إلى هدفه، فلا يمكن فرض التشكيك في الكمال هنا، بل إمّا وجودٌ أو عدم.
التفسير الثاني: أن تكون للكمال هنا درجاتٌ ومراتب، فيكون الشيء كاملاً بالنسبة إلى شيءٍ آخر، وناقصاً بالنسبة إلى شيءٍ ثالث، وهذا معناه أنّ الكمال أمرٌ مشكّك نسبي. وبهذا يُفهم أيضاً معنى أنّ الإسلام أكمل الأديان.
ووفقاً لهذين التفسيرين يمكن القول بأنّ آية إكمال الدين لها دلالةٌ ما على شموليّة الإسلام ومفاهيمه وتشريعاته، وذلك من خلال بيانين:
البيان الأوّل: إذا اعتبرنا الكمال بمعنى تحقّق الأجزاء والأهداف جميعاً، انسجاماً مع التفسير الأوّل المتقدّم للكمال، فإنّ معنى ذلك أنّ البرنامج الإسلاميّ كاملٌ، فيكون الإسلام أكمل البرامج وأعمّها؛ نظراً لما للدين من دورٍ في برمجة الحياة، وهذا يعني أنّه قادرٌ على الإجابة عن جميع حاجات البشر في حدود ضرورات الكمال المفترض، مما يُلزمه بالعناية بمختلف الأبعاد الوجوديّة الإنسانيّة، ما لم يطرأ مانعٌ.
ويظهر هذا التفسير جيّداً عندما نلاحظ تكملة الآية الكريمة تتحدّث عن إتمام النّعمة الإلهية؛ لأنّ النعمة هنا معناها أنّ الله تعالى يريد أن يقول: إنّ جميع ما تتطلّبه سعادتكم قد جاء في دينكم.
ولا معنى هنا لفرض أنّ كمال الدين يكون بمعيّة دور العقل، أي إنّ علل كماله هو الأنبياء والعقل معاً، فقسمٌ من الدين يكون ويصل عبر العقل، وقسمٌ منه عبر الوحي. والسبب في رفض هذا الاحتمال أنّه يتعارض مع مفاد إكمال الدين بواسطة الأمر الإلهي؛ لأنّ ظاهر ﴿أَكْمَلْتُ﴾ هو أنّ الإكمال قد تمّ من خلال الوحي إلى الرسول| لا بواسطة العقل.
البيان الثاني: إذا كان الكمالُ صفةً وجودية تعبّر عن استغناء الموجود عن غيره إذا قيس به فسيكون مفهوم إكمال الدين في الآية الكريمة أكثر وضوحاً في إفادة شموليّة الإسلام، كما هو جليٌّ (انظر: مصطفى كريمي، الدين حدوده ومدياته، دراسة في ضوء النصّ القرآني: 274 ـ 282، ترجمة: محمد عبد الرزّاق، نشر مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط1، 2010م، بيروت).
وقفةٌ نقديّة مع مقاربة الأستاذ كريمي
هذا الطرح برمّته يعاني من ثغرات عدّة. وقد استند فيه كاتبه إلى أُطروحات الشيخ صادق لاريجاني، بل يبدو أنّه استقى أكثر أبحاثه هنا منه. ويمكن التعليق:
أوّلاً: إنّ الباحث اعتبر أنّ تفسير كمال الدين بتحقّق أجزائه وأهدافه يُنتج أكمليّة البرامج الدينية وأعمِّيتها وقدرتها على الجواب عن تمام متطلّبات الحياة. وهذه هي المصادرة عينها؛ لأنّه ما دمنا نفرض أنّ الكمال بملاحظة الأجزاء فهذا معناه ـ ضمناً ـ عدم أخذنا أيّ شيءٍ آخر غير البُنْية الداخليّة للدين.
كما أنّ فرض كمال الدين من خلال تحقّق الأهداف لا يعني شموليّة الدين، إلاّ إذا أثبتنا في المرحلة السابقة أنّ الهدف من الدين هو تنظيم جميع مرافق الحياة وتغطيتها بنفسه. والمفروض أنّنا ما نزال نبحث في أنّ الدين هل هو معنيٌّ بهذا المستوى من التغطية أو لا؟ وكأنّ الكاتب الموقّر ما زال مسكوناً بفرضيّة الشموليّة، ولهذا فسّر الكمال استتباعاً لما استكنّ في أعماق فكره.
ثانياً: لم يتّضح لماذا إذا كان الكمال الديني بملاحظة تماميّة الأجزاء والأهداف فسيكون الدين حاوياً لأكمل البرامج وأعمّها؟! وذلك أنّ المفروض أنّنا في البيان الأوّل صرفنا النظر عن عنصر المقارنة النسبيّة مع خارج الشيء، وركّزناه على بنيته الداخلية في أجزائه ومكوّناته، فلو تمّ بهذا الاعتبار فكيف نثبت أنّه صار الأكمل، وأنّه لا توجد برامج أكمل منه وأعمّ؟!
ثالثاً: إنّ الاستعانة هنا بمقطع (إتمام النعمة) من الآية الكريمة غير موفّقة في ما يبدو؛ لأنّ فاعل الإتمام هنا ليس هو الدين، وإنّما هو الله سبحانه. وهذه هي المشكلة التي تورّط فيها الكاتب المحترم؛ فهناك فرق بين أن أقول: إنّ الدين قد جاء بكلّ ما تتطلّبه سعادة الإنسان، وبين أن أقول: إنّ الله قد أعطى الإنسان كلَّ ما تتطلّبه سعادته. ففي الحالة الأولى ربما أمكن استفادة شيء،
أما في الحالة الثانية فلا؛ لأنّ الله إذا أعطى تمام النعمة فلا دليل على أنّ إعطاءه ذلك كان من خلال الدين فحَسْب، حتى نجسّر بين تمام النعمة والدين، فقد يكون أعطى ذلك بالدين والعقل والفطرة وغير ذلك، فباكتمال الدين تمّت العناصر كلّها وتحقّق إتمام النعمة، لا أنّ الدين هو تمام عناصر السعادة والنعمة. وهذا يُشبه ما يُنسب إلى القدّيس الإسكندراني تيتوس فلاويوس إكليمندس (كليمنت)(حوالي 215م) من القول: إنّ الله خاطب اليونانيّين بعقولهم، وخاطب اليهود بالوحي والنبوّة.
رابعاً: لو تنزَّلنا عن الملاحظة الثالثة، وسلَّمنا بأنّ الدين هو الذي يعطي الإنسان تمام النعمة، فهنا نسأل: ما هو المراد بتمام النعمة؟
فإذا قيل: إنّ تمام النعمة هنا هو في الفوز الأخرويّ، ولا سيَّما بناءً على ثقافة القرآن التي تركّز البُعْد الأخروي، فإنّه لا يثبت أكثر من أنّ الدين معنيٌّ بتحقيق النعمة العليا، وهي السعادة الأخرويّة. وأين هذا من شموليّة تشريعاته لتنظيم شؤون الحياة الدنيويّة؟!
وأمّا إذا قيل بأنّ تمام النعمة هو في كلّ خيرات الدنيا والآخرة فهذا واضح الفساد؛ لأنّ الله لم يتمّ على العرب المسلمين آنذاك كلّ هذه النعم بإنزال هذه الآية، أو بتنصيب الإمام علي× بناءً على ربطها بذلك؛ لأنّ الآية تفرض تحقّق تمامية النعمة خارجاً وواقعاً، لا تقديراً، ونفس تشريعات الدين لوحدها ليست كافية لتحقّق تمام النعم الدنيويّة والأخرويّة ما لم تطبّق في الواقع الخارجي.
وأما إذا قصد السعادة الدنيوية والأخروية معاً فإنّ الآية تشير إلى إتمام ذلك لا إلى تمامه. فإتمامه كان بأمرٍ وحياني، وهذا غير أنّ تمامه كان وحيانيّاً. والإتمام يتحقّق بكون الجزء الأخير وحيانياً، ولا يفترض كون تمام الأجزاء كذلك، فتأمَّلْ جيّداً.
ولعلّ المراد من إتمام النعمة هو البُعْد الديني، أي إنّ الله قد أتمّ عليكم ـ بإنزال هذه الآية، أو بتنصيب عليّ× ـ نعمَتَه المنظورة له، لا تمام نعمه، ولا بعضاً معيناً لنا منها. وهذه النعمة عنوانها العام هو صلاحهم وفوزهم، بل ربما يكون معنى النعمة هنا هو الدين نفسه.
وعليه فلا يوجد شاهدٌ في إتمام النعمة على فرضيّة الشمول في إكمال الدين.
خامساً: إنّ مناقشة الباحث لفرضيّة أنّ إكمال الدين كان بمعيّة العقل بأنّ ظاهر الآية هو الإكمال بواسطة الوحي، دون غيره، هذه المناقشة غير واضحةٍ أيضاً؛ لأنّ الإكمال وحييٌّ، لا الكمال، كما تقدّم.
يضاف إلى ذلك مشكلةٌ أخرى، وهي أنّ الله تعالى ينسب الإكمال إلى نفسه، فإذا أخذنا بالتفسير الشيعي للآية وأسباب نزولها سيكون المعنى: إنّ الله تعالى قد أكمل الدين بيوم الغدير وتنصيب عليٍّ للخلافة، وهذا التنصيب ـ وفق المعتقد الشيعي ـ لم يكن قد حصل في يوم الغدير، وإنّما تمّ الإعلان عنه في هذا اليوم؛ إذ يعتقد الشيعة بأنّ نصوص إمامة عليّ عليه السلام ممتدّة إلى يوم الدار في السنوات الأولى من البعثة النبويّة، وأنّ هذه النصوص القرآنية والحديثية استمرّت بشكلٍ متواصل، لا أنّ إمامة عليٍّ جُعلت من قبل المولى سبحانه في يوم الغدير. وهذا ما يفرض علينا اعتبار أنّ إكمال الدين ـ انسجاماً مع المعتقد الشيعي ـ لم يكن أساساً باكتمال أجزائه؛ لأنّها كانت مكتملةً، بل قوّته وكماله الواقعي، وحمايته والطمأنينة عليه.
وقد فسّر بعضُهم أو احتمل أن يُراد بالآية أنّكم كُفيتم خوف عدوّكم، وأُظهرتم عليه، تماماً كما تقول: اليوم تمّ لنا الملك، وكمل لنا ما نريد. (انظر: الزمخشري، الكشّاف 1: 593؛ والطوسي، التبيان 3: 435؛ والطبرسي، مجمع البيان 3: 274). ووفقاً لذلك كيف نجعل الاكتمال منحصراً بالوحي؟! بل ما يعزِّز هذا الاحتمال هو أنّ الآية نفسها قالت: ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: 3)، فإنّ هذا ما ينسجم مع فرضيّة الكمال الواقعي، لا الكمال البنيوي الذاتي.
وهذا كلُّه معناه أنّ الباحث هنا ملزمٌ بمزيدٍ من تفكيك الموقف وتحليله وفق الأصول العقديّة الشيعيّة.
سادساً: إنّ البيان الثاني المذكور لا ينفع شيئاً؛ لأنّه مبنيٌّ على فرضيّة تفسيرية للكمال غير ظاهرة لغةً، ولا عرفاً؛ فإنّ حذف المتعلَّق والطرف المقيس عليه الكمال من الآية يفيد أنّ الاكتمال كان له في بنيته الداخلية، ولا يظهر من الآية أنّها تريد أن تقول بأنّني اليوم جعلت الدين أكمل من أيّ برنامجٍ آخر.
وحصيلة الكلام: إنّ هذه المداخلة هنا غير واضحة بهذا المقدار.
وبهذا يظهر لنا أنّ آية إكمال الدين ومفهوم إكمال الدين لا ارتباط لهما بمفهوم شمول الدين لجميع وقائع الحياة وزواياها، وإنّما هما مرتبطان إمّا برسوخ الدين في الواقع الإنساني، بحيث لم تعُدْ هناك خشية عليه من خصومه، أو بالتئام أجزائه ومكوّناته الداخليّة، أو ببلوغه مرحلة تحقيق الهدف المرجوّ منه… وهذه المفاهيم أو الصور الثلاث لا يوجد ارتباطٌ عضويّ أو قهريّ ضروري بينها وبين مفهوم الشمول.
4 ـ قاعدة اللطف والشموليّة القانونيّة، محاولة السيّد الصدر
رابع الأدلّة هنا هو ما ذكره السيد محمد باقر الصدر، من الاستناد إلى قاعدة اللطف، حيث ذكر أنّ الله تعالى عالمٌ بجميع المصالح والمفاسد الراجعة لحياة الإنسان، وهذا معناه أنّه «من اللطف اللائق برحمته أن يشرّع للإنسان التشريع الأفضل، وفقاً لتلك المصالح والمفاسد، في شتى جوانب الحياة…». (انظر: الصدر، دروس في علم الأصول 1: 148).
وهذا الاستدلال ـ إذا قصده الصدر بجِدِّية في موضوع بحثنا ـ يحمل في طيّاته نزعةً كلامية واضحة، مبنيّة على قاعدة اللطف.
وهنا يمكن التعليق بعدّة أمور:
أوّلاً: ثمّة كلام في أصل صحّة قاعدة اللطف. ونحن لا ننكر كبرى قاعدة اللطف، مع أنّ بعض علماء العدلية أنكرها ـ كالإمام الخميني في بعض أبحاثه (انظر: أنوار الهداية 1: 257) ـ إلاّ أننا ننكر، وفاقاً للمحقّق النراقي (انظر: عوائد الأيّام: 197، 705 ـ 709)، قدرتنا على تطبيقها الموردي.
وقد ذكرنا في محلّه (انظر: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 151 ـ 152) أنّ العقل الإنساني لا يملك الأدوات المعرفيّة التي يستطيع من خلالها تحديد ما هو الأصلح هنا وهناك؛ لأنّ تشابك المصالح والمفاسد في الخلق، والأسرار الإلهيّة في العلل الغائيّة لهذا الخلق، لا تبدو واضحة للإنسان في أكثر التفاصيل. وهذا معناه أنّ بإمكان العقل أن يحكم في أصل الموضوع (اللطف)، لكنّه غير قادر على الحكم في الامتدادات الميدانيّة. فتشخيصه للأصلح يظلّ أمراً عسيراً جدّاً، تماماً كمعرفة العقل لحُسْن العدل، وصعوبة توصُّله إلى تحليل الكثير من مصاديقه.
ثانياً: واستتباعاً لما تقدّم، ما هو المانع أن يرى المولى سبحانه أنّ البشر من صالحهم أن نعطي عقولهم حقّ التشريع في مساحاتٍ محدَّدة، دون تدخُّلنا المباشر بجعل الأحكام في تلك المساحات، ولا سيَّما أنّهم كما قد يختلفون في أحكامهم العقليّة، قد اختلفوا كثيراً في فهم الأحكام الشرعيّة. فإمكانيّة الخطأ في الحالتين واردة عمليّاً. ونحن لا نريد فرض تخلّي الوحي عن دوره، بل فرض كونه لا يغطّي كلّ الوقائع، بحيث تكفينا القضيّة المهملة، ولو بنسبة الخمسة في المائة. فهل من استحالةٍ عقليّة في هذا أو حكمٍ بالقُبْح في ذلك على الله سبحانه؟! وكيف؟ يُرجى بيانه عقلانيّاً.
5ـ مرجعيّة البيانيّة القرآنيّة
الدليل الخامس لإثبات الشموليّة التشريعيّة هو الاعتماد على نصوص البيانيّة الكلّية للقرآن الكريم، حيث تُثبت هذه النصوص أنّ في القرآن بيانات ترجع لكلّ شيءٍ، وهذا ما يُثبت شموليّة القرآن الكريم وجامعيّته لكلّ ما يتصل بشؤون الإنسان والمجتمع وغير ذلك.
وهذه الآيات القرآنيّة هي:
1ـ قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْء﴾ (الأنعام: 38).
2ـ قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: 89).
3ـ قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً﴾ (الأنعام: 114).
4ـ قوله تبارك اسمه: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً﴾ (الأعراف: 52).
5ـ قوله عزَّ من قائلٍ: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (هود: 1).
6ـ قوله جلَّ جلاله: ﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (يوسف: 111).
هذه الآيات القرآنية الكريمة تنطق بإثبات عدم سقوط شيءٍ من الكتاب الكريم، وأنّه استوعب كلَّ شيءٍ، وبيّن كلَّ شيءٍ، وكان ما فيه مفصَّلاً تفصيلاً، وأنّ تفصيله تعلَّق بكلِّ شيءٍ. فبعد هذه النصوص هل يمكن الحديث عن نفي الشموليّة القرآنية، أو أنّ الدين ليس بمستوعبٍ لكلّ وقائع الحياة؟! (انظر ـ على سبيل المثال ـ: عبد الله نصري، الدين بين الحدود والتوقُّع: 65 ـ 70؛ ومصطفى كريمي، الدين: حدوده ومَدَياته: 282 ـ 292).
قراءةٌ نقديّة في الاستناد لمفهوم الكلِّية القرآنيّة
وهذا الدليل يمكن عدُّه ـ إلى جانب النصوص الحديثيّة ـ أقوى الأدلّة على مبدأ الشمول والكلِّية. ولا بُدَّ لنا هنا من بعض التعليقات:
أـ بين الكتاب التشريعي والكتاب التكويني
التعليق الأوّل: إنّ الآية الأولى ـ وفق ترتيبنا ـ لا ربط لها بموضوع بحثنا هنا، كما ذكرنا ذلك في مناسبةٍ أخرى (انظر: حيدر حبّ الله، حجِّية السنّة في الفكر الإسلامي: 235 ـ 236)؛ وذلك أنّ ملاحظة الآية بتمامها، والتي جاء هذا المقطع في سياقها، يعطي معنىً آخر للكتاب الوارد فيها، فقد قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الأنعام: 38). وهذا السياق المرتبط بالشؤون التكوينية يثير احتمالاً آخر في المراد من الكتاب؛ لأنّ كلمة (الكتاب) قد استعملت في القرآن بمعانٍ مختلفة، منها:
1ـ التوراة والإنجيل، ولهذا سُمِّي اليهود والنصارى بـ (أهل الكتاب).
2ـ القرآن الكريم، قال سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ (المائدة: 48).
بل يمكن أن يكون المعنى الأوّل والثاني راجعين إلى معنىً واحد، وهو الدين أو الشريعة أو الوحي الإلزاميّ النازل من السماء على النبيّ، فيكون القرآن أو التوراة مجرَّد تطبيقات لهذا العنوان.
3ـ اللوح المحفوظ أو أيّ شيء يشبهه في أنّه خلقٌ تكويني، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (الأنعام: 59).
بل ربما كانت هذه التعابير كنائيّةً عن ثبات العلم الإلهي المتعلّق بوقائع العالم وحتميّته.
4ـ الفرض والإلزام والتنجيز القانوني، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء: 103).
5ـ ما يرجع للتوافقات القانونيّة بين طرفين، مثل: المكاتبة مع العبد، قال تعالى: ﴿…وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آَتَاكُمْ…﴾ (النور: 33).
6ـ صحائف الأعمال يوم القيامة، مثل: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ (الإسراء: 71)، ففيها تُثبت وتحتم وتنجّز أعمال الإنسان.
وغير ذلك من المعاني والاستخدامات.
وبعضُ هذه المعاني يمكن إرجاعه إلى بعضٍ. والجامع في كلمة الكتاب في اللغة العربيّة هو التنجيز والحَتْم والثبات، ولهذا سمُّي الكتاب كتاباً؛ لأنّ المكتوب فيه ناجز وحتمي بشكلٍ أكبر في المعاملات التجاريّة وغيرها. وقد شرحنا في بعض محاضراتنا التفسيريّة مفردة الكتاب، ووجوه تصريفها في القرآن الكريم، وجذورها اللغويّة. وعليه، فلو لاحظنا التردُّد في الاحتمالات يكون الأقرب في الآية التي نحن فيها هو المعنى الثالث المتقدِّم (اللوح المحفوظ)، ولا أقلّ من عدم إمكان الجزم بظهورها في أنّ المراد من الكتاب هو القرآن الكريم.
ب ـ مفهوم (التفصيل) في توصيف القرآن الكريم
التعليق الثاني: إنّ ما ينصرف اليوم إلى ذهننا من كلمة «التفصيل» هو تناول جزئيات الأمور، واستيعاب الامتدادات والثنايا، في مقابل الإجمال، الذي بات يعني التناول العامّ لموضوعٍ ما. وهذا المعنى يوحي في آيات تفصيل الكتاب بشموليّته واستيعابه بما يخدم نظريّة الشموليّة هنا.
إلاّ أنّ الرجوع إلى اللغة والتفاسير يوضِّح للإنسان أنّ المراد بالتفصيل هو التبيين، فالمفصَّل هو المبيَّن، في مقابل المُجْمَل الذي يعني غير المبيَّن. فوصفُ القرآن بأنّه فُصّلت آياته أو فيه تفصيل يعني أنّه كتاب واضح ومبين وتبيان ونور. ولهذا فسَّروا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (فصلت: 44)، بمعنى أنّه بيّنت بلسانٍ عربي واضح نفهمه (انظر ـ على سبيل المثال ـ: الطبرسي، مجمع البيان 9: 29؛ والطبري، جامع البيان 24: 157). فليس المراد من تفصيل القرآن استيعابه وشموله، وإنّما بيانه ووضوحه ونوريّته وما شابه ذلك. ولعلّ ما بتنا نعبّر عنه بالتفصيل اليوم إنّما سمَّيناه بذلك لأنّه مصداقٌ للتبيين، وأسلوبٌ من أساليبه.
هذا كلُّه بقطع النظر عن قيد «كلّ شيء» الوارد هنا في الآية.
ج ـ مفهوم (الكلِّية) ومناسبات الحكم والموضوع
التعليق الثالث: إنّ الأخذ بحرفيّة «كلّ شيء» الوارد في الآية الثانية والسادسة هنا يستلزم اشتمال القرآن على كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ على الإطلاق من كلّ جزئيّات العلوم والمعارف، بل وكلّ الأحداث التي وقعت وتقع وستقع إلى ما بعد يوم القيامة. والآية الكريمة لا تفيد فقط اشتمال القرآن على هذا، بل بيانه له. والالتزامُ بمثل هذا اللازم غير معقول إطلاقاً، ومن ثم فلا بُدَّ من فهم «كلّ شيء» بما يخرج هذا العنوان عن الشموليّة المطلقة. وحيث إنّ المراد بكلّ شيء بعد إلغاء الكليّة المطلقة غيرُ واضحٍ لنا فنأخذ بكلِّ ما يثبت كونه قَدْراً متيقَّناً.
من هنا، نجد أنّ السياق ومناسبات الحكم والموضوع وطبيعة ما يظهر عقلائياً من القرآن و…، ذلك كلّه يفرض أنّ الكلّية هنا بلحاظ الهداية والإرشاد وتقريب الإنسان نحو الله سبحانه وما فيه صلاحه وكماله من هذه الجوانب، تماماً كما لو قال شخصٌ يضع كتاباً في الكيمياء: إنّ هذا الكتاب فيه تبيان كلّ شيء، فإنّ المناسبات تستدعي إرادته الشموليّة بملاحظة الكيمياء، لا مطلق العلوم والمعارف البشريّة.
بعد هذا كلِّه ينبغي أن يثبت لنا أنّ «الشيء» هنا، المراد تعلّق الكلِّية «كلّ» به، ما هو؟ وذلك من دليلٍ آخر خارج الآية نفسها، ولو كان حافّاً بها. فلو أثبتنا أنّ الشأن الذي تصدّى له القرآن الكريم هو البرنامج الحياتي والأخروي للإنسان، بتمام الأبعاد الوجوديّة لهذا الكائن البشري، فإنّ الآيتين هنا ستثبتان أنّ القرآن استوعب كلّ ما يتّصل بهذا الجانب.
أما لو أنّنا أثبتنا أنّ الدليل يدلّ على تصدّي القرآن لتوضيح الجانب الروحي والخُلُقي للإنسان ـ مثلاً ـ فإنّ الشموليّة لن تفيد في بعض الجوانب السياسيّة، وهكذا. وهذا ما يُنتج عدم قدرة هذه الآيات هنا على البتّ في هذا الموضوع، فلا يُستدلّ بها لوحدها، وإنّما تحتاج لمُعينات خارجيّة أو حافّة.
وما قلناه برمّته مبنيٌّ على غير النظريّة الصوفية العرفانيّة في فهم القرآن الكريم ونهج تأويله، وأنّه تعبيرٌ آخر عن العلم الإلهي المتنزِّل في النشآت، فباطنه نشأةٌ وجودية له، وليس باطناً دلاليّاً. لكنّ إثباتَ ذلك كلِّه بالدليل مشكلٌ.
د ـ نقد الفهم المنطقي لمفهوم (الكلِّية) في اللغة العربيّة
التعليق الرابع: سلَّمْنا أنّ القرآن الكريم يتصدّى لبيان كلّ شأنٍ إنسانيّ يرتبط بالحياة الإنسانيّة وبنائها ونظامها، لكنْ مع ذلك يمكن التوقُّف عند إفادة «كلّ» للكلِّية المطلقة، بحيث لا وجود لمساحةٍ محدودة ترك القرآن فيها الحديث والتصدّي.
والموجِبُ لإثارة هذا التساؤل هو استخدامات كلمة «كلّ» في الأعمّ الأغلب عند العرب، بل وفي القرآن الكريم، مثل:
1ـ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (الأنعام: 44). فهلّ حقّاً فتح عليهم أبواب كلِّ شيءٍ على الإطلاق؟!
2ـ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: 154).
3ـ قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (الأعراف: 145). فهل حقّاً في توراة موسى كلُّ شيءٍ، بحيث صارت مساويةً تماماً للقرآن الكريم في مضمونها؟!
4ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً﴾ (الكهف: 84). فهل حقّاً كان لذي القرنين سببٌ لكلّ شيءٍ على الإطلاق، بحيث كان يمكنه الذهاب في الفضاء مثلاً، أو صناعة القنبلة الذريّة؟!
5ـ قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ (النمل: 16).
6ـ قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ (النمل: 23). فهل حقّاً أنّ ملكة سبأ كان عندها من كلّ شيءٍ، أو هو تعبير كنائي أو بليغ عن الكثرة والوفرة والعظمة؟
7ـ قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آَمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُون﴾ (القصص: 57). فهل مكّة في زمن النبيّ وقبله كانت تجبى إليها ثمرات العالم كلِّه، ثمرات أفريقيا وشرق آسيا وشمال أوروبا والقارة الأمريكيّة؟!
8ـ قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: 68 ـ 69).
إنّ هذا كلَّه يدلّنا على أنّ استخدام كلمة (كلّ) في اللغة العربيّة ليس كما أراد الأصوليّون والفلاسفة في السور المنطقي للقضيّة المنطقية أن يفسِّروه، وهو الشموليّة المطلقة والموجبة الكلِّية، فهذا بيانٌ منطقيّ دخل اللغة العربيّة في القرن الثاني الهجري، وأمّا اللغة العربيّة فكثيراً ما تستخدم مثل هذه التعابير وتريد الكثرة والوفرة والمبالغة فيهما، بل هذا هو الأصل في الاستخدام عندما يكون المورد واسع المصاديق والأفراد وغير محصور، ولو أراد المتكلِّم الشموليّة المطلقة للزمه مزيدُ بيانٍ.
هـ ـ مصادرة القفز من البيانيّة الشموليّة للشريعة الشاملة
التعليق الخامس: وهو في نظري من أهمّ التعليقات عندي هنا؛ وذلك أنّ غاية ما تُثبت الآيات المستدلّ بها هنا أنّ القرآن فيه كلّ شيءٍ، لكنّها لا تثبت أنّ هناك شيئاً اسمه شريعة شاملة حتّى يتكلّم عنها القرآن. وهنا نقطة الضعف الاستدلالي بهذه الآيات.
ولتوضيح مرادي أقول: نحن افترضنا أنّ الشريعة والدين شاملين لكلّ الحياة، ثم لما قال القرآن بأنّ فيه كلّ شيء فهذا يعني أنّ فيه أحكاماً دينيّة لكلّ الحياة. مع أنّ هذا مصادرةٌ؛ وذلك أنّه من أين عرفنا أنّ الدين شاملٌ لكلّ الحياة؟ فلعلّ الدين مختصٌّ بمساحة تساوي الثمانين في المائة من الحياة مثلاً، والقرآن جاء وبيَّن كلّ شيءٍ، ومعنى أنّه بيَّن كلّ شيء هو أنّه بيّن هذه الثمانين في المائة، ثم بيّن العشرين لكنْ لا بوصفها جزءاً من الدين، بل بوصفها قِيَماً أو أحكاماً عقليّة إنسانيّة (ليست مجعولات دينيّة شرعيّة)، قام بالإخبار عنها.
فالانطلاق ـ وأرجو التأمُّل ـ من شموليّة البيان القرآني لشموليّة الشريعة مغلوطٌ، بل لا بُدَّ أوّلاً من إثبات شموليّة الشريعة، حتّى تكون شموليّة البيان القرآني مغطِّيةً للشريعة الشاملة من قَبْل، وإلاّ كان القرآن مبيِّناً للشريعة غير الشاملة، وأمّا سائر الأمور فهو يبيِّنها لا بما هي شرعٌ، بل بما هي معطيات حقّة غير دينيّة، تماماً كحديثه عن أيّ قضيّة تكوينيّة، فهل كون النحل يأكل من الأزهار مسألةً دينيّة؟ مع أنّ القرآن قد ذكرها… إلاّ بناءً على قول:
أـ مَنْ يرى أنّ كلّ العلوم دينيّةً، كما في ما يُنسب لبعض المعاصرين، مثل: أستاذنا الشيخ عبد الله جوادي الآملي.
ب ـ أو مَنْ يرى أنّ كلّ ما بُيِّن في القرآن فهو دينٌ، فلو كان أمراً سلوكيّاً (وبُيِّن حتّى ولو من دون ظهور البيان في نسبته للدين) صار شريعةً مجعولة مدخلة في العهدة والذمّة بيننا وبين الله.
لكنّ كلا هذين التوجُّهين غير صحيح؛ فليست كلُّ العلوم دينيّةً، حتّى لو كانت تبحث عن خلق الله الراجع للفعل الإلهي، فهذا لا يصيِّرها دينيّةً، والبحث في هويّة العلم الديني موضوعٌ طويل جدّاً، نَكِلُه لمباحث فلسفة الدين والكلام الجديد.
وليس كلُّ ما ذكره القرآن فهو دين أو شرع، بل قد يذكر ما هو مجعول شرعي أو عقيدة دينيّة، وقد يذكر أموراً واقعيّةً حقيقيّة (في الفعل أو التكوين) لخدمة المجعول الشرعي أو العقيدة الدينيّة، كتوصيفه السماوات والأرض. فهذا التوصيف حقٌّ، لكنّه ليس بدين.
نعم، تصديق القرآن في توصيفاته واجبٌ شرعيّ. لكنّ هذا لا يعني أنّ نفس توصيفاته هي دينٌ (أترك تفصيل هذه النقطة لمباحث فلسفة الدين والكلام الجديد، وكذلك مباحث اللغة الدينيّة عموماً، وأكتفي بهذا القَدْر). وهذا كلُّه يعني أنّ عليَّ مراجعة النصّ الديني والقرآني، فما ظهر أنّه بُيّن بوصفه تكليفاً شرعيّاً أو حقيقةً عقديّة أخذتُ به، وما لم يظهر لي ذلك لا أستطيع أن أقول ـ بنحو القاعدة المسبقة المسقطة من الأعلى ـ بأنّ القرآن قد قدَّمه حقيقةً دينيّة، حتّى لو لم أَرَه بنفسي، بل يمكن أن يكون قد قدَّمه بوصفه حقيقةً واقعيّة، أعمّ من الدينيّة وغيرها.
فبحثنا في الشريعة الشاملة التي تستبطن مفهوم جعل قانوني شرعي إلهيّ لكلّ الوقائع، لا في أصل الحسن الذاتي لهذا الفعل أو غيره في كلّ واقعةٍ، فهذا لا يلازم الجعل التشريعي، كما قلنا سابقاً في إطار مناقشة مداخلة المحقّق النراقي، فراجِعْ.
وهذا يفيد أنّ القرآن ربما تحدَّث عن أحكام العقل والتجربة الإنسانيّة، وأمرنا باتّباع عقولنا، وبيّن لنا الذي تحكم به عقولنا، دون أن يقول بأنّ حكم عقلنا هو مجعولٌ شرعيّ ديني له، بل المجعول الشرعي الوحيد هو وجوب اتّباع أحكام عقولنا القائمة على التجربة الإنسانيّة والقِيَم الفطريّة. فسلوك الإنسان يوجَّه دينيّاً من خلال النصّ والعقل معاً.
والذي نفهمه من جملة المقاربات التي تقدَّمت أنّ القرآن الكريم قد اشتمل على مجمل القضايا الدينية المرتبطة بهداية البشر إلى الله تعالى، وأنّ ذلك لا يمنع من وجود بعض الأمور التي ترك القرآن الكريم أمر بيانها إلى مصدرٍ آخر. كما لا يوجد ما يمنع من أن تكون المساحة التي يغطّيها البيان القرآني غير شاملة لكلّ تفاصيل حياة الإنسان.
نتيجة البحث
أكتفي بهذا القَدْر من الأدلّة. وغيرُها يظهر حاله ممّا ذكرناه. وبهذا يظهر أنّه لم يتوفَّر لنا دليلٌ عقلي أو عقلاني أو قرآني حاسم يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة لكلّ وقائع الحياة. وهذا ما يؤكِّد أنّ المستند العمدة هنا هو ثنائي الحديث الشريف، المؤيَّد بالإجماع أو الشهرة، والذي يحتاج لدراسةٍ أخرى مستقلّة، نتركها لمناسبةٍ ثانية
المصدر : حوارات
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي