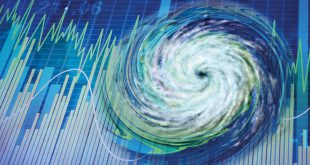الاجتهاد: اهتمت الشريعة اهتمامًا فائقاً بالمعقود عليه، في مختلف العقود المالية وغيرها. وحيث إن عقود المعاوضات تقوم على بذل كل طرف من أطراف التعاقد مالاً بهدف الحصول على مقابله من الطرف الآخر.
فقد اشترط الإسلام لصحة ذلك تحقيق الرضى من كلا الطرفين, والرضى الحقيقي لا يقوم على جهالة كبيرة بالمعقود عليه من أي من الطرفين، إذ كيف يرضى الإنسان بشيء لا يدرك أبعاده! ومن هنا كانت معلومية المعقود عليه لدى كل من الطرفين من شروط صحة المعاوضات المالية.
وفي إطار ذلك ظهرت مسألة العيوب التي قد تكون في المعقود عليه، ومعنى وجود عيب فيه أن فيه نقيصة ما قد تؤثر جوهرياً في ركن التراضي، ومن ثم تطلب الأمر دراسات فقهية مفصلة لمسألة العيوب في المعقود عليه في العقود المختلفة، حتى ما كان فيه غير مالي بطبيعته،
وهذا ما قام به الفقه الإسلامي في الماضي خير قيام، وما ينبغي أن يقوم به الفقهاء في كل عصر ومكان، حيث إن العيوب متنوعة ومتجددة لاسيما أن مرجعها العرف، وهو متغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ويترتب على ذلك خطأ تحكيم أقوال فقهية سابقة في هذا المجال على ما يحدث الآن بشكل مطلق.
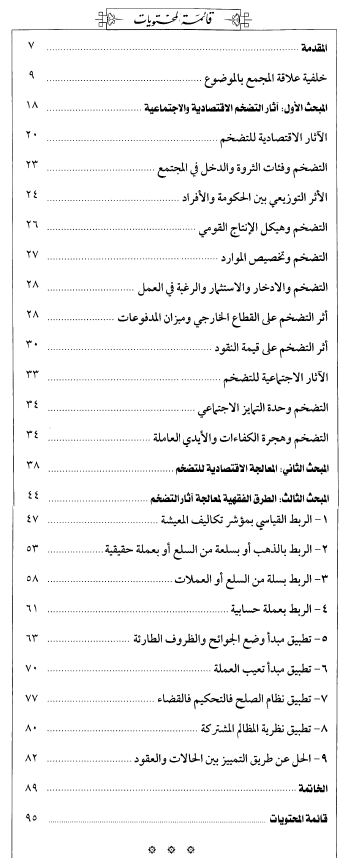
6- تطبيق مبدأ تعيّب العملة:
وحيث إننا نعيش مشكلة التضخم المستمر والجامح الذي يعرض النقود للتآكل المستمر والسريع في قيمتها الحقيقية، وحيث إن نقودنا من حيث مادتها ومن حيث الآليات الحاكمة لها مختلفة عن النقود في العصور السابقة، وحيث إنها تعد معقوداً عليه كأجر أو ثمن أو قرض أو صداق أو رأسمال …الخ في العديد من العقود، كان لابد من عناية الفقه المعاصر بما يعتري هذه النقود من عيوب، مستفيدًا في ذلك مما يقدمه الاقتصاد من معلومات فنية.
ومن هنا تجيء أهمية دراسة التضخم ومدى اعتباره عيباً في نقودنا، ومن ثم تطبيق الأحكام الشرعية حياله. وبالفعل فقد قدمت أفكار وآراء ودراسات فقهية في هذا الصدد.
ويمكن عرض الموضوع في النقاط التالية:
(أ)نقطة البدء تحديد دقيق لمفهوم العيب: وفي هذه النقطة لن نجد خلافًا يذكر بين الفقهاء المعاصرين والفقهاء القدامى، قد يكون الخلاف في المصادقات والأفراد الداخلة في الماهية والمضمون، فمثلاً قال الفقهاء إن انقطاع النقود عيب فيها، واليوم وجود هذا الشيء غير وارد، فلو حكمنا ما مضى في الحاضر لنتج عن ذلك القول بعدم وجود عيوب في نقودنا الحاضرة، مع أن حقيقة الحال قد تكون غير ذلك، ومع أن مفهوم وماهية العيب تتسع لصور أخرى قد تكون موجودة، إذن ما العيب في المعقود عليه؟
نذكر مرة ثانية بأن المعقود عليه لا يقف عند حد ما يبذله طرف من طرفي التعاقد دون الآخر وإنما هو ما يبذله كل منهما، ثمناً كان أو مثمناً، أجرًا كان أو منفعة، مهرًا كان أو بضعاً …الخ، ومما يحمد لفقهائنا أنهم تضافروا على تقديم مفهوم دقيق للعيب،
نذكر منهم:
– قال ابن رشد: “العيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والعوائد والأشخاص” (بداية المجتهد 2/152).
– وقال ابن قدامة: “فصل في معرفة العيوب: وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار، لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصًا فيها يكون عيباً، والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل هذا الشأن…” (المغني 6/235).
– وقال السرخسي: “ثم المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار، وفي كل شيء إنما يرجع إلى أهل تلك الصنعة، فما يعدونه عيباً فهو عيب يرد به، أو ما ينقص المالية فهو عيب” (المبسوط 13/106).
– وقال القونوي: “هو نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة” (أنيس الفقهاء 207).
وقال ابن حجر الهيتمي: “كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح” (تحفة المنهاج 4/357).
هذه التعاريف المختلفة تقدم لنا العناصر الأساسية في حقيقة ومفهوم العيب، فهو نقص يلحق الشيء على خلاف خلقته، له أثره المالي، فهو ينقص مالية هذا الشيء الذي لحق به، والمرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص.
لو طبقنا هذه الخصائص على التضخم الحادث في نقودنا المعاصرة، فإننا نجدها منطبقة فيه، فعندما تصاب نقود بالتضخم فإنها تصبح نقوداً مريضة، فالتضخم في عرف أهل الاختصاص “الاقتصاديين” مرض، ثم إنه عرض مغير لفطرة النقود الطبيعية، فالجميع يدرك أن النقود من حيث الفطرة هي معايير ومقاييس للقيم، وأن الأصل فيها أن تكون مستقرة القيمة.
إذن تدهور قيمتها وتقلبها الكبير خروج بها عن أصل فطرتها، ثم إنها من حيث الشرع يجب أن تكون كذلك، ومن ثم فإن التدهور المستمر في قيمتها يعد خروجاً بها كذلك على الخلق الشرعي، كما قال ابن رشد، ثم إنه ينقص مالية النقود، ويؤثر بالتالي في مقدار المقابل لها،
فعشرون جنيهاً مصرياً منذ عشرين عاماً ماليتها أكبر بكثير من عشرين جنيهاً مصرياً اليوم، وما تقابل به العشرون جنيهاً سابقاً من سلع وخدمات أكبر بكثير مما يقابلها اليوم من هذه السلع والخدمات، بمعنى أن الخلل الذي طرأ عليها أثر في ماليتها، وفيما يقابلها من سلع، ومعنى ذلك أن التضخم تحقق فيه كل من النقص عن أصل الخلقة، وأن هذا النقص أثر بالنقص أيضاً في ثمنها أو في قيمتها أو مقابلها، وأن ذلك باعتراف كل أهل الاختصاص وهم الاقتصاديون.
إذن التضخم عيب شرعي في النقود، ولا يعكر على ذلك ما ورد في كتب الفقه على لسان بعض الفقهاء من أن رخص النقد وغلاءه ليس عيباً.
فالوضع والظروف والملابسات مختلفة تماماً، سواء نظرنا إلى مادة النقود أو تنظيمها، والكثير من الفقهاء المعاصرين يرون ذلك، وإن كان البعض منهم تحت التأثير القوي لمقولات بعض الفقهاء السابقين حيال غلاء النقد ورخصه لا يرون التضخم عيباً في النقود، مع أن الفقهاء القدامى هم الذين قالوا لنا إن المرجع في ذلك ليس إلى الفقهاء وإنما إلى أهل الاختصاص (الاقتصاديون)، فالفقيه الجيد لا يقول بادئ ذي بدء هذا عيب وهذا ليس عيباً، وإنما يعتمد في ذلك على أهل الخبرة؛ الأطباء، المهندسون، والاقتصاديون … الخ.
(ب) هناك زاوية جديرة بالاهتمام وهي أن الحديث الفقهي المفصل والمسهب في العيوب انصرف أساساً إلى العيوب التي تكون قائمة بالمعقود عليه عند التعاقد، لكنها غير معلومة لكلا الطرفين أو أحدهما، ثم ظهرت بعد ذلك. فإلى أي مدى ينطبق ذلك على ما نحن فيه من تضخم؟ الواضح أننا نتحدث عن تضخم متوقع وغير معلوم ولا قائم لدى العقد.
ولو كان موجودًا ومعلوماً عند التعاقد كان كعيب معلوم وموجود لدى المتعاقدين، وهذا لا كلام لأحد المتعاقدين فيه، فقد دخل على علم به وقد رضي به.
وغالباً ما يكون قد كيّف موقفه معه, ومع ذلك يمكن وجود تضخم قائم وموجود، ولكنه غير معلوم، على الأقل لأحد الطرفين، كما إذا تعاقد وطني مع أجنبي يجهل أوضاع العملة الوطنية، لكننا سنغض النظر عن تلك الصور التي قد لا تكون شائعة.
وإذن فمازال الإشكال قائماً، حديث الفقهاء القدامى كان عن عيوب موجودة عند العقد غير معروفة، ولكننا الآن حيال عيب يطرأ بعد العقد وقبل القبض، فهل يأخذ حكم العيب القديم أم يحتاج إلى اجتهاد فقهي معاصر؟ لا حرج من الاجتهاد، ومع ذلك فقد تحدث بعض الفقهاء القدامى عن حكم العيوب التي تحدث في المعقود عليه قبل قبضه، وألحقوها تماماً بالعيوب التي كانت قائمة قبل التعاقد. ومعنى ذلك تسهيل المهمة على فقهائنا المعاصرين.
يقول السرخسي – رحمه الله: “إذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وقيمتها ألف درهم فولدت عند البائع بنتًا تساوي ألف درهم، ونقصت الولادة الأم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء تركها لأنها تعيبت في ضمان البائع، والعيب الحادث قبل القبض فيها يجعل كالمقترن بالعقد” (المبسوط 13/186).
فالعبارة واضحة تماماً؛ حيث تجعل العيب الذي يحدث في المعقود عليه قبل قبضه يعامل معاملة العيب المقترن بالعقد. وبتطبيق ذلك على موضوعنا لا يكلفنا إلا معرفة ما قاله الفقهاء قديماً حيال ما يمكن عمله مع العيوب.
(ج) لو قلنا بالحل عن طريق تطبيق مبدأ العيب فإننا نواجَه ببعض المسائل، منها: كيف يتم العمل؟ وهل يمكن اشتراط الرجوع بالعيب عند التعاقد أو اشتراط البراءة منه؟ أما كيفية العمل فإنه عند السداد ينظر في وضع التضخم، فإن كان، فإننا نتعرف على مقدار النقص في قيمة النقود، وعند ذلك يجري التعويض عن العيب في ضوء ما نأخذ به من مجرد وجود تضخم أو تضخم بمقدار معين.
أما عن اشتراط العمل به أو إلغائه إذا وجد فهي مسألة متروكة لتبادل الرأي الفقهي فيها. واعتقد أن المسألة خلافية(1). كذلك من المسائل المثارة ألا يوقع ذلك في الربا، حيث قد ردّ أكثر مما اتفق عليه؟ وهذه المسألة هي الأخرى خاضعة للبحث الفقهي، وإن كان بعض الفقهاء صرح بأن الزيادة هي تعويض عن عيب، وهذا ليس من باب الربا.
وقدم البعض مخرجاً من ذلك بأنه بدلاً من اشتراط العمل بمبدأ العيب إذا ما طرأ تضخم، وبعداً عن الربا والغرر يتفق في العقد على التحكيم الشرعي في حال التضخم، بحيث إذا حصل، نظر فيه المحكمون فإن ثبت عندهم عالجوا الأمر بما يناسبه بتقدير القيمة العادلة للانخفاض الذي طرأ، وهذا لا يدخلنا في باب الربا ولا الغرر والجهالة، لأنه من باب الإصلاح بين طرفين متنازعين. ولو اعتبرنا ذلك شرطاً فإنه يقتضيه العقد، أو مما فيه مصلحة لأحد الطرفين، ولا يصطدم بحكم شرعي ولا ينافي مقتضى العقد.
7- تطبيق نظام الصلح.. فالتحكيم.. فالقضاء:
من المسَلَّم به أنه في حال حدوث تضخم غير متوقع وفي بعض الحالات حال تراكم التضخم المتوقع فإن ضرراً يلحق بصاحب الحق أو الدَّين النقدي المؤجل، ومن المسلّم به أيضاً أن الطرف الثاني لم يكن هو المتسبب في هذا التضخم الذي ألحق الضرر بالطرف الأول، ومن جهة ثانية فإن تحميل هذا الطرف إزالة الضرر الذي لحق بالطرف الآخر هو عند الكثيرين إزالة ضرر بضرر، ثم إن هذا التضخم قد يكون من الارتفاع بحيث يتعذر على هذا الطرف الثاني تحمله لرفع أعبائه عن الطرف الآخر.
من هنا طرح التفكير في مواجهة الموقف من خلال الصلح بين الطرفين، فإن لم يكن فيلجأ إلى نظام التحكيم، فإن لم يكن فعليهما باللجوء إلى القضاء.
(أ) الرأي حول خضوع الطرفين في حال التضخم للمصالحة: قال كثير من الفقهاء يجوز الصلح على ما يتفق ويتراضى عليه الطرفان، ولا يعتبر هذا الصلح من قبيل الربا، وليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، وإنما هو صلح بين طرفين متنازعين، كل طرف يتمسك بدعوى حقه قبل الآخر، ثم زال ما بينهما من خلال وإشكال فيما اصطلحا عليه.
واستأنس بعض من قال بذلك بمواقف سابقة لبعض الفقهاء؛ كما ورد في رسالة تنبيه الرقود لابن عابدين(2)، وقد أشار إليه وأقره الامام السيوطي(3). وهكذا لو وقع هذا الصلح فهو ملزم للطرفين، وهو من قبيل صلح الإقرار المعترف به لدى العلماء.
(ب) كيفية العمل به: هناك احتمالان:
الأول عدم اشتراط ذلك الصلح في العقد، ومعنى ذلك أن العقد أبرم عادياً خالياً من أي شرط أو اتفاق، وعند السداد كان التضخم قد وقع، وهو تضخم كبير بأي معيار يتفق عليه للكبر. وتنازع الطرفان ثم لجآ إلى الصلح، بحيث تراضيا على تحمل كل منهما لنسبة من التضخم الذي وقع وتحدد من خلال معيار من المعايير المتعارف عليها.
والأسلوب الثاني أن يشترطا في العقد اللجوء إلى الصلح عند حدوث التضخم بمعدل معين قبل موعد التسديد، ثم يجري العمل عند السداد كما ذكرنا في الأسلوب الأول. هذا الأسلوب أقره بعض العلماء. وقد يحدث الاتفاق في العقد على أنه إذا لم يمكن فض النزاع ودياً فيرجع إلى التحكيم، فالقضاء، وهذا أيضاً أجازه بعض العلماء.
ولكن بعض العلماء له اعتراض على الصلح هنا، وخاصة المشروط، حيث سيأخذ صاحب الحق أكثر من حقه، وفي ذلك ربا. والحق أن الكثير من الفقهاء لا يرى ذلك، والمسألة بحاجة إلى تحرير فقهي جيد، حيث إن الصلح من المخارج التي يمكن أن تكون أفضل من غيرها شرعاً واقتصاداً، حيث لا يتطلب مزيداً من الجهد والمال والوقت، ويهيئ السبيل إلى المزيد من استقرار المعاملات ونموها.
8- تطبيق نظرية المظالم المشتركة:
التضخم آفة قومية لا تصيب فرداً بعينه ولا يحدثها فرد بعينه. ويرى بعض الفقهاء أن أفضل مواجهة لآثارها هي التي تضع هذه الحقيقة نصب أعينها. وكما هي عادة فقهائنا المعاصرين – وهي عادة حميدة من حيث الأصل – الرجوع إلى كتب الفقه، والبحث والتنقيب فيها عندما يكونون بصدد إبداء الرأي حيال مشكلة من المشكلات المعاصرة.
فقد قام بعض العلماء بذلك وعثر على ما يعرف في بعض الكتب بالمظالم المشتركة أو النوائب العامة، وكيفية العمل الشرعي حيالها(4). وحيث إن التضخم قد اعتبر نائبة عامة فقد قالوا بتطبيق ما قيل قديماً على طرفي التعاقد حالياً، من اقتسام المضار وتوزيعها بين الطرفين بالتساوي.
أمثلة النوائب العامة والمظالم المشتركة ومدى اعتبار التضخم المعاصر مثالاً من أمثلتها، مثل الفقهاء القدامى الذين تناولوا هذا الموضوع لهذه النوائب والمظالم بالكلف السلطانية “الضرائب” التي كانت توضع على الناس خارج الفرائض المالية الشرعية، وأحياناً كانت تفرض مجملة، أي مبلغ كلي مقطوع على أهل القرية.
وهنا قال ابن تيمية – رحمه الله – يجب قسمتها بالعدل بين أهل القرية، ولا يجوز لأحد التهرب منها مادام ما عليه سيوزع على غيره، لأنه عند ذلك سيكون قد ظلم غيره. هذا أحد الأمثلة البارزة لما يسمى بالمظالم المشتركة، وبقية الأمثلة لا تخرج عن هذا النطاق، فهي أموال تفرض بالقوة على جماعة من الناس، ومن يتهرب من دفع حصته منها تدفعها بقية الجماعة.
فهل للتضخم الحاضر بهذه المظالم وبهذه الأمثلة وجه شبه وبالتالي يعامل معاملتها؟ عند إمعان النظر لا يوجد وجه شبه قريب ومباشر، لكنه قد يشبهها في كونه حديثاً قهرياً خارج إرادة الطرفين، قد يكون في الغالب مصدره الدولة، كما أن الكلف السلطانية مصدرها الدولة، ثم إنه يجحف إجمالاً بأموال الناس. لكنه يفترق عنها من وجوه عديدة، فهو من جهة لا يلحق ضرراً بكل الناس، فالبعض يضار بقوة، والبعض يكون ضرره خفيفاً، والبعض قد لا يضار، والبعض يستفيد بقوة.
إذن مواقف الناس المالية من جراء التضخم متفاوتة تماماً، ولو كانت متماثلة لما كان هناك داعٍ على الإطلاق للحديث عن الربط القياسي، وعلاج الآثار التوزيعية للتضخم. ثم إن موقف الطرفين في التعاقد الآجل أمام هذه النكبة العامة من خلال ما قدمه كل منهما ليس متساوياً.
ولا يستطيع أحد أن يدعي أن الضرر الذي لحق المدين – إن كان قد لحقه ضرر – مساوٍ من بعيد أو قريب للضرر الذي لحق الدائن، حتى تقتضي العدالة تحميلهما معاً إجبارياً مشاطرة ما حدث من ضرر، وهل عند حدوث الضرر انصرف شطره إلى هذا وشطره إلى ذاك، ومن ثم فإن الإخلال بذلك يعد ظلماً؟ لهذه الاعتبارات ولغيرها قد لا يكون لتطبيق نظرية المظالم المشتركة على موضوعنا درجة كبيرة من القبول رغم أن فكرة اقتسام هذه المضار بصورة أو بأخرى واردة، لكن ليس من قبيل المظالم المشتركة، وإنما من قبيل الظروف الطارئة أو المصالحة …الخ.
والأمر متروك لما يراه الفقهاء الأجلاء، مع إعادة التنبيه بأننا في حالة التضخم أمام دين في ضمان المشتري أو المقترض أو غيرهما، وليس الحال كذلك في حالة المظالم المشتركة، فنحن أمام عبء وقع على طرفين أو أكثر ظلماً، يريد أحدهما أن يدفعه عن نفسه ومن ثم يتحمله الطرف الثاني.
9- الحل عن طريق التمييز بين الحالات والعقود:
نظراً لتعدد الحالات والملابسات، ولتعدد أنواع العقود الآجلة وتنوع طباعها. فهل الأمثل فقهياً أخذها كلها كشيء واحد وتطبيق ما يطرح من حل عليها كلها دون تمييز؟ أم الأمثل التمييز والتفريق بين كل حالة وأخرى وكل عقد وآخر؟ أو على الأقل مراعاة ما قد يكون هنالك من فروق ضخمة بارزة؟
بعض العلماء لا يرى التمييز ولا التفريق، لأن ذلك يفتح أبواباً لممارسات قد تكون خاطئة، ولأن العدالة تقتضي المعاملة الواحدة للجميع مادمنا أمام تضخم، إما بمراعاته أو عدم مراعاته.
لكن البعض يرى التمييز. وأبرز مواطن التمييز ما يلي:
(أ) المعاوضات والأمانات: ذهب فريق من العلماء إلى أن محل النقاش والحوار حيال مسألة التضخم ينبغي أن يكون فقط في عقود المعاوضات، مثل البيوع والإجارات والقروض… الخ. ويستبعد من ذلك عقود الأمانات، مثل المضاربات؛ إذ في الأولى نجد طرفين مستقلين وعوضين متقابلين، ومن ثم فمن المتصور والممكن حدوث ضرر لطرف دون الآخر، إذن فالأمر قد يستدعي النظر لإزالة هذا الضرر، لكن في الأمانات الأمر مختلف، إن الطرفين بمثابة طرف واحد، فالمضارب مثلاً أو المودع لديه هو بمثابة رب المال أو المودع، ومعنى ذلك أنه ليس لرب المال إلا مثل ماله الذي دفعه ولا يعتد بتغيير قيمته في حال المضاربة، وهناك نصوص فقهية تؤيد هذا التمييز.
ومع ذلك فإن البعض لا يرى هذا التمييز، بل ويصرح بأنه ينبغي أن يجري الربط في الأمانات عند حدوث التضخم تماماً بتمام كما يجري في الديون المضمونة، تحقيقاً للعدالة، وحتى لا يظلم رب المال بعودة ماله ناقصاً، ويأخذ المضارب أموالاً هي ليست في الحقيقة أرباحاً تجارية بعمل يده.
وهذا مثال توضيحي: لنفرض أن رجلاً دفع مائة جنيه مضاربة، وفي نهاية العام كان الربح 20 جنيها تقسم مناصفة، وكان معدل التضخم 20%، فمعنى ذلك أن صاحب المال قد حصل في نهاية العام على 110، وأن المضارب قد حصل على 10 جنيهات. وإذا تأملنا جلياً لوجدنا أنه من حيث المالية والقيمة الحقيقية فإن رأس المال الذي عاد لصاحبه قد نقص تقريبًا 20%، أي كأنه ثمانون جنيها، يضاف إليها 10 لتصبح تسعين جنيها.
معنى ذلك أنه لم يسلم له رأسماله حقيقة، فكيف يكون هناك ربح ويوزع.. وما العمل إذن؟ هل يأخذ رب المال كل المبلغ وهو 120 جنيهاً بحجة أن هذا هو في الحقيقة ما دفعه من قبل؟ وهل هذا عدل في حق المضارب الذي عمل طول العام وتحمل ما تحمل من جهد ومشقة وكلفة؟ بل وحقق – من الناحية الواقعية الملموسة – ربحاً؟.
هل من المستساغ أن يقال له، بعد كل ذلك، إن هذا ربح تضخمي أو صوري محض، وليس لك أي حق فيه؟ ومن الذي حول المال النقدي وهو المائة إلى سلع تستفيد من التضخم وترتفع أسعارها؟ ومن الذي تسبب في تحقيق 20 جنيهاً ربحاً؟ إذن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق.
(ب) البيع والقرض: يذهب بعض الفقهاء إلى قيام معاملة مغايرة لكل من البيوع والقروض حيال التضخم غير المتوقع.
فمن الممكن مراعاة التضخم في ديون البيع، لكن ذلك مرفوض في ديون القرض، للنصوص الصريحة الواردة فيه، وابتعاداً عن الربا وشبهه، إضافة إلى أن القرض عقد إرفاق ومعاونة، عكس البيع، فهو عقد مشاحة ومكايسة، والبعض لا يرى هذه التفرقة ويرى أن تعامل القروض نفس المعاملة التي تعامل بها البيوع الآجلة، بل قد يكون من الأولى رعايتها بدرجة أكبر، حيث إن الدائن في البيع الآجل من حقه أن يراعي في الثمن ما قد يحدث مستقبلاً ويحتاط له، لكن المقرض لا يسوغ له ذلك، وإلا فهو الربا الجلي، ولم تعد القروض في أيامنا هذه في كثير من الحالات قروض إرفاق وإحسان، وبفرض أنها كذلك في بعض الصور فليس من المطلوب أن يكافأ المحسن بالضرر، وليس المطلوب أن يحسَن إليه، وإنما المطلوب ألا يضار. وعموماً فإن الخلاف قوي حيال هذه القضية.
(ج) القروض والودائع المصرفية الجارية: التكييف الشرعي الصحيح وكذلك التكييف القانوني والاقتصادي للودائع المصرفية الجارية أنها قروض من صاحبها للمصرف، ومن ثم فتجري عليها أحكام القروض، وخاصة ما يتعلق بضمانها وعدم جواز الحصول على زيادة مشروطة أو متعارف عليها بالنسبة لها.
معنى ذلك أن ما يجري على القروض حيال مسألة التضخم يجري عليها، سواء قلنا بالربط أو بالصلح أو بغير ذلك، هذا ما يتمشى مع الأصول الشرعية. لكن البعض ذهب إلى التمييز بينهما في المعاملة هنا استحساناً، ناظراً إلى ما هنالك من خلاف بينهما يراه جوهرياً مؤثراً في المعالجة، وهو اختلافهما في مدى حرية صاحب القرض أو الوديعة في استرداد حقه عندما يريد، فليس ذلك من حقه القروض العادية، لكن ذلك حقه في الودائع المصرفية الجارية، ومعنى ذلك أنه كان بوسع صاحب الوديعة أن يسحبها ويتصرف بها كيف يشاء في الوقت الذي يريده،
وبالتالي فقد كان بإمكانه التحصن ضد التضخم، ولم يمنعه المصرف من ذلك، لكنه بمطلق حريته لم يفعل، فكيف يجيء ويطالب بالتعويض عما ألحقه التضخم به من مضار؟ بينما ذلك غير متأتٍ في القروض العادية، حيث لها أجل محدد، ومن الواضح أن هذا الاختلاف هو اختلاف فعلي واقعي، وهو من جهة أخرى اختلاف مؤثر في القدرة على التصرفات من قِبل أصحاب الأموال، ومن ثم فقد يكون للتمييز وجه قوي.
(د) المدين المماطل والمدين غير المماطل: هناك من يقول بالتمييز بين الحالتين، بحيث إن جاز القول بمراعاة التضخم بأي شكل من الأشكال بالنسبة للمدين غير المماطل، فإن ذلك مستبعد بالنسبة للمدين غير المماطل، كما استبعد وضع الجائحة عن المشتري الذي فرط في جني ثمرته أو اقتلاع زرعه.
ومعنى القول بالتمييز هنا أنه إن ساغ استبعاد تحميل المدين غير المماطل الضرر أو بعضه الواقع على دائنه من جراء التضخم فإنه من غير المستبعد أن يحمّل المدين المماطل بذلك، وقد استأنس من يقول بذلك ببعض المواقف الفقهية السابقة.
وأعتقد أن الخلاف إذا كان قوياً حيال المدين غير المماطل وما يمكن العمل معه عند حدوث التضخم، فالخلاف – إن كان – حيال المدين المماطل أقل حدة، حيث الكثرة من الآراء على تحميله ما نجم من التضخم من ضرر للدائن. ومع ذلك فهناك من لا يرى ذلك.
(هـ) الربط العام والربط الانتقائي والربط الإجباري والربط الاختياري: بعض الأفكار ذهبت إلى أهمية التفرقة والتمييز بين ربط وآخر، وفضلت تغيير المواقف الشرعية والاقتصادية بتغير أنواعها، وذهبت إلى تفضيل القول بالربط في بعضها وعدمه في بعضها الآخر، لكننا لسنا أمام اتفاق في ذلك.
فمثلاً يرى البعض الربط الانتقائي، بينما يرى البعض الآخر أنه إن كان ولابد فليكن ربطاً عاماً.. وعموماً فإن الوصول إلى موقف مقبول حيال ذلك ليس من الصعوبة الكبيرة.
الخاتمة
بعد هذا العرض لملف هذه القضية، نجد في الكثير من الدول التي كانت منذ فترة تقع تحت وطأة تضخم جامح نجد اليوم ضبطاً قوياً لهذا التضخم ونزولاً مستمراً في معدلاته، ومع هذه التراجع في التضخم المتوقع أو المعتاد، ظهر في الآونة الأخيرة نوع آخر من التضخم المصاحب أو المسبوق بتدهور حاد في قيم العملات، والذي يحل كالعاصفة المفاجئة، حيث خلال أيام معدودات تفقد العملات معظم قيمتها نتيجة مضاربات خارجية وعوامل أخرى، وأعتقد أن هذا اللون الذي يحدث فجأة وبقوة بالغة يعد من الكوارث الاقتصادية التي تفوق في قوتها الكوارث الطبيعية، ولا ينجو منه أحد، وهذا ما يجعلنا نوليه اهتماماً قوياً عند تقديم القرارات والتوصيات المجمعية.
النتائج
نبرز هنا أهم النتائج المستخلصة من الدراسة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً: ليس هناك خلاف حول ماهية وأهمية الحلول الواقية من التضخم والتقلبات المستمرة في قيم العملات الحقيقية والخارجية، فالكل مجمع على أهميتها وضرورة أخذ المسئولين بها، والمشكلة فيها أنها حلول طويلة الأجل لا تتحقق بين يوم وليلة، ثم إنها تتطلب إحداث العديد من التغيرات الجوهرية في السياسات الاقتصادية وغيرها.
ثانياً: تبقى الحلول العلاجية للآثار التوزيعية للتضخم وتغير قيمة العملة، وهي حلول تتميز بالسرعة من جهة، والقابلية للتطبيق بدرجة أكبر من جهة ثانية، إضافة إلى ما لها من خاصية الإسعاف ورفع المضار بدرجة مناسبة من السرعة بدلاً من ترك الحال على ما هو عليه إلى أن يتم إنجاز حلول دائمة،
وجميع الأفكار المطروحة حيال هذه الحلول تلتقي على أنها ليست حلاً للمشكلة، بل هي علاج لبعض آثارها، ومعنى ذلك ضرورة الوعي بأهمية القيام بالحلول الجذرية بشكل متواز مع هذه الحلول، وألا يؤدي العمل بها إلى عرقلة أو عدم الاهتمام بالحلول الدائمة.
ثالثاً: من الصعوبة بمكان تقديم علاج شرعي لآثار التضخم وتدهور قيم العملات، وخاصة ما يتعلق منها بما يلحق بأطراف التعاقدات المالية الآجلة، ومرجع ذلك أن المشكلة بالغة التعقيد؛ لما يكتنفها ويحيط بها ويؤثر فيها من عوامل واعتبارات متعددة متعارضة، فهناك الربا وهناك الغرر والجهالة، وهناك العدالة وهناك الضرر،
وهناك مآلات الأمور من الناحية الاقتصادية والناحية الشرعية، وهناك الطبيعة الفريدة للنقود الورقية المعاصرة وللأنظمة النقدية السائدة المغايرة تمام المغايرة للأنظمة النقدية التي كانت سائدة من قبل، وهناك النصوص العامة الحاملة للتفسيرات والتأويلات، وقد اعترف بهذه الصعوبة صراحة بعض الفقهاء القدامى، فيقول الإمام الرهوني “إنها مسألة اضطرب فيها المتقدمون والمتأخرون“(5)، ويقول ابن عابدين: “إنها مسألة ذات اشتباه، وهذا غاية ما ظهر له فيها“(6).
وعلى الرغم مما لهذه المشكلة من هذه التعقيدات، فإن لها وجهاً ميسراً يتمثل في كونها باتفاق الفقهاء، وخاصة المعاصرين، مسألة اجتهادية، وبالتالي فهناك مجال فسيح لإعمال العقل، وهناك ساحة متسعة للرأي والرأي الآخر، ولا شك أن ذلك ييسر المهمة أمام فقهاء العصر،
ومن جوانب عظمة التشريع الإسلامي أنه حيال هذا اللون من القضايا يقدم العديد من المخارج والحلول التي يمكن من خلال بعضها على الأقل التعامل الفعال مع هذه المشكلات، لكن ذلك يبقى رهين التصرف الصحيح مع هذه المخارج وتوظيفها التوظيف الجيد، ولا يقوى على ذلك إلا من رزقه الله تعالى صحة فهم وبُعد نظر.
رابعاً: واضح أننا أمام حلول عديدة، وبالرغم أن كلاً منها له مؤيداته فإنها ليست على درجة واحدة من الصواب، وليست على مسافة واحدة من مقصود الشريعة ومبناها، فمنها ما هو أبعد ما يكون عن ذلك، ومنها ما هو أقرب ما يكون من ذلك. ومن الضروري في ضوء ذلك النظر في هذه الحلول نظرة تقويمية بهدف ترتيبها تبعاً لدرجة اقترابها من الحق والصواب بقدر الإمكان،
وأمامنا في ذلك معياران: معيار كمي يتمثل في عدد من قال بهذا الحل أو ذاك في مقابلة من رفضه أو في مقابلة كل المشاركين، فحلٌّ يقول به سبعون في المائة أفضل من حل يقول به خمسون في المائة، ومعيار كيفي أو نوعي يتمثل فيما قد يكون لبعض الحلول من اعتبارات قوية، وإن خفيت على الكثير، مما يجعل الحل وإن لم يقل به الكثير لكنه معتمد على مبررات قوية،
ولقد عودنا الفقه على أنه ليس بالضرورة أن يكون رأي الجمهور أو الرأي المشهور هو الرأي الراجح، وبالطبع فإن هذين المعيارين قد يتفقان في الجهة ويسيران سوياً وقد يختلفان، ومن فضل الله أنه في موضوعنا هذا – وحسب فهمي – نجد المعيارين متوافقين.
خامساً: حاولت قدر جهدي واعتماداً على ما تحت يدي من أوراق وما عايشته من محاورات ولقاءات أن أحصر المشاركين في هذا الموضوع وأحدد موقف كل منهم،
وفي ضوء ذلك أستطيع القول بقدر من الثقة والاطمئنان بما يلي:
1- الحل عن طريق الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة لا يحظى بموافقة الأغلبية لا من الفقهاء ولا من الاقتصاديين، إضافة إلى ما عليه من ملاحظات اقتصادية وشرعية ليس من السهل التغاضي عنها، وعليه فمن الأفضل تجاوزه والنظر في غيره، على الأقل مراعاةً للخلاف من جهة، واتباعاً لما هو أولى وأفضل من جهة ثانية.
2- الحل عن طريق الربط غير القياسي (بعملة أو سلعة أو سلة منهما) هو الآخر لم يحظ بقبول الأغلبية من الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين، وإن كان عدد من يقبله منهما أكبر من عدد من قبل الحل عن طريق الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، ويلاحظ أن الاعتبارات الشرعية وراء عدم قبول هذا الحل كانت أكثر بروزاً من الاعتبارات الاقتصادية. وأرى أنه من الأفضل تجاوزه هو الآخر، لأن الخلاف بشأنه مازال قوياً، ولوجود ما هو أولى وأفضل منه.
3- الحل عن طريق تطبيق مبدأ وضع الجوائح أو طريق تطبيق مبدأ العيب يحظى بقبول غالبية الفقهاء والاقتصاديين، وليس عليه إلا اعتراضات قليلة هينة، ومن ثم فهو من الحلول القابلة للأخذ بها.
4- الحل عن طريق “تنصيف” الضرر أو ما سماه البعض تطبيق نظام المظالم المشتركة، لا يحظى إلا بقبول قلة من الفقهاء، وأهم نقاط الضعف فيه هي الإلزام بتحميل الطرفين معاً الضرر وبنسبة متساوية، مع أن الملابسات المحيطة قد لا تؤيد ذلك.
5- الحل عن طريق الصلح أولاً، فإن لم يكن فالتحكيم ثانياً، فإن لم يكن فالقضاء ثالثاً، يحظى بقبول أكبر عدد من الفقهاء والاقتصاديين، ومن ثم فهو يعد أفضل الحلول على الإطلاق.
6- وفي كل الحالات ظهر اتجاه للتمييز والتفرقة في الأحكام بين الحالات المختلفة والعقود المتغايرة بحيث لا يعمم حكم على الكل، بل يفرد لكل حالة حكم يناسبها ومع ذلك فلم يسلم هذا الاتجاه بدوره من معارضة تشتد وتقوى في حالات وتهون في حالات أخرى.
المراجع
(1) المبسوط: 13/91.
(2) ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، رسائل ابن عابديند 2/66.
(3) الحاوي للفتاوي، دار الكتب العلمية، ج2، ص13، بيروت 1975.
(4) من أوسع ما قيل فيها قديماً ما قاله الشيخ ابن تيمية – رحمه الله – في رسالته في المظالم المشتركة والمذكورة في فتاواه (30/237).
(5) الرهوني، حاشية الرهوني 5/20.
(6) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت 1966م، 4/538.
أستاذ الاقتصاد – عميد كلية التجارة (سابقاً) / جامعة الأزهر
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي