الاجتهاد: إنَّ فكرة ولاية الفقيه الشيعيّ العامّة، التي تخوِّله تولّي السلطة الشاملة، بما تشتمل عليه من الصلاحيّات الدستوريّة والقضائيّة التي تُناط بمثله بين المؤمنين في دولة الشيعة الإماميّة إلى أن يظهر صاحب الزمان الإمام المهديّ المعصوم الثاني عشر (والأخير) في آخر الزمان، قد بَدَت لكثيرٍ من العلماء، من المسلمين والغربيّين، ابتكاراً من نحوٍ ما، ينحرفُ عن المظاهر الأساسيّة للمبدأ الدينيّ ـــ السياسيّ للإماميّة.
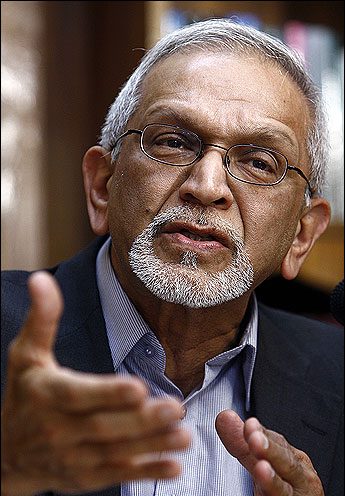 يأتي نشر كتاب «تطوُّر المرجعيّة الشيعيّة: من الغيبة إلى ولاية الفقيه»، للدكتور هيثم أحمد مزاحم، في وقت تجد المرجعيّة نفسَها تحت المجهر، لجهة إدراكها للإصلاح المنشود لها ومواءمتها لشؤون الرجال والنساء الشيعة في العصر الحديث.
يأتي نشر كتاب «تطوُّر المرجعيّة الشيعيّة: من الغيبة إلى ولاية الفقيه»، للدكتور هيثم أحمد مزاحم، في وقت تجد المرجعيّة نفسَها تحت المجهر، لجهة إدراكها للإصلاح المنشود لها ومواءمتها لشؤون الرجال والنساء الشيعة في العصر الحديث.
وحيث إنّ السلطة القانونيّة للمجتهد الشيعيّ أمرٌ لابدّ منه لاستمرار الإرشاد الروحيّ والأخلاقيّ المنشود للمجتمع فإنّ الشكل والإدارة التقليديّين للمرجعيّة قد أثارا تساؤلاتٍ جدّيّة حول قدرتها على تأمين الإرشاد الضروريّ ـ في حيّز المبادئ الأخلاقيّة العمليّة والفقه الإجرائيّ ـ المواكب للحاجات اليوميّة للشيعة.
تُبرز دراسة الدكتور هيثم مزاحم أهمّيّة هذا الموضوع للناس العاديّين الذين يحاولون فهم الأهمّيّة المنوطة بمنصب المرجعيّة في القرن الحادي والعشرين. والصفحات التالية ترسم إطار تاريخ المرجعيّة، الذي حاول مزاحم الإحاطة به بشكلٍ مميَّز في هذا الكتاب؛ إذ إنّ أسلوبه مباشر ودقيق في تقديم مناقشة أصيلة يُعتدُّ بها لقرّائه حول كيفيّة تمكُّن المذهب الشيعيّ من البقاء، على الرغم من تقلُّب الظروف، مع كونه يشكِّل أقلّيّةً ضمن حيِّز الأمّة المسلمة الأوسع، وحول قدرة قيادته الدينيّة على إرشاد الطائفة خلال عصور مختلفة، لتجاوز تحدِّياتٍ متنوِّعة تواجهها.
ويأتي توقيت نشر هذه الدراسة مناسباً جدّاً؛ إذ تلازمَ مع الوفاة المحزِنة للمرجع العظيم السيد محمد حسين فضل الله، في وقت تشتدُّ الحاجة إلى أمثاله بنظر كثيرين من المفكِّرين والأكاديميّين الشيعة المعاصرين حول العالم.
 إنَّ أبرز ما يقدِّمه هذا الكتاب هو مناقشة الآراء العلميّة الفقهيّة الشيعيّة اللبنانيّة ــ فضلاً عن الآراء الفقهيّة الأخرى: الإيرانيّة، والعراقيّة ــ حول السلطة الدستوريّة لولاية الفقيه، ممّا كُتب القليلُ عنه إلى اليوم.
إنَّ أبرز ما يقدِّمه هذا الكتاب هو مناقشة الآراء العلميّة الفقهيّة الشيعيّة اللبنانيّة ــ فضلاً عن الآراء الفقهيّة الأخرى: الإيرانيّة، والعراقيّة ــ حول السلطة الدستوريّة لولاية الفقيه، ممّا كُتب القليلُ عنه إلى اليوم.
إنه لَوقتٌ مؤاتٍ، للقرّاء اللبنانيّين على وجه التحديد، للتأمُّل في أهمّيّة التنعُّم بقيادةٍ كفوءة في المجتمعات الشيعيّة حول العالم؛ لإرشاد الناس إلى تحقيق أهدافهم المشروعة في سلامٍ وانسجام مع مجتمعات أخرى.
تجديد أم تتمّة؟
إنَّ فكرة ولاية الفقيه الشيعيّ العامّة، التي تخوِّله تولّي السلطة الشاملة، بما تشتمل عليه من الصلاحيّات الدستوريّة والقضائيّة التي تُناط بمثله بين المؤمنين في دولة الشيعة الإماميّة إلى أن يظهر صاحب الزمان الإمام المهديّ المعصوم الثاني عشر (والأخير) في آخر الزمان، قد بَدَت لكثيرٍ من العلماء، من المسلمين والغربيّين، ابتكاراً من نحوٍ ما، ينحرفُ عن المظاهر الأساسيّة للمبدأ الدينيّ ـــ السياسيّ للإماميّة.
هذا الابتكار، بحسب هؤلاء العلماء، يمثِّل امتداداً لـ «ولاية الإمام المعصوم» بالنسبة إلى عالِم دينيّ شيعيّ، على الرغم من غياب أيّ نصّ كهذا في عقائد الإماميّة.
إنّ سبب هذا الرأي، في اعتقادي، يكمن في فرضيّة أنّ سلطةً كهذه لعالم دينيّ شيعيّ يمكن استنباطها من خلال تعيينٍ صريحٍ من قِبَل قائد معصوم، سواء كان نبيّاً أو إماماً، اصطفته المشيئة الإلهيّة كطريقة وحيدة تتأسَّس من خلالها سلطة الإمام الشيعيّ.
ومن المهمّ الالتفاتُ إلى أنّه منذ أنْ تشكَّلت نظريّة الإماميّة، خلال القرن الثامن الميلاديّ، لم تخضع لأيّة مراجعات كان يمكن أن تجرى نتيجة تطويراتٍ معيَّنة في التاريخ السياسيّ لمجتمع الشيعة الإماميّة في الحقبات اللاحقة. وعلى الرغم من قيام دويلات شيعيّة لفترات محدودة، كالدولة البويهيّة في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديّين، والدولة الصفويّة في القرن السادس عشر الميلاديّ، فإنّ عقيدة إمامة المعصومين الاثني عشر لدى الشيعة قد بقيت على حالها من دون أيّ تغيير.
وهكذا فعلى إثر غياب السلطة السياسيّة لمعظم أئمّة الشيعة، في أعقاب استشهاد الإمام الأوّل عليّ بن أبي طالب(40هـ)، استدعت الحاجات الدينيّة والاجتماعيّة للجماعة الشيعيّة باكراً ظهور مؤسَّسة النيابة أو الوكالة عن الإمام المعصوم. وهذا النقاش لم يجرِ في حقل أصول الدين، بل في إطار الفقه والتكاليف الشرعيّة.
الجذور التاريخيّة لـ «ولاية الفقيه»
يقدِّم التشيُّع، للعالَم المعاصر، نموذجاً نادراً لحَرَكيّة أيديولوجيا دينيّة تكتنف فرضيّات عن تدخُّل إلهيّ مستمرّ على مدى التاريخ الإنسانيّ؛ لتمكين الإنسانيّة من بناء انتظام اجتماعيّ مثاليّ.
وقد أخذ علماء الدين الشيعة على عاتقهم ـ في فترات مختلفة من التاريخ ـ تأويل ثوابت التدخُّل الإلهيّ لإنشاء مجتمع وحكومة جديدين. وشغل موضوع غياب العدالة في المجتمع تفكير الملتزمين من المسلمين، وواجب المجتمع إزاء ذلك.
تاريخيّاً أبرز إرشاد علماء الدين الشيعة تأويلاتهم لاثنين من المعتقدات الأساسيّة الجوهريّة لمنظور سلطويٍّ ينظِّم الوجود الدنيويّ للمجتمع الشيعيّ. هذان المبدآن هما: العدل الإلهيّ؛ وإمامة أفراد مستقيمين يحفظون حكم العدالة والمساواة، ويشرِّعون الواجبات في ظلّه.
إنّ الجدل حول الأحقّ بخلافة النبيّ قد وسم الشرخَ الدائم في وحدة الأمّة، الذي أَبرَزَ مدرستين فكريّتين متميِّزتين في الإسلام، هما مذهب أهل السنّة (الأكثريّة)؛ والتشيّع (الأقلّيّة).
إنّ المسألة الأهمّ التي تحدِّد الوجهة السياسيّة الدينيّة للأمّة تتعلَّق بالقيود على قوّة سلطة مسلمة في الدولة، التي وجدت بدايةً على أنّها حاجة مقرَّرة إلهيّاً؛ لبسط العدل والإنصاف. وحدَّدت المسألة المسارات التي ينبغي أن يمضي وفقها الملتزمون المسلمون؛ لتقويض انحراف السلطة عن خطّ العدالة، جاعلةً السلطة المنحرفة دولة غير شرعيّة من الوجهة الدينيّة.
ومع بدء الأزمة الثانية، مع انتهاء القيادة الظاهرة للأئمّة بغياب الإمام الثاني عشر والأخير محمّد المهديّ(329هـ)، الذي أثّر على الفقه السياسيّ للشيعة، تأجَّلت فكرة الكفاح المسلَّح ضدّ أيّة سلطة مسلمة في الظاهر، ولكنَّها بقيت تعتبر فاسدةً ومنحطّةً إلى أجل غير مسمّى، حتّى آخر الـزمان. فالثورة ستأتي في المستقبل «ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً». والاعتقاد هذا حاضرٌ لدى جميع المسلمين، ولو أنّ لفظ «المهديّ» أصبح منوطاً أكثر بوظيفة الإمام الأخير عند الشيعة الإماميّة.
وقد أدّى الاعتقاد الشيعيّ بظهور الإمام وظيفةً معقَّدة، وعلى الأظهر متضادّةً. فقد كان وراء حركات راديكاليّة سياسيّة تدعو إلى دوام التيقُّظ والاستعداد للمحاربة مع الإمام الذي قد يظهر في أيّ وقت، وكذلك وراء انتظار هادئ لقضاء الله، في شبه استقالةٍ مسلِّمةٍ للقَدَر حيال عودة الإمام قبل يوم الحساب.
وفي الحاتين كانت المشكلة الرئيسة هي تحديد المسار الصحيح للتحرُّك ضمن حيِّز اجتماعيّ وسياسيّ. وقد توقَّف الحلّ العقلانيّ حيال مسار التحرُّك على الاتّفاق على وجود سلطة تأخذ على عاتقها جعل إرادة الإمام واضحةً لأتباعه. فحتّى في الوقت الذي كان فيه الإمام قاعداً عن السلطة على رأس دولة المسلمين ظلَّ مكمن سلطته على ثلّة المؤمنين من أتباعه في أنّه القادر على تأويل الوحي الإلهيّ، في مصدرَيْه: القرآن؛ وسنّة النبيّ المثاليّة، بطريقة لا يشوبها أيّ خطأ. فكان في الواقع شرح الإمام للوحي جزءاً من الواجب الدينيّ على المؤمنين.
واعتبر المؤمنون الشيعة تأويل الإمام هو الإرشاد الصائب الذي يحتاجه الناس في كلّ الأوقات. وبالنتيجة بحث الشيعة خلال الغيبة الكبرى للإمام المهديّ عن ذلك الإرشاد لدى قيادةٍ تكون قادرة على تقلُّد مسؤوليّة القيادة الحاسمة للأمّة في الظروف الدقيقة، بحسب إرادة الإمام المعصوم وتعاليمه الدينيّة.
ولقد كان خطيراً أنْ تُوكَل سلطة الإمام في غيابه إلى فردٍ يتولّى منحيَيْها: الدينيّ؛ والسياسيّ، فتلقّف الفقهاء الأمرَ بأن أنتجوا استجابةً شافية لهذا الوضع في أعمالهم الفقهيّة، التي فيها تأكَّد اعتقاد الإماميّة بأنّ الإمام هو القائد المؤهَّل الوحيد. فإلى أنْ يعود الإمام الغائب صار غير وارد احتمال تولّي السلطة السياسيّة والسلطة الدينيّة المشابهة لتلك التي لدى الإمام المعصوم نفسه. وبالتالي تولّى واجب إرشاد الأمّة فقهاء شيعة مؤهَّلون، فأضحَوْا، بحسب الاعتقاد الشيعيّ، قادةَ الأمّة بتعيينٍ عامّ من الإمام الغائب.
عزَّز هذا الأمر سلطة الفقهاء الشيعة؛ باستثارة علاقة غير مسبوقة بين المؤمنين وعلمائهم الدينيّين. كما ولَّد إحساساً قويّاً بالإخلاص للقادة الدينيّين بصفتهم وكلاء عامّين للإمام، بعد العام 329هـ. هيّأ هذا الإخلاص تدريجيّاً لانبثاق قيادة دينيّة هائلة التأثير من غير الأئمّة المعيَّنين إلهيّاً في المجتمع الشيعيّ.
شرعيّة سلطة الفقيه في الفقه الشيعيّ
مع عدم وجود تعيين صريح من الإمام الغائب لشخصٍ محدَّد ينوب عنه في مهامّ الإمامة أفضى النقاش الفقهيّ حول حيثيّة تولّي نيابة الإمام المعصوم أثناء غيبته إلى اعتماد أن تكون النيابة شرطًا في أداء وظائف عامّة معيّنة، كما في منصب القضاء (إحكام العدالة). فقد تطلّبت الظروف التاريخيّة الواقعيّة أن يميِّز الفقهاء بين «القوّة» و«السلطة»، وأن يعترفوا بأن تقلُّد منصب السلطة وانتحال القوّة السياسيّة ضرورتان لإحكام العدالة.
ولم يغيِّر تأسيس الدول الشيعيّة الحاكمة، كالدولة البويهيّة (954 ـ 1055م)، والدولة الصفويّة (1501 ـ 1789م)، التي حوّلت إيران إلى التشيُّع، والدولة القاجاريّة (1794 ـ 1789م)، والزنديّة (1750 ـ 1794م)، والبهلويّة (1925 ـ 1979م)، خلال غيبة الإمام العقيدةَ الأساس للإماميّة، القائمة على التقيّة والانتظار.
واستناداً إلى عقيدة الشيعة الاثني عشريّة فإنّ الإمام الثاني عشر الغائب هو الحاكم الشرعيّ الوحيد للمسلمين، وهو سيعود في آخر الزمان ليقيم النظام الإسلاميّ العامّ. مع ذلك فقد تولّى الفقهاء الذين عاصروا الحكومات الجائرة منصب الحاكم الشيعيّ العادل، الذي يستطيع مؤقَّتاً اتّباع التفويض القرآنيّ القاضي بخلق نظام عامّ «يكرِّس الخير، ويدرأ الشرّ»، إلاّ أنَّ تولّي ذلك المنصب كان مؤقَّتاً وعرضةً للخطأ.
والفقهاء الشيعة أقلُّ طواعيةً من نظرائهم من أهل السنّة لتحفيز الانقياد للحكومات الجائرة المستبدّة، إلاّ أنّهم انشغلوا في تبرير ظروفهم التاريخيّة والسكون لها. فالغيبة الكبرى للإمام والحالة الأقلّويّة للشيعة مكَّنت الفقهاء، بل ألزَمَتهم، أن يكونوا براغماتيّين وواقعيّين في تواصلهم مع الحكومات المعاصرة لهم، وفي صوغ آرائهم الفقهيّة حيالهم، وخاصّة أنّ حكّام الأمر الواقع كانوا محسوبين على التشيُّع. لهذا كان كلّ عمل فقهيّ يُحَال بِوَفْرةٍ إلى اقتباساتٍ من القرآن والسنّة النبويّة، وإلى تقييم الفقهاء الدقيق لمَنْ سبقوهم من الفقهاء. فالفتاوى، المستنبَطة من خلال الأدلّة العقليّة والنقليّة، تكشف عن أنّها وُضعت لخاصّيّة مواكبة حالات ظرفيّة معيَّنة في الدولة الإسلاميّة في ذلك الوقت.
اعتبر الفقهاء المتقدِّمون النيابة عن الإمام نوعاً من الثقة المولاة منه في غيبته؛ فشرَّعوا لأيٍّ منهم أن يتصرَّف بصفته حجّة للإمام بين أتباعه، فيأخذ على عاتقه كلّ الوظائف التي خُوِّل الإمام أن يشرع بها بنفسه، أو يفوِّض أمرها إلى مَنْ يجده أهلاً لتمثيله. وقد ارتكز الفقهاء في ما استنبطوه من نيابتهم عن الإمام على مبدأ المصلحة العامّة للأمّة، الذي يخوِّلهم صلاحيّة القيام بوظائف ذات طابع سياسيّ، كأئمّة قائمين، وذلك استناداً إلى ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة التي لا مناص من تحقُّقها، وخصوصاً حفظ النظام العامّ.
وكي يضمن مرجع التقليد إخلاص الشيعة له وجب عليه أن يُثبِت استحقاقه ليكون حارس الأمّة، بوضوح وموضوعيّة، من خلال معايير الإيمان السليم والعلم والشخصيّة الحاضرة، إلى ذياع صيته على أنّه الأعلم، بما ينشره من مؤلَّفات عن القضايا الدينيّة، ومن خلال تدريس طلاّبه ومقلِّديه. أمّا شخصيّته فوجب أن تتأسَّس على التقوى التي تؤهِّله ـ من بين ما تؤهِّله إليه ـ إلى استلام حقوق شرعيّة (زكاة وخمس) يحدِّدها التشريع، ليتمَّ توزيعها على المحتاجين.
مع دخول الحداثة كنمط حديث في الإدارة، والتعليم الحديث، ومنظومة القيم الحديثة، مثَّلت الإصلاحات التي أدخلت إلى النظام القضائيّ والحكوميّ عبر وضع دستور «مشروطة» في إيران محاولات تحديثٍ للمؤسَّسات الاجتماعيّة والسياسيّة التقليدية الإسلاميّة في المجالات الإيرانيّة، ما أثار نقاشاً حادّاً بين فصائل مختلفة تنتمي إلى طيفٍ واسع من الأيديولوجيّات. وقد واجهت الحركة الدستوريّة (المشروطة) في إيران معارضة من النظام والمجتمع التقليديّ وبعض الفقهاء التقليديّين في إيران خلال حكم القاجار الملكيّ.
وقد أدّى الاصطدام المضطرب، والعدائيّ أحياناً، بين الثقافة الإسلاميّة التقليديّة والقيم الغربيّة الحديثة إلى تقويض فعاليّة القيادة الشيعيّة التقليديّة في التعاطي مع التطوُّرات الاجتماعيّة والسياسيّة في ذلك الوقت. فمارس الشيعة الملتمسون للإرشاد في مجال العلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة في حالة الحداثة المعاصرة ضغطاً هائلاً على مراجع التقليد؛ كي يبيِّنوا لهم أَوْجُهَ فعاليّة المعالجات الإسلاميّة التقليديّة للقضايا الطارئة التي تستثير توقُّعات للشيعة فوق العادة، وقد بات على المراجع مواكبتُها.
وفي أوائل القرن العشرين تزايَدَ انحصار موقع الأعلم من بين الفقهاء في المسائل الدينيّة البحتة، ما حدا بهؤلاء إلى الانكفاء عن الساحة الاجتماعيّة ـ السياسيّة. وقد أدّى هذا الأمر إلى تسليمٍ لدى القيادة والجسم الشيعيّ العامّ بأنّه ليس بمقدور الفقهاء تقلُّد أيّة مسؤوليّة سياسيّة، ولا سيّما في دولةٍ حديثة.
كان الردّ العقيديّ، في مقابل الانكفاء هذا، إعادة تأكيد مبدأ «ولاية الفقيه»، الذي أعيد تفسيره وتطويره، في محاضرات الإمام الخمينيّ في النجف الأشرف بين 21 كانون الثاني و8 شباط من العام 1970م.
لقد مثَّل مبدأ «ولاية الفقيه» الركيزة الدينيّة التي على أساسها يتمّ تعزيز موقع الفقيه الشيعيّ كـ «منفِّذ شؤون الشيعة» في دولة شيعيّة في العصر الحديث.
ولاية الفقيه منذ الثورة الإسلاميّة في إيران
لقد طُوِّرت نظريّة ولاية الفقيه في التاريخ الشيعيّ مراراً، سواء من خلال الإطار السياسيّ أو نتيجة تغيُّر التوقُّعات وعبر تطبيق الفقهاء لها. وعزَّز تصوُّر الإمام الخمينيّ الخاصّ لنظريّة ولاية الفقيه هذا البعد المتغيِّر؛ إذ كان ثمة فرق جوهريّ وملحوظ بين موقفه في شأن الجدل حول الولاية السياسيّة للفقيه قبل الثورة وموقفه منه بعد الثورة، وخصوصاً حول ما إذا كانت هذه الولاية شاملة وعامّة ومطلقة، على غرار ولاية الإمام المعصوم، أم لا؟
فموقف الخمينيّ المبكِّر من «ولاية الفقيه» قد ظهر في كتابه المعنون «كشف الأسرار». فالكتاب عبارةٌ عن ردٍّ مفصَّل على الاتّجاه المعادي للدين، الذي كان يتضمَّن بيانات تنتقد مطالبة المجتهد الفقيه بتولّي السلطة السياسيّة. فقد طرح الخمينيّ مفهوم «ولاية الفقيه» في «كشف الأسرار» بناءً على آراء تقليديّة وحذرة ظهرت في أعمال الفقهاء المشهورين في المرحلة القاجاريّة والمرحلة التي تلتها. وكان هذا المفهوم قد ذكر مع ملاحظة أنّ «ولاية الفقيه» كانت منذ البداية مسألة خلافيّة بين الفقهاء أنفسهم، الذين اختلفوا في ما بينهم حول المسألة الجوهريّة، وهي: «هل يحظى الفقيه بأيّة ولاية؟ وما هو مدى هذه الولاية، ونطاق اختصاصها؟».
وعلاوةً على ذلك فقد أوضح الخمينيّ أنّ حقيقة تولّي الفقهاء للحكومة والولاية في هذا الوقت لا يعني أنّهم في الوقت نفسه «الملك، والوزير، والمسؤولون العسكريّون، وهلمّ جرا».
واقترح الخمينيّ تأسيس مجلس مؤلَّف من فقهاء عدول وذوي أهليّة ويخافون الله، يكون مكان المجلس الفاسد الذي كان تحت حكم الشاه. وينبغي لهذا المجلس أن يباشر بانتخاب سلطان عادل غير بعيد عن الالتزام بالقوانين الإلهيّة، ولا يحكم بِحَيفٍ ولا استبداد. وإذا كان مجلس الشورى مكوَّناً من فقهاء أتقياء، أو ظلَّ تحت رقابتهم، كما ينصّ الدستور، فالدولة ستحقِّق هدفَها في حفظ العدالة والرَّفاه. إذاً فاقتراح الإمام الخمينيّ لا يستبعد احتمال وجود حاكم عادل يمثِّل الذراع التنفيذيّة للمجلس المؤسَّس شرعيّاً من الفقهاء.
وبعبارة أخرى: إنّ اقتراح الخمينيّ لا يستبعد إمكان وجود حاكم عادل كذراع تنفيذيّة لمجلس الشورى الشرعيّ المكوَّن من الفقهاء. هذه الملاحظة المستنتجة في هذا الصدد ترتبط بالدور السلميّ الذي يلعبه المجتهدون في العالم الإسلاميّ، حيث يؤكِّد الإمام الخمينيّ أنّهم لا يعترضون على الوضع المستقلّ لبلدانهم، حتّى عندما واجهوا سلوكاً ظالماً من الحكّام، واعترفوا بالنظام الظالم لهؤلاء الحكّام.
وفي ضوء هذه المهمّة السلميّة التي ينتهجها المجتهدون عندما يتحدَّثون عن مدى حقّهم في إقامة حكومة العدل وممارسة الولاية فهم لا يتجاوزون عدداً قليلاً من البنود المحدَّدة بشكلٍ صحيح في الفقه، بما في ذلك الولاية في إصدار الأحكام القضائيّة؛ للفصل والتدخُّل في حماية أموال القُصَّر، أي ما يسمّى بالمصطلح الفقهيّ: الأمور الحسبيّة في أموال الأيتام والقُصَّر. فهم لا يأتون إطلاقاً على ذكر مسألة ممارسة الحكم (الحكومة) بين هذه البنود، كما أنّها لا تتحدَّث عن السلطة السياسيّة (السلطنة)، وذلك على الرغم من إدراكهم التامّ بأنّه باستثناء شريعة الله فجميع الأنظمة القضائيّة (المستمدّة من أوروبا) فاسدة وغير مناسبة للشعوب المسلمة. مع ذلك فإنّهم يحترمون هذه القوانين غير الملائمة البتّة، ولا يرفضونها، ويعتقدون أنّه ينبغي أن يتمّ التسامح معها ما دام النظام لا يتحسَّن.
هذا الموقف المتردِّد للإمام الخمينيّ في «كشف الأسرار» قد تغيَّر إلى موقف أكثر حركيّة في النجف الأشرف، خلال محاضراته عام 1970م، والتي نشرت لاحقاً في كتاب بعنوان «الحكومة الإسلاميّة»، وذلك بشأن ولاية الفقيه في الدولة الشيعيّة التي بلغت ذروتها في الوقت الحاضر.
يطرح العنوان المعطى لهذه المحاضرات حول ولاية الفقيه، في كتاب «الحكومة الإسلاميّة»، تحوُّلَ مبدأ ولاية الفقيه إلى نسق حكوميٍّ، موجباً إخضاع السلطة السياسيّة (السلطنة) للمعايير الإلهيّة الموضَّحة في الفقه الإسلاميّ. إذاً فالحكومة الإسلاميّة هي السلطة الدينيّة الأخلاقيّة للفقهاء، التي تسود في فروع حكومة حديثة، تشريعيّاً وتنفيذيّاً وقضائيّاً. فالمحاضرات توضح الحاجةَ الملحّة إلى أن يتمسَّك الفقهاء بمواقع المسؤوليّة في تحقيق أهداف الحكومة الإلهيّة للإنسانيّة.
وقد أدّى عدمُ الإجابة عن أسئلةٍ حيال عددٍ من الإجراءات التشريعيّة إلى عودة ظهور النقاش الغائب الحاضر بين العلماء الدينيّين ـ من جهة ـ، الذين يقاربون موضوع منع الامتياز الإنسانيّ في التشريع من منحاه الحَرفيّ الضيّق، وأولئك الذين يُجيزون تشريعات إضافيّة ـ من جهة أخرى ـ، على أساس أنّ الفقه التقليديّ؛ بكونه سلسلة معايير، يفتقر في جوهره إلى أهليّة طرح حلول لمشاكل معقَّدة يواجهها المجتمع الحديث.
إنّ التساؤلات غير المجاب عنها تطرح الشكوك في تأكيد الطبقة الدينيّة في العصر الحديث أنّ الإسلام؛ بكونه نمطَ حياة، يملك حلَّه الفريد للمشكلات الأساسيّة التي تواجه الإنسانيّة، كما تتحدّى مقدرة الفقهاء على الإتيان بأجوبة شافية عن أسئلة عميقة، كـ «إعادة توزيع الأراضي لضمان الصالح العامّ»، أو «التدخُّل في العلاقات بين ربّ العمل والموظَّف لإحراز وزنٍ من عدالة، ممّا لا حلول له لدى الفقه التقليديّ».
وفي مناسبات عدّة لقي البرلمان معارضة مجلس الخبراء، الذي عُيِّنت وظيفته بإقرار انسجام تشريعات البرلمان مع الشريعة؛ لتمريره إجراءات معاكسة للفقه التقليديّ. هذا المأزق المتواصل في تحديد حيِّز قوّة الدولة للتدخُّل في بعض الأمور التي تؤكِّد ثقلاً للعدالة في المجتمع كان الأساسَ الذي انطلق منه الخمينيّ في فتواه التي تؤكِّد تفوُّقَ الدولة الإسلاميّة في ظلّ ولاية الفقيه في حفظ رفاهية مواطنيها.
أتت فتوى الخمينيّ على شكل رسالة وجَّهها إلى رئيس الجمهوريّة آنذاك السيد عليّ الخامنئيّ، الذي أشار في خطبة الجمعة إلى أنّ إنشاء دولة لم يكن من أولويّات رسالة النبيّ، فأجاب الإمام الخمينيّ بالتالي: «يبدو من خلال مواقف سماحتكم في صلاة الجمعة أنّك لا ترى الحكومة تساوي الولاية المطلقة التي مُنحت للنبيّ الأعظم| من قِبَل الله، والتي هي أهمّ جزء من الشريعة الإلهيّة، ولها الأولويّة أمام جميع الأحكام الفرعيّة. إنّ تأويلَك لما قلتُه من أنّ الحكومة لها أن تتصرَّف ضمن التشريعات الإلهيّة الموجودة (الأحكام الثانويّة المحفوظة في الشريعة) فحسب يصبّ كلِّياً في ما يناقض ما قد قلتُه…. ينبغي أن أشير إلى أنّ الحكومة، التي هي فرعٌ من الولاية المطلقة لرسول الله، هي من بين الأولويّات التشـريعيّة في الإسلام، وتتمتَّع بأسبقيّة أمام جميع التشريعات الثانويّة، كالصلاة والصيام والحجّ».
إنّ كلام الخمينيّ في فتواه المقتبَس منها أعلاه ينفتح على مروحةٍ واسعة من التأويلات، في إيران والغرب، بين باحثي الدراسات الإسلاميّة والشرق أوسطيّة. فما يظهر من إعلان الخمينيّ في فتواه أنّ اعتبارات سياسيّة قد تكون لها أولويّة على معتقدات أخرى في الشريعة. هذه هي الوُجهة التي اعتبر معظم الأكاديميّين الغربيّين أنّ الإعلان في الفتوى ينحى منحاها، فلها سَنَدٌ في التاريخ السياسيّ للإسلام، حين خالف ـ بالفعل ـ الحكّام المسلمون ــ سواء من الخلفاء السنّة أو سلاطين الأمر الواقع ــ تعاليم الشريعة؛ لأغراض سياسيّة.
لذا لا دليلَ على أيّ انتهاكٍ للعقيدة في ما ورد في الفتوى، إذا ما كانت الحكومة الإسلاميّة قد أُعلِنت حكومةً تامّة تحدِّد كل الأمور المتعلِّقة بمصالح الناس، وإنْ بهيمنةٍ على التشـريعات الثانويّة، إذا ما اقتضت الضرورة.
والأدلُّ على هذا التحوُّل إلى «ولاية الفقيه» مطلقة الصلاحيّات هو تعبير الخمينيّ ـ في الفتوى عينها ـ بأنّه بمقدور الحكومة الإسلاميّة ــ أحاديّاً ــ إبطال التزامات شرعيّة، كانت أنجزتها مع أفراد شعبها، حالما تكون هذه الالتزامات متعارضة مع مصلحة البلد والإسلام. فيمكن لحكومة الوليّ الفقيه إنهاء أمور كانت ــ تقليديّاً ــ جزءاً من القِسم الفقهيّ المتعلِّق بـ «المعاملات» (حيِّز الطاعة في إطار العلاقات الإنسانيّة). وبذلك بات الدستور الذي ضَمِن سيادة الشعب خاضعاً لسلطة القيادة الإسلاميّة المهيمنة، تحت رعاية ولاية الفقيه (الوَحدَة الوحيدة المؤهّلة لتحديد الخطوط العريضة لماهيّة مصلحة البلد والإسلام).
فباتت الحكومة الإسلاميّة مفوَّضة لـ «منع أيّ عمل يُقام به على نحوٍ عباديّ فرديٍّ لوجه الله ـ أو أيّ نحو آخر ـ، ويصبُّ في ما يتعارض مع مصلحة الإسلام، طالما أنّه يظلّ مؤذياً للإسلام». مثلاً: تستطيع الحكومة أن تمنع الحجّ إلى بيت الله الحرام ــ والحجّ واحدٌ من أوجب العبادات التي أمر الله بها ــ حينما تكون رحلة الحجّ منافيةً لسلامة الإسلام، بمقتضى الظرف المحيط. ما كان يقال في السابق، أو هو يُقال الآن، حول ولاية الفقيه ينمّ عن إلمامٍ قاصرٍ بمفهوم «الولاية المطلقة».
أراد الخمينيّ بشرحه المبتكَر عن أساس ولاية الفقيه في فتواه أن يوفِّر حلولاً للمشكلات الاجتماعيّة الاقتصاديّة العمليّة على المستوى التشـريعيّ النظريّ، من خلال منح المجلس السلطة، وقد كان يشكَّك في مدى قدرته على إحكام تنفيذ القوانين في دولة حديثة. فصار ــ كما أراد الخمينيّ ــ للمجلس طابع الشرعيّة الدينيّة، ممّا أهَّله لتطبيق قراراته بصفتها منسجمةً حتماً مع مصلحة الإسلام والمجتمع.
ومع وفاة السيد الخمينيّ في العام 1989م ظلّ منصبه «الوليّ الفقيه» غير قابل بعده لِلمَلء إلاّ من قِبَل مرجعٍ للتقليد شبيه بالخمينيّ عِلماً وتقوىً. ولتدارك هذا الفراغ في القيادة المُقَرَّة دستوريّاً للنظام الشيعيّ الحاكم عمد مجلس صيانة الدستور إلى هجر تقليدٍ شيعيّ راسخ في التشيُّع، وهو الاعتراف بإجازة الاجتهاد الفقهيّ للمجتهد قبل الإقرار له بأهليّته في أن يكون مرجعاً للتقليد، وتولّي منصب الوليّ الفقيه. فلم يكن في أساس مبدأ «ولاية الفقيه» أيُّ سَنَد ليكون غيرُ المجتهد أهلاً ليصير «الوليّ الفقيه»؛ إذ أتاح فقط تدبيرٌ دستوريٌّ حديث لحجّة الإسلام عليّ الخامنئيّ أن يرتقي إلى رتبة «آية الله».
بهذا تحوَّلَ مبدأ تقليد مرجع دينيّ من مسألة اقتناع ورضاً شخصيّين للمؤمن إلى مسألة ولاء يفرضه الدستور في إيران تجاه حامل وظيفة «الوليّ الفقيه»، كما هي الحال تجاه السيد الخامنئيّ.
إنّ الوضع الراهن لولاية الفقيه يسطِّر ذروة خصوصيّتها التدريجيّة في النطاق الشيعيّ الإيرانيّ، لأنّها أخفقت في أنْ تجد لها أرضيّةً خصبةً سياسيّاً خارج النطاق الإقليميّ لإيران. بل باتت تشوب قيامها في إيران مشاكل عمليّة معقَّدة، تواجهها الدولة في مكابدتها لهموم أكثر بروزاً ـ كإعادة إثبات نفسها عضواً ذا مصداقيّة في النظام العالميّ الحديث ـ من مجرَّد أن تُعتَبَر أمل المضطهَدين في خلق نظام عالَميّ مسلم في ظلّ ولاية الفقيه.
إنّ التجربة العقيديّة للشيعة كابدت اضطراباتٍ ناجمة عن جور المتمسِّكين بالسلطة. ولن يكون مفاجئاً أن نشهد ثورة أخرى للمضطهدين بتوجيهٍ من قادتهم الدينيّين، في سياق الطموح الرساليّ للشيعة في حكم العدالة والإنصاف على الأرض.
(*) مفكّر عالمي متخصّص في الفكر الإسلامي، وأستاذ الأديان في جامعة فيرجينيا، وقد كتب هذه الصفحات تقديماً لأحد أعمال الأستاذ هيثم مزاحم في تطوير المرجعيّة الشيعية.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي



