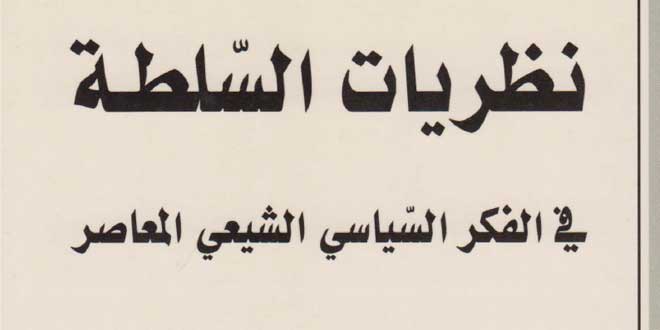الاجتهاد: يُولي “الإمام الخميني”، في نظريّته الولاية العامة للفقيه، صفات الحاكم والشروط التي يجب أن تتوفر فيه، أهمية خاصة، ويَمنحُها موقعاً جوهريّاً في البناء النظري للأطروحة، إذ لا يَخفى أن المضمون العقائدي لصفات الحاكم، ليس إلا تعبيراً عن فلسفة النظريّة نفسها؛ لذلك، تكاد هذه الصفات والشروط، أن تكون الحصيلة التطبيقيّة لمجموع المفاهيم التي قامت عليها النظرية.
فالانسجام بين المشروعية والوظيفة وصفات الحاكم، هو أحد المعايير البديهيّة، في الاستدلال على اتّساق البُنية المنهجيّة للنّظرية. وفي حالة “الإمام الخميني”، تَفوقُ صفات الحاكم والشروط الذاتية التي يجب أن تتوفر فيه، مكانة نظيراتها في النظريات الأخرى، بل يصځ كذلك، القول إنَّ هذه الشروط، تشكل عنده عنواناً للنظرية، ووصفاً مكثَّفاً لمضامينها كافَّة.
فإذا تجاوزنا بحث المشروعة الدينية، الذي رسم منذ البدء للنظرية وِجْهَتها، فإنَّ المماثلة بين الإمام المعصوم والولي الفقيه، من الطبيعي أن تتجلى في مواصفتين يجب أن تتوقّرا بالحاكم، وهما العلم والعدالة، وهما المعادل الطبيعي الذي يسمح للفقيه بأن يؤدّي نیابته المتمايلة للمعصوم.
فالتماثُل الذي لا يُمكن أن يبلغ بحال من الأحوال العصمة، أو مقام الخلافة الإلهيَّة الكبرى، التي هي شأن غَيبِي يتَّصل بالاختبار الإلهي، يَؤُوب إلى ما يشكِّل اقتراباً من ماهيّة المتمایل معه؛ أي العلم والعدالة.
إن ذلك ما يفسر قول “الإمام الخميني”: «إن الشروط اللازمة للحاكم، ناشئة من طبيعة نمط الحكومة الإسلامية بشكل مباشر. فبعد الشروط العامة، مثل العقل والتدبير، هناك شرطان أساسيّان هما:
1- العلم بالقانون. 2- العدالة(1).
وهو يقدم شرحاً للأسباب التي تجعل من هذين الشرطين أساسيَّين، فالعلم بالقانون تفرضُه حكومة الإسلام التي هي حكومة القانون. ولا دور أو ضرورة لأشكال أخرى من العلم، كالعلم بكيفية الملائكة، أو أوصاف الصانع أو الموسيقى، أو العلوم الطبيعية أو غيرها، فإن ذلك مما لا دخل له في أمر الإمامة .
أما شرط العدالة، فتقتضيه ضرورة أن يكون الحاكم مُتمتِّعاً بالكمال العقائدي والأخلاقي؛ حيث إنَّ إقامة الحدود، وتطبيق القانون الجزائي الإسلامي، وإدارة بیت المال، وموارد البلاد ومصارفها، لا يمكن أن تُوكَل إلى أهل المعاصي، إذ بمقتضاها، يجب أن يكون الإمام هو الأفضل، وعالماً بالأحكام والقوانين، وعادلاً في تنفيذها().
ما يُلفِت في نصّ «الإمام الخميني»، أنه اشترط العلم، ولم يشترط الأعلميّة. والمقصود بالعلم هو الاجتهاد، الذي يثبت “بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة»(3).
أما الأعلمية، فهي تفوُّق الفقيه في الفقه، على ما عداه من الفقهاء، ويُعتبر ذلك شرطاً للمَرجعيّة. لذلك، فهو لم يكن ممّن يشترطون المُلازَمة بين مرجعية التقليد وولاية الفقيه .
أما العدالة، فيُعرّفها في كتابه الفقهي «زبدة الأحكام”، بأنها : عبارة عن مَلَكة راسخة، باعثة على مُلازَمة التقوى، من ترك المحرمات وإتيان الواجبات، وتزول حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. بل بارتكاب الصغائر أيضاً، على الأحوط، وتعود بالتوبة مع بقاء المَلَكة المذكورة»(4).
وإذ نلاحظ أنَّ الإمام الخميني، قد حدد في كتاب «الحكومة الإسلامية»، معنىً للعلم، من حيث هو علم بالقانون الإسلامي، ما يُفيدُ أنه قد قَصَر معناه على العلم بالفقه والأحكام، إلّا أنّنا نجده بالمقابل، في مواطن أخرى، قد أقدم على تَوسِعَة معنى العلم بما يَتجاوز اقتصاره على الفقه؛ إذ يقرّر أنه «لا بدّ للمجتهد من الإحاطة بمسائل عصره» (5)، وكتا قد أشرنا إلى تأكيده على الزمان والمكان كعُنصرين أساسيين في الاجتهاد، وعلى تأثير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على علاقة الأحكام بالموضوعات، وتحولها بفعل ذلك إلى أحكام جديدة .
إن هذه المفاهيم تبدو مُترابطة، وهي تُؤدّي دوراً حاسماً في صياغة الخصوصية الخمينيّة، في مجالَيْ الفقه والسياسة. ففي تَوسِعَة معنى العلم، واشتماله على سَيرُورات الواقع وتحوّلات الزمان والمكان فيه، ما يُفضِي إلى إعادة تشكيل التراتُبيّة العلميّة في الحوزة. على نحو مغاير للحال التي ظلَّت قائمة لقرون طويلة.
كما أنه يقضي بالحكم على الفقه التقليدي بعدم الكفاية، رغم تمسُّك «الإمام الخميني» بقواعده وأصوله المعروفة.
فمن وجهة نظره، «المجتهد هو الذي يُدرك أبعاد الحكم ومتطلِّبات المجتمع بنحوٍ سليم، وإن الاجتهاد المتعارَف عليه في الحوزات، من الطبيعي أن لا يدعو إلى الإحاطة بمعاناة الدولة، ووعي مُتطلِّبات المجتمع الإسلامي.
فمن الممكن أن يكون شخص ما، هو الأعلم في العلوم المتداولة في أوساط الحوزات، إلّا أنه يجهل المجتمع ومصالحه، فلا يُمكنه إدارة شؤونه. إذن، ففقيه الحوزة، إذا افتقد إلى الرؤية السياسية والاجتماعية، يبقى مجرّد خبير يضع خبرته تحت تصرف الشخص الذي يُمسك بزمام أمور المجتمع(6).
إن بوسع هذه المفاهيم، أن تُشكِّل تحديثاً للفقه والبُنية المَعرفيّة للفقيه، وهي تُتيح من ناحية أخرى، وبالضبط من زاوية علاقة التلازُم بين الفقه وعُنصرَيْ الزمان والمكان، تسويغاً أكثر من ذي قبل، للبحث في إبستمولوجيا وسوسيولوجيا الفقه، إذ إنّ النتائج المُرتَقبة لتطبيقات القواعد الفقهية على موضوعاتها، ستكون أكثر صلة بالواقع بما فيه من تباين واختلاف.
إن ذلك سيقطع على الفقه، في حال تطوُّره، أن يتَّسم باستقلاليَّة سكونيَّة، بل سيرزح تحت تأثیر اختلاف البُنية المعرفية للفقيه، وتأثيرات الإطار الإجتماعي – السياسي الذي تنمو شخصية الفقيه في ظلّه.
إنَّ ما نخلُص إليه، حول شَرطَي العلم والعدالة، في بناء حاكميَّة الفقيه، وهما شرطان أساسيان إلى جانب شروط أخرى(7)، كالتحلىِّ بالذكاء والفَراسة والتقوى والزهد والإدارة والتدبير، يظهر جوهريا، عمق التركيب الأخلاقي لأطروحة ولاية الفقيه .
فهي من وجه، ولاية علم وعدالة، الأمر الذي يُفصح عن الضمانات الذاتية التي تشكِّل ضابطة الممارسة السلطة. فالسلطة في ظلّ ولاية الفقيه، ترتكزُ إلى منظومة قيم وضوابط ذاتيّة، تُمثّل موطن الثقل في إنتاج السياسة وضبط ممارستها اكثر مما تتحكّم إلى مؤسسات رقابة خارجية.
وقد يصحُّ القول إن نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم تُشكّل مقوّماً موضوعية لحاكمية الفقيه. بينما العلم والعدالة، يشكّلان مقوّماً ذاتياً لحاکميته .
إن ذلك يعني أن حضور الفقيه في المجتمع السياسي، وفي الأمة، على حدّ سواء، لا يلتمس عبر نیابته عن المعصوم فقط، بل عبر علمه وعدالته أيضاُ. بل إنَّ العلم والعدالة، هما جوهر نیابته نفسها، فهما قوام المُماثلة التي تفرضها علاقة النائب بالمَنُوب عنه.
الهوامش
1- الإمام الخميني : “الحكومة الإسلامية”، ص 82 – 83.
2- المصدر نفسه، ص3 – 85.
3- “الإمام الخميني”:تحرير الوسيلة/العبادات»،(دار المنتظر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان،1985م، ط2،المسألة 19، ص6).
4- “الإمام الخميني”: «زبدة الأحكام»،(منظمة الإعلام الإسلامي، قسم العلاقات الدولية،طهران،1404هـ، ص4).
5- السيد أحمد الخميني:«مرآة الشمس/ استعراض لأفكار “الإمام الخميني”، (مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخميني، الشؤون الدولية، طهران، 1997م، ط1، ص48.
6- المصدر نفسه، مر50.
7- المصدر نفسه، مر50.
المصدر: الصفحة 231 من كتاب نظريات السلطة في فكر السياسي الشيعي المعاصر للدكتور علي فيّاض
تحميل الكتاب
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي