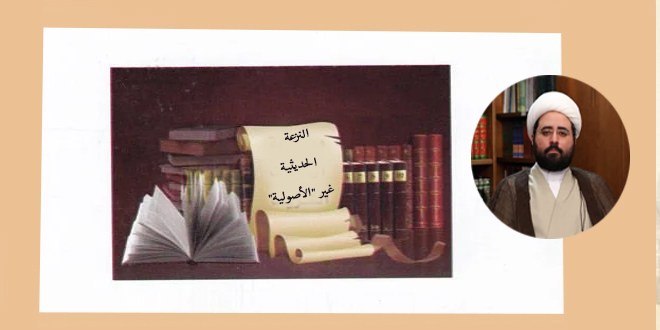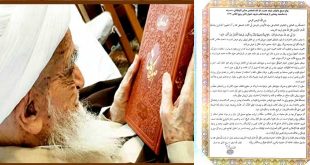الاجتهاد: على الرغم من اعتناء أهل العلم بدراسات علوم الحديث، وأبحاثهم المحكّمة لتقييم النصوص والأسانيد؛ التي قد حظيت باهتمام كبير في عصرنا، ممّا أسهم في توضيح مصداقية عدد من الكتب الحديثية، إلاّ أننا لا نزال نشهد للأسف أنّ بعض الأشخاص – دون أيّ احتياط أو مراعاة لمعايير صحّة الحديث ومصادره – يعمدون إلى قراءة أيّ نص عربي قديم أو مشهور على الناس بمجرّد الظن بأنّه حديث مأثور.
بل وأكثر من ذلك، فإنهم يستنبطون منه نتائج وتأويلات بعيدة عن أصول “أهل البحث والتحقيق” ومناهج الدراسات التراثية!
والمصيبة الأكبر أنّ هذا النوع من القراءة يختلط أحيانًا بتفسيرات صوفية أو ابن عربيّة أو حتى ببعض النزعات الصدرائية والشيخية، ثم يُقدَّم تحت مسمى: “الحقائق والأسرار” ليُسوَّق لعامة الناس.
وتزداد خطورة الأمر عندما يتم نشر هذه الاستنباطات غير “الأصولية” في منصّات عامّة، ولم تعد تقتصر على مجالس محدودة كما كان الحال في العصر الصفوي والعثماني أو القاجاري، بل أصبحت اليوم، بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تصل إلى ملايين الأشخاص خلال دقائق؛ ممّا يضاعف تأثير هذه الأفكار المغلوطة والمزاعم الباطلة.
ليس كلامنا عن المصادر الحديثية الأصيلة والموثوقة، بل عن مجموعة من الكتب الحديثية التي لا تُعرف أصولها التاريخية بشكل واضح، بل وهناك خلافات بشأن صحّة نسبتها إلى مؤلّفيها المفترضين؛ إذ لا يوجد دليل قطعي أو معتبر على أصالتها.
في السنوات الأخيرة، كشفت العديد من الدراسات عن طبيعة هذه النصوص، وبيّنت ارتباطها بالتيارات الغالية والمبالِغة داخل دائرة التشيّع المصطلَح، أو بمحدّثين تساهلوا في نقل الأحاديث، خصوصًا تلك النصوص والأخبار التي تخدم أغراضًا سياسية أو ترويجية للأشخاص أو المجموعات؛ فكيف يمكن تبرير الاستناد إلى هذه المصادر دون مراعاة مناهج “أهل التحقيق”، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك عبر مزجها بمضامين أخرى غير معتبرة، ممّا يؤدّي إلى إنتاج تفسيرات دينية لا تمت بصلة إلى ما وصلنا محكمًا من القرآن الكريم والمصادر الشيعية الأصيلة؟
بل إنّ التهاون في النقل والمزج العشوائي لهذه النصوص قد يصل إلى حدّ ينفر أصحاب العقول السليمة والنظرة الفطرية النقية من الدين، بل ويدفع البعض إلى السخرية والاستهزاء من هذه الروايات وتلك التفسيرات.
والأدهى من ذلك أنّ بعض الأشخاص ممّن يصنّف من العلماء أو الخطباء – رغم الدراسات العلمية الجادّة المتقدّمة والمتأخرة والمعاصرة – لا يزالون يتردّدون في الإقرار بعدم اعتبار بعض الأحاديث أو المصادر الحديثية، ويستخدمون أساليب غير علمية لإضفاء مصداقية على تلك النصوص.
ومن أخطر الأمثلة على ذلك انتشار العديد من النصوص النصيرية خلال السنوات الماضية؛ مثل: كتابات حسين بن حمدان الخصيبي، وبعض نصيريي بغداد وحلب واللاذقية.
وقد أدى ذلك للأسف إلى أنّ بعض غير المطّلعين بات يتعامل بمرونة مع هذه المصادر ونصوصها؛ إذ يستخدمها لتأييد كتب وأحاديث أخرى غير موثوقة أيضًا! دون الالتفات إلى أنّ الدراسات العلمية قد أثبتت كرارًا ارتباط بعض الكتب؛ مثل: هداية الخصيبي، وعيون المعجزات المنسوب إلى الحسين بن عبد الوهاب، وأجزاء من دلائل الإمامة، وإثبات الوصية، و … بأفكار الغلاة النصيرية والتيارات الغالية في بغداد آنذاك، وأمثالهم!
والإشكال الأبرز في الاعتماد على مصادر حديثية غير موثوقة؛ هو: أنّ أسانيدها لا تُقِرّها “قواعد علم الحديث” و”علم الرجال” عند المتقدمين، ولا تؤيّدها المناهج التاريخية الحديثة لدى المتأخّرين، كما أنّ مضامينها تتعارض مع “أصول العقيدة الشيعية” وفقًا لأعلامها الكبار مثل الشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلاّمة الحلّي وأمثالهم.
والأخطر أنّ هذه الأحاديث غير الموثوقة كانت، عبر التاريخ، من أهمّ المستندات التي اعتمدت عليها الفرق المنحرفة، لا سيما التيارات الغالية والتأويلية الباطنية والغنوصية والعرفانية ونحوها، خاصّة بعد العصر الإيلخاني، ومن ثمّ خلال القرون الأخيرة مع ظهور الحركات التي تبنت أفكار تجديد النبوّة أو المهدوية أو البابية وأمثالها.
ومن المؤسف أنّ بعض الفرق المنحرفة المعاصرة قد استندت وأسّست أركانها على حديثين أو ثلاثة من تلك الأحاديث والروايات والأخبار التي تعود جذورها إلى الغلاة والمفوّضة وأمثالهم؛ لتقديم دعاواها على أنّها مستندة إلى أحاديث الأئمة الأطهار(عليهم السلام). وهذا لا يمثل سوى جزء بسيط من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تجاهل “أصول علم الحديث” و”قواعده”.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي