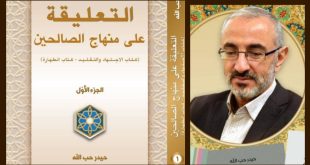الاِجتهاد: ما الذي يدفع الفقيه الإسلامي إلى معالجة إشكاليّة الثابت والمتغيّر؟ ماهو الحل المناسب لعلاج إشكاليّة الثابت والمتغير في القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة؟ يتطرق الباحث في بحثه هذا إلى المرجعيات الثلاث التي جاءت في سياق الموضوع. كما يطرح التساءلات النقدية التي تواجه هذه المرجعيات.1ـ المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة (ولاية الأمر) للسيد محمدباقر الصدر والعلاّمة محمد حسين الطباطبائي وأمثالهما. 2 – مرجعيّة المبادئ الفقهيّة التحوّليّة المساعدة (نظريّة مشهور الفقهاء). 3 – مرجعيّة أدلّة التشريع العليا المساعدة (نظريّة العلاّمة شمس الدين)
شغل موضوع الثابت والمتغير أذهان علماء المسلمين منذ فجر النهضة الإسلاميّة الحديثة. وقد طُرحت في هذا المجال نظريّات وطروحات كثيرة، وبحوث ونقاشات عدّة. لكنّ المؤسف ـ وبعد مرور حوالي القرن ـ أنّنا لا نجد لهذا البحث حضوراً في علم أصول الفقه حتّى هذه اللحظة، مع كونه أصوليّاً بامتياز؛ فإنّ علم الأصول هو المعنيّ بالقضايا البنويّة التحتيّة التي تقوم عليها الشريعة، ومن الواضح أنّ الثابت والمتغير من أهمّ الموضوعات المعاصرة التي أدلى جملةٌ من العلماء برأيهم فيها، من دون أن يتحوَّل هذا البحث إلى جزءٍ من البحوث الأصوليّة، أو أن يبحث الأعلام في بحوث الخارج التخصُّصيّة فيه.
ومن هنا أدعو بجدٍّ إلى الاهتمام به، على غرار الاهتمام الذي يوليه الأصوليّون لمباحث الإطلاق والتقييد؛ فهو بحثٌ لا يقلّ أهمّيّةً وخطورة وعمقاً عن هذه الأبحاث، وليس بحثاً ثقافيّاً عاماً يمكن الوصول إلى نتيجةٍ حاسمة فيه من خلال محاضرةٍ أو ندوة صغيرة أو مقالة عابرة يكتبها باحثٌ أو مثقّف أو عالم؛ فقد شغل هذا البحث كبار العلماء، كالصدر والطباطبائي وشمس الدين وغيرهم أيضاً. من هنا نتمنّى الاهتمام به؛ لنقدِّم أجوبةً متطوّرة على الدوام إزاء هذه الإشكاليّات التي تواجه الإسلام، بل تواجه المشروع الإسلاميّ برُمَّته.
وفي سياق التدليل على سعة وعمق هذا البحث أذكِّر بالتجربة الشخصيّة التي مرَرْتُ بها، وأنا أدرِّس بحوث هذا الموضوع في السنوات الماضية؛ إذ وجدْتُ نفسي مضطراً إلى إلقاء أكثر من (55) محاضرة فيه؛ نظراً لكثرة النظريّات فيه وتعدُّد الاتجاهات الموجودة عند علمائنا ومفكِّرينا. من هنا أكرّر بأنّ أهمّ وظائف الحوزة العلميّة والعلماء والمفكِّرين والفقهاء الاشتغال بهذه الموضوعات اشتغالاً جادّاً؛ لتصبح جزءاً من دروسنا وبحوثنا اليوميّة؛ إذ كثيراً ما تُستغلّ هذه الموضوعات للنقد على الإسلام، والتعريض بمشروعه الإنساني.
لماذا يندفع الفقيه المسلم لمعالجة موضوع الثابت والمتغير؟
وقبل أن نبدأ باستعراض المفاصل الأساسيّة لهذا العنوان بشكلٍ موجز علينا أن نطرح هذا التساؤل: ما الذي يدفع الفقيه الإسلامي إلى معالجة إشكاليّة الثابت والمتغير؟
والجواب: يمكن الحديث عن عاملين أساسيّين، هما اللذان يدفعان الفقيه الإسلاميّ إلى تناول هذا الموضوع ومعالجته:
1ـ العامل الدفاعيّ.
2ـ العامل البنائيّ.
أمّا العامل الأوّل، فقد اجتاحت الطروحات الأيديولوجيّة والمدارس الفكريّة العالم الإسلاميّ في خمسينات وستينات وسبعينات القرن المنصرم، ولا سيَّما المدارس الماركسيّة والاشتراكيّة وأمثالها. وهذه الطروحات والأيديولوجيّات كانت تتفاخر بأنّ لديها نظاماً سياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وتعليميّاً وتربويّاً، وأنّ النظام الإسلاميّ غير قادرٍ على الانسجام والتكيُّف مع متطلّبات العصر، ولا يصلح إلاّ للمواءمة مع العصر الزراعي والقبلي الذي عفَّ عليه الزمن، فكيف يمكن لنظامكم الفقهي والاجتهادي أن يواكب الحياة في العصر الحديث المليء بالتطوُّر والتكنولوجيا؟!… الحياة تتغيَّر وفقهكم الإسلامي ثابتٌ، فما هو السبيل لتناسب الثابت مع المتغيِّر؟
واجه المفكِّر والفقيه المسلم ثغرةً أساسيّة شكَّلَتْ تحدِّياً بالنسبة إليه. فأين هو البرنامج الاقتصادي الإسلاميّ؟ وأين هو نظام العلاقات الدوليّة؟ وأين هو النظام البيئي؟!
نعم، يوجد نظامٌ عباديّ، يتلخّص بالصلاة والصوم والحجّ والخمس والزكاة وغيرها؛ وتوجد بعض الأمور المتعلِّقة بالأمور المدنيّة، كالبيع والنكاح والطلاق، لكنْ لا توجد نُظُم بعنوانها العامّ. من هنا فإنّ ما يدفع الفقيه المسلم إلى الدخول في غمار هذا البحث هو الدفاع عن الإسلام، ليقول: إنّ هناك انسجاماً بين الإسلام والتغيُّرات والتحوُّلات، بين الحياة المتحوّلة والفقه والشريعة الثابتة.
أمّا العامل الثاني فهو أنّ الفقيه والمفكِّر المسلم أراد أن يوضّح إنّ للإسلام مشروعَ دولةٍ، ومشروعَ مجتمعٍ، ومشروعَ حياة. وهذا هو الذي يُطْلَق عليه في الدراسات المعاصرة (أسلمة الحياة). فكيف يمكن لك الحديث عن كلّ مرافق الحياة من غير أن تكون لك رؤيةٌ شاملة؟! مع أنّ الحياة المعاصرة تتبدَّل وتتحوَّل وتتغيَّر بشكلٍ متقارب وسريع. من هنا؛ ولكي ينطلق مشروع الدولة الإسلاميّة والحركة الإسلاميّة، أراد الفقيه والمفكِّر المسلم أن يضع جواباً عن هذه التساؤلات. فكيف يمكن له أن يسنّ قوانينه للقرن العشرين على أساس قوانين جاءت في القرن السابع والثامن الميلاديَّين؟!
ربما يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات في علاج إشكاليّة الثابت والمتغير في القضايا الفرديّة الجزئيّة، لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة في القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، وعلينا التفكير الجادّ في سبيل إيجاد الحلّ المناسب لذلك.
وما يزيد هذا الأمر تعقيداً أنّ الفقه يرى شمول الأحكام لجميع الوقائع الحياتيّة، حتّى عُرف عن الفقهاء هذه الكلمة: (ما من واقعةٍ إلاّ ولله فيها حكمٌ). ويستندون في ذلك إلى عدّة أدلّة؛ حيث أورد الحُرّ العاملي ما يقرب من سبعين رواية في باب (يتحدّث عن أنّ الشريعة تجيب على كلّ الأمور الصغيرة والكبيرة)، وذلك من كتابه (الفصول المهمّة في أصول الأئمة). وهذه قاعدةٌ تحتيّة ثابتة عند الفقيه عادةً.
ومن جهةٍ أخرى نلاحظ أنّ الحياة مستجدّةٌ متطوّرة، تحمل حوادث ووقائع ليس لها وجود في عصر التشريع الأوّل، كما في الاستنساخ البشري.
وعلى هذا، فما هو الحلّ الأنسب والأوفق لحلحلة هذه الإشكاليّة؟!
سأقوم هنا بتقديم طريقتي الخاصّة، وتقسيمي الخاصّ للمشهد الذي تحكي عنه النظريات. وسأقتصر على بعض النظريّات المحدودة التي أتَتْ في سياق الجواب عن هذا السؤال الكبير. وسأذكر ـ بحول الله ـ بعض الملاحظات النقديّة العابرة؛ طَلَباً للاختصار. وقد لا يُسعفني الوقت لطرح رؤيتي الشخصيّة هنا؛ لأنّها تقوم على سلسلة من البنيات التحتيّة التي لا تسمح طبيعة الموضوع بمعالجتها هنا.
الاتجاهان المركزيّان في معالجة الموضوع
وفي سياق معالجة هذا الموضوع وُجد اتّجاهان أساسيّان، يمكن أن تنضوي تحتهما جميع النظريّات تقريباً:
الاتّجاه الأوّل: إنّ الشريعة تستوعب كلّ مرافق الحياة، ولكنّ الأحكام في هذه الشريعة على نوعين: ثابتة؛ ومتغيِّرة ترجع إلى هذه الثابتة. فكما أنّ في القرآن متشابهات ترجع إلى المُحْكَمات، كذلك الأمر في الشريعة أيضاً. ومن ثمّ فلا نَقْصَ في الشريعة بناءً على هذا الاتّجاه. وهذا الاتّجاه يميل للإسلاميّة.
الاتّجاه الثاني: إنّ الشريعة كلّها متغيِّرة، ولا يوجد ثباتٌ فيها. نعم، الثابت هو القِيَم الأخلاقيّة فقط. وهذا الاتّجاه أقرب للعلمانيّة.
أولاً: أطروحات التيّارات ذات الميول الإسلاميّة (مشروع المرجعيّة المساعدة)
وإيضاحاً للاتّجاه الأوّل طرح أتباعه تفسيراً له، حيث قالوا: كما أنّ لدينا ثوابت لدينا متغيِّرات تديرها مرجعيّةٌ ثابتة مساعدة أيضاً. وقد وضعت الشريعة هذه المرجعيّات الثابتة بغية سنِّ القوانين. وقد انقسم أتباع هذا الاتّجاه في تفسير وتحديد هذه المرجعيّة إلى ثلاث نظريّات أساسيّة:
1 ـ المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة (ولاية الأمر)
يذهب السيد محمد باقر الصدر والعلاّمة محمد حسين الطباطبائي وأمثالهما إلى أنّ المرجعيّة المساعدة التي نرجع إليها في المتغيِّرات؛ لتعطينا القوانين المواكبة للحياة، هي مرجعية ولاية الأمر.
يقول السيد الطباطبائي: «إنّ الأحكام والقوانين التي يجب تنفيذها في المجتمع تنقسم من وجهة نظر الإسلام إلى نوعين، هما:
النوع الأول: الأحكام والقوانين التي لها جذر تكوينيّ ثابت، مثل: احتياجات الإنسان الطبيعيّة التي تفضي إلى مقتضيات ثابتة غير قابلة للتغيير؛ بحكم ارتباطها بالبنية التكوينيّة الثابتة للإنسان نفسه. فتَبَعاً لوجود مثل هذه المقتضيات الثابتة والحاجات غير المتغيِّرة يجب أن تكون هناك أحكام ثابتة، وذلك من قبيل: الأحكام والقوانين ذات الصلة بالمِلْكيّة والاختصاص، وأحكام المعاملات والوراثة، وأحكام الزواج والطلاق واعتبار الأنساب، وأحكام الحدود والقصاص ونظائر ذلك.
ومن هذا القبيل: أحكام العبادات، التي ترتكز إلى جذرٍ ثابتٍ، يتمثَّل برابطة الربوبيّة والعبودية، ممّا لا يمكن أن يطالها التغيير، أو ينالها الاهتزاز أبداً.
هذه السلسلة من الأحكام والقوانين هي بنفسها الشريعة الإسلامية، التي جاء بيان كلِّياتها في القرآن الكريم، وتكفَّلت السنّة النبويّة ببيان جزئيّاتها وتفاصيلها. هذا اللون من الأحكام (الشريعة) لا طريق لنسخه أو إبطاله بنصّ القرآن وصريح السنّة.
النوع الثاني: الأحكام والقوانين ذات الصلة بالحياة اليومية للناس. ومثل هذه القوانين تكون بالضرورة محكومةً بالتغيير، وذلك تبعاً للتغيير والاختلاف الذي يطرأ على طرق الحياة ووسائل معاش الناس من يوم الى آخر؛ ومن عصرٍ إلى عصر.
ومثال هذه الأنظمة المتغيِّرة: التحوّلات التدريجيّة التي طرأت على وسائل النقل، بحيث كان بديهياً أن يقود وجود الطرق البريّة والبحريّة والجويّة إلى انبثاق أوضاعٍ جديدة تستدعي بدورها إيجاد وتطبيق سلسلة من النُظُم الجديدة التي لم يكن لها حاجةٌ في العصور السابقة». (الطباطبائي، الشيعة، نصّ الحوار مع المستشرق كوربان: 141، تعريب: جواد علي كسّار، مؤسَّسة أم القرى للتحقيق والنشر، ط2، 1418هـ، بيروت، لبنان).
وهكذا يخلص الطباطبائي إلى أنّ الأحكام من النوع الثاني هي التي يضعها ويسنّها وليّ الأمر (الحاكم الشرعي في الدولة الإسلاميّة)، في إطار الإسلام، وتَبَعاً لمقتضيات المصالح الطارئة المستجدّة، ثمّ ترتفع هذه الأحكام والقوانين وتسقط بصورةٍ طبيعيّة تلقائيّة بمجرد انتفاء المصالح الموجبة لها. (انظر: الطباطبائي، مقالات تأسيسيّة في الفكر الإسلامي: 351، تعريب: جواد علي كسّار، مؤسَّسة أم القرى للتحقيق والنشر، ط2، 1418هـ، بيروت، لبنان).
أمّا السيّد محمد باقر الصدر فقد ذهب إلى أنّ الأحكام في الشريعة على نوعين: إلزامات، وهي الأمور الإلزاميّة التي نرجع فيها إلى النصّ؛ ومباحات، وهي الأمور التي يحقّ فيها لوليّ الأمر أن يشرّع قوانين إلزاميّة تَبَعاً لما يراه من مصلحةٍ، في ضوء المؤشّرات العامّة للشريعة الإسلاميّة، وهي التي اصطلح عليها بـ (منطقة الفراغ). (انظر: الصدر، اقتصادنا، المطبوع ضمن: موسوعة مؤلَّفات السيّد الشهيد 3: 443 فما بعد؛ والإسلام يقود الحياة، المطبوع ضمن: موسوعة مؤلَّفات السيّد الشهيد 5: 43).
فالنقطة التي يلتقي فيها السيّد الصدر مع السيّد الطباطبائي هي في وجود الثوابت والمتغيِّرات في الشريعة. أمّا الثوابت فالمرجعيّة فيها هي النصوص الدينيّة وأمثالها فقط؛ وأمّا المتغيِّرات فالمرجعيّة فيها وليّ الأمر، الذي يحقّ له سنّ القوانين وفقاً لما يراه من المصلحة، في ضوء المؤشّرات العامّة للقيم والتشريعات الإسلاميّة.
لكنّ النقطة التي يختلفان فيها هي أنّ السيّد الصدر حصر دائرة صلاحيّات وليّ الأمر في قسم المباحات فقط، أمّا السيّد الطباطبائي فلم ينصّ على ذلك، بل قال: إنّ المرجعيّة في الأحكام المتغيِّرة هي وليّ الأمر. على أنّ الأخير لا يسنّ القوانين بشكلٍ مزاجيّ وفقاً لرأي هؤلاء، بل ينطلق في سنّها وفقاً للمؤشِّرات العامّة حَسْب تعبير السيّد الصدر، فهو يعي الأهداف الكبرى للشريعة، ويشرِّع القوانين الجزئيّة في إطارها وسياقاتها. وبهذا البيان يمكن سدّ الثغرة الحاصلة في ذلك.
وهذه القوانين الجزئيّة التي يسنّها وليّ الأمر مُلْزِمةٌ؛ لكنّ إلزامها لا يصيِّرها جزءاً من الشريعة. وهذه نقطة مهمّة؛ إذ قد تقول: إذا لم تكن أوامر وليّ الأمر من الشريعة فلماذا يعاقب المكلَّف على مخالفتها، وهو لم يرتكب حراماً شرعيّاً إسلاميّاً؟!
وهنا يجيب هذا الاتجاه بأنّ المسألة ليست غريبةً، بل هي أشبه بأمر الوالد ولده بجلب الماء؛ فإنّ هذا الأمر قد تجب طاعته شرعاً، لكنّه ليس حكماً تشريعيّاً إلهيّاً.
وخُذْ مثالاً آخر وهو: شخصٌ ما استأجرك بعقدٍ موقَّع بينكما أن تعمل في عمارة منزله. وهذا عقد (إجارة). والشريعة تجعل هذا العقد ملزماً للطرفين. فلو قال لك الشخص الذي استأجرك: ضَعْ لي هذا الحجر هناك، أليس من الواجب شرعاً عليك أن تضع الحجر حيث طلب؟ إنّه كذلك بالتأكيد؛ إذ بمقتضى عقد الإجارة تكون أنت ملزماً بأن تعمل بما يطلب منك الطرف الآخر، لكنْ هل وضع الحجر هناك هو جزءٌ من الدين، بحيث لو أردنا أن نشرح الدين فنحن نذكر وضع الحجر في هذا الموضع على أنّه قضيّةٌ دينيّة؟!
والجواب بالنفي بالتأكيد. فأنت هنا ملزَمٌ بالطاعة، ولكنَّ المضمون ليس جزءاً من الدين. وما هو جزءٌ من الدين هو وجوب الالتزام بالعقود الموقَّعة بين الناس. وهكذا الحال في إمكانيّة إلزام الزوجة بالتمكين عندما يريد الزوج، ولكنّ نفس طلب الزوج ليس جزءاً من الدين. وبهذا يمكن الجمع بين دينيّة الإلزام وعدم دينيّة المضمون الملزَم به.
ملاحظات على مرجعيّة ولاية الأمر في حلّ معضل الثابت والمتغير
وقد سجَّل بعض العلماء ـ ويمكن أن تُضاف ـ ملاحظاتٌ ومناقشات أمام اتّجاه الطباطبائي والصدر، الذي يمثِّل اتجاهاً واسعاً داخل الرؤية الفقهية لكثير من الحركات الإسلاميّة اليوم. وسأكتفي ببعض الملاحظات، تاركاً تفصيل ذلك إلى الدراسات المختصّة؛ إذ قد تبلغ الملاحظات هنا ما يقارب عشر ملاحظات، فصَّلناها في دروسنا الأصوليّة.
حين ينصّ السيّد الصدر على عنوان منطقة الفراغ فهل يعني من ذلك وجود فراغ حقيقيّ في الشريعة الإسلاميّة؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف هو السبيل للتوفيق بين هذا الفراغ وبين المنطلق الذي قرَّره الأصوليّون، والقائل: ما من واقعة إلاّ ولله فيها حكمٌ؟!
وفي سبيل حلِّ هذا الإعضال علينا أن نستبعد أن يكون المقصودُ من وجود منطقة فراغٍ الفراغَ التشريعي؛ لأنّ هذا لا ينسجم مع البنية التحتيّة الأصوليّة الكلاميّة، والتي أثبتت ـ وفق رأي مشهور الفقهاء ـ عدم وجود فراغٍ تشريعي في الشريعة الإسلاميّة.
وبعد استبعاد هذا اللون من الفراغ ينفتح المجال أمام لونٍ آخر من الفراغ يقع في دائرة المباح، وهو الذي يُصْطَلَح عليه بـ (الفراغ الإلزاميّ). وهنا حين نرجع إلى وليّ الأمر فعلى أيّ أساسٍ يسنّ وليّ الأمر القوانين في هذه الدائرة؟
قالوا: هناك أساسان يعتمد عليهما وليّ الأمر في ذلك:
أـ العنوان الثانوي.
ب ـ المصلحة والمفسدة.
فإذا سنّ وليّ الأمر القوانين على أساس العنوان الثانوي فلا خلاف في هذا، إذا جاء ذلك مخالفاً للحكم الأوليّ. وليس هذا من مرجعيّة وليّ الأمر. بل إنّ بعض القواعد الفقهيّة ـ كقاعدة لا ضرر، ولا حَرَج ـ حاكمةٌ على سائر الأدلّة الأوليّة. وعلى هذا فإذا كان المقصود من سنّ القوانين الجديدة لمواكبة الحياة هو من خلال العودة إلى العناوين الثانويّة الشرعيّة، كقاعدتي لا ضَرَر ولا حَرَج وقواعد التزاحم وغيرها، فهذا الأمر ليس جديداً؛ لأنّ جميع العلماء يقولون بذلك. بل حتّى مَنْ لا يرى وجود منطقة فراغ في الشريعة الإسلاميّة يذهب إلى ذلك. وطبعاً يبقى سؤال نتركه الآن: هل تستطيع العناوين الثانوية وحدها أن تخلق نظاماً تشريعيّاً مُعِينَاً وواسعاً في ظلّ المتغيِّرات الكثيرة؟!
أمّا إذا سنّ وليّ الأمر القوانين على أساس المنطلق الثاني (المصلحة والمفسدة)، بأن نقول: إنّ لوليّ الأمر ولاية ممنوحة له على المجتمع، كولاية الأب على الطفل الصغير القاصر. وإنّ هذه الولاية يمكنه إعمالها من غير حاجةٍ إلى استخدام عناوين ثانويّة أو غيرها، ولا يشترط فيها إلاّ وجود المصلحة للمولَّى عليهم، حيث يقوم الأب بتشخيص المصلحة بعقله المتواضع، ثمّ يسنّ القوانين لأولاده، منظّماً أمورهم. وإنّ هذه الولاية التي في دائرة الأسرة يمكن توسعتها للأمّة كلّها بالنسبة لوليّ الأمر. وهنا لا تلجأ الدولة الإسلاميّة إلى العناوين الثانويّة، بل تمارس نفس الولاية التي أُعطيَتْ للأب والجدّ على الأولاد؛ للتصرُّف بشؤونهم وفقاً لما يرَوْنه من مصلحةٍ لهم، فيكون هذا التدخُّل عن طريق دليل الولاية، لا عن طريق دليل العناوين الثانويّة.
ونصوص السيّد الصدر تؤيِّد هذا الافتراض، رغم أنّ ما كتبه الصدر عن هذا الموضوع ـ وللأسف ـ ليس سوى صفحاتٍ قليلة في كتابَيْه: (اقتصادنا)؛ و(الإسلام يقود الحياة)، بنحو الاستطراد، ولو طرحه في بحوثه الأصوليّة لكان علاجه له وإيضاحه أكبر. من هنا كان لزاماً علينا الذهاب خلف عباراته المختصرة؛ للتكهُّن بما يريد.
والأمر كذلك عند العلامة الطباطبائي، فالبحث عنده جاء بشكلٍ استطرادي، وليس بنحو تأصيلي وتأسيسي موسَّع.
ومجمل القول عندهم: إنّ ما يمارسه وليّ الأمر لا يرجع إلى العناوين الثانويّة بالضرورة، وإنّما إلى دليل ولايته، وإعمال القوانين وفقاً لما يراه من مصلحةٍ. كما لا يحقّ له التدخّل في الأحكام الشرعيّة؛ لكونها شرع الله الثابت. ولكنْ حيث إنّها مساحة مباحات فيكون تدخّل وليّ الأمر فيها بالوضع والرفع غير مخالف لشرع الله عزَّ وجلَّ.
إذن إذا أردنا أن نحلِّل نظريّة مرجعيّة ولاية الأمر المساعدة ـ والتي تبنّاها الطباطبائي والصدر و… ـ نلاحظ أنّها ترجع في حقيقة الأمر إلى دليل الولاية، الذي يسمح لوليّ الأمر بسنّ القوانين وفقاً لما يراه من المصلحة؛ لأنّ دليل الولاية يعطيه الصلاحيّة في هذه الدائرة، لا أنّه يرجع إلى العناوين الثانويّة بالضرورة.
وهنا يتَّضح الفرق بين نظريّة الطباطبائي والصدر؛ فالأوّل لم يفرِّق بين المباح وغيره. ومن هنا أشكلوا عليه بكون الترخيص الذي منحْتَه لوليّ الأمر لازمه الاجتهاد في مقابل النصّ؛ لأنّ نظريَّتك تقول: يمكن لوليّ الأمر سنّ القوانين في دائرة الإلزامات (= غير المباح) وفقاً لما يراه من مصلحةٍ، وهذا بعينه تعطيلٌ للشريعة، في مقابل نظر وليّ الأمر، بلا دخول العناوين الثانويّة على الخطّ.
من هنا نلاحظ أنّ نصوص السيّد الصدر كانت أكثر دقّةً من الزاوية الأصوليّة من عبارات الطباطبائي؛ لأنّ كلمات الأخير حملت ظاهراً استوحي منه أنّ لوليّ الأمر حقّ التدخّل في المتغيِّرات مطلقاً، سواء أكان فيها إلزامٌ أم لا. وهذا خلاف النصّ الموجود في هذا الإطار.
وعليه، فمرجعية دليل الولاية إذا أخذ على إطلاقه ليشمل الإلزامات توقعنا في الاجتهاد المقابل للنصّ، أمّا إذا تمّ حصرها بالمباحات، كما فعل السيد الصدر، فهي توقعنا في إشكاليّةٍ أخرى، وهي أنّ الشريعة قد منحت العقل الإنسانيّ (عقل وليّ الأمر) صلاحية سنّ القوانين في مدد زمنيّة طويلة تَبَعاً لحاجات البشر، وهذا إقرارٌ ضمنيّ حقيقيّ بأنّ الشريعة لم تكن قادرةً على أن تسنّ قوانين جميع الشعوب في جميع الأزمنة والأمكنة من خلال نصوصها التي ترجع إلى مئات السنين الماضية. وبهذا يأخذ الناقد العلماني وثيقةً إضافيّة من نصوص المفكِّرين الإسلاميّين بأنّهم يقرّون بأنّ الشريعة ليست قادرة ـ من خلال نصوصها الأصليّة ـ على تغطية جميع الوقائع، وأنّ مجموعةً وافرة من الوقائع المستجدّة قد مُنحَتْ صلاحيّة تشخيص المصلحة والمفسدة فيها لوليّ الأمر، ليُصدر قوانينه بهذا الصدد في دائرتها. وهذا نقضٌ حقيقي لقاعدة: ما من واقعةٍ إلاّ ولها حكمٌ، وأمثال هذه القواعد، التي تفترض بوصفها مسلَّمات قاطعة في الاجتهاد الشرعي!
وعليه، فنظرية مرجعيّة وليّ الأمر إما ترجع إلى العناوين الثانوية، فلا جديد فيها؛ أو ترجع إلى مرجعيّة العقل الإنساني في سدّ فراغ التقنين الديني، وهذا يناقض أصول مدرسة أصحاب هذه النظريّة.
إنّ نظرية مرجعيّة ولاية الأمر هنا مطالَبةٌ بالجواب عن هذا التساؤل. وثمّة ملاحظاتٌ عدّة أخرى نتركها للتفاصيل والمطوَّلات.
2ـ مرجعيّة المبادئ الفقهيّة التحوّليّة المساعدة (نظريّة مشهور الفقهاء)
اختار هذه النظريّة جمهور الفقهاء القدامى والمعاصرين. وهي نظريّة ترى عدم وجود منطقة فراغ في الشريعة الإسلاميّة، كما أنّه لا توجد متغيِّرات يمكن للفقيه أن يسنّ القوانين لها، بل ليست له مثل هذه الصلاحيّة أساساً، والخطأ الذي حصل هو تصوّر وجود عجز داخل المنظومة الاجتهاديّة أظهرها غير قادرة على تغطية مساحة المتغيِّرات، فألجأها لمرجعيّاتٍ مساعدة، كمرجعيّة وليّ الأمر في سنّ القوانين، في حين أنّ واقع الحال ليس كذلك، حيث جهَّزت المنظومة الاجتهاديّة بعدّةٍ ذاتيّة كافية لتغطية المستجدّات.
إنّ حلّ المشكلة ـ عند هذا الاتجاه ـ يكون من خلال وضع أربعة مبادئ متعاضدة متكاتفة متعاونة، وهي:
المبدأ الأوّل: تغيُّر الأحكام بتغيُّر العناوين
إنّ هذا المبدأ هو الذي يضمن ـ عند هذا الاتجاه ـ حركيّة الفقه، وهو الذي يُطلق عليه قديماً عنوان: (تبعيّة الأحكام للأسماء)، أو كما اصطلح عليه المتأخِّرون: (تبعيّة الأحكام للعناوين)، أو (تغيُّر الأحكام بتغيُّر موضوعاتها).
فالماء الطاهر يحتفظ بوصفه واسمه، ومن ثمّ جواز شربه والتوضُّؤ به، طالما لم يتَّصف بالنجاسة، ويتبدَّل اسمه إثرها، فيكون ماءً نجساً. فالأحكام تتغيَّر تبعاً لتغيُّر العناوين. وهذا الأمر موجودٌ في حياتنا بشكلٍ طبيعي؛ فربما يكون الشيء حراماً في فترةٍ من الفترات، وها هو اليوم يتحوَّل إلى حلالٍ؛ لتغيُّر عنوانه الذي صُبَّتْ عليه الحرمة إلى عنوانٍ يقتضي ويستدعي الحلِّيّة. وبهذه الطريقة نضمن عدم جفاف الشريعة وجمودها.
المبدأ الثاني: العناوين الثانويّة
يمكن الركون إلى العناوين الثانويّة لتكييف الحياة مع متطلَّباتها واقتضاءاتها؛ فحين يتزاحم الأكثر ضرراً مع الأقلّ ضرراً تأتي قاعدة التزاحم؛ لتقدِّم الأقلّ ضرراً على الأكثر؛ وحينما يكون الحكم المعيّن ضارّاً بمعنى من المعاني فسوف تتدخّل قاعدة (لا ضرر)؛ من أجل نفيه أو تحجيمه؛ وكذا الأمر في قاعدة (لا حَرَج) مثلاً. وهذا معناه أنّ الأحكام الأوَّليّة تقع على الدوام تحت سلطان العناوين الثانوية، القادرة على نفيها أو تحجيمها في موردها. فحينما تثبت الولاية لشخصٍ فغاية ما هنالك هو أنّه سوف يتمكَّن من إعمال القواعد الثانوية نفسها في المواطن المسموحة، وهنا لا يضع هو أيَّ حكمٍ، ولا يلغي أيَّ حكمٍ، بل يقوم بتطبيق الحكم الثانوي على مورده الخارجي. فدورُه تطبيقيّ تنفيذيّ، وليس تشريعيّاً تقنينيّاً.
المبدأ الثالث: عمومات الشريعة وإطلاقاتها
جاءت الأحكام في الشريعة الإسلاميّة على نحو القضيّة الحقيقيّة، أي إنّ موضوعها ليس الموضوع الخارجيّ الذي صدر الحكم لإعطاء موقفٍ إزاءه، بل هو موضوعٌ مقدَّر على طول الزمان، فكلَّما فُرض موضوعٌ بهذه المواصفات فهذا حكمه. وهذا يعني أنّ لمثل هذه الأحكام استمراريّة عالية في التطبيق، لا تقتصر على المصداق الخارجيّ في زمانها، بل تتعدّاه إلى كلِّ الأزمنة القادمة، شرط توفُّر نفس الشروط والمواصفات.
ومن خلال عمومات هذه النصوص وإطلاقاتها نستطيع أن نوفِّر الحكم المناسب لكلّ المتطلَّبات في عصرنا الحاضر.
فالاستصحاب روايةٌ وردت في باب الوضوء، وأخرى في باب الصلاة، لكنّ الفقيه الأصوليّ استنتج منها قاعدةً كلِّية عامّة، جعلتها تنطبق في جميع موارد الشكّ المسبوق باليقين.
كما أنّ الضرر الذي نفَتْه الشريعة كما ينطبق على تناول السمّ ينطبق أيضاً على استنشاق الهواء الذي يحمل إشعاعات نوويّة مثلاً، دون فرقٍ بينهما.
وهكذا الحال في (العقود المُستحْدَثة والمعاملات الجديدة)، فهي مشمولة لعنوان وجوب الوفاء بالعقود الوارد في الآية الأولى من سورة المائدة. فمهما كثرت المعاملات والعقود واستجدَّتْ فلدينا نصوصٌ عامّة ومطلقة زمانيّاً وأفراديّاً وحاليّاً تصلح لاستيعابها، بلا حاجةٍ إلى نصوصٍ خاصّة في واقعةٍ حادثة في هذا الزمان أو ذاك.
المبدأ الرابع: ولاية الأمر، من القوانين إلى المقرَّرات
حينما لا تنفع إطلاقات الشريعة وعموماتها في الاستجابة لابتلاءات الناس وقضاياهم في هذه العصور، كما في قوانين السَّيْر والبيئة، فإنّ المجيب في مثل هذه الحال هو النظام السياسي الذي يختاره الفقيه في عصر الغيبة، سواءٌ كان ولاية الفقيه العامّة أو شورى الفقهاء أو نظريّة ولاية الأمّة على نفسها أو غير ذلك.
وقد ذهب الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في نقده لنظريّة السيّد الصدر المتقدِّمة إلى أنّ الأحكام التي يسنّها وليّ الأمر ما هي إلاّ مقرّرات إجرائيّة تطبيقيّة، وليست قوانين تشريعيّة، ومن ثمّ لا تحمل هذه القوانين طابعاً تأسيسيّاً يقع في عرض وبموازاة أحكام الإسلام الأساسيّة. كما لا يوجد في الإسلام فراغٌ لكي تأتي مثل هذه الأحكام لملئه، بل هي قوانين جزئيّة، تتعلَّق بآليّة التطبيق، لا بالحكم نفسه.
ومجمل القول في هذه النظريّة: إنّ هذه المبادئ الأربعة هي التي تستطيع أن تحلّ لنا الأزمة التي تخلِّفها ما يُطلق عليه (منطقة الفراغ)؛ وذلك من خلال تغيُّر الأحكام تبعاً لتغيُّر عناوينها؛ أو من خلال العناوين الثانويّة؛ أو من خلال عمومات الأدلّة وإطلاقاتها؛ أو من خلال إعطاء وليّ الأمر صلاحيّة سنّ مقرَّرات إجرائيّة تطبيقيّة جزئيّة. ومن هنا حاول هذا الفريق من العلماء، الذين لأكثرهم موقفٌ سلبيّ من حركة التحديث في الفقه، أن ينتقدوا نظريّة الطباطبائي والصدر، حيث وسموا نظريّاتهم هذه بكونها تقرِّر نقصان الشريعة، وهو أمرٌ مسلَّم البطلان.
تساؤلات نقديّة في النظريّة المشهورة
هناك العديد من الملاحظات النقديّة على هذه النظريّة. ولا أريد الآن أن أخوض فيها؛ فالمجال لا يسمح، وأكتفي بمداخلةٍ واحدة، وهي أنّه من حقّنا هنا أن نتساءل: هل حقّاً أنّ الأحكام الولائيّة هي في واقع الأمر مقرَّرات إجرائيّة تنفيذيّة بسيطة، وليست سنّاً لقوانين إضافيّة، كما تحاول هذه النظريّة أن تبسِّطها؟!
يبدو لي أنّ الصدر والطباطبائي والمطهَّري وآخرين شعروا بأنّ مساحة الأحكام الولائيّة ليست بسيطةً، ومن ثمّ لا يمكن أن يقال: إنّها مجرّد إجراءات تطبيقيّة يسيرة، كما تذهب لذلك النظريّة الآنفة الذكر؛ فكيف يمكن الذهاب إلى أنّ قوانين البيئة مثلاً هي أمورٌ بسيطة؟! وكيف يمكن أن نتعقَّل أنّ الشريعة التي اهتمَّتْ بطريقة دخول الإنسان إلى بيت الخلاء لم تهتمّ بقضايا الاحتباس الحراري وذوبان الجليد في القطب الشمالي والموادّ الكيميائيّة التي أُسِّست لها مجالس قانونيّة في العالم؛ بغية إيجاد الحلّ المناسب لها؟! كيف يمكن تبسيطها وجعلها قضايا جزئيّة بسيطة فيما أحكام الطهارة والنجاسة قضايا كلِّية وعميقة، تحتاج لتدخُّلٍ مباشر من الله تعالى؟!
من هنا، قد يصف المنتصرون لنظريّة أمثال: الصدر والطباطبائي… النظريّةَ أعلاه بكونها تبسّط المشكلة، ولا تنظر إليها بعُمْقٍ. فالدولة ومؤسَّساتها التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، بمختلف تشعّباتها وتراتبيّتها، مع آلاف القوانين المتعلِّقة بعمل المحاكم والوزارات و…، تحتاج إلى رؤيةٍ معمَّقة لا يمكن طرحها من خلال المبادئ الأربعة التي طرحتها النظريّة المتقدِّمة. ولا يمكن افتراض جميع هذه الأمور ثانويّة بسيطة تحتاج إلى مقرَّرات إجرائيّة جزئيّة تطبيقيّة. كما لا يمكن للباحث أن يتعقَّل أنّ أمثال هذه الأمور تحتاج إلى قوانين إجرائيّة جزئيّة تفتقدها النصوص الشرعيّة الأساسيّة، بينما نجد نصوصاً شرعيّة في قضايا جزئيّةٍ بسيطة للغاية في حياة الإنسان! هذا كلُّه يدعونا إلى تقديم نظريّة أكثر عمقاً ودقّةً من هذه النظريّة.
إنّ تغيير كلمة (القوانين) إلى كلمة (المقرَّرات)؛ بهدف تبسيط دور العقل الإنساني وعقل وليّ الأمر في ما يقوم به، لا يغيِّر من واقع الحال شيئاً. فالنصوص الدينية الموجودة اليوم ليس فيها شيءٌ عن الكثير من هذه المسمّاة بالمقرَّرات، رغم أنّ هذه المقرَّرات تطال اليوم أبعاداً عميقة في تنظيم حياة الإنسان المالية والاقتصادية والسياسيّة والاجتماعيّة وغيرها، أليس من الأفضل أن نقول بأنّ حجم هذه التحوُّلات ـ مع عدم وجود نصوص، وإنّما مبادئ تشريعيّة عامّة ـ كاشفٌ عن أنّ الشريعة تركت هذا الأمر من الأوّل، وأوكلَتْ إلى العقل الإنساني أن يدير أموره في ظلِّ عناوين شرعيّة عامّة؟! فلماذا نبخل على العقل الإنساني في تسمية نشاطه الضخم هذا بأنّه تقنينٌ، ونقوم بتقزيم جهوده، عبر وصفها بأنّها مجرَّد مقرَّرات أو تطبيقات؟! وسوف يأتي مزيدٌ من توضيح هذا النقد عند استعراض نظريّة العلاّمة شمس الدين.
وخلاصةُ القول: إنّ إعطاء شخص ثلاث أو أربع قواعد قانونيّة عامّة؛ ليقوم بوضع مئات المقرَّرات في ضوئها، يستدعي منطقيّاً تسمية جهوده هذه بالتقنين الجزئي تحت سقف الدستور الكُلِّي؛ فليست القوانين الجزئيّة في كثيرٍ منها سوى استعانة بكُلِّيات الدستور، وتحويلها إلى مفردات قانونيّة، فكيف نسلب وصف التقنين عن كلِّ هذا؟ وما هي معايير تسمية هذا الجهد تقنيناً أو سَنّاً لمقرَّرات؟ هل قدَّمت هذه النظريّة رؤيةً تمييزيّة بين جهود التقنين البشري (المقرَّرات) وما تقدِّمه النصوص الدينية من قوانين جزئيّة كثيرة أيضاً، حتّى نقول: هذا تقنين، وذاك ليس بتقنين؟! وأين؟! وهل التقنين ـ بوصفه مفهوماً ـ مشروطٌ بالخلود، فنحن لا نريد أن نخلع على هذه الجهود اسم القانون الكُلِّي الأبدي، لكنَّ توصيفه بأنّه تقنين ـ ولو زمنيّ ـ ليس أمراً غير موضوعيّ أبداً، بعيداً عن أيديولوجيا التبرير والتوجيه.
3ـ مرجعيّة أدلّة التشريع العليا المساعدة (نظريّة العلاّمة شمس الدين)
يذهب الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى أنّ المرجعيّة المساعدة لحلّ أزمة المتغيّرات هي ما يُسمَّى بـ (أدلّة التشريع العليا). ولهذا لم يقبل بالنظريّة الأولى واتّجاهاتها، ولا بالنظريّة الثانية ومبادئها.
لقد مال العلاّمة شمس الدين إلى أنّ الشريعة الواقعيّة في اللوح المحفوظ شاملةٌ لكلّ الوقائع والأحداث، لكنّ النصوص الواصلة إلينا لا تفي بذلك، وليس لها قدرة شمول لكلّ الوقائع الحادثة، ولا يمكن للنصوص ـ خلافاً للإجماع الإماميّ ـ أن تُغطّي مساحات الحياة، لا بالعمومات ولا بالإطلاقات. بينما المعروف والمشهور في الفقه الإماميّ أنّ الشريعة بوجودها الواصل، لها قدرة تغطية جميع متطلَّبات الحياة؛ إمّا بنحو الحكم الواقعي؛ أو بنحو الحكم الظاهري، سواء أكان أمارةً أم أصلاً عمليّاً، كما هو معروفٌ في علم أصول الفقه، بمعنى أنّها تغطّي مساحات الحياة كلّها؛ إمّا عبر الحكم الواقعي؛ أو الظاهري الظنّي؛ أو عبر الأصل العملي.
وهذه النقطة في نظريّة شمس الدين تشبه ما ذهب إليه أهل السنّة؛ إذ إنّهم لجأوا إلى القياس؛ لعدم توفّر نصوص دينيّة أو نصوص من الصحابة أو إجماعات؛ لحلّ القضايا المُستحْدَثة في حياتهم. ومن هنا تداول في فقهم اصطلاح: (ما لا نصّ فيه). لكنّ الفقه الإماميّ لا يعاني من هذه المشكلة من وجهة نظره؛ إذ لا توجد مسألةٌ مُستحْدَثة لا يوجد فيها نصٌّ يقدر على تغطيتها، سواء كان هذا النصّ يقدِّم حكماً ظاهريّاً أماريّاً، أم كان مرجعاً لأصلٍ عملي له قدرة التغطية، كما هو مبحوثٌ في علم أصول الفقه الإمامي.
من هنا نرى أنّ تنديد أئمّة أهل البيت النبويّ بالقياس، وتحريمهم استخدامه في الأحكام الشرعيّة؛ لأنّهم قالوا: إنّ استخدام القياس مع وجود النصّ يعني مَحْق الدين والشريعة. وهكذا طلبوا من مستخدمي القياس أن يرجعوا إليهم؛ كي يعرِّفوهم ما قاله الله وما قاله رسوله، لا أن يتمسَّكوا بعدم وجدان النصّ؛ بغية تمرير قياساتهم، واستنساخ حكم أقرب الأشياء إلى القضيّة.
إنّ أدلّة التشريع العليا هي الحاكمة في دائرة ما لا يوجد فيه نصٌّ مباشر أو شبه مباشر، عند العلاّمة شمس الدين. وهذه المبادئ هي قوانين وقواعد كبرى أشبه بالدستور، وفي ضوئها تُسَنّ القوانين التفصيليّة المدنيّة، والجزائيّة، والتجاريّة، والجنائيّة…
فإذا اعتبرنا آية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10) دستوراً دينيّاً يمكن سنّ القوانين الجزئيّة على أساسه، مثل: تزاوجوا، تزاوروا، تحالفوا.
وإذا اعتبرنا مبدأ (حفظ الأمّة الإسلاميّة)، من خلال ملاحظة خطوط الشريعة العامّة، فيمكن أن يسنّ على أساسه مجموعة من القوانين التي تحفظ للدولة الإسلاميّة قوَّتها…
وهكذا يخلُص شمس الدين إلى ضرورة استقصاء المبادئ العليا للشريعة في الاجتهاد المعاصر، وهذه المبادئ العليا تشبه مفردة (المؤشِّرات) التي جاءت في بعض نصوص السيّد الصدر.
فالفارق بين نظريّة شمس الدين وكلٍّ من: نظريّة المشهور؛ ونظرية الصدر والطباطبائي، هو أنّ شمس الدين أقرّ واقعيّاً بوجود فراغٍ تشريعي على مستوى بعض التفاصيل، ولم يَرَ أنّ الأصول العمليّة وقوانين التزاحم والعناوين الثانويّة وغير ذلك ممّا ذكره المشهور بالذي يقدر على أن يؤمِّن تقنينات للمستجدّات البشريّة الكثيرة؛ وأنّ هذه الدعوى أشبه بالمبالغة الأيديولوجيّة. وفي المقابل أخذ شمس الدين بمنطلق فكرة مرجعيّة وليّ الأمر، لكنْ من زاوية أنّها إقرارٌ حقيقيّ واقعيّ بأنّ الشريعة الواصلة ليست قادرةً على التغطية، وأنّ الأصول العمليّة (البراءة؛ والاستصحاب؛ والاحتياط؛ والتخيير) لا تستطيع أن ترفدنا بما نحتاجه اليوم من مئات القوانين الجزئيّة المتفرِّقة، التي يجب تسميتها بالقوانين، وليس بالمقرَّرات.
لقد كان شمس الدين ـ من وجهة نظر المنتصرين له ـ أكثر واقعيّةً من جهةٍ، وأكثر التيّارات الإسلاميّة تسميةً للأمور بأسمائها. ولعلَّهم ينتصرون لنظريّته من خلال تجارب تطبيق الشريعة في مختلف المناطق التي مارست هذا التطبيق في العصر الحديث، حيث رأينا حجم القوانين التي سُنَّتْ في ضوء المؤشّرات العامّة والمبادئ الكُلِّية، لا في ضوء عمليّةٍ اجتهاديّة تفصيليّة على طريقة الاجتهاد الفقهي.
ولعلّ الأمر الآخر الذي لا يقلّ أهميّةً هنا يكمن في ما قدَّمه شمس الدين من تسميته النصوص بأدلّة التشريع العليا. فهو يريد بهذا أن يعطي العقل الإنسانيّ دور التشريع ـ ولو الزمنيّ ـ بما للكلمة من معنىً، غاية الأمر أنّ هذا التشريع يجب أن يمارسه العقل الإنسانيّ في ضوء القواعد الدينيّة القانونيّة العامّة، فليست القواعد هي التي تُنتج القوانين الجزئيّة بالدقّة، بل العقل يُنتج القوانين في ضوء توجيهات القواعد. والفرق بالغ الدقّة.
ويستعين شمس الدين بعدَّةٍ من المقولات، لا مجال لطرحها في هذا المختصر، مثل: دعواه أنّ الإطلاقات والعمومات منصرفةٌ عن كثيرٍ من الوقائع المُستَجِدَّة اليوم، وأنّ فرض عمومات لهذه الوقائع ضربٌ من التكلُّف والمبالغة.
تساؤلاتٌ تواجه نظريّة العلاّمة شمس الدين
ولم تَخْلُ نظريّة الشيخ شمس الدين من ملاحظاتٍ واعتراضات:
فكيف يمكن تحديد أدلّة التشريع العليا؟ وما هو الفرق بينها وبين العمومات والمطلقات؟ وإذا قُدِّر للإنسان الاجتهاد والوصول إلى قوانين في ضوء مبادئ التشريع العليا فهل تعتبر هذه القوانين جزءاً من الشريعة أو لا؟ وإذا كانت جزءاً من الشريعة فكيف يمكن القبول بشرعيَّتها ولا يوجد تنصيص من الشريعة عليها؟ وإذا لم تكن كذلك فلا فرق حينئذٍ بينها وبين نظريّة ولاية الأمر، وغير ذلك من الأسئلة العديدة.
كلمةٌ أخيرة
مجمل ما نريده قوله في هذا المقال المقتضب: إنّ إشكاليّة الثابت والمتغير، وقدرة الشريعة على التكيُّف مع الواقع المعاصر ومتطلَّباته، إشكاليّةٌ تحتاج إلى مزيدٍ من التفكير والتطوير. وإنّ الاستمرار في مسيرة علماء الجيل السابق هو مطلبٌ أساس؛ بغية التوصُّل إلى صيغةٍ عقلانيّة منطقيّة مقنعة لكيفيّة كون الدين صالحاً لكلِّ مرافق الحياة، وكيف يمكن لقانون سابق أن يُغطّي احتياجات مراحل لاحقة.
وما نتمنّاه على الدراسين من طلابنا وباحثينا أن يخصّوا هذا البحث بطروحاتهم الجامعيّة، وأن يتواصلوا معه بطرح أسئلةٍ جديدة، وإثارات نافعة؛ بغية إعطاء رؤية جديدة ومعمَّقة للبحث، نروم بذلك الوصول إلى إجابات لما يدور في خلد شبابنا في العصر الحديث، في ظلّ المرحلة العصيبة التي تمرّ على حاضر أمَّتنا الإسلاميّة، دون الاستخفاف بالعدوّ، ودون الانطلاق من انفعالٍ وردّات فعلٍ، وإنَّما من خلال رؤيةٍ بحثيّة جادّة.
إنّ مشكلة الثابت والمتغير هي التي تدفع كثيرين اليوم للحديث عن عُقْم الشريعة، وأنّه قد انتهى وقتها. لذلك قلنا بأنّ هذا الموضوع مهمٌّ؛ لأنّ التيارات الأخرى تقول بأنّكم تتكلَّفون جعل الشريعة قادرةً على تغطية مختلف الوقائع.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي