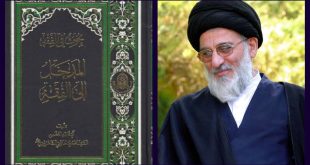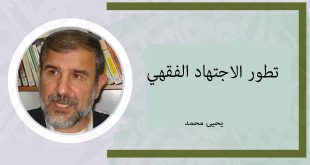بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.
الاجتهاد: إن من أهم ما تمتاز به الظاهرة التشريعية المعاصرة: امتدادها الواسع وانفتاحها الكبير على كثير من مناشط الحياة المتجددة، ومعايشها الطارئة، فقد طال الاجتهاد الفقهي المعاصر مجالات جديدة، ودرس نوازل كثيرة لم يعهدها البحث الشرعي من قبل، حتى غدا علم الفقه من فرط هذه الكثرة الكاثرة والحوادث الطارئة أوسع العلوم فروعا، وأكثرها أصولا، وأشقها ضبطا وتحصيلا.

لقد امتدت تفاصيل الحياة امتدادا واسعا لم يعرف له في تاريخ البشرية نظير، وأصبح فقيه العصر ملزما تحت وطأة هذا التوسع والتمدد بالبحث في قضايا البيئة والمجال، وأحكام المصارف والأبناك والبورصات والتأمينات، ومستجدات الطب والتداوي والعلاج، وغرائب الجرائم: المادية والفكرية والإلكترونية، والحقوق اللامتناهية للإنسان، والمرأة، والطفل، والمهاجر، والأسير، والمؤلف، والمعاق، والقارئ، والمستهلك، والموظف، وتنظيم الجمعيات المدنية، والهيئات التعاضدية والنقابية، وقوانين البحر والبر والجو…الخ.
وهكذا أصبح الاجتهاد الإسلامي يجد نفسه أمام معضلات مستحدثة، صعبة على التصور، لا ينفع معها المسلك المعهود من شأن الفقهاء في التفريع والتأصيل، أو التخريج والترجيح، بل لابد من البحث عن تدبير شرعي جديد، يكافئ الطارئ من هذه المستحدثات، ويجيب عن غرائبها وعجائبها، وذلك ما اهتدى إليه فقهاؤنا المعاصرون لما أرسوا صرح العمل الفقهي المؤسسي الذي يجمع صفوة أهل الفنون والعلوم ذات الصلة ببحث هذه النوازل ودراسة حقائقها وتبين تفاصيلها.
إن استيعاب طبائع هذه القضايا، والدراية بحقائقها، والإلمام بتفاصيلها، وتمحيص وجوه الحق والمصلحة فيها، وكشف ألوان الباطل والمفاسد الكامنة فيها، لا يمكن أن يتأتى بالملاحظة الخاطفة، أو الدراسة العابرة، بل لابد فيه من الخبرات المتخصصة، المستندة إلى الدراسات العلمية القويمة، والتجارب العملية البصيرة، وهذا شأن لا يتحصل إلا من وجه واحد، وهو الإفادة من مختلف التخصصات العلمية والخبرات الفنية ذات الصلة بتفسير وبيان هذه القضايا الحادثة.
في هذا البحث نحاول، بحمد الله، أن نتبين حاجة الاجتهاد الفقهي المعاصر إلى الإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة، ومشروعية ذلك، وضوابطه، وطبيعته، ومحاذيره، ومحاسنه.
المطلب الأول: في المقصود بالإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة، وبيان أوجه الحاجة إليها في الاجتهاد الفقهي المعاصر
نقصد بالعلوم والخبرات المتخصصة؛ تلك العلوم والمعارف التي تهتم بدراسة الواقع الإنساني وأحواله وظروفه الظاهرة والخفية؛ دراسة علمية رصينة تتنوع بين البحث الاجتماعي الهادف، والدراية النفسية والتربوية الواسعة، والإدراك القانوني والسياسي الواعي، والإحاطة الاقتصادية والطبية والاجتماعية الدقيقة، وكل ذلك بغرض قراءة وتحليل الظواهر التي تؤثر في مسار الإنسان وحركة المجتمع، بالسلب أو بالإيجاب، مع الضبط التام لأصول ذلك وفروعه، والوعي بالأنساق المعرفية والمنهجية التي يعتمد عليها في تدبير شؤونه الحيوية، ومعالجة أحواله المعيشة، والعناية الكاملة بأبعاده ومقاصده، والعلم بمشاكله والتحديات التي تواجهه.
إنها علوم وخبرات تعالج الظاهرة الإنسانية في مختلف مظاهرها؛ تفكك عناصرها وتبحث قوانينها وأسبابها وعللها وآثارها، وكل ما يتعلق بها، ومن هنا تبرز أهميتها المنهجية وقيمتها العلمية عند الحديث عن الإفادة الفقهية منها والاستئناس بخلاصاتها ونتائجها في الاجتهاد الفقهي المعاصر.
ونقصد بالإفادة منها في قضايا الاجتهاد الفقهي المعاصر: استثمار مناهجها الدقيقة، الموثوق بصحتها، والاسترشاد بنتائجها وخبراتها، عند تقرير وإصدار الأحكام الشرعية المنظمة للعلاقات الاجتماعية والمرافق الإنسانية.
إن التحول الكبير والغريب الذي طرأ اليوم على مختلف ألوان الحراك الإنساني اجتماعا واقتصادا وسياسة… لا يدع أمام كل مجتهد منصف يسعى إلى تقدير سديد وتقويم حسن لموضوع اجتهاده فرصة للإعراض عن هذه الإفادة أو الزهد في نتائجها وثمارها العلمية، فلا يستقيم أن يتأسس بحث شرعي أو حكم فقهي في قضايا شديدة التعقيد بالغة الصعوبة؛ من المستجدات الطبية والمستحدثات الاقتصادية والمالية والظواهر الاجتماعية مما لم يكن للفقه به عهد ولا اتصال، لا يستقيم أن يتأسس، اعتمادا على خبرة الفقيه غير المتخصصة وتقديره الشخصي البعيد عن الدراية العلمية الدقيقة بأحوال هذه القضايا وتصاريفها في الحياة.
إن هذه العلوم أصبحت في كثير من الأحايين، تمكننا من إعادة قراءة وتفسير كثير من نصوص الوحي قرآنا وسنة بناء على مكتشفات معرفية جديدة وبيانات علمية ثابتة، قراءة أكثر عمقا وأبعد غورا وأرشد سبيلا، “فبفضل التقدم الذي حصل فيها أمكنها أن تضع بين يديه [المجتهد] الكثير من الحقائق التي تساعد على التفسير السليم لنصوص الشريعة، سواء في ذلك العلوم الإنسانية كعلوم الاجتماع والقانون والاقتصاد، أو العلوم التجريبية كالطب، والكيمياء، وغيرها[1].”
ومن هنا تصبح هذه العلوم بمثابة الشاهد المتجدد عبر الأزمان والعصور على سمة العلمية الفائقة التي يمتاز بها الوحي الشريف، وعدم تعارضه مع القواعد والحقائق العلمية؛ متفاعلا مع كل طفرات التقدم والتطور المتسارعة في عالم اليوم؛ قائما على أساس من العلم الدقيق والدراية المحيطة.
“إن حسن إدراك المعاني الثاوية في جنبات كثير من نصوص الوحي يتوقف، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، على مدى إدراك المتصدي للنظر الاجتهادي لمبادئ هذه المعرفة، وعليه فيمكننا القول بأن في مبادئ هذه العلوم مما يتعلق بحياة الإنسان من الحقائق التي اكتشفها العقل ما يعين على تحديد وجه المراد الإلهي من بين احتمالات عدة، فيسدد النظر الاجتهادي، ويفضي تبعا لذلك إلى ترشيد التدين بتحكيم الأفهام السديدة في شؤون الحياة[2].”
وبالجملة فإن كثرة هذه المستحدثات الطارئة وتنوعها لاشك يتطلب أمر تدبيرها، وتقرير ما يناسب من الأحكام الفقهية بشأنها، تداخل وتكامل كثير من التخصصات العلمية والخبرات الفنية التي يحتاجها الفقيه وهو يدير هذا الشأن ويسبر هذه الأغوار، فهي كثيرة ومتنوعة، ويصعب وضع قائمة حصرية لكل العلوم التي يمكن أن تقدم إفادات علمية رصينة للاجتهاد الفقهي المعاصر،
غير أنه بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.
وأولها: علم الاجتماع؛ وهو “من الفنون المعرفية المهمة في تنظيم حركة المجتمع، ودراسة ظواهره، ومتعلقاته، والعمل على تحقيق أفضل النظم والمعاملات…[3]”.
وفائدته أنه لما كانت غاية الفقه والاجتهاد تنظيم المجتمع، وضبط مرافقه على وفاق الميزان العدل، وكان علم الاجتماع دراسة علمية لحركة هذا المجتمع وظواهره، لزم من ذلك أن تكون أبحاث هذا العلم، ونظرياته ونتائجه العلمية خير قاعدة وأقرب تفسير يمكن أن يستأنس به، أو يعتد به في صياغة وتقرير ما نريد من القواعد (مع مراعاة ما سيأتي ذكره من المحاذير).
وأمثلة ذلك في الاجتهاد الفقهي المعاصر كثيرة، وكلها تفصح عن جدوى وفائدة إجراء البحث الاجتماعي المنضبط بضوابط العلم والهادف، ومن ذلك:
ـ إسناد الحضانة عند فقد الأبوين، لمن تثبت؟ وهل ينفع في ذلك التقنين العام الجامد؟ أم يسند أمر البث فيها إلى البحث الاجتماعي الدقيق، فينظر حينئذ في كل حالة على حدة؟
ـ اختيار أكثر القوانين الأسرية المعاصرة، ومنها التشريع المغربي القديم خلافا للجديد؛ ترتيب مستحقي الحضانة على نسق مذهبي معين، وبعضها يحتاط فيشترط بعض الشروط في الحاضن من قبيل اليسر والكفاءة، ونحو ذلك. والحق أن ترتيب الحاضنين على نسق قانوني جامد لا وجه له؛ لأن علة الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه، وهي أمر تقديري له أبعاده الدينية الخلقية، وتكاليفه المادية، وحاجاته المعنوية، وكل هذا على التحقيق لا تعلق له بقوة القرابة إلا افتراضا،
ومن ثم فإنه لا يتأتى فيه الترتيب على النمط التقنيني المذكور، فقد يكون عند بعض الحاضنين ممن لهم تأخر في الترتيب من الخبرة والاستعداد والكفاءة ما ليس في كثير من المتقدمين، وهذا أمر ملحوظ، بل هو كثير، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما؛ فلذلك يكون البحث الاجتماعي الكاشف حقيقة عن مصلحة المحضون فاصلا وحكما في كثير من حالات الاستحقاق.
ـ زواج المرأة بغير ولي وخطورته الأسرية والاجتماعية. فقد سارت معظم التشريعات المعاصرة على إسناد الولاية للمرأة الرشيدة في مباشرة عقد النكاح عن نفسها، ومنعوا الصغيرة التي لا خبرة لها بهذه الشؤون، وحجة ذلك: الجمع بين نصوص كثيرة تسند هذا الحق للمرأة تارة، وللولي تارة أخرى على ما هو مفصل في كتب الفروع.
والحق أن من تأمل مقاصد الولاية وعللها وشروطها وتطبيقاتها الجارية في مجتمعاتنا المعاصرة يدرك أن الأمر لا يخلو من مخاطرة، فقد يكون في الرشيدات ذوات عقل وبصيرة، ولا شك أنهن المقصودات بقول من أجاز ولايتهن على أنفسهن، وقد يكون فيهن من ليس لها من وصف الرشد إلا الاسم؛ خصوصا من لم يتجاوزن سن الرشد إلا بزمن قليل، فلا يزال في كثيرات منهن من الضعف وسوء التقدير وقصر النظر ما يمنعهن من إدراك خطورة ما هن مقبلات عليه، فلذلك تضيع مصالحهن، ويتعرضن للإساءة والإذاية، وربما لحق شيء من ذلك ذرياتهن، فيتعاظم الضرر ويتفاحش الفساد.
وفي كثير من بلاد العالم المتقدم تنتشر مراكز الاستماع والتوجيه الاجتماعي والدعم النفسي، ويقوم عليه خبراء وعلماء مختصون، ويلجها الراغبون في الزواج، والمقبلون على الطلاق، وتقدم لهم الاستشارات الضرورية، ويخضعون لتدريبات وإعدادات نفسية وتأهيل اجتماعي يجعلهم على بينة من القرارات التي هم مقدمون عليها.
فلذلك نقول: لربما يكون من حسن التدبير وجودة التقرير أن نقيد هذه الإجازة على جهة المساعدة وسبيل الرعاية، بإجراء البحث الاجتماعي النفسي الذي يبت في أهلية هذه الرشيدة، سواء من جهة المؤهلات الثقافية، والدراية الاجتماعية، والاستعداد النفسي لتولي هذا الأمر الجلل! وربما كان من الأصوب، أيضا، دفعا لشبهة الوصاية وهضم الحقوق أن يقيد ذلك بشروط معينة وقيود محددة يخشى من فوات التحقق بها الضرر والفساد!
ومنها أيضا قضايا فقهية اجتماعية، يقع فيها كثير من المكلفين، وتتعلق بتقدير الضرورات، وتقويم الحاجات التي تطرأ عليهم وترد على تصرفاتهم ومرافقهم الحيوية، فيجدون في ذلك من العنت والحيرة قدرا كبيرا، ويصعب عليهم الإقدام على الفعل، مثلما يعسر عليهم الإحجام عنه. وفي هذا مسائل كثيرة من ضروب المعاش، والإنفاق، والعلاج والاستشفاء، لا ينفع في تقديرها إلا البحث الاجتماعي الدقيق المفصل.
فمن ذلك مسألة تقدير الضرورة في الاقتراض بالربا لأجل اقتناء البيوت والسيارات، وألوان أخرى من المتاع، وهجرة العلماء إلى بلاد الغرب والاستقرر فيها، والتجنس بجنسيات أجنبية غير إسلامية، وما يترتب على ذلك من الدخول في مؤسساتها العسكرية، والإسهام في عائداتها الضريبية، ومنها أيضا: الاشتغال في المقاولات والشركات التي تتاجر في الحرام، مثل الأبناك التقليدية ومصانع الخمر، ونحو ذلك.
فأمثال هذه المسائل أصبح الإفتاء فيها ديدنا ساريا في كل لحظة وحين، وذلك لما تشتد إليه حاجة الناس في عالم اليوم، ومن تتبع فتاوى العلماء مشرقا ومغربا علم مقدار التضارب والتفاوت في ذلك بين العلماء، فما يبدو لأحدهم ضرورة شديدة ملجئة إلى الحرام في حالات تعرض عليه، قد لا يراها آخر كذلك، ومن تم يصبح مسمى الضرورة الشرعية مفهوما واسعا رجراجا لا يستقيم ضبطه، ولا يتأتى تدقيق حاله، وهذا يناقض أصول الأخذ بالضرورة، ويعارض مقاصدها في التيسير ورفع الحرج.
أفلا يكون، إذن، البحث الاجتماعي القائم على الدراسة العلمية المحيطة بالحالة موضوع البحث إحاطة شاملة مستوعبة سائر تفاصيلها غنى وفقرا، مشقة ويسرا، مصلحة ومفسدة، وما يلحق بذلك من المآلات والعواقب مما قد لا يفطن له الفقيه يكون ضابطا معينا على تقرير الأحكام الصائبة والاجتهادات القويمة في هذه القضايا وأمثالها؟!
ويلحق بذلك مسائل تتعلق بتقدير المشقة، ومتى تكون متحملة؟ ومتى تكون غير متحملة، وهذه من أوسع القضايا وأشملها، ولا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه من بعض شواهدها وأمثلتها، ونجد شيئا من ذلك مبثوثا في أبواب الطهارة، كما نجده في أبواب البيوع والصرف والجهاد والإمامة والسياسة الشرعية، وهي تعم حالات كثيرة: خاصة وعامة: مالية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وصحية، وغير ذلك، وكثيرا ما يتوقف البت الفقهي في عدد منها على تقويم درجة المشقة وشدتها كما في اختلاف العلماء في مسألة الرمي قبل الزوال يوم النحر، واختلافهم في جهاد الكفار المتغلبين بقوة العدد والسلاح، واختلافهم في الخروج عن الحكام الظلمة المستبدين، وغير ذلك كثير… فإنه لا يخلو الأمر لمن تدبر من اعتبار التقرير الاجتماعي القاطع في هذا الشأن.
وبالجملة فهذه الأمثلة وغيرها كثير، يتنازع البث فيها في غالب الأحيان، اتجاهان اثنان:
1. اتجاه التهويل والإفراط. 2. اتجاه التهوين والتفريط، وبسببها تقع مزالق ومعارك، وتضيع مصالح وجهود وأوقات، فلذلك يكون الالتجاء إلى الخبرة المتخصصة، والاسترشاد بنتائجها العلمية والموضوعية، خير عاصم من ذلك، وأفضل نهج لإصابة الحق والسداد.
ثانيها: علم الطب؛ وفائدته إعداد ما يلزم من الدراسات الطبية والبحوث العلمية التي تشرح القضية موضوع البحث الفقهي وتجلي كافة أبعاده وتفاصيله ومآلاته. وقد غدا العمل بهذا الأمر سنة جارية في المؤتمرات، والمجامع الفقهية، والندوات الشرعية، التي تنظمها الهيئات العلمية والطبية في العالم كله.
إن التطور الطبي الذي تشهده البشرية اليوم في فنون الوقاية والتداوي، وإجراء العمليات الجراحية، وزرع واستنبات الأنسجة والأعضاء، واستعمال وسائل وتقنيات جديدة لم يعهدها الطب من قبل؛ يضطر الفقيه إلى تقليب النظر وتعميق البحث في مشروعية هذه المستجدات، ودراسة نظمها وطرائق استعمالها، وسبل الاستفادة منها؛ رعاية لمقاصد الشرع، ووقوفا عند أمره ونهيه، وحفاظا على مصالح الخلق، وفي كثير من الحالات قد لا يتأتى له الحسم في بحثه، ولا يستقيم له الإفتاء؛ لما يجده من عنت وصعوبة في تصور وإدراك كثير من تفاصيل هذه الحالات.
ومما أستطيع التمثيل به، هاهنا، من الأحكام والقضايا الفقهية التي يتوقف البث فيها على البحوث والدراسات الطبية، الشارحة لطبيعتها وآثارها، وما يتحصل منها من المنافع والمضار، أذكر:
ـ حكم الاستنساخ بشقيه الحيواني والبشري، وأحكامه؛
ـ قتل المريض الذي اشتد عليه الألم، ويئس الأطباء من شفائه: تكييفه وحكمه؛
ـ زرع الأعضاء بأنواعه، وصوره المختلفة؛
ـ بنوك المني والحليب، وأحكام الانتفاع بهما؛
ـ استخدام الأجنة في زراعة الأعضاء؛
ـ رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ…[4].
فهذه القضايا وأمثالها جديدة أيما جدة على فقهنا الإسلامي، وكذلك القانون الوضعي، والدراية بها وبدقائقها التفصيلية أمر يشق على غير المتخصصين، وينذر جدا أن تجد من أهل الفقه والقانون من يحصل شيئا من ذلك اعتمادا على مقدرته الذاتية، إلا أن يكون عمدته في ذلك دراسات الجهابذة من أهل هذا الشأن وأبحاثهم التي حازت الاعتراف العلمي الواسع والتقدير الفائق.
يستحيل من جهة النظر أن يقول أي فقيه قولا فيما أثبتته من أمثلة حظرا أو إباحة إلا بالاستناد إلى خبرة طبية معتبرة تتولى عبء بيان التصور الأكمل للقضية موضوع البحث، وما يرد عليها من تصديقات حاضرة وقابلة سلبا أو إيجابا عندما تتفاعل في الوجود في مراحل سيرورتها المختلفة.
ثالثها: علم الاقتصاد؛ وفائدته أنه يهتم “بدراسة الظاهرة الاقتصادية من حيث وصفها وتفسيرها، والكشف عما بينها من علاقات وقوانين، وكيفية توجيهها، بحيث تشبع للإنسان أقصى قدر من حاجاته، وفق ما هو عليه من قيم[5].”
من هنا نستفيد أن علم الاقتصاد يقوم بدورين متكاملين:
1. وصف الظاهرة وتفسيرها.
2. تصحيح جوانب الخلل فيها، وتوجيهها لتلبي حاجات الإنسان وفق قيمه وآدابه المعيشة.
وفي ضوء ما نعرفه اليوم من تطورات غريبة وعجيبة يشهدها سوق المال والاقتصاد في العقود والمعاملات والتصرفات والالتزامات، لا يصح أن يعتبر فقه في هذا الباب، إلا إذا استند في بحث أحكامه إلى العلم الذي يكمله ويضبطه، ويبحث وجوه الانتفاع به.
ومن العقود والأحكام التي تظهر فيها فائدة هذه الصفة، وتبرز الحاجة إليها.
ـ التأمين التعاوني والتأمين التجاري، أيهما أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة في التكافل والتآزر، وأجود في تدبير الثروة وتحقيق العدالة؟ وأيهما أرعى لنصوصها وأحكامها؟
ـ حكم ربط الفوائد والديون، بمستوى انخفاض أو ارتفاع العملات والأسعار، فهذا مما يطرحه بعض رجالات الاقتصاد وخبرائه، وعندهم أنه عين الإنصاف والعدل، فتارة ترتفع العملات في أسواق الصرف، فيتضرر المدين لذلك ضررا فاحشا، وأحيانا أخرى تنخفض فيتضرر الدائن!
ـ تحقيق علة تحريم الربا، وهل تكون هي مجرد رفع الظلم؟ ماذا يترتب على ذلك من مصادمة لكثير من الأحكام المتداولة في فقهنا الإسلامي؟
فمما يذكره دعاة الربا أن الأمر الشائع اليوم بين التجار والمستثمرين الجاري في أسواقهم وأغراضهم أن آكل الربا وموكله كليهما راغب راض بهذا التعامل، وأنهما معا يربحان في غالب الأحوال، فأي شيء يجعل هذا الأمر حراما، مادام الظلم قد ارتفع فيه؟ وهو علة الربا بنص القرآن: ﴿يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ (البقرة: 278-279).
ـ أحكام الحقوق الفكرية والملكية الصناعية، فهذا من الجديد الذي لا زال لم يلق من العناية والدراسة الشرعية ما يفي بالغرض، وتفاصيله شديدة التعقيد، ففيها ما يتعلق بحيازة هذه الحقوق، وبيعها، وشرائها، والتنازل عنها، وإرثها، وتقادمها والمنازعات التي تنشأ عن المساس بها، الخ…
إن جدة هذه القضايا وخطورتها وتشعب تفاصيلها يجعل من له أدنى معرفة بها يقر، بلا تردد، أن الفقه والقانون بسلطتهما الحكمية ما هما في الحقيقة إلا حلقة في سلسة حلقات مترابطة تتدخل في عملية فحص هذه القضايا ورصد تفاعلاتها في الوجود من أجل تقويم دقيق لأصولها وطبيعتها وآثارها، ومن تم الحكم عليها.
وصفوة القول في هذا المطلب أن نذكر “بأن تحقيق غاية ومقصد حسن تنزيل المراد الإلهي من النظر الاجتهادي يتوقف توقفا كليا على معرفة المتصدي للنظر الاجتهادي في هذا العصر بمبادئ ما يصطلح عليه في هذه الدراسة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية… إن هذه المعارف بما تشتمل عليه من أدوات ومناهج تعتبر خير وسيلة معينة على ضبط الاجتهادات والآراء المتأثرة بالظروف والبيئة بغية إعادة النظر فيها من جديد وعرضها على بساط المراجعة والنقد والتمحيص والتدقيق[6].”
المطلب الثاني: في مشروعية الإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة
قد يقول قائل: إن دور العلوم والخبرات المتخصصة في مجال الفقه والتشريع لا يعدو أن يكون دور المساعد والمسهم في تفسير القضية موضوع البحث، والكشف عن طبيعتها، وتحديد ما يترتب عليها من منافع أو مضار، دون التطرق إلى أحكامها الشرعية، وما دامت هذه هي الحدود، فالحكم هو الإباحة؛ لأنه لا يمنع مانع من ذلك، ولا مضار تتحصل منه، بل إن فيه مصالح كثيرة لا تنكر ولا ترد.
وفي تقديري أن هذا تبسيط للموضوع، وجناية على حقائقه الثابتة، فالتقرير العلمي ليس منفصلا عن التقرير الشرعي، أو منعزلا عنه، بل هو قاعدة من قواعده، وأصل من أصوله، وعلى شروحه وبياناته تبنى الأحكام الشرعية، وتصاغ مفرداتها وعباراتها.
إن البحث العلمي، إذن، جزء من البحث الشرعي، وهو يسهم إسهاما فعليا في بلورة نتائجه وأحكامه، بل إن كثيرا من القضايا لا يكون للفقه فيها رأي ابتداء إلا أن أحكامها تتبع الحقيقة العلمية الموثوقة التي كشفها التقرير العلمي الصحيح، ويكثر هذا في القضايا التشريعية المبنية على قواعد المصلحة، ورفع الحرج، واعتبار العرف الصحيح، ونحو ذلك، فماذا بإمكان الفقيه أن يقول إذا أثبت الطب بالبرهان القاطع، مثلا، أن الجنين لا يستقر في بطن أمه أكثر من اثني عشر شهرا، ليس بإمكانه إلا أن يعتمد ذلك في أحكام النسب، والميراث، وما يتبعهما[7].
ثمة عناصر أساسية وملاحظ قوية تجعلني أتبنى القول بوجوب وفرضية هذه الإفادة فرضية شرعية وعقلية، أختصر بيانها في عناصر جامعة:
أولها: أن الحياة اليوم تعقدت قضاياها، وكثرت مشاكلها، وتداخلت علومها. ومن أجل التغلب على هذه السمة الغالبة اليوم في جميع فروع الحياة المختلفة، أصبح الاعتماد على الخبرات والعلوم المتخصصة سنة متبعة في كافة المجامع والندوات الفقهية والمؤتمرات الشرعية. ومرد هذا التداخل والتكامل بين البحثين الشرعي والعلمي يرجع إلى القطع المبني على الاستقراء الصريح والتجربة المشهودة باستحالة أن يجتمع علم كليهما عند مختص في واحد منهما، بل إني لا أبعد إذا قلت إن علم تفاصيل أحدهما لا يجمعه المتخصص فيه، فكيف إذا أضفنا إليه غيره!
لا يستقيم، إذن، أن نؤسس قواعدنا الشرعية المرتبطة بهذا المجال دون الرجوع إلى أهل الخبرة والتخصص، كل في مجاله. وهذا الرجوع أو الإفادة، كما سميتها من قبل، هي التي عناها القرآن بقوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (النحل: 45، الاَنبياء: 7)؛ فالأمر هاهنا صريح في لزوم الرجوع إلى أهل الذكر. وأهل الذكر هم أهل العلم المختصون به، القائمون به في الناس تعليما وتدريسا، بحثا وتحقيقا، وقولهم هو الحكم والفيصل، لما تحصل عندهم من الكفاءة والخبرة مما لم يتحصل عند غيرهم.
ثانيها: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتوضيح ذلك أن صياغة أحكامنا الشرعية على مقتضى هدي الشريعة، واجب مجمع عليه، مقطوع به.
قال تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، عليه توكلت، وإليه أنيب﴾ (الشورى: 8) وقال: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقومٍ يوقنون﴾ (المائدة: 49-50). وعملا بقاعدة: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[8]”، فإن هذه الإفادة تكون لازمة واجبة.
ثالثها: أن الرجوع إلى الخبرة المتخصصة دأب شكره القرآن، ومنهج أثنى عليه خير الأنام، وقد وقفت في شأن ذلك على إشارات كثيرة وبليغة، من أهمها:
1. في قصة موسى، عليه السلام، مع العبد الصالح، ففيها أن موسى أتاه الله الكتاب، وعلمه الوحي، وهو إمام في الدين، ومرجع في الأحكام والشرائع، لكن رغم ذلك لم يكن عنده من العلم في قضايا كثيرة من السياسة والتدبير مثل ما عند العبد الصالح، فلذلك لم يجد موسى، عليه السلام، حرجا في أن يقول: ﴿هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدًا﴾ (الكهف: 66)، فوضع نفسه موضع التلميذ المتعلم، ووضع العبد الصالح موضع الأستاذ المعلم.
ففي هذه القصة أن الرجوع إلى أهل الذكر والعلم أمر محمود مطلوب، ولولا أن موسى ثبت عنده أن ما عند هذا الرجل الصالح من العلم نافع مفيد لكمال بلاغه والقيام بدعوته وشؤون إمامته؛ لما تجشم هذا العناء في الطلب.
2. أخرج مسلم وابن ماجة عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بقوم يلقحون، فقال: “لو لم تفعلوا لصلح، قال فخرج شيصا، فمر بهم، قال: ما لنخلكم، قالوا: قلت كذا وكذا، قال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي[9].”
في هذا الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم، والذي إليه مرجع الفتوى والقضاء والإمامة تخفى عليه قضايا من معايش الدنيا؛ لأنها ليست من مهمته الرسالية، ولا من وظيفته النبوية، فيدخل عليه فيها سوء التقدير، كما يدخل على غيره. ويستفاد من ذلك بطريق التنبيه أن من خفي عليه شيء من المعرفة، لزمه الرجوع إلى أهلها، واستفسارهم عنها، والإفادة من خبراتهم بها، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: “إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي”.
ومما يوضح ذلك أن النبي لو كان عنده علم بأنه لا يعلم بقضية التلقيح وفوائدها لما تردد في الاستفسار عنها، ولا يتصور منه شيء غير هذا البتة، وقد سأل عن أشياء كثيرة، وكان ذلك في قضايا يسيرة، فكيف بما هو أكبر من ذلك، وأخطر!
ومن ذلك أنه منع حسان بن ثابت الشاعر من أن يقول في أنساب قريش هجاء حتى لا يقع في نسبه، صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن يرجع إلى صاحب هذا الفن الخبير بدقائقه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه[10].
وكان يقول: “خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب[11].”
ومما يستأنس به في هذا المقام من المواقف العمرية أن الشاعر الحطيئة جرول بن أوس هجا الزبرقان بن بدر بكلام حمال ملتبس، قال فيه: “دع المكارم لا ترحل لبغيتها… واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”.
فشكاه إلى عمر، فلما سمع عمر الأبيات، قال: ما أسمع هجاء، ولكنها معاتبة، فقال الزبرقان: أو ما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟ فقال عمر: علي بحسان، فجيء به، فسأله، فقال: لم يهجه بل سلح عليه، فسجنه عمر[12].
قال الأستاذ العقاد في تعقيب له على هذه القصة: “فنسي أنه الأديب الراوية، ولم يذكر إلا أنه القاضي، الذي يدرأ الحدود بالشبهات، ولا يحكم بما يعلم دون ما يعلمه أهل الصناعة[13].”
وصفوة القول، إذن، أن الرجوع إلى أهل العلم والخبرة في القضايا المستحدثة، لا ينزل في الجملة عن مرتبة الوجوب، وهذا حكم ظاهر بالشواهد الثابتة، وسيتأكد أكثر عند التعرض للمطلبين الآتيين:
المطلب الثالث: طبيعة الإفادة من العلوم المتخصصة وضوابطها
حينما نؤكد على ضرورة الإفادة والاسترشاد بمختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية التي تبصر الفقيه بطبائع التصرف الإنساني، وتكشف عن أبعاده وحقائقه، وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، فإن منطلقنا في ذلك هو ما شهد به الواقع، وأثبتته التجربة لهذه العلوم من أدوار حسنة في توجيه الاجتهاد الفقهي الوجهة الصحيحة، التي تبتغي تنظيم التصرف البشري، وإرشاده إلى مواطن الخير والصلاح، وإسعاده في مساره الخاص والعام.
غير أني بإلحاحي على ضرورة هذه الإفادة، لا أعطي لهذه العلوم سلطة الحَكم الوحيد، والمقرر الفريد الذي بالاقتصار على أمره تشرع الأحكام وتسن القوانين، فهذه وجهة وضعية غريبة على مقصودنا وغايتنا.
لا نريد أن تكون سلطة الخبير المتخصص سلطة متفردة بالتشريع والاجتهاد؛ تعارض سلطة الفقه أو تنافسها، كما أني لا أقصر مفهوم الإفادة الذي أذكره على مجرد الاستئناس كما يختاره بعض الباحثين، بل إني أرى أن الإفادة التي أعني، أوسع من هذا وأشمل، فهي تأتي بهذه المعاني تارة، وبغيرها تارة أخرى.
فمن معاني الإفادة العلمية التي تخدم صناعة الفقه والتشريع ما يكون اعتمادا كليا، وأخذا مطلقا، بما قرره البحث العلمي، وفي هذه الحالة لا يخرج الحكم الفقهي عن كونه صياغة شرعية للحقيقة العلمية؛ لأن هذه حقيقة الأمر، وأكثر ما يكون ذلك في الأحكام المعقولة المعنى، المدركة عللها بالبيان العلمي القاطع، والتجربة المشهودة الصريحة، ومن أمثلة ذلك:
ـ تحريم الاستنساخ البشري بناء على ما قررته بحوث طبية واجتماعية، وأن ذلك سيؤدي إلى نتائج مروعة وعواقب وخيمة على مستوى النظام الكوني ومنظومة الأخلاق والقوانين والأعراف الإنسانية العامة والخاصة[14].
ـ إباحة التلقيح الصناعي بشروطه المقررة بين الزوجين، بناء على شهادة البحث العلمي بأنه مجرد علاج ومساعدة طبية لأحد مكونات عملية الإخصاب التي طرأ عليها خلل..[15].
ومن معاني الإفادة: الاختيار والترجيح، ومحل ذلك حينما تكون نتائج البحث العلمي مشتبهة محتملة، لكن وجه الرجحان في بعضها غالب، وليس فيه أي مناقضة أو معارضة لثوابت الشريعة وأحكامها الكلية، فها هنا نختار ونرجح بين هذه النتائج بحسب ما يتلاءم مع قواعد الشريعة ومصالحها العامة، ومن أمثلة ذلك:
ـ تحريم أو إباحة الاستنساخ النباتي والحيواني بناء على قولين مختلفين:
أولهما: أن في ذلك مصلحة تحسين النوعية، والإكثار من المنتوج كما ونوعا، وذلك بأقل جهد، وبأيسر كلفة.
ثانيهما: أن ذلك قد لا يخلو من أخطار حقيقية، ومفاسد محتملة، لا تظهر إلا بعد التجارب المتواصلة والمدد المتعاقبة، كما هو الحال في آفة جنون البقر[16].
ـ تحريم أو إباحة رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ بناء على الخلاصة العلمية القائلة بأنه ميت لا حياة فيه، أو على الخلاصة القائلة بأنه حي حياة ضعيفة.
ومن معاني الإفادة: الاستئناس والاسترشاد دون الاعتداد الكلي بما توصل إليه البحث العلمي المتخصص، ومثال ذلك: “الاستئناس بمناهج البحث، والتوثيق، والتفسير، والتخريج، وفي إجراء المقارنات، والملاحظات، والإحصاءات، والاستبيانات، واختيار العينات…[17]” المستعملة في علم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، وعلم النفس… والإفادة من ذلك في الاجتهاد الفقهي المعاصر، فهذه المناهج وإن كانت غريبة عن طرق التفسير الشرعي والبحث الفقهي، كما قد يبدو في الظاهر، فهي مرشحة لأن تكون وسيلة صالحة وأداة مهمة لتقدير المصالح والمفاسد التي تتوارد على الأحكام الشرعية في خضم أوضاع غريبة متجددة استقرت عليها نظم الحياة المعاصرة.
وبالجملة، فقد أصبحت هذه المناهج من أهم الركائز العلمية التي تعتمد عليها البشرية اليوم قاطبة في التوصل إلى النتائج المقبولة التي يسلم الجميع بصوابها وصحتها. فلا حرج علينا أن نستفيد من ذلك كله، لكن على نحو يحقق الخير والصلاح، ويمنع الشر والفساد.
المطلب الرابع: في المحاسن المنهجية والعلمية للإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة…
من خلال ما بسطته عن معاني الإفادة وكيفياتها، وما ذكرته من المواقف والتجارب الفعلية يمكن، في تقديري ، الحديث عن فائدتين كبيرتين جليلتين: فائدة منهجية، وفائدة علمية.
1. الفائدة المنهجية
ذكرت سابقا أن أمر الفقه والتشريع أضحى اليوم أخطر المهمات المجتمعية، وأعقد المسؤوليات الإنسانية، وما ذلك إلا لأنه في سباق مع التطورات السريعة التي يشهدها الإنسان، والتقلبات الحثيثة التي يراد منه أن يسعى إلى تنظيمها وضبطها، وإحكام التعاطي معها، وبينت أن ذلك لا يقف عند حد، ولا يستطيعه فقيه أو مجموعة فقهاء، بل لابد أن يشركهم فيه العلماء الخبراء بمجالات الفعل الإنساني المختلفة.
وما أريد أن أذكره الآن؛ أن اعتماد مبدأ الإفادة من العلوم والخبرات هو المنهج الأمثل والمسلك الأصوب في مقاربة الشأن الفقهي، وبفضله تتحقق حسنات منهجية كثيرة، تمهد السبيل لضمان نتائج خيرة، وقواعد محكمة قادرة على التنظيم الأفضل لحركة المجتمع، والترتيب الأقوم لمختلف العلاقات والمرافق التي تنشأ فيه.
أولها؛ تقليل الجهد، وتبسيط طرائق العمل، وتجاوز كلفة البحث خارج التخصص، ولا يخفى ما في ذلك من المشاق والمحاذير المنهجية والمعرفية الكثيرة.
ثانيها؛ السرعة في الإنجاز، وربح الوقت، فإن تقسيم العمل إلى تخصصات متكاملة الأدوار يسرع لاشك وثيرة العمل. وهذا يعطي قدرة على اللحاق والمواكبة المطلوبة بين الحوادث الطارئة والقواعد الشرعية المنظمة لها.
ثالثها؛ وضوح الرؤية والهدف، وذلك بفضل تحديد المسئوليات، ووسائل العمل، وطرائق الإنجاز.
2. الفائدة العلمية
العلمية هاهنا معناها: إسناد البحث عن المعاني والحقائق موضوع الدراسة إلى قواعد العلم الدقيقة الضابطة لسيرورة وتطور الظاهرة المدروسة في مختلف مراحل تفاعلها وتشكلها.
وليس من غرضي أن أخوض في الحديث عن إشكالية العلمية والنسبية في المعارف والعلوم. فإن هذا مدون في مظانه المعروفة، ولكنني أقول: إنه، في الجملة، وبالرغم من بعض التحفظات التي قد نبديها على هذا البحث أو ذاك، فإن ثمة فوائد وحسنات كثيرة تتحقق بسلوك طريق الإفادة من الخبرات والعلوم المتخصصة.
أولها: الدقة والحبك؛ فحين تستند الأحكام الفقهية في صياغتها ومقتضياتها إلى البحث الشرعي المسنود بالخبرة المتخصصة، فإن ذلك يعطى لهذه القواعد أسمى درجات الدقة والحبك..
ولو ألقينا نظرة متفحصة في القضايا والأحكام التي تبث فيها المجامع الفقهية الدولية، وهي تعمل بآلية الاجتهاد الجماعي، والإفادة من الخبرات المتخصصة، نجدها على درجة عالية من الدقة والحبك، بحيث تحقق شيوعا وانتشارا واسعين في كل المحافل والقنوات، وتجد القبول والرضى من طرف الكتاب والباحثين، بل من طرف المؤسسات التشريعية في بعض البلاد الإسلامية.
وحين تغيب هذه المزاوجة بين الخبرة الشرعية والخبرة المتخصصة تضيع الأحكام والنتائج، ونحيد عن جادة الصواب.
ومما أذكره عند التعرض لهذا الشأن: فتوى بعيدة عن قوانين العلم، مجردة عن الإفادة من قواعد الخبرة المتخصصة، قال فيها صاحبها وهو عالم جليل وشيخ محترم، أن الكرة الأرضية ساكنة لا تدور ولا تتحرك، وقد تكون حجته في ذلك ظواهر آيات قرآنية كثيرة وردت بهذا الحكم، لكن بل رغم من ذلك يبقى المحذور ثابتا[18].
ومن ذلك أيضا فتوى لشيخ جليل، رحمه الله، أمر فيها أهل فلسطين بالخروج من ديارهم؛ لأنها لم تعد أرض إسلام[19].
الحس السياسي، والبعد الاجتماعي، والبحث المصلحي، وما أجزم به أن الشيخ، رحمه الله، لو أفاد من الخبرة المتخصصة، وسأل أهل الذكر، ووقف على الأبعاد السياسية والحقوقية للموضوع، والمشاق والمفاسد الاجتماعية، بل لو اقتصر على النظر في مفهوم دار الحرب، وأنه مفهوم اجتماعي نسبي، ووازنه بالإمكانات المتاحة لإقامة الشعائر والعبادات في أرض الإسراء، والقيام بفريضة الجهاد، ولو تمعن في المهجر البديل إلى أين سيكون؟ لما كانت تلك هي وجهته في الفتوى.
ثانيها: الموضوعية؛ وأقصد بها تجرد الاجتهاد من كل المؤثرات، والدوافع الذاتية للمجتهد، فلا وجهة للاجتهاد إلا ما حدده العلم، ولا افتراض أو تحليل أو استنتاج، إلا بالبرهان الواضح، والتعليل المبين، والتفسير المقنع.
ومن هنا يكون دور الباحث هو حسن تدبير قواعد البحث العلمي لتخبر عن النتيجة العلمية الصحيحة مهما كانت طبيعتها، أو درجة مناقضتها لهوى الباحث وإرادته.
حينما نشتغل بأصل الإفادة من الخبرة المتخصصة تتحقق صفة الموضوعية بشكل معتبر، وتأتي النتائج على درجة عالية من الصحة والوثوق.
ومن هنا يصبح النظر إلى هذه القواعد على أنها إنتاج اجتهادي مؤيد بالعلم، وليس تسلطا كهنوتيا، أو تحكما وضعيا، أملته رغبات ومصالح فئة طاغية من الناس، وهذا، في تقديري، أهم ضمانات القوة والقبول، والاستمرار والتجدد.
المطلب الخامس: محاذير الاستفادة من العلوم المتخصصة
العلوم المتخصصة لما كانت إنتاجا بشريا محكوما بقدراتنا الإنسانية، وسقفنا المعرفي المحدود، فلن تخلو الإفادة منها على النحو الذي بينته من محاذير ومخاطر، قد تجرفنا عن مسار الدقة العلمية التي نريد، والمصلحة الشرعية التي نقصد، ومن تم تهدد وجهة الأحكام الشرعية نحو التنظيم الأمثل للعلاقات والمرافق الاجتماعية؛ لتنزاح بها إلى الضلال والفساد.
لذلك أشير في هذه الفقرة إلى ثلاثة تنبيهات أساسية، يعتبر الاهتمام بها والتنبه إليها من الضمانات القوية لإفادة سليمة وصحيحة من العلوم المتخصصة.
1. أن يسند أمر البحث العلمي إلى أهله الخبراء المختصين ذوي الكفاءة العلمية والخلقية، فلا يجوز من جهة العقل أو الشرع أن يسند هذا الأمر إلى ضعاف النفوس وأنصاف العلماء؛ لأن في ذلك مساس خطير بموضوعية وعلمية النتائج والخلاصات التي عليها المعول في الاجتهاد الفقهي المطلوب.
2. أن نحذر ونتحفظ من كل الأبحاث والدراسات التي تنطلق من منطلقات ومسلمات تمليها قيم ثقافية ودينية وسلوكية غريبة كل الغرابة عن قيمنا ومبادئنا الإسلامية، فلذلك غالبا ما تأتي نتائجها العلمية على هذا المستوى من المفارقة والشذوذ.
3. أن نتبين في علمية كل المناهج المستعملة في تقرير الحقيقة العلمية، ونقتصد في استعمال الفرضيات والاحتمالات والإحصاءات… ونتأكد من أن كل ذلك يتوفر على قدر من الوثوق والقوة والاطمئنان؛ “فإن إقحام الفرضيات الضعيفة في تحديد المراد الإلهي يسيء إلى النص الديني حينما يظهر خطؤها، وقد عدت مدلولات له. كما أنه يجر إرهاقا وحرجا في شؤون الحياة لما تصبح جارية على أساسه، وهذا ما يدعو إلى الاقتصاد في استخدام المعارف العقلية في فهم الدين بما يضمن إصابة الحق في أقصى درجات الإمكان[20].”
الهوامش
[1]. أحمد الخمليشي، سلسلة وجهة نظر، 1/321، المطبعية الأمنية الرباط: 2002م هامش رقم 6.
[2]. قطب مصطفى سانو، أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، بيروت: دار الفكر المعاصر، 2000م، ص138.
[3]. نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، حجيته.. ضوابطه.. مجالاته، سلسلة كتاب الأمة عدد65-66 الدوحة، 1998م، 2/163.
[4]. من النماذج الناجحة التي ظهر فيها هذا النوع من التكامل والتجاوب بين الخبرة الشرعية والخبرة الطبية؛ ما ذكرته الأستاذة الدكتورة “رجاء ناجي”؛ عضو الفريق المكلف بإعداد واقتراح مشروع قانون ينظم شأن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ من أن فريق العمل كان يضم طائفة من الباحثين والخبراء المختصين في كل العلوم ذات الصلة بالموضوع، ولذلك توج العمل بصدور ظهير 1/99/288 بتطبيق قانون 16/98 بتاريخ 16 سبتمبر 1999 بشأن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها، أنظر نقل وزرع الأعضاء أو الاستخدام الطبي لأعضاء الإنسان وجثته: مقاربة بين القانون المغربي والمقارن والشريعة الإسلامية، ص11.
[5]. عبد اللطيف العبد اللطيف، الإيجاز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: دار ابن حزم، 1997م، ص13.
[6]. قطب مصطفى سانو، أدوات النظر الاجتهادي في ضوء الواقع المعاصر، م، س، ص130.
[7]. من الأمثلة الواضحة في ذلك؛ قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ 21 أكتوبر1987م وقد جاء فيه: “المريض الذي ركبت جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه» من كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء، سميرة عايد ديان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2004م، ص380.
من الأمثلة التي كان يذكرها الفقهاء تحت تأثير العادة: مسألة “من جاءت بولد بعد سنتين من طلاقها”. قال السرخسي في المبسوط: “لزمه الولد؛ لأن المعتدة إذا جاءت بولد من وقت الطلاق إلى سنتين ثبت النسب؛ لأن الحكم بوجوب العدة حكم بشغل الرحم، وشغل الرحم يمتد إلى سنتين عندنا، فيثبت النسب إلى سنتين” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب النكاح، فصل حكم الخيار، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، 2/327.
وقد عرف بالبرهان العلمي اليوم أن الولد لا يمكث في بطن أمه كل هذه المدة، وأن ما يقع من تأخر مدة الحمل إلى ما بعد السنة والسنتين عند بعض النساء المتزوجات، وهو الأصل المنظور في هذه المسألة يرجع في الغالب إلى حالة مرضية ناتجة عن خلل هرموني تظهر معها كل أعراض الحمل، ويسمون هذا العرض: “توهم الحمل”، حتى إذا وقع الحمل فعلا في سنة لاحقة، لم تستطع المرأة أن تميزه عن مرضها السابق، فتظن أنه استمرار للحمل القديم. وهكذا يصل الحمل إلى أمثال هذه المدد الطويلة.
هذا إذا كان للمرأة زوج، أما إذا انفصل عنها بموت أو فراق، ثم ادعت أن الحمل منه بعد كل هذه المدة ! فهذا لم يثبت بعلم ولا يصدقه برهان.
[8]. ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية، ص130.
[9]. رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش، رقم: 4358 ورواه بن ماجة في كتاب الأحكام، رقم: 2462.
[10]. رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، رقم: 4672.
[11]. رواه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بن كعب، رقم 3632.
[12]. محمد الصلابي، ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1958م، ص284 وما بعدها، وانظر فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين، ص241.
[13]. عباس محمود العقاد، عبقرية عمر، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1947م، ص288.
[14]. قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 100 /د 10 في 03/07/1997 نقلا عن: نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، م، س، 2/122.
[15]. انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة بمكة المكرمة خلال شهر كانون سنة 1985م، وقد جاء فيه “إنه مقبول مبدئيا في ذاته، لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزم ويحيط به من ملابسات فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى” من كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء، سميرة عايد ديان، م، س، ص180.
[16]. “تبنى مجمع الفقه الإسلامي الجواز الشرعي للأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم، وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد” من كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء، سميرة عايد ديان، م، س، ص196. وانظر: نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، م، س، 2/126.
[17]. الاجتهاد المقاصدي، م، س، 2/166. نقله عن فقه التدين ذ: النجار “كتاب الأمة”،1/108.
[18]. انظر كتاب الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر وسكون الأرض، ص23.
[19]. نقل هذه الفتوى وعلق عليها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ الهامش رقم 1، بيروت: دار الفكر المعاصر، بيروت، 1997م، ص238.
[20]. الاجتهاد المقاصدي، م، س، 2/165.
* – أستاذ مادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي التأهيلي بمدينة البيضاء.
المصدر: مجلة الإحياء
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي