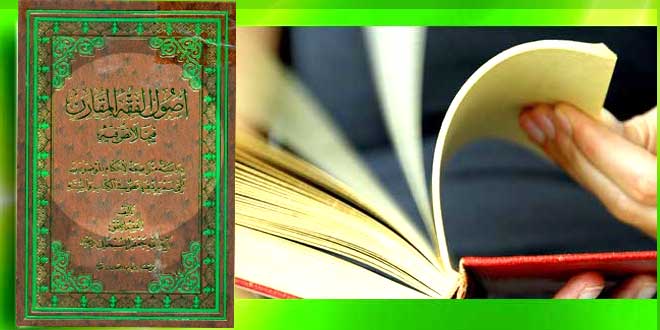إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.
الاجتهاد: لقد حدثت في العقود الأخيرة انعطافات مهمّة في حركة التأليف والمنهجة في الحوزة العلمية في المذهب الإمامي، حيث برز اتجاه جديد ينحو صوب إحياء وتفعيل ظاهرة الدراسات المقارنة بين المدارس والمذاهب الإسلامية على صعيد علمَي الفقه وأصول الفقه.
وهذه الظاهرة التجديدية لا يمكن لحاظها بمعزل عن المشاريع المناهجية التجديدية الأخرى في مجال العلوم الشرعية والإسلامية بعامّة، وبخاصّة في دائرة علم (أصول الفقه)، والتي تمثّلت بـ «أصول الفقه»، للشيخ المظفّر، و«أصول الاستنباط»، للسيد الحيدري، و«دروس في علم الأصول»، للشهيد السيد محمد باقر الصدر، وتلتها ـــ وربما عاصرتها ـــ محاولات أخرى، ولا تزال.
كما طالت مشاريع التجديد علوماً إسلامية أخرى، كالمنطق، والفلسفة، والعقائد، والكلام، فإنّ المشاريع المزبورة، وإن اقتصرت على معالجة تلك العلوم والمعارف من زاوية الرؤية الإمامية فحسب، ولم تخُضْ ميدان المقارنة، إلا أنّها تشترك مع الدراسات والمناهج المقارنة في النزوع نحو التجديد، وعدم الجمود على النمط التقليدي في التأليف، سواءٌ أكان على صعيد الخطاب أم التبويب أم التنظير.
ويمكن القول: إنّ أوّل مَنْ دشّن منهج التدوين المقارن في مجال علم الأصول هو السيد محمد تقي الحكيم، في كتابه الخالد « الأصول العامّة للفقه المقارن »، والذي بقي إنتاجاً يتيماً عدّة عقود، ولم يشفع بمحاولة ثانية، حتّى أطلّت علينا المحاولة الموفّقة للشيخ جعفر السبحاني في ما قدّم من كتاب في هذا المجال، ألا وهو كتاب «أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه»، فجزاه الله خير جزاء، ونفع المسلمين بمواهبه، وكثّر الله أمثاله.
النقطة الأولى: العرض الوصفي للكتاب ومحتوياته
أوّلاً: المحتويات
يقع الكتاب في (394) صفحة، توزّعت على افتتاحية؛ ومقدّمة؛ وبابين رئيسين؛ وخاتمة؛ وفهارس فنّية. وتفصيل ذلك:
أـ الافتتاحية
استهلّ المؤلّف كتابه بافتتاحية جميلة، بيّن فيها ما يُمليه المنطق العلمي من الموضوعية وعدم المحاباة في بيان الآراء ونقدها، وأنّ الاختلاف هو عنصر قوّة في الفكر، وحالة طبيعية، بل وإيجابية. ثمّ تعرّض إلى الدواعي التي دعته إلى التصدّي لتأليف الكتاب. كما أشار الى أنّ الكتاب مبنيّ على الاختصار، وعدم التوسّع في دقائق علم الأصول، والتي حفلت بها الكتب الأصولية التخصُّصية.
ب ـ المقدّمة
بعد الافتتاحية مهّد المؤلّف لبحوث كتابه بمقدّمة نافعة جدّاً، امتدّت من الصفحة (9) وحتى الصفحة (35)، بل لا يبعد دعوى كون بعضها ضرورياً للدارس. وقد اشتملت على عدّة إثارات، طرحها ضمن أمور تسعة، وهي:
1ـ كمال الدين وإتمام النعمة.
2ـ القرآن وسعة آفاق دلالته.
3ـ عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة.
4ـ دراسة آيات الأحكام بصورتين.
5ـ السنّة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي.
6ـ ظاهرة عدم النصّ بعد رحيل رسول الله.
7ـ السبب الأوّل لظاهرة عدم النصّ.
8ـ السبب الثاني لظاهرة عدم النصّ.
9ـ حجّية أحاديث أهل البيت.
ج ـ الباب الأوّل
وقد بدأ من الصفحة (39) وانتهى بالصفحة (83). وقد تناول فيه الكاتب بحث الأصول العملية الأربعة عند الإمامية، بياناً وتحليلاً واستدلالاً، وتعرّض إلى موارد جريانها، وهذه الأصول هي: 1ــ أصالة البراءة؛ 2ـ أصالة التخيير؛ 3ـ أصالة الاحتياط؛ 4ــ الاستصحاب.
د ـ الباب الثاني
وكان له السهم الأوفر من الكتاب، حيث امتدّ من الصفحة (87) إلى الصفحة (296). وقد تعرّض فيه الكاتب إلى ثمانية بحوث، وهي: 1ـ القياس؛ 2ـ الاستحسان؛ 3ـ المصالح المرسلة، أو الاستصلاح؛ 4ـ سدّ الذرائع؛ 5ـ فتح الذرائع؛ 6ــ إعمال الحيل الشرعية؛ 7ـــ قول الصحابي؛ 8ـــ إجماع العترة.
هـ ـ الخاتمة
وقد كانت كبيرة نسبياً إذا ما قيست بالحجم الكلّي للكتاب، حيث امتدّت من الصفحة (299) وحتى الصفحة (366). وقد اشتملت على مبحثين مهمّين، وهما: 1ـــ دور العرف وسيرة العقلاء في ما لا نصّ فيه؛ 2ـــ المقاصد الشرعية العامّة.
و ـ الفهارس الفنّية
وقد انتظمت في نوعين، وهما: 1ـــ فهرس مصادر التأليف؛ 2ـــ فهرس المحتويات.
ثمّ إنّ نسخة الكتاب التي راجعناها هي الطبعة الأولى، والتي كانت بتاريخ 1425هـ، 1383هـ ش، وقد قامت بطبعه ونشره مؤسسة الإمام الصادق”عليه السلام”.
ثانياً: المنهج العامّ للكتاب
امتاز هذا الكتاب « أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه » بتبويب خاصّ، كما اتّضح ذلك من خلال ما مرّ من العرض الإجمالي لمحتوياته. وأمّا المنهج فهو يتحدّد عادة في ضوء جملة من العناصر، وأحدُها الهدفُ الأساس للكتاب. وحيث إنّ الهدف منه جاء واضحاً انعكس على عنوان الكتاب، ألا وهو المقارنة في مجال علم الأصول بين المذاهب الإسلامية، وخاصة بين المدرسة الإمامية والمدرسة السنّية.
وحينئذٍ لابدّ أن يكون المنهج المعتمد فيه هو المنهج المقارن. بل قد أثّر ذلك على التبويب العامّ للكتاب، حيث طرح الكاتب بحوثه العلمية الأصولية في ما لا نصّ فيه ضمن بابين؛ خصّ أوّلهما ببيان وتحليل المعالجة التي قدّمتها المدرسة الإمامية بهذا الشأن؛ وخصّ ثانيهما ببيان وتحليل المعالجة التي قدّمتها المدرسة السنّية.
ثالثاً: طبيعة الأسلوب والبيان
إنّ الطابع العامّ لهذا الكتاب بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. علماً بأنّ المؤلّف كان قد نوّه في نهاية افتتاحية الكتاب إلى أن الكتاب ليس موضوعاً على سبيل البسط والتوسعة، بل هو مبنيٌّ على الاختصار، ممّا يوحي بأنّه لم يقصد التعمّق والتفصيل، ولم يكن هدفه مخاطبة المتخصّصين والخبراء من أهل الفنّ.
النقطة الثانية: دراسة الكتاب برؤية تحليلية نقدية
وسنورد ملاحظاتنا على هذا الكتاب ضمن محورين:
المحور الأوّل: الملاحظات العامّة
أوّلاً: من المناسب ـــ بل الضروري ـــ أن يُتحف المؤلّف قرّاءه ببيان موضوع الكتاب أوّلاً، قبل الولوج في تضاعيف البحث. وهذا ما يقتضيه المنهج البحثي مطلقاً في كلّ دراسة علمية، وإن كان الموضوع واضحاً. وقد سار علماؤنا على هذا المنهج، حيث يفتتحون بحوثهم عادةً بما كانوا يصطلحون عليه بـ (تحرير محلّ النزاع)، ثمّ يخوضون في بيان النظريات والآراء حول ذلك الموضوع.
لكنّنا نرى أنّ الكاتب قد دخل في بيان الآراء، دون أن يبيّن مسبقاً موضوع بحثه. علماً أنّه قد تعرّض إلى تسعة أمور في المقدّمة، وهي ليست بأهمّ من بيان موضوع البحث. وكان من اللازم عليه بيان موضوع البحث هنا؛ وذلك للأمور التالية:
1ـ الغموض الذي يُحيط بهذا الموضوع في حدّ ذاته؛ ولا سيما أنّ عنوان (ما لا نصّ فيه) لم يصِلْ إلى مستوى الألفاظ المصطلحة عند أهل الفنّ، بل هو لفظ ورد استعماله في بعض الموارد بما له من معنى لغويّ، أو عرفي عامّ، وليس له معنى معيّن في العرف الخاصّ، أي في عرف الأصوليين، ممّا يسبب الاختلاف في تفسير المراد به؛ فقد يُعطى تفسيراً واسعاً جدّاً؛ وربما يُفسَّر بتفسير أضيق.
2ـ تأثير تحديد موضوع البحث ـ وهو (ما لا نصّ فيه) ـ على طبيعة البحث فيه، سعةً وضيقاً، وعلى كيفية الورود والخروج في المباحث. ولو كان الموضوع محدَّداً لوجب التعرُّض إلى بعض ما تركه المؤلّف.
3ـ تأثير ذلك على الهدف الأساس من البحث، ألا وهو المقارنة بين المدرستين الإمامية والسنّية. فما لم يتحدّد المراد بـ (ما لا نصّ فيه) على وجه الدقّة لا تتحقّق المقارنة، ولا ينتهي البحث إلى نتيجة واضحة حينئذٍ.
ومن هنا يتضح أنّ هذا الإشكال لا يكون منحصراً بفاتحة البحث، حتى يمكن الإغضاء عنه، أو استدراكه بإضافة مقطع توضيحي، بل سوف ينسحب إلى كلّ البحث بجميع أطرافه.
ثانياً: وقد كان من المناسب أيضاً بيان منهج البحث في هذا الكتاب، وطريقة طرح الآراء، والاستدلال عليها، والمصادر المعتمدة.
ثالثاً: تبرز امتيازات المنهج العامّ للكتاب بجلاء فيما لو قارنّاه بكتاب «الأصول العامّة للفقه المقارن»؛ فإنّهما يشتركان في بعض النقاط، ويختلفان في أخرى.
فمن نقاط الاشتراك أنّهما تعرّضا إلى بحث الأدلّة التالية: القياس؛ الاستحسان؛ المصالح المرسلة؛ فتح الذرائع وسدّها؛ قول الصحابي؛ العرف؛ البراءة؛ الاحتياط؛ التخيير؛ الاستصحاب.
وامتاز كتاب «الأصول العامّة للفقه المقارن» ببحث ما يلي: «الكتاب؛ والسنّة؛ والإجماع؛ والعقل؛ وشرع من قبلنا؛ والقرعة. كما أنّه فصّل البحث في الأصول العملية التالية: البراءة؛ والاحتياط؛ والتخيير، ضمن مرحلتين:
الأولى: من حيث هي أصول شرعية؛ والثانية: من حيث هي أصول عقلية.
في حين امتاز كتاب «أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه» بتعرّضه للبحوث التالية: إجماع أهل المدينة؛ وإجماع العترة؛ والمقاصد الشرعية العامّة.
بيد أنّه لم يتعرّض إلى: الإجماع؛ والعقل؛ وشرع من قبلنا؛ والقرعة. كما أنّه لم يُفرد الأصول الشرعية عن العقلية.
أمّا الوجه في عدم تعرّضه للكتاب والسنّة فهو واضح ؛ لخروجهما عن موضوع ما لا نصّ فيه. لكن لا يُعرف الوجه في عدم وضع عنوانَيْ: العُرف؛ والمقاصد، في أصل الكتاب، وإنّما ألحقهما بالخاتمة!!
ومن الغريب أنّ المؤلّف قال في نهاية الباب الثاني: «بقي هنا أصلان، اتفق عليهما الفريقان، وإن اختلفا في بعض الخصوصيات، ألا وهما: 1ـــ دور العرف والسيرة العقلية في ما لا نصّ فيه؛ 2ـــ مقاصد الشريعة وأهدافها». ثمّ قال: «وهذا ما دعاني للبحث فيهما، وجعلهما خاتمة البحث»([1]).
أقول: أولاً: لا شك بأنّ اتفاق الفريقين على أمر يكون مبرّراً، بل مرجّحاً، لتقديمه.
وثانياً: لا داعي لفرزه عن سائر الأدلّة، فثمّة أدلّة متفق عليها أوردها المؤلّف في أصل البحث، كما هو الحال بالنسبة إلى البراءة والاستصحاب.
رابعاً: إن المتوقّع أن يعكس الكتاب الآراء المعروفة أو المشهورة بين الفريقين، كما يُفهم من بعض التعابير التي وردت في الكتاب، لكنّنا نرى الكاتب أحياناً يطرح آراءه الأصولية الخاصّة. ولا نتوقّف كثيراً عند هذه الملاحظة.
خامساً: من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع، من قبيل: مناقشته للمحقّق الخراساني في تقسيمه الثنائي لحالات المكلّف إذا التفت للحكم الشرعي([2])؛ مناقشته في تحديد مجاري الأصول العملية: البراءة، والاحتياط([3])؛ مناقشته للشهيد الصدر في مسلك حقّ الطاعة([4]).
المحور الثاني: الملاحظات الموردية
أوّلاً: تحت عنوان (القرآن وسعة آفاق دلالته)، ومن أجل إثبات هذه الحقيقة طرح المؤلّف عدّة أدلّة:
أوّلها: استدلال الإمام الهادي”عليه السلام” ــ في قصّة النصراني الذي فجر بمسلمة، وأسلم لدرء الحدّ ـــ بقوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنّا بِاللهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} (غافر: 84 ـ 85) على أنّه يُضرب حتى يموت([5]).
أقول: في مثل هذه الموارد ينبغي الإتيان بأمثلة وأدلة من سنخ المحكمات، لا المتشابهات؛ فإنّ هذا المورد لم يتضح فيه تقريب الاستدلال بالآية على الحكم بحسب المنهج المتعارف في الاستدلال. فأمام الكاتب هنا طريقان لا ثالث لهما:
الأوّل: بيان وجه الاستدلال لو فُرض وضوحه عنده.
الثاني: على فرض عدم وضوح وجه الاستدلال، وأنّ ذلك راجع إلى العلوم الغيبية للأئمّة، ومن باب التأويل، وفي مثل المقام يقال عادةً: نُرجع علمه إلى أهله. لكن لو كان ذلك لما نفع الكاتب كثيراً في دعم مدّعاه.
ورابعها ـــ بحسب الظاهر ـــ: قال المؤلّف: «قد حكى بعض مشايخنا أنّ بعض الفقهاء استنبط من سورة (المسد) أربعة وعشرين حكماً شرعياً»([6]).
أقول: إنّ مقتضى المقام يُملي على الكاتب ذكر مصدر لما أورده، أو الإشارة إلى بعض تلك الأحكام الأربعة والعشرين، كنماذج. ولا يحسن النقل المبهم الذي لا يُعرف فيه الناقل، ولا المنقول عنه، ولا المنقول، ولا سيما مع غرابته!!
ثانياً: تحت عنوان (عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة) قال المؤلّف: «على ضوء ما ذكرنا من سعة آفاق دلالة القرآن الكريم نقف على أنّ تخصيص آيات الأحكام بخمسمائة آية، أو أقلّ منها، إنما هو لأجل قصر النظر على الآيات التي [تتبنّى]([7]) الحكم الشرعي بدلالة مطابقية، كآيات الإرث، وغيره، وأمّا بالنظر إلى ما ذكرنا من دلالة قسم من الآيات على أحكام شرعية عملية دلالة التزامية، أو غير ذلك، فإنّها سوف تتجاوز الخمسمائة آية…»([8]).
أقول: 1ـــ إنّ ما تقدّم تضمّن فقط سعة دلالة الآيات، سواء أكانت مطابقية أم التزامية، بحيث يمكن انتزاع أحكام منها، فكيف يدلّ ذلك على عدد الآيات، فضلاً عن أن يدلّ على أنّها أكثر من خمسمائة؟!
2ــ لم يتقدّم من المؤلّف بيان تنوّع دلالة الآيات على الأحكام؛ وكونها تارة بالمطابقة؛ وأخرى بالالتزام.
ثالثاً: تحت عنوان (ظاهرة عدم النصّ بعد رحيل رسول الله’) أشار المؤلّف إلى أهمية السنّة، وأظهر أسفه على إهمالها، واستثنى ما وجد في ثنايا التاريخ من تصدّي بعض الصحابة لتدوين نزر قليل من السنّة، إلى أن أدرك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز خطورة الموقف، فأمر ابن حزم بكتابة السنة، ثم جاء دور التدوين الجادّ للسنّة عام 143هـ، واستمرّ العلماء في مواصلة ذلك بعده([9]).
أقول: 1ـــ الغريب من المؤلّف أنّه صوّر قصّة تدوين السنّة بهذا الشكل، ولم يُشِرْ ـ لا تصريحاً ولا تلويحاً ـ إلى دور أهل البيت” عليهم السلام”، وهل كانوا متفرّجين، وهم يرون السنّة مهدّدة بخطر الاندراس؟! في حين أنّه لا يخفى على كلّ من راجع الوثائق التاريخية والحديثية أنّهم أوّل من دوّن السنّة، وحافظوا عليها، كما يحافظ الناس على ذهبهم ودنانيرهم، وتوارثوها يداً بيد، وكابراً عن كابر.
2ـــ لقد عرض المؤلّف تاريخ تدوين السنّة من خلال الاقتصار على طرح الرؤية السنّية، ولم يُشِرْ إلى الجهود الكبيرة لعلماء الإمامية الأوائل، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا لا يتناسب مع الدراسات المقارنة، كما هو واضح.
ولا يُجدي الاعتذار بأنّ البحث هنا مبنيّ على الاختصار؛ لأنّ معنى الاختصار عدم التفصيل، أو عدم ذكر الأدلّة، وليس معناه طرح الفكرة مبتورة ومجتزأة، والاكتفاء ببيان وجهة نظر واحدة وإهمال غيرها.
كما لا يُغني تعرّض المؤلّف لذلك في مواضع أو كتب أخرى؛ فإنّنا بصدد تحليل ما ورد في هذا المطلب فعلاً، ولا نظر لنا إلى ما وراء هذه الوريقات.
كما لا يُغني تعرّضه فيما بعد إلى كتاب (جامع أحاديث الشيعة)؛ لكونه من الكتب المتأخّرة، والبحث المطروح متعلّق بمرحلة ما بعد العهد النبوي.
رابعاً: تحت عنوان (السبب الثاني لظاهرة عدم النصّ) ذكر المؤلّف أنّ السبب الثاني هو الإعراض عن أئمّة أهل البيت” عليهم السلام”. ثمّ عقّب بالقول: «وبذلك عالج الرسول’ مشكلة عدم النصّ بالأمر بالرجوع إلى أئمّة أهل البيت” عليهم السلام”، ليغرف المسلمون من معينهم الصافي، بعد الصدور عن الكتاب والسنّة، لكي لا يتوهّم الغافل أنّ الكتاب والسنّة غير مستوعبين لأحكام المواضيع ومتطلّبات العصر الحديث…»([10]).
ثمّ أشار إلى كثرة الأحاديث المروية عن أهل البيت” عليهم السلام”، وأنّها تربو على خمسين ألف حديث، ثمّ قال: «وعندئذٍ يصبح ما لا نصّ فيه شيئاً قليلاً، يمكن استخراج أحكامه من النصوص الموجودة…»([11]).
أقول: 1ـــ إنّ عدم بيان المؤلّف للمراد بما لا نصّ فيه ربما يكون مدعاة لإثارة التساؤل بأنّه إذا كانت مشكلة ما لا نصّ فيه قد تمّ حلّها على يد النبي الأكرم’ فكيف برزت مرّة أخرى، ولو في موارد قليلة، وتمّ علاجها من قِبَل الإمامية بالأصول العملية؟!
2ــــ إنّ قول المؤلّف: «وبذلك عالج الرسول’ مشكلة عدم النصّ بالأمر بالرجوع الى أئمّة أهل البيت^…» فيه قصور من جهة التعبير؛ فربما يوهم هذا الكلام أنّ ثمّة تسليماً بوجود مشكلة عدم النصّ، وقد تصدّى النبي’ لحلّها على سبيل التدارك والعلاج، في حين أنّ الشارع المقدّس اتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعها من الأساس.
3ــــ إنّ قول المؤلّف: «وعندئذٍ يصبح ما لا نصّ فيه شيئاً قليلاً…» لا يخلو من غموض. ولعلّ مراده ما أوضحه بعد ذلك من أنّ تلك الموارد القليلة ممّا لا نصّ فيه قد عالجه الإمامية بالأصول العملية([12]). فلو كان مراده ذلك فسوف يقع التهافت بين هذه العبارة والعبارة الأولى.
خامساً: تحت عنوان (حجّية أحاديث أهل البيت^) أورد المؤلّف ثلاثة أحاديث للاستدلال على ذلك([13])، ولم يتعرّض إلى الكتاب ولو بنحو الإجمال، وإنّما تعرّض لآية التطهير في البحث الثامن من الباب الأوّل، تحت عنوان (إجماع العترة)([14]). ولا أدري ما الوجه في ذلك؟!
كما أنه أشار إلى أهمية السنّة، وأظهر أسفه على إهمالها، واستثنى ما وجد في ثنايا التاريخ من تصدّي بعض الصحابة لتدوين نزر قليل من السنة، إلى أن أدرك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز خطورة الموقف، فأمر ابن حزم بكتابة السنة، ثم جاء دور التدوين الجادّ للسنّة عام 143هـ، واستمرّ العلماء في مواصلة ذلك بعده([15]).
أقول: عطفاً على ما تقدّم في ملاحظة سابقة لنا: إنّ القول بضياع الحديث لا يصح على إطلاقه؛ فإنّ ذلك ممّا ابتُلي به التيار المقابل لأهل البيت” عليهم السلام”، وأمّا هم فقد حفظوا السنّة بحذافيرها، ولم يخسروا منها حديثاً واحداً.
سادساً: قال المؤلّف في آخر المقدّمة: «نعم، عالجوا [أي الإمامية] ما لا نصّ فيه عندهم بالأصول العملية الأربعة، التي كلّها مستفادة من الكتاب والسنّة». ثمّ قال: «لكن مواردها ليست متوفّرة»([16]).
أقول: لم يتضح لي المراد بالعبارة الأخيرة، فهل المراد تعذّر أو ندرة موارد جريانها أو المراد شيء آخر؟!
فإن كان المراد الأوّل فهو يتنافى مع واقع العملية الاجتهادية. فما أكثر موارد جريان الأصول العملية، كما هو واضح، حتى قيل: إنّه لا توجد مسألة إلاّ ويمكن أن تكون مجرى لأصل من الأصول العملية.
سابعاً: يرِدُ على إعطاء الباب الأوّل عنوان (في الأصول العملية الأربعة) أنّ هذا العنوان، وما سبقه من التصريح بأنّ الإمامية عالجوا ما لا نصّ فيه بهذه الأصول، معناه الاختصاص بالإمامية، دون غيرهم. وهذا المدّعى ليس بتلك الدرجة من الوضوح. مضافاً إلى أنّ المؤلّف قد نقل عن نجم الدين الطوفي أنّه عدّ البراءة الشرعية والاستصحاب من ضمن مصادر التشريع([17]).
ثامناً: بدأ المؤلّف بحث الأصول العملية بالمقولة المعروفة للشيخ الأنصاري من تقسيم حالات المكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي إلى ثلاث، وهي: القطع؛ والظنّ؛ والشك. ثمّ أخذ في بيان الموقف تجاه كلّ حالة، وبيان الترتيب بين الأدلّة([18]).
أقول: إنّ الورود في البحث بهذا النحو ورودٌ غير فنّي ؛ لأنّ التقسيم الثلاثي لم يتمّ على أساس وجود النصّ وعدمه، بل على أساس درجة انكشاف الحكم الشرعي.
تاسعاً: إنّ جعل عنوان الباب (في الأصول العملية الأربعة) معناه اختصاص البحث بها. فما هي المناسبة للتعرّض لغيرها في أوّل البحث، حيث قسّم الأصول العملية إلى قسمين: الأوّل: ما يختصّ بباب دون باب، نظير: أصالة الطهارة؛ وأصالة الحلّية؛ وأصالة الصحة؛ والثاني: ما يجري في عامّة الأبواب الفقهية كافّة، وهي: الأصول الأربعة([19])؟!
ولم يذكر السبب في إهمال القسم الأوّل والبحث في خصوص الثاني.
وربما يُعتذر بوضوح السبب، ألا وهو كالبحث في القسم الأوّل غير أصولي. إلا أنّ ذلك لا يتناسب مع التعرّض في بحث الاستصحاب إلى أنّه مسألة أصولية. وقد أشار هناك المؤلّف إلى الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية([20]).
عاشراً: إنّ أحد الأدلّة التي ذكرها المؤلّف لإثبات البراءة مرسلة الصدوق([21]).
أقول: لا حاجة للاستدلال بالمرسلة ـــ وإن أمكن القول بحجيتها؛ بناء على بعض المباني ـــ ما دام بالإمكان الاستدلال بحديث آخر تامّ سنداً.
الحادي عشر: ذكر المؤلّف نظرية مسلك حق الطاعة للشهيد الصدر، ثمّ شرع في مناقشتها كبروياً وصغروياً. وممّا جاء في تلك المناقشات:
1ـــ قوله: «إنّ الاعتماد في التعذيب والمؤاخذة على مثل هذا الحكم العقلي إنّما يصح إذا كان ذلك الحكم من الأحكام العقلية الواضحة لدى العقلاء، حتى يعتمد عليه المولى سبحانه في التنجيز والتعذيب، ولكن المعلوم خلافها؛ إذ لو كان واضحاً لما أنكره العلماء»([22]).
أقول: إنّ حكم العقل في غاية الوضوح. وقد سلّم به الأصوليون كافّة؛ لحكمهم بالاحتياط في بعض الموارد مع عدم البيان، نظير: حكمهم بالاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص، مع أنّه لا بيان هنا، بل لمجرّد احتمال التكليف حكموا بتنجّزه.
وأمّا لِمَ اختار المشهور القول بمسلك قبح العقاب بلا بيان؟
فالجواب: هو وجود شبهة حصلت لهم، فأثارت ضبابية في أذهانهم الشريفة. والسبب في هذه الشبهة أحد أمرين:
أوّلهما: وجود السيرة العقلائية في دائرة المولويات العرفية.
ثانيهما: وجود النصوص الشرعية الكثيرة جدّاً، الواردة في الكتاب والسنّة، والتي تدلّ على البراءة عند عدم وجود الدليل على الحكم الشرعي.
2ـــ قوله: «إنّ اتفاق العقلاء على قبح العقاب بلا بيان نابع عن حكم العقل…، وإلا يعود بناء العقلاء إلى أمر تعبّدي. وهو كما ترى»([23]).
أقول: لا ضرورة لحصر مناشئ بناء العقلاء وسيرتهم في أمرين: حكم العقل؛ والتعبّد، بل إنّ النسبة الغالبة لمناشئ ذلك هو تنظيم شؤونهم، وتيسير الوصول لتحقيق مآربهم وسدّ حاجاتهم. وهذا هو السبب في اتفاقهم في البناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ما يرتبط بمولوياتهم العرفية؛ لتناسب ذلك مع الأغراض العقلائية؛ لأنّ القول بالاحتياط يوجب الوقوع في الحرج واختلال النظام.
ولا يصح التمسّك باتفاق العقلاء لإثبات كون الحكم عقلياً ؛ لأنّنا لو فكّرنا بهذه الطريقة فسوف ننتهي إلى نظرية خطيرة، وهي أنّ جميع الأحكام العقلائية هي أحكام عقلية، ولا يبقى لدينا حكم عقلائي واحد. وهو كما ترى.
3ـــ قوله: «إنّ الظاهر من الذكر الحكيم كون المسألة من الأمور الفطرية… فتبيّن بذلك أنّ الكبرى من الأحكام الواضحة لدى العقل والعقلاء بشرط التقرير على نحو ما ذكرناه»([24]).
أقول: 1ـــ لو سلّمنا أنّ ظاهر الآيات يدلّ على وضوح كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنّها تكون دالّة عليها في الجملة، لكنّها لا تدلّ على كون القاعدة حكماً عقلياً أو عقلائياً.
2ـــ إنّنا لا نسلّم أنّ قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} (طه: 134)، ونحوه من الآيات، يدلّ على صحة احتجاج الكفّار، وكونه احتجاجاً منطقياً، بادّعائهم أنّ المولى لا حق له بتعذيبهم قبل إنذارهم، وإنّما يدلّ على أنّ لله الحجة البالغة، بحيث لم يترك أيّة ذريعة يتشبّث بها الكفّار، بل أغلق الباب أمامهم.
وأمّا قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (الإسراء: 15) فالأمر فيه أوضح؛ إذ لا دلالة له على عدم استحقاق العصاة العذاب الإلهي قبل بعث الأنبياء إليهم، وأنّ التعذيب يكون ظلماً حينئذٍ، بل لعلّ ذلك من سعة رحمة الله ولطفه بعباده، وأنّه يعاملهم على أساس التفضّل والإحسان، لا على أساس العدل والاستحقاق.
إذاً فالاستدلال بهذه الآيات؛ لإثبات البراءة الشرعية، لا يستلزم التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بشأن المولى جلّ وعلا، وأنّه لا حق له في أعناق عباده إلاّ بعد البيان، وأنّه لو عذّبهم قبل البيان كان ظلماً، بل يدلّ على أنّه لا يعذّب قبل البيان، أمّا أنّ ذلك كان بسبب انتفاء حقه سبحانه، أي من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أم أنّه كان من باب التنازل عن حقه بعد ثبوته، أي أنّه من باب السلب لانتفاء المحمول، فهذه الآية وأمثالها لا تعيّن أحدهما، وليست بصدد البيان من هذه الجهة، كما هو واضح.
الثاني عشر: تعرّض المؤلّف في آخر الباب الثاني إلى سرد مصادر التشريع، ونقل عن نجم الدين الطوفي أنّه أنهاها إلى (19) مصدراً، ثمّ علّق عليه([25]).
أقول: إنّ هذا المطلب ينبغي أن يذكر في أوّل الكتاب، ولا داعي لتأخيره إلى الصفحة الأخيرة من الباب الثاني.
الثالث عشر: قوله: «إنّما يُعتبر العرف عنصراً في الشرع إذا لم يكن في مجراه حكم شرعي. وبتعبير آخر: يكون المورد منطقة فراغ، وإلا فلو كان هناك حكم شرعي فلا يكون العرف مورداً للاعتماد»([26]).
أقول: لم ألتفت إلى المراد من هذه العبارة، رغم لطافة ألفاظها. فما هو إلا حشد مجموعة من التعابير التي ليس لها معنى اصطلاحي مشخّص، من قبيل: التعبير بـ «إنّما يُعتبر العرف عنصراً في الشرع»، و«وإلا… فلا يكون العرف مورداً للاعتماد»، وكذا التعبير بـ «إذا لم يكن في مجراه حكم شرعي. وبتعبير آخر: يكون المورد منطقة فراغ، وإلا فلو كان هناك حكم شرعي…».
فهل المراد عدم صحة اعتماده كدليل شرعي في هذه الحالات فقط، دون غيرها، بمعنى صحة اعتماده دليلاً في موارد عدم وجود الحكم؟! أو المراد ما أشار له المؤلّف قبل هذه العبارة من تقسيم الأعراف إلى قسمين: صحيح؛ وفاسد؟!
الرابع عشر: قوله: «إنّ مصبّ البحث هو صيرورة العرف مصدراً لاستنباط الحكم الشرعي الكلّي، كخبر الواحد، والإجماع المنقول، والشهرة على القول بحجّيتها، وإلا فمجرّد كونه ممّا يرجع إليه الفقيه في تبيين المفاهيم، أو تمييز المصاديق، أو القاضي في القضاء وفصل الخصومات، لا يكون سبباً لعدّه من المسائل الأصولية»([27]).
أقول: إنّ المصرّح به في صدر العبارة أنّ البحث إنّما هو في كون العرف مصدراً، وليس في مطلق الإفادة منه، ولو في تبيين المفاهيم ونحوه، في حين أنّ ما أورده المؤلّف فيما بعد من عناوين لا ينطبق عليها الضابط المتقدّم.
الخامس عشر: لقد أورد المؤلّف عنوان (دور العرف في فهم المقاصد)، وبحث تحته جملة من العناوين الفرعية([28]).
أقول: 1ــ لم يتضح المراد من لفظ (المقاصد) الذي ورد في العنوان، فهل المراد به المعنى الاصطلاحي، أي مقاصد الشريعة العامّة، أم المراد شيء آخر؟
وعلى أيّة حال، وبأيّ معنى فسّرنا (المقاصد)، يبدو عدم انطباقه على جميع الموارد المذكورة تحت هذا العنوان؛ لكونها متشتِّتة، ولا يجمعها عنوان واحد، إلا إذا كان العنوان انتزاعياً.
2ــ إنّ بعض الموارد المذكورة خارجة عن عنوان (المقاصد) قطعاً، نظير: ما أورده المؤلّف بعنوان (الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق)([29]).
السادس عشر: لقد أورد المؤلّف عنوان (هل العرف من مصادر التشريع؟). وأوّل عبارة ذكرها تحت هذا العنوان هي قوله: «هذا بحسب أصولنا، ولكن الظاهر من أهل السنّة أنّه من مصادر التشريع…»([30]).
أقول: 1ــ من الواضح عدم ارتباط الجملة الأولى بالعنوان. والظاهر أنّها مرتبطة بالمطلب السابق.
2ــ لعلّ السبب في حصول هذا الخلل أنّ المؤلّف كان قد كتب هذه المطالب أوّلاً، ثمّ قطّعه إلى فقرات، ثمّ وضع عناوين لها، كما يظهر من هذا المورد، وأيضاً من موارد أخرى. كما تحتمل أسباب أخرى لذلك، والله أعلم.
خاتمة المقال
إنّ الموضوع الذي عالجه كتاب «أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه»، لمؤلّفه الشيخ جعفر السبحاني، من المواضيع الحسّاسة الدقيقة، والتي تحتاج إلى أن يركّز عليها العلماء والمفكّرون. وقد قام المؤلّف بفتح الباب في هذا المجال، فجزاه الله خير الجزاء، وكم ترك الأوّل للآخر.
الهوامش
(*) الشيخ خالد الغفوري: أستاذ في الحوزة العلمية، وباحث متخصِّص في الفقه الإسلامي، ورئيس تحرير مجلة فقه أهل البيت” عليهم السلام”، من العراق.
([1]) أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه: 296.
([2]) المصدر السابق: 39.
([3]) المصدر السابق: 41.
([4])المصدر السابق: 53 ـــ 56.
([5]) المصدر السابق: 11 ـــ 12.
([6]) المصدر السابق: 12.
([7]) كذا. وربما وقع خطأ مطبعي، ولعلّ الصحيح هو: (تبيّن).
([8]) المصدر السابق: 14.
([9]) انظر: المصدر السابق: 21 ـــ 22.
([10]) المصدر السابق: 25.
([11]) المصدر السابق: 26.
([12]) المصدر السابق: 35.
([13]) انظر: المصدر السابق: 27 وما بعدها.
([14]) انظر: المصدر السابق: 291 ـــ 292.
([15]) انظر: المصدر السابق: 21 ـــ 22.
([16]) المصدر السابق: 35.
([17]) المصدر السابق: 296.
([18]) انظر: المصدر السابق: 39.
([19]) المصدر السابق: 40.
([20]) المصدر السابق: 74.
([21]) المصدر السابق: 51.
([22]) المصدر السابق: 54.
([23]) المصدر السابق: 54.
([24]) المصدر السابق: 54 ـــ 55.
([25]) المصدر السابق: 296.
([26]) المصدر السابق: 303.
([27]) المصدر السابق: 303.
([28]) المصدر السابق: 304 وما بعدها.
([29]) المصدر السابق: 307.
([30]) المصدر السابق: 315.
یمکنکم قراءة الكتاب في مكتبة مدرسة الفقاهة (هنا)
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي