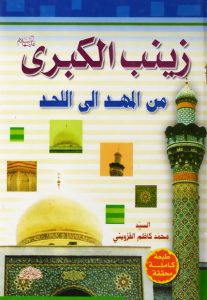الاجتهاد: يُعتبر تحديد أو تعيين السنة التي وصلت فيها قافلة آل الرسول إلى أرض كربلاء بعد رجوعهم من الشام من غوامض المسائل التاريخيّة. فهل كان الوصول في نفس السنة التي حدثت فيها فاجعة كربلاء الدامية، أي سنة (61) للهجرة، أم كان ذلك في السنة التي بعدها؟
مرت فاجعة كربلاء المؤلمة لتسجل أفجع يوم عرفه التأريخ، وأن مأساة كربلاء أمثولة كل متاس في دنيا الفجائع والاحداث. وفجعت كربلاء يوم انتهت المعركة لتبتدئ مسيرة الطف من جديد وتدك هذه الأرض التي انتقلت إلى أرض الشام بعد أن تواصلت تلك الأنفاس بصبر النفوس التي لم تخذل.
يوم الأربعين : هو اليوم العشرون من شهر صفر، وفيه وصلت عائلة الإمام الحسين (عليه السّلام) إلى كربلاء قادمين من الشام، وهم في طريقهم إلى المدينة المنوّرة.
وسُمّيَ بـ (يوم الأربعين)؛ لأنّه يصادف انقضاء أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام).
ويُعتبر تحديد أو تعيين السنة التي وصلت فيها قافلة آل الرسول إلى أرض كربلاء بعد رجوعهم من الشام من غوامض المسائل التاريخيّة. فهل كان الوصول في نفس السنة التي حدثت فيها فاجعة كربلاء الدامية، أي سنة (61) للهجرة، أم كان ذلك في السنة التي بعدها؟
فهنا تساؤل يقول: كيف يُمكن ذهاب العائلة من كربلاء إلى الكوفة، ثم إلى دمشق، ثم الرجوع والوصول إلى كربلاء، كلّ ذلك في أربعين يوماً، مع الانتباه إلى نوعيّة الوسائل النقليّة المتوفّرة يومذاك؟!
وهذه معركة علميّة تاريخيّة لا تزال قائمة على قدم وساق بين حملة الأقلام من المحدّثين والمؤرّخين.
ولعلّ رجوعهم كان من طريق الأردن إلى المدينة المنوّرة، فحينما وصلوا إلى مفترق الطرق طلبوا من الحَرَس الذين رافقوهم من دمشق أن يجعلوا طريقهم نحو العراق وليس إلى المدينة. ولم يستطع الحرس إلاّ الخضوع لهذا الطلب والتوجه نحو كربلاء.
وحينما وصلوا أرض كربلاء صادف وصولهم يوم العشرين من شهر صفر، وكان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري قد جاء إلى كربلاء يرافقه عطاء، أو عطيّة العوفي (1) وجماعة مِن بني هاشم، جاؤوا جميعاً لزيارة قبر الإمام الحسين (عليه السّلام).
واجتمع جماعة من أهل السواد (2)، وهم أهل القرى والأرياف التي كانت في ضواحي كربلاء يومذاك، فصار هناك اجتماع كبير نِسبيّاً من شتّى الطبقات، فالجميع حضروا عند قبر ريحانة رسول الله، وسيّد شباب أهل الجنة، يزورون قبره ويسلّمون عليه، والكآبة تخيّم على وجوههم، والأسى والأحزان تَعصِر قلوبهم.
كانت القلوب تشتعل حزناً، والدموع مستعدّة لتجري على الخدود، ولكنّهم ينتظرون شرارة واحدة حتّى تضطرم النفوس بالبكاء، وترتفع أصوات النحيب والعويل.
في تلك اللحظات وصلت قافلة العائلة المكرّمة إلى كربلاء، فكان وصولها في تلك الساعات هي الشرارة المترقّبة المتوقّعة، فتلاقَوا في وقت واحد بالبكاء والعويل (3).
كانت السيّدة زينب (عليها السّلام) في هذا المقطع من الزمان، وفي هذه المنطقة بالذّات ـ وهي أرض كربلاء ـ لها الموقف العظيم، وكانت هي القلب النابض للنشاطات والأحاسيس المبذولة عند قبور آل رسول الله (عليهم السّلام) في كربلاء. نشاطات مشفوعة بكلّ حزن وندبة، مِن قلوب ملتهبة بالأسى.
وما تظنّ بسيّدة فارقت هذه الأرض قبل أربعين يوماً، وتركت جُثَث ذويها معفّرة على التراب بلا دفن، واليوم رجعت إلى محلّ الفاجعة؟! فما تراها تصنع , وماذا تراها تقول؟!
أقبلت نحو قبر أخيها الحسين (عليه السّلام)، فلمّا قربت من القبر صرخت ونادت أكثر من مرّة ومرتين: وا أخاه! وا أخاه! وا أخاه!
كانت هذه الكلمات البسيطة المنبعثة من ذلك القلب الملتهب سبباً لتهييج الأحزان وإسالة الدموع، وارتفاع أصوات البكاء والنحيب، والله العالم كم كانت كلمات الشكوى تمرّ بخاطر السيّدة زينب الكبرى (عليها السّلام) حين كانت تبثّ آلامها، وأحزانها عند قبر أخيها الإمام الحسين؟ ممّا جرى عليها وعلى العائلة طيلة تلك الرحلة المُزعجة.
وما يُدرينا؟ ولعلّها كانت سعيدة ومُرتاحة الضمير بما قامت به طيلة تلك الرحلة؛ فقد أيقظت عشرات الآلاف من الضمائر الغافلة، وأحيَت آلاف القلوب الميّتة، وجعلت أفكار المنحرفين تتغيّر وتتبدّل مئة وثمانين درجة على خلاف ما كانت عليه قبل ذلك!
كلّ ذلك بسبب إلقاء تلك الخطَب المفصّلة، والمحاورات الموجزة التي دارت بينها وبين الجانب المُناوئ، أو الأفراد المحايدين الذين كانوا يجهلون الحقائق، ولا يعرفون شيئاً عن أهل البيت النبويّ الطاهر.
وتُعتبر هذه المساعي من أهمّ إنجازات السيّدة زينب الكبرى، فقد أخذوها أسيرة إلى عاصمة الاُمويِّين، وإلى البلاط الاُموي الذي أُسّس على عداء أهل البيت النبويّ من أوّل يوم، والذي كانت موادّه الإنشائية يوم بناء صرحه من النُصب والعداء لآل رسول الله، ومكافحة الدين الإسلامي الذي لا ينسجم مع أعمال الاُمويِّين وهواياتهم.
أخذوها إلى مقرّ ومسكن طاغوت الاُمويِّين، وبمحضر منه ومشهد، ومسمع منه ومن أسرته. خطبت السيّدة زينب تلك الخطبة الجريئة، وصبّت جام غضبها على يزيد، ووَصَمته بكلّ عارٍ وخِزي، وجعلت عليه سبّة الدهر، ولعنة التاريخ!
نعم، قد يتجرّأ الإنسان أن يقوم بمغامرات، اعتماداً على القدرة التي يَملكها، أو على السلطة التي تُسانده، وأمثال ذلك.
ولكن ـ بالله عليك ـ على مَنْ كانت تعتمد السيّدة زينب الكبرى في مواجهاتها مع اُولئك الطواغيت وأبناء الفراعنة، وفاقدي الضمائر والوجدان، والسُكارى الذين أسكرتهم خمرة الحكم والانتصار، مع الخمرة التي كانوا يشربونها ليلاً ونهاراً، وسرّاً وجهاراً؟!
هل كانت تعتمد على أحد غير الله تعالى؟!
ويُمكن أن نقول: إنّها قالت ما قالت، وصنعت ما صنعت في اصطدامها مع الظالمين؛ أداءً للواجب، وهي غير مُبالية بالعواقب الوخيمة المحتملة، والأضرار المتوقّعة، والأخطار المتّجهة إلى حياتها، فليكن كلّ هذا؛ فإنّ الجهاد في سبيل الله محفوف بالمخاطر، والمجاهد يتوقّع كلّ مكروه يُحيط به وبحياته.
ونقرأ في بعض كتب التاريخ: أنّ قافلة آل الرسول مكثت في كربلاء مدّة ثلاثة أيّام، مشغولة بالعزاء والنياحة، ثمّ غادرت كربلاء نحو المدينة المنوّرة.
الرجوع إلى مدينة الرسول (صلّى الله عليه وآله):
وصلت السيّدة زينب الكبرى إلى وطنها الحبيب، ومسقط رأسها، ومهاجَر جدّها الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله).
وكانت قد خرجت من المدينة قبل شهور، وهي في غاية العزّ والاحترام بصُحبة إخوتها ورجالات أُسرتها، واليوم قد رجعت إلى المدينة وليس معها من اُولئك السادة الأشاوس سوى ابن أخيها الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السّلام)، فرأت الديار خالية مِن آل الرسول الطاهرة.
وتـرى ديـارَ اُميّة معمورةً وديارَ أهلَ البيتِ منهم خاليهْ
وجاء في التاريخ: أنّ السيّدة زينب (عليها السّلام) لمّا وصلت إلى المدينة توجّهت نحو مسجد جدّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ومعها جماعة من نساء بني هاشم، وأخذت بعُضادَتي باب المسجد (4)، ونادت: يا جدّاه! إنّي ناعية إليك أخي الحسين. وهي مع ذلك لا تجفّ لها عبرة، ولا تفتُـرُ عن البكـاء والنحيـب (5).
إنّ الأعداء كانوا قد منعوا العائلة عن البكاء طيلة مسيرتهنّ من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام، وهنّ في قيد الأسر والسَبي، حتّى قال الإمام زين العابدين (عليه السّلام): ( (إن دمعت من أحدنا عينٌ قُرع رأسه بالرمح)) (6).
والآن قد وصلت السيّدة إلى بيتها، وقد ارتفعت الموانع عن البكاء، فلا مانع أن تُطلق السيّدة سراح آلامها لتنفجر بالبكاء والعويل على أشرف قتيل وأعزّ فقيد، وأكرم أُسرة فقدتهم السيّدة زينب في معركة كربلاء.
وخاصةً إذا اجتمعت عندها نساء بني هاشم ليُساعدنها على البكاء والنياحة على قتلاها، وحضرت عندها نساء أهل المدينة ليُشاركنها في ذرف الدموع، ورفع الأصوات بالصراخ والعويل.
والبلاغة والحكمة تتطلّب من السيّدة زينب أن تتحدّث عمّا جرى عليها وعلى أُسرتها طيلة هذه الرحلة من ظلم يزيد وآل أبي سفيان، وعملائهم الأرجاس الأنذال. وتتناوب عنها السيّدات الهاشميات اللاتي حضرن في كربلاء , ونظرن إلى تلك المآسي والفجائع، وشاهدنَ المجازر التي قام بها أتباع الشياطين من بني اُميّة.
كانت النسوة يخرُجن من مجلس العزاء وقد احمرّت عيونهنّ من كثرة البكاء، وكلّ امرأة مرتبطة برجل أو أكثر، من زوج أو أبٍ أو أخ أو ابن، وتقصّ عليهم ما سمعته من السيّدة زينب (عليها السّلام) من الفجائع التي وقعت في كربلاء، وفي الكوفة، وفي طريق الشام، وفي مجلس يزيد، وفي مدينة دمشق بصورة خاصّة.
كان التحدّث عن أيّ مشهد من تلك المشاهد المؤلمة يكفي لأن تمتلئ القلوب حقداً وغيظاً على يزيد وعلى مَنْ يدور في فَلكه، وحتى الذين كانوا يحملون الحبّ والوداد لبني اُميّة انقلبت المحبّة عندهم إلى الكراهية والبغض، كما وأنّ الذين كانوا يُكنّون الطاعة والانقياد للسلطة الحاكمـة صـاروا على أعتاب التمـرّد والثورة ضـدّ السلطة (7).
ومن الطبيعي أنّ الأخبار كانت تصل إلى حاكم المدينة، وهو من نفس الشجرة التي أثمرت يزيد وأباه وجدّه، فكان يرفع التقارير إلى يزيد ويُخبره عن نشاطات السيّدة زينب، ويُنذره بالانفجار، وانفلات الأمر من يده، قائلاً: إن كان لك في المدينة حاجة فأخرج منها زينب.
جُبَناء، يحكمون على نصف الكرة الأرضية ويخافون من بكاء امرأة لا تملك شيئاً من الإمكانات والإمكانيّات!
إنّهم يعرفون أنفسهم ويعرفون غيرهم، يعرفون أنفسهم أنّهم يحكمون على رقاب الناس، ويعرفون أنّ غيرهم يملكون قلوب الناس.
من المؤسف المؤلم أن يُحسَب هؤلاء الظلمة مِن المسلمين، وأن تُحسَب جناياتهم على الدين الإسلامي.
وأيّ إسلام يرضى بهذه الجناية التي تقشعرّ منها السماوات والأرض؟! هل هو إسلام النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله)، أم إسلام بني اُميّة؟! إسلام معاوية، ويزيد بن معاوية، وعمر بن سعد، والدعيّ ابن الدعيّ عبيد الله بن زياد؟!
ولا مانع لدى يزيد أن يأمر حاكم المدينة بإبعاد السيّدة زينب مِن مدينة جدّها الرسول، ولكن السيّدة امتنعت عن الخروج من المدينة، وكأنّها لا تَهاب الموت، ولا تخاف مِن أيّ رجس من اُولئك الأرجاس.
وهل يستطيع الأعداء أن يَحكُموا عليها بشيء أمرّ من الإعدام؟ فلا مانع، فلقد صارت الحياة مبغوضة عندها، والموت خير لها من الحياة تحت سلطة الظالمين.
إنّها تلميذة مدرسة كان أساتذتها يقولون: ( (إنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ بَرَما)).
وتحدّت السلطة، وأعلنت امتناعها عن الخروج من المدينة , ولكنّ عدداً من السيّدات الهاشميات اجتمعن عندها وذكّرنها بيزيد وطغيانه، وأنّه لا يخاف من الله تعالى، ومن الممكن أن تتكرّر فاجعة كربلاء؛ بأن يأمر الوالي بإخراج السيّدة من المدينة قَسراً وجَبراً، فيقوم بعض مَنْ تبقّى من بني هاشم لأجل الدفاع، وتقع الحرب بين الفريقين، وتُقام المجزرة الرهيبة؛ فقرّرت السيّدة زينب (عليها السّلام) السفر إلى بلاد مصر.
ولماذا اختارت مصر؟
إنّ أحسن بلاد الله تعالى عند السيّدة زينب بعد المدينة المنوّرة هو مصر؛ لأنّه كان لآل رسول الله في بلاد مصر رصيدٌ عظيم من ذلك الزمان إلى هذا اليوم. والسبب في ذلك أنّ أفراداً من الخط المُوالي للإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) كانوا قد حكموا مصر في تلك السنوات، أمثال: قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، ومحمد بن أبي بكر، وأخيراً مالك الأشتر النخعي (8).
المصدر: الفصل الثامن عشر من كتاب زينب الكبرى (ع) من المهد الى اللحد للسيد محمد كاظم القزويني
الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)وهو من مشاهير التابعين الذين لم يَرَوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ولكنّهم رأوا صحابة الرسول.
(2) أهل السواد: كان يُعبّر عن أراضي العراق بـ (أرض السواد)؛ لكثرة وكثافة الأشجار فيها، مع الانتباه إلى تُربتها الصالحة للزراعة لدرجة كبيرة. فالأراضي التي تُغطّيها الأشجار تتراءى من بعيد وكأنّها سوداء؛ ومِن هنا سمَّوا المزارع والبساتين بـ (أرض السواد)، وسمَّوا الذين يسكنون هذه المناطق بـ (أهل السواد). المحقّق.
(3) ذكر السيّد ابن طاووس في كتاب (الملهوف) / 225: ولمّا رجعت نساء الحسين (عليه السّلام) وعياله من الشام وبلغوا العراق، قالوا للدليل: مُرّ بنا على طريق كربلاء. فوصلوا إلى موضع المصرع، فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم، ورجالاً من آل الرسول، قد وردوا لزيارة قبر الحسين (عليه السّلام)، فوافَوا في وقت واحد، وتلاقوا بالبكاء والحزن واللَطم، وأقاموا المآتم المُقرحة للأكباد، واجتمعت إليهم نساء ذلك السواد، وأقاموا على ذلك أيّاماً. المحقّق.
(4) أي الخشبتين المنصوبتين عن يمين الباب وشماله. كما في (لسان العرب).
(5) كتاب (بحار الأنوار) 45 / 198. المحقّق.
(6) بحار الأنوار 45 / 154، ب 39، نقلاً عن كتاب (إقبال الأعمال).
(7) وقد جاء في التاريخ: أنّ عبد الله بن جعفر كان جالساً في داره يستقبل الناس الذين يريدون أن يعزّوه باستشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام) واستشهاد ولديه عون وجعفر، إذ دخل عليه رجل وعزّاه، فقال عبد الله: إنّا لله وإنّا إليه راجعون!
فقال رجل يُقال له (أبو السلاسل): هذا ما لَقينا من الحسين بن علي! فحَذَفه (أي رماهُ) عبد الله بن جعفر بنعله، وقال له: يابن اللَخناء! (يُقال في السبّ: يابنَ اللخناء، أي يابن المرأة المُنتنَة) أللحسين تقول هذا؟!
ثمّ قال: والله، لو شهدتُه لأحببت أن لا أُفارقه حتّى أُقتَل معه. والله إنّه لمِمّا يُسكّن نفسي، ويُهوّن عليّ المُصاب أنّ أخي وابن عمّي أُصيبا مع الحسين، مواسيَين له، صابرَين معه.
ثمّ أقبل على جلسائه فقال: الحمد لله، عزّ عليّ مصرع الحسين، إن لم أكن واسيتُ حسيناً بيدَيّ فقد واساه ولداي.
المصدر: كتاب (بحار الأنوار) 45 / 122 ـ 123، وذكره الطبري في تاريخه 5 / 466. المحقّق.
(8) وقد ذكر تفاصيل ذلك المَقريزي (المتوفى عام 845 هـ) في كتابه (المواعظ والاعتبار)، طبع لبنان (سنة 1418 هـ) 2 / 93، و 4 / 151 و 156 ـ 157، حيث قال: ومصر يومئذ من جيش علي بن أبي طالب.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي