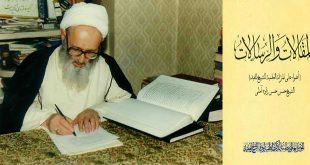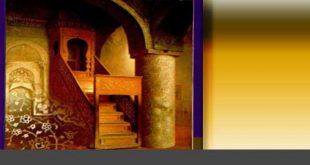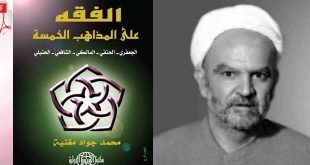الاجتهاد: المسلمون اليوم بأمسّ الحاجة إلى الحضور في الساحة الدولية، وهذا الأمر يتطلب التعايش مع غير المسلمين، وخاصّة أهل الكتاب؛ التعايش في الأمور السياسة والثقافية والاقتصادية والعسكرية وما شابه ذلك. والحكم بنجاسة غير المسلمين وأهل الكتاب، مضافاً إلى أنه يوجب العُسْر والحَرَج للمسلمين، ينافي الكرامة الإنسانية التي وردت في القرآن والسنّة الشريفة. والعقل يحكم بأن الإنسان حسب الإنسانية خلق طاهراً، إلاّ أن يحكم بنجاسته العرضية بملاقاة الأعيان النجسة.
هذه الدراسة جاءت لبيان وعرض مسألة نجاسة غير المسلمين وأهل الكتاب ، وأدلتها القرآنية والروائية، وتمحيصها مهما أمكن.
ومن المسائل المهمّة ومحل الابتلاء، والتي كانت منذ قديم الزمان معركة آراء فقهاء الإسلام، هي طهارة ونجاسة غير المسلمين عامّة، وأهل الكتاب خاصّة.
وقد استند فقهاء الشيعة والسنّة في فتاواهم إلى أدلّة مختلفة من العقل والنقل، وهذه الأدلة المختلفة تسبب فتاوى شتّى في موضوع نجاسة وطهارة غير المسلمين.
يطرح الكاتبُ الأدلّة القرآنية والروائية في نجاسة غير المسلمين و أهل الكتاب، وينتقدها، ويتابع الكاتب بحثه بالأدلة القرآنية والروائية في موضعين.
والمنهج في هذا التحقيق بيان المسألة وأدلّة الفقهاء فيها، ثمّ نقدها، وبيان المختار في الموضوع، مع الأدلة القرآنية والروائية والعقلية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل إذا كان الإنسان غير مسلم فهو نجسٌ بذاته؟ وهل يمكن أن نعالج الأدلّة التي تحكم بنجاسة الإنسان؟
مع أن الفقهاء يجيبون عن هذه الأسئلة، ويطرحون مسألة نجاسة أو طهارة أهل الكتاب بطرقٍ مختلفة كمسألةٍ من المسائل الشرعية، أو بشكل بحثٍ مستقلّ، فإنّ هذا البحث يطرح هذه المسألة من وجهة نظر أخرى، وهي عرض الأدلة القرآنية والروائية في نجاسة أهل الكتاب تفصيلاً، ثمّ نقدها بالأدلة القرآنية والروائية.
أدلة الفقهاء على نجاسة أهل الكتاب
أوّلاً: الاستدلال على نجاسة أهل الكتاب بالكتاب
1ـ استدلّ على نجاسة أهل الكتاب بقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 28).
استدلّ على القول بنجاسة أهل الكتاب بأنّهم مشركون، سواءٌ أكانوا يهوداً أم نصارى أم مجوساً. ويستشهد لذلك بآياتٌ كثيرة من القرآن الكريم، سنشير إليها؛ وذلك بأنّ اليهود قد قالوا بأنّ عزيراً هو ابنُ الله، والنصارى قالوا عن المسيح× ذلك أيضاً، واعتقدوا بالتثليث، ويعتقد المجوس بالثنويّة أيضاً. إذن فكلُّهم من المشركين، والآية المذكورة صريحةُ الدلالة على نجاسة كلِّ المشركين.
وقبل مناقشة هذا الاستدلال لا بُدَّ من الإشارة إلى مطلبٍ مهمّ، وهو أنّ هذه الآية لم تكن عمدة استدلال القائلين بنجاسة أهلالكتاب. وقد استشكل البعض منهم في دلالتها على النجاسة، وأعرض البعض الآخر عن أصل الاستدلال بها، فاستدلّوا على النجاسة بأدلّةٍ أخرى، في حين صرَّح آخرون بعدم دلالتها على المدَّعى.
أدلة الشهيد محمد باقر الصدر في شرحه على كتاب العروة والوثقى
وقد عثرنا على كلامٍ جامع للمحقِّق الفقيه الشهيد السيد محمد باقر الصدر(1980م)، وذلك في شرحه على العروة الوثقى. وحيث إنّه يغنينا عن الكثير من الأبحاث والكلمات فإنّنا ننقله بنصّه وإنْ طال؛ نظراً لأهميّة ومحوريّة الاستدلال بهذه الآية في محلّ الكلام، وفي الاستدلال على نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار أيضاً.
قال: «…وتحقيق الكلام في هذه الآية يقع في ثلاث جهات:
الجهة الأولى: في إمكان استفادة النجاسة بالمعنى المبحوث عنه من كلمة «نجس» في الآية.
وتوضيحه: إنّ كلمة نَجَس ـ بفتح الجيم ـ مصدر، والنجاسة اسم مصدر، وأمّا الوصف فهو نَجِس، بكسر الجيم.
نعم، ذكر بعض أنّ كلمة نَجَس ـ بفتح الجيم ـ تأتي أيضاً بمعنى الوصف. وهذا ـ لو سُلِّم ـ فلا شَكَّ في أنّ الظاهر من الآية الكريمة إرادة المعنى الأوّل، أي المصدر؛ إذ بناءً على الوصفيّة كان مقتضى الطبع المطابقة بين الوصف والموصوف في الجمع، بخلافه على المصدريّة؛ لأنّ نفس العناية التي لا بُدَّ من إعمالها في الشخص الواحد عند حمل المصدر عليه يمكن إعمالها في مجموع الجماعة.
وعليه يقع الكلام في تعيين المراد من المعنى المصدري في الآية؛ فإنّ القذارة تتصوّر على أنحاء ثلاثة:
الأوّل: قذارة حسّيّة قائمة بالجسم خارجاً.
الثاني: قذارة قائمة بالشخص أو المعنى. وقد يعبَّر عنها بالخبث وسوء السريرة، ويقول الراغب الإصفهاني: «إنّ هذه قذارة تدرك بالبصيرة، لا بالبصر».
الثالث: قذارة قائمة بالجسم، غير قابلة للتعدّي إلى الآخر. فمثلاً: الخمر مسكر، والإسكار صفةٌ لجسم الخمر، فإذا كان الإسكار قذارةً واقعيّة أو اعتباريّة فالخمر بجسمه قذر، كما في القسم الأوّل، إلاّ أنّ هذه القذارة ـ بناءً على هذا التصوير لها ـ لا تقبل السريان، بخلاف القسم الأوّل. وهذا هو الذي يشار إليه في الروايات الدالّة على طهارة الخمر بلسان: إنّ الثوب لا يَسْكَر.
ثمّ إنّ هذه القذارات الثلاث؛ تارةً تكون حقيقيّة، كما في الأجسام الحاملة عرفاً للقذارة المتعديّة، وفي الإنسان الخبيث، وفي الخمر ـ بناءً على كون الإسكار قذارة واقعيّة ـ؛ وأخرى تكون اعتباريّة؛ فالقذارة الاعتباريّة إنّما هي اعتبارٌ لنفس هذه القذارات الثلاث.
أمّا اعتبار القذارة الأولى فمن قبيل: اعتبار الشارع نجاسة الكافر، بناءً على نجاسته.
وأمّا اعتبار القذارة الثانية فهذا ممّا لا نحتمله في الشريعة، ولكنْ لو تمّت أخبار تنقيص وتخبيث ولد الزنا احتمل حملها على هذا المعنى.
وأمّا اعتبار القذارة الثالثة فمن قبيل: الجنابة، والحيض، ونحوهما من الأحداث.
فالجنابة ـ مثلاً ـ ليست قذراً معنويّاً قائماً بالروح ـ كما يقال: إنّ الحدث ظلمة نفسانيّة ـ؛ فإن هذا كلامٌ شعري، بل المستفاد من الأخبار كون الجنابة حالة في الجسم، ولهذا ورد أنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابة، وهذه الحالة تعتبر قذارة عند الشارع؛ بدليل التعبير عن الغسل بالطهارة، كما في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (المائدة: 6). فهي قذارة قائمةٌ بوصف في الجسم، ولا تسري إلى جسمٍ آخر بالملاقاة؛ لأنّ ذلك الوصف لا يسري كذلك.
ولهذا جاء في روايات طهارة الثوب الملاقي لبدن الجُنُب: إنّ الثوب لا يجنب، وورد في عرق الجنب والحائض: إنّ الجنابة والحيض حيث وضعهما الله. والعجب أنّ بعضهم ـ بعد أن ذكر النجاسة الشرعية، التي هي قذارةٌ جسميّة، والقذارة المعنويّة ـ أنكر تصوُّر قسمٍ ثالث من القذارة، وادَّعى أنّ فرض قذارة قائمة بالجسم غير القذارة الأولى غير مألوفٍ ولا مقبول عند أهل الشرع، مع أنّا لاحظنا أنّ هذا القسم الثالث هو المستفاد من الشرع في مثل الجنابة والحيض.
وهكذا يتَّضح أنّ القذارة متى كانت صفة ابتدائيّة للجسم كانت قذارة جسميّة قابلة للسريان بالملاقاة، ومتى كانت قائمة بصفةٍ ثابتة للجسم، ولم تكن تلك الصفة قابلة للسريان بالملاقاة، فلا تسري القذارة إلى الملاقي، بالرغم من كونها قذارةً جسميّة.
وتعدّد أقسام القذارة لا ينافي أنّها ذات معنى واحد معروف. والأقسام المذكورة إنّما تختلف في مركز القذارة والنجاسة؛ فهو تارةً الجسم؛ وأخرى المعنى أو النفس؛ وثالثةً صفة قائمة بالجسم. ولا انصراف إلى أحد الأقسام إلاّ بضمّ المناسبات والملابسات. والنجاسة الشرعيّة ليست معنىً آخر للفظ القذارة، وإنّما هي اعتبار للنجاسة الحقيقيّة.
وعلى هذا الأساس فقد يستشكل على الاستدلال بالآية الكريمة بأنّ لفظة النجاسة يمكن حملها على معناها الحقيقي اللغوي، أي القذارة، فلا تعطي إلاّ الطعن في المشركين بالقذارة والوساخة، ولا موجب لحملها على الفرد الاعتباري من القذارة المدَّعاة في المقام.
تقريب استدلال الشهيد الصدر
نقرِّب الاستدلال هنا بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: دعوى أنّ هذا المعنى هو الاصطلاح الشرعي في زمن النبيّ|؛ إمّا على أساس الحقيقة الشرعيّة؛ أو القرينة العامّة.
وأورد عليه السيّد الأستاذ([1]) بأنّ هذا يتوقَّف على تسليم أصل تشريع النجاسة في الجملة في زمان نزول الآية، وهذا غير معلومٍ؛ لما نعلم من أنّ الأحكام بُيِّنت بالتدريج.
ولكنّ التحقيق أنّ المظنون قويّاً تشريع أصل النجاسة قبل هذه الآية؛ فإنّ هذه الآية نزلت في سورة التوبة ـ كما هو معلومٌ ـ في السنة التاسعة من الهجرة، في أواخر أيّام النبيّ|، والمظنون قويّاً تشريع عدّة نجاسات إلى ذلك الزمان. ويشهد لذلك أمورٌ:
منها: إنّ تدريجيّة الأحكام إنّما كانت لمصلحة تكليف الناس وإعدادهم. ومن المعلوم أنّ نجاسة بعض النجاسات على وفق الطبع العقلائي، فلا موجب لتأخير تشريعها. وحين دخل الرسول| المدينة كان متعارفاً عند أهل المدينة الاستنجاء بالحَجَر أو الماء، وكان البراء بن معرور الأنصاري أوّل مَنْ استنجى بالماء من المسلمين، فنزلت في حقّه: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: 222).
ومنها: إنّ بعض روايات الإسراء ـ وهو قبل الهجرة ـ فيها إشارةٌ إلى النجاسة؛ إذ يقارن فيها بين هذه الأمّة والأمم السالفة التي قصَّرَتْ، فحملت عليهم تكاليف شاقّة في حالة إصابة البول للبَدَن ونحوه، وأمّا هذه الأمّة فقد جعل الماء لها طهوراً.
ومنها: ما ورد في بعض روايات حبّ النبيّ| للحسن أو للحسين ـ على اختلاف متونها ـ، من أنّه كان في حجر النبيّ|، فبال، فأريد أخذه أو تأنيبه، فمنع النبيّ|، ودعا بماءٍ فصبَّه عليه، وفي بعضها أنّ النبيّ| «بال عليه الحسن والحسين قبل أن يطعما فكان لا يغسل بولهما من ثوبه».
ومنها: قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّبَاً﴾ (المائدة: 6)، بناءً على كون الطيِّب بمعنى الطاهر الشرعي، كما هو مقتضى استدلال الفقهاء بالآية على اشتراط طهارة التراب. وافتراض طاهرٍ كذلك يساوق افتراض تشريع النجاسة. والمنقول أنّ سورة المائدة قبل سورة التوبة، فإذا أوجبت هذه الشواهد وغيرها الظنَّ الاطمئنانيّ بسبق تشريع النجاسة لم يتمّ الجواب المذكور.
غير أنّ الصحيح ـ مع هذا ـ عدم تماميّة أصل الوجه؛ لأنّ النجاسة وإنْ كانت مشرَّعة إجمالاً في ذلك الزمان، ولكنَّ المتتبِّع يكاد أن يحصل له القطع بأنّ لفظة النجاسة لم تكن قد خُصِّصت للتعبير عن القذارة الشرعيّة، وإنّما كان يعبَّر عنها بتعبيرات مختلفة في الموارد المتفرّقة.
ولهذا نلاحظ أنّ مجيء لفظ «النجاسة» في مجموع الأحاديث المنقولة عن النبيّ| إمّا معدوم؛ وإمّا نادرٌ جدّاً، لا في طرقنا فقط، بل حتّى في روايات العامّة التي تشتمل على ستّمائة حديثٍ عن النبيّ| في أحكام النجاسة، ولم أجِدْ فيها التعبير بعنوان النجس، إلاّ في روايتين: في إحداهما نقل الراوي أنّ رسول الله| قال: «إنّ الهرّ ليس بنجسٍ»؛ وفي الأخرى نقل أنّ صحابيّاً واجه النبيّ| وهو جنبٌ، فاستحيى، وذهب واغتسل، واعتذر من النبيّ، فقال|: «سبحان الله! إنّ المؤمن لا ينجس».
وهذا يكشف عن ضآلة استعمال لفظة النجاسة ودورانها في لسان الشارع، الأمر الذي ينفي استقرار الاصطلاح الشرعي بشأن هذه اللفظة.
الوجه الثاني: دعوى حمل النجاسة على النجاسة الشرعيّة؛ بقرينةٍ حاليّة خاصّة، وهي ظهور حال المولى في كونه في مقام المولويّة، فلو حمل اللفظ على النجاسة غير الشرعيّة الاعتباريّة لكان هذا إخباراً من قبل المولى عن أمرٍ خارجي، وهو خلاف الظهور الحالي المذكور.
ويَرِدُ عليه ـ مضافاً إلى إمكان منع هذا الظهور في القرآن الكريم، الذي له أغراض تربويّة شتّى ـ أنّ نجاسة المشرك ذُكرت تعليلاً لحكمٍ شرعي، وهذا مناسبٌ لمقام المولويّة، سواءٌ أريد بالعلّة النجاسة الشرعيّة أو النجاسة الواقعيّة.
الوجه الثالث: دعوى أنّ الأمر دائرٌ بين القذارة الخارجيّة والقذارة الاعتباريّة، والأوّل لا يحتمل كونه علّةً لمنع المشركين من الاقتراب إلى المسجد الحرام؛ إمّا لوضوح عدم انطباقها على كثيرٍ منهم؛ وإمّا لوضوح أنّ مجرّد القذارة الخارجيّة لا يوجب حرمة الاقتراب، فيتعيَّن الثاني.
ويَرِدُ عليه ـ مضافاً الى أنّ الحمل على الثاني يقتضي أيضاً الالتزام بكون النجاسة الشرعيّة لشيءٍ مناطاً لحرمة دخوله، ولو لم يلزم سراية أو هتك ـ أنّه يوجد فردٌ معنويّ من القذارة الخارجيّة كما تقدَّم، والحمل عليه لا يَرِدُ عليه الإشكال المذكور.
ثم إنّه يوجد مبعِّدٌ لما تدَّعيه هذه الوجوه الثلاثة من الحمل على النجاسة الاعتباريّة، وهو أنّ الآية الكريمة سيقت مساق حصر حقيقة المشركين بأنّهم نجس؛ بلحاظ أداة الحصر، فكأنّه لا حقيقة لهم سوى ذلك، وهذا إنّما يناسب النجاسة الحقيقيّة المعنويّة، لا النجاسة الاعتباريّة.
الوجه الرابع: دعوى الإطلاق في كلمة «نجس»، وأنّه بالإطلاق تدلّ الآية الكريمة على نجاسة المشرك بتمام شؤونه ومراتبه، نَفْساً وبَدَناً، فتثبت النجاسة المعنويّة والجسميّة. وبعد معلوميّة عدم النجاسة الجسميّة الحسّيّة في بدن المشرك تحمل على نجاسة البدن الاعتباريّة؛ فليس الأمر دائراً بين نجاسة النفس ونجاسة البدن ليُدَّعى عدم تعيُّن الثاني، بل الإطلاق كفيلٌ بإثباتهما معاً.
ويَرِدُ عليه: إنّ النفس والبدن ليسا فردين من الموضوع في القضيّة لتثبت بالإطلاق نجاستهما معاً، بل مرجعهما إلى نحوين من ملاحظة المشرك؛ فقد يلحظ بما هو جسمٌ؛ وقد يلحظ بما هو شخصٌ معنوي. ولحاظه بما هو جسمٌ ومعنى معاً وإنْ كان أمراً معقولاً، ولكنّه لا يفي به الإطلاق؛ لأنّ الإطلاق ينفي أخذ قيدٍ زائد في الموضوع، وليس له نظر إلى توسعة اللحاظ، وإدخال حيثيّاتٍ عديدة تحته، بل يحتاج ذلك إلى قرينةٍ خاصّة. وعليه فالظاهر عدم تماميّة الحمل على المعنى الشرعي، فلا يتمّ الاستدلال بالآية الكريمة.
الجهة الثانية: في أنّه بعد افتراض حمل النجاسة على الاعتبار الشرعي قد يُقال: إنّ الأمر يدور بين عنايتين: إحداهما: عناية حمل المبدأ على الذات؛ والأخرى: عناية تقدير كلمة «ذو». ولا مرجِّح للعناية الأولى، ومع احتمال العناية الثانية لا تدلّ الآية إلاّ على كون المشرك ذا نجاسة، وهذا يتلاءم مع النجاسة العرضيّة.
ويَرِدُ عليه ـ مضافاً إلى أنّ عناية حمل المصدر أخفّ من عناية التقدير عُرْفاً ـ أنّ مقتضى إطلاق كون المشرك ذا نجاسة عينيّة نجاسته كما هو واضح، وحصر حقيقة المشرك بالنجاسة أنسب بالنجاسة العينيّة من النجاسة العرضيّة، كما لا يخفى.
الجهة الثالثة: في أنّه ـ بعد افتراض تماميّة الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة المشرك ـ هل يمكن أن نثبت بها نجاسة الكتابيّ وغيره من أقسام الكفّار؟
وتوضيح ذلك: إنّ المشرك تارةً يُراد به في الآية الكريمة معناه اللغويّ، وهو كلّ مَنْ كان متلبسّاً بالشرك في الواقع، سواءٌ دان بعنوان الشرك أو لا؛ وأخرى يُراد به معناه الاصطلاحي الذي كان المجتمع الإسلامي يسير عليه، تمييزاً للمشرك عن الذمّي، وهو عبارة عمَّنْ يدين بالشرك بعنوانه، فلا ينطبق على مَنْ كان واقع عقيدته شركاً، وإنْ لم يقبل عنوان الشرك لنفسه، كالنصراني.
فعلى الأوّل لا إشكال في شمول الآية لأقسامٍ من الكفّار الكتابيّين، كالنصارى والمجوس، إلاّ أنّ نجاسة النصراني حينئذٍ تكون بوصفه مشركاً، فلا تشمل نصرانيّاً اتَّفق إيمانُه بالنصرانيّة، دون تورُّطٍ في شركها وتثليثها.
وقد يُورَد على هذا التقدير بدعوى أنّ الأخذ بإطلاق كلمة «المشرك» في الآية غير ممكن؛ لأنّ المشرك عنوان يطبَّق على كثيرٍ من العصاة المسلمين أيضاً، كالمرائي مثلاً، فلا بُدَّ أن يكون المقصود نوعاً خاصّاً من المشركين، ومعه لا يمكن التمسّك بإطلاق الآية للمشرك من الكتابيّين.
ويندفع ذلك بأنّ المشرك وإنْ كان ينطبق على كلّ مَنْ أشرك شخصاً مع الله تعالى في مقامٍ من المقامات المختصّة به من وجوب الوجود، أو الخالقيّة، أو الألوهيّة، أو الحاكميّة ووجوب الطاعة، أو الاستعانة الغيبيّة، وغير ذلك، إلاّ أنّه ينصرف إلى الإشراك بلحاظ مرتبة الألوهيّة والعبادة؛ لأنّها هي المرتبة التي يكون اختصاص الله تعالى بها أمراً مركوزاً. هذا مضافاً إلى أنّ ارتكاز طهارة المسلم ـ ولو كان مرائياً وعاصياً ـ يكون بمثابة القرينة المتَّصلة على تقييد الإطلاق، ومعه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق إلاّ بمقدار اقتضاء هذه القرينة اللبّيّة على التقييد.
وعلى التقدير الثاني تختصّ الآية بالمشرك المقابل للكتابيّ، كما هو واضحٌ.
وليس من المجازفة دعوى ظهور كلمة المشرك عند الإطلاق في الثاني؛ لكونه اصطلاحاً عامّاً في المجتمع الإسلامي. وممّا يؤيِّد المعنى الثاني جعلُ الشرك ملاكاً لمنع المشركين من الاقتراب إلى المسجد الحرام؛ فإنّ وضوح أنّ مَنْ يقصد بهذا المنع ـ عمليّاً ـ هم المشركون الوثنيّون، دون الكتابيّين الذين لا يقدِّسون الكعبة أصلاً، وليسوا في معرض الوصول إليها، قد يشكِّل قرينةً على ذلك. وكذلك ما تصدّى له النصّ القرآني عقيب ذلك من تطمين أهل مكّة بقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ﴾ (التوبة: 28)؛ فإنّ العلة إنّما تخاف بسبب تحريم مجيء المشركين الوثنيّين، الذين اعتادوا المجيء. ويكفي على أيّ حال افتراض تكافؤ المعنيَيْن في إجمال الآية الكريمة»([2]).
هذا تحقيقٌ جامع حول الآية الكريمة يغنينا عن الكثير من القيل والقال حولها. وقد اتَّضح أنّها لا يمكن الاستدلال بها على نجاسة أهل الكتاب. وكذلك اتَّضح أنّها لا تصلح دليلاً على نجاسة أحدٍ من بني آدم، حتّى لو كانوا من الملاحدة. نعم، يبقى المهمّ هو استعراض بقيّة الأدلّة المدَّعاة، والتي لا بُدَّ من استئناف الحديث حولها في إطار البحث الروائي إنْ شاء الله.
البحث الروائي
مقدّمة
ولقد آثرنا قبل الانتقال إلى البحث الروائي أن نسلِّط الضوء على مسألة دعوى الشرك على أهل الكتاب. ومن هنا فقد استأنفنا البحث التالي:
الاستدلال على شرك أهل الكتاب
إنّ أهمّ ما استُدلّ به على شرك أهل الكتاب أمران:
الأوّل: استدلّ أغلب من الفقهاء ـ كـصاحب الجواهر وصاحب الحدائق ـ على شرك أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (التوبة: 30)، وقوله أيضاً: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَاً﴾ (مريم: 88).
ووجه استدلالهم على كون اليهود والنصارى مشركين أنّهم جعلوا له سبحانه وتعالى ولداً، وعدّوه والداً لهذا الولد، فاعتبروا أنّ هذا شركٌ.
وأجاب بعض الفقهاء والمفسِّرين على الاستدلال بأجوبةٍ، منها:
1ـ إنّ الاعتقاد بأنّ عزيراً كان ابناً لله مختصٌّ ببعض فرق اليهود الذين كانوا في زمن الرسول|، وقد انقرضوا. أمّا اليهود الموجودون في زماننا الحالي فإنّهم لا يعتقدون ببنوّة عزير، وبالتالي لا يمكن عدُّهم من المشركين.
ونقل أصحاب التفاسير ـ كـالطبرسي والطباطبائي والفخر الرازي ـ في شأن نزول هذه الآية روايةً عن ابن عبّاس: «أتى جماعةٌ من اليهود إلى رسول الله|، وهم: سلام بن مشكم والنعمان بن أوفى ومالك بن سيف، وقالوا: كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا، ولا تزعم أنّ عزيراً ابن الله، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ﴾»([3]).
وقد تبنَّى بعض المفسِّرين والفقهاء هذه النظريّة، حيث أكَّد الطبرسي على أنّ هذا الاعتقاد كان لفرقةٍ من اليهود الذين انقرضوا، وليس اعتقاداً لليهود الموجودين الآن.
وصرَّح الإمام الخميني بذلك فقال: «ومجرَّد القول بأنّ عزيراً ابن الله لا يوجب الشرك، وإنْ لزم منه الكفر، مع أنّ القائلين بذلك ـ على ما قيل ـ طائفةٌ منهم قد انقرضوا»([4]).
وذكر الفخر الرازي ثلاثة أقوال في هذه المسألة هي:
أوّلاً: قال عبيد بن عمير: «إنّما قال هذا القول رجلٌ واحدٌ من اليهود، اسمه فنحاص بن عازوراء».
ثانياً: قول ابن عبّاس أنّها نزلت في جماعةٍ من اليهود جاؤوا إلى رسول الله|، وذكر أسماءهم، ثمّ قال: وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا المذهب بعض اليهود…، إلخ.
ثالثاً: لعلّ هذا المذهب كان منتشراً فيهم، ثمّ انقطع…
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه كيف نسب القرآن ذلك إلى كلّ اليهود؟!
فنقول: بعد أن اتَّضحت آراء المفسِّرين في عدم شمول هذا الاعتقاد لكلّ اليهود فقد أجيب عن هذا الأمر بإجاباتٍ، منها:
أوّلاً: أن يكون كلّ اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة يعتقدون بنوّة عزير، ولكنْ انقرضوا بعد ذلك.
ثانياً: كما قال الشيخ الطوسي والعلاّمة الطباطبائي: نسب ذلك إلى جميعهم؛ لأنّ البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخر، والجميع ذو رأس متوافق الأجزاء، ورؤية متشابهة التأثير، فصحَّتْ النسبة هذه إلى جميعهم من هذه الجهة.
2ـ أن يكون الاعتقاد بأنّ لله تعالى ابناً ـ مع كونه اعتقاداً باطلاً ـ لا يوجب شركاً؛ لأنّ الشرك هو جعل شريكٍ له في احدى مقاماته الخاصّة، كأن يعتقد أنّ أحداً غير الله مؤثِّرٌ في الخلق والإيجاد. أمّا مجرّد الاعتقاد بالبنوّة وإنْ كان كفراً، لكنَّه ليس بشرك.ٍ وهذا ما ذهب إليه الإمام الخميني(1988م)، حيث يقول: «مجرّد القول بأنّ عزيزاً ابن الله لا يوجب الشِّرْك، وإنْ لزم منه الكفر»([5])؛ إذ إنّ الاعتقاد بأنْ يكون له سبحانه وتعالى ولدٌ لازمه أن يكون جسماً ومركَّباً، وهذا لازمه الكفر، لا الشرك.
وهذا إذا كان يدرك لوازم ما يعتقده، أما إذا لم يكن ملتفتاً إلى هذه اللوازم فإنّه ـ حَسْب رأي الإمام الخميني ومشهور الفقهاء ـ ليس بكافرٍ حتماً.
3ـ أن تكون لكلمة «ابن الله» دلالاتٌ ومعانٍ مختلفة؛ بعضها صحيح؛ والبعض الآخر باطل. ولكي نتمكّن من إيجاد المعنى الصحيح لا بُدَّ من معرفة المراد من «البنوّة»؛ إذ لا يمكن الوصول إلى المعنى الصحيح من دونها.
يقول العلاّمة الطباطبائي، صاحب تفسير الميزان، في بحثه حول اعتقاد اليهود ببنوّة عزير ما ملخَّصه: لمّا شاهد اليهود عزيراً وقّروه وعظّموه تعظيماً، ووضعوا له اسم ابن الله. ولا ندري هل أنّ مقصودهم بالبنوّة هي البنوّة الحقيقيّة لله، كما يعتقدون ذلك في كون جوهر الألوهيّة في المسيح، أم أنّ هذه التسمية صرف التشريف والاحترام، أم أنّه اعتقاد للبنوّة، كما يعتقدون لأنفسهم ذلك؟ فظاهر الآية يؤيِّد هذا الاتّجاه في المسألة، بأنّ هذه التسمية صرف التشريف والاحترام([6]).
ومع هذا فإنّ العلاّمة الطباطبائي يرى أنّ اعتقادهم البنوّة للمسيح حقيقيّة. ويخالفه في ذلك الفخر الرازي، الذي يعتقد بأنّ «لفظ الابن في الإنجيل على سبيل التشريف، كما ورد لفظ الخليل في حقّ إبراهيم على سبيل التشريف»([7]).
الثاني: كما واستدلّ صاحب الجواهر والحدائق والشيخ الأنصاري وآخرون على شرك أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِدَاً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 31)، بما مجمله: إنّ القرآن الكريم نسب الشرك في الربوبيّة لهؤلاء، وقد ذمَّهم بسبب ترك العبوديّة وعبادة الله، وقد نزَّه الله سبحانه نفسه من شركهم في آخر الآية.
وحيث دلّت هذه الآية على شرك أهل الكتاب، وانطباق قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: 28) عليهم، فقد حكم العلماء بنجاسة أهل الكتاب.
ولكنْ قد أجيب عن هذا الأمر بأنّه وإنْ كان اليهود قد اتّخذوا علماءهم وزهّادهم ورهبانهم أرباباً، إلاّ أنّ هذا لا يصحّ أن يكون دليلاً على جعلهم آلهة أو خالقين أو مدبِّرين لعالم الكون، أو كونهم معبودين لهم، بل ـ بحَسَب الروايات وصريح قول العلماء في هذا المجال ـ أنّ اليهود قد أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في كلّ شيءٍ على الإطلاق، من دون أيّ ردٍّ لأوامرهم، ولو كان ذلك مخالفاً لحكم الله، حتّى في دينهم؛ لأنّ الطاعة المطلقة هي لله فقط ومن شؤونه، وإطاعة غيره بهذا الشكل هي نحوٌ من أنحاء الشرك، كما قال رسول الله|: «مَنْ أطاع رجلاً في معصيةٍ فقد عبده»([8]).
ومن المعلوم أنّ هذا الشرك هو شركٌ في الطاعة، لا في العبادة، وقد جاء ذكره في القرآن أيضاً ـ عصمنا الله من الزلل ـ، حيث إنّه ينطبق على بعض المسلمين الذين قد يطيعون الشيطان. فإذا كان الأمر كذلك فلا بُدَّ وأن نحسبهم مشركين، ونجري عليهم آثار الشرك، وليس الأمر كذلك.
ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (يوسف: 106).
أحاديث لدعم الآية القرآنيّة
وقد جاءت أحاديث وروايات كثيرة حول هذه الآية القرانيّة أيَّدَتْ هذا المعنى، منها:
1ـ إنّ عدي بن حاتم كان نصرانيّاً، فانتهى إلى رسول الله وهو يقرأ سورة براءة، فوصل إلى هذه الآية: «قال: فقلتُ: لسنا نعبدهم، فقال|: أليس يحرِّمون ما أحلّ الله فتحرِّمونه؟! ويحلّون ما حرَّم الله فتستحلّونه؟! قلتُ: بلى، قال: فتلك عبادتهم»([9]).
2ـ رُوي عن أبي جعفر وأبي عبد الله× أنّهما قالا: «أما والله ما صاموا ولا صلّوا لهم، ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً، وحرّموا عليهم حلالاً، فاتَّبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون»([10]).
3ـ عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبد الله× عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ﴾؟ فقال: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعَوْهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكنْ أحلُّوا لهم حراماً وحرَّموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون»([11]).
كما واستدلّ بعض علمائنا من المفسِّرين والفقهاء على كونها تدلّ على الشرك في الطاعة، وليس الشرك في العبادة:
قال العلاّمة الطباطبائي: «واتّخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله هو إصغاؤهم لهم وإطاعتهم من غير قيدٍ وشرط، ولا يطاع كذلك إلاّ الله سبحانه»([12]).
وقال الإمام الخميني: «والمراد باتِّخاذهم أرباباً ليس ما هو ظاهرها؛ لعدم قولهم بألوهيّتهم»([13]).
وقال السيد الحكيم: إنّ «نسبة الإشراك إليهم ليست على الحقيقة؛ فإنّ ذلك خلاف الآيات والروايات، وخلاف المفهوم منها عند المتشرِّعة والعُرْف، فيتعيَّن حمله على التجوُّز في الإسناد. وليس الكلام وارداً في مقام جعل الحكم ليؤخذ بإطلاق التنزيل؛ كي يثبت حكم المشركين لهم»([14]).
وقال الفخر الرازي: «الأكثرون من المفسِّرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنّهم اعتقدوا فيهم أنّهم آلهة العالم، بل المراد أنّهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم… [بل كانوا يطيعونهم طاعة مطلقة، والآية كانت بصدد نهيهم… إلى أن يقول:] ولو تأمّلت حقّ التأمّل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا»([15]).
وممّا يؤيِّد أنّ إطلاق المشرك على أهل الكتاب إنّما هو لبعض الاعتبارات، لا على وجه الحقيقة، إطلاقُ المشرك على العاصي المطيع للشيطان، كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: 121)، فأطلق لفظ الشرك على المؤمنين بلحاظ إطاعتهم الشيطان، فهم بهذا اللحاظ مشركون.
وكقوله سبحانه: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (يوسف: 106)، فترى أنّه تعالى أثبت الشرك على أكثر المؤمنين بالله تعالى.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 99 ـ 100)، فإنّه تعالى أطلق المشرك على المؤمن الذي يتولّى الشيطان، وأشرك غيره تعالى في الطاعة.
إلى غير ذلك من الآيات.
وفي خبر أبي بصير وإسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله×، في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾، قال: «يطيع الشيطان من حيث لا يعلم، فيشرك»([16]).
في خبر ضريس، عن أبي عبد الله×، في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾، قال: «شرك طاعة، وليس شرك عبادة»([17]).
وخبر ابن أبي عمير، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله× قال: «مَنْ أطاع رجلاً في معصيةٍ فقد عبده»([18]).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وكذلك فقد أطلق الشِّرْك على الرياء، والمشرك على المرائي؛ حيث ورد استعمال الشِّرْك في القرآن في الرياء، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحَاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ (الكهف: 110). فقد أمر الله تعالى بالعمل الخالص، وأن يعبدوه مخلصين، فالإشراك بواسطة الرياء في العبادة شركٌ.
وقد أطلق المشرك على المرائي في جملةٍ من الأخبار:
ـ ففي خبر زرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: «لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة، ثمّ أدخل فيه رضا أحدٍ من الناس، كان مشركاً»([19]).
ـ وفي خبر أبي الجارود، عن أبي جعفر× قال: «سُئل رسول الله| عن تفسير هذه الآية، فقال: مَنْ صلّى مراءاة الناس فهو مشركٌ، ومَنْ زكّى مراءاة الناس فهو مشركٌ، ومَنْ صام مراءاة الناس فهو مشركٌ، ومَنْ حجَّ مراءاة الناس فهو مشركٌ، ومَنْ عمل عملاً ممّا أمره الله عزَّ وجلَّ مراءاة الناس فهو مشركٌ، ولا يقبل الله عمل مراءٍ»([20]).
ـ وفي خبر العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله× قال: «سألتُه عن تفسير هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾؟ قال: مَنْ صلّى أو صام أو أعتق أو حجّ يريد محمدة الناس فقد أشرك في عمله، فهو شركٌ مغفور»([21]).
وقد أطلق الشرك على الرياء في غير واحدٍ من الأخبار:
ـ ففي خبر يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله×: «كلّ رياء شرك. إنّه مَنْ عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومَنْ عمل لله كان ثوابه على الله»([22]).
ـ وفي خبر شدّاد بن أوس قال: «دخلتُ على رسول الله|، فرأيتُ في وجهه ما ساءني، فقلت: ما الذي أرى بك؟ فقال: أخاف على أمّتي الشِّرْك، فقلت: أيشركون من بعدك؟ فقال: أمّا إنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وَثَناً ولا حَجَراً، ولكنّهم يراؤون بأعمالهم، والرياء هو الشِّرْك…، إلخ»([23]).
ـ وفي خبر مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه^: «إنّ رسول الله| سُئل: فيمَ النجاة غداً؟ [إلى أن قال:] …فاتقوا الله في الرِّياء؛ فإنّه الشرك بالله. إنّ المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممَّنْ كنت تعمل له»([24]).
وعن الشهيد الثاني في منية المريد: «قال رسول الله|: إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشِّرْك الأصغر، قيل: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرِّياء»([25]).
هذا، وقد أطلق الشرك على أدنى مراتب الطاعة لغير الله في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً﴾ (الأعراف: 189).
وبالجملة فإنّ الشرك له مراتب، لا يخلو منه غير المعصومين وقليلٌ من المؤمنين. ومعه كيف يحكم بنجاسة المشرك؟! فإنّ لازم الشرك، وبما له من المراتب، وكما سبق أن أشرنا إليه، هو الحكم بنجاسة المسلم المرائي في عمله، أو المطيع للشيطان.
فالحاصل أنّ أهل الكتاب وإنْ كانوا مشركين ببعض مراتب الشِّرْك، إلاّ أنّ المتتبِّع في القرآن الكريم يرى أنّ المتبادر من المشركين في لسان القرآن هم عبدة الأصنام وغيرها، الذين اعتقدوا بأنّها تجلب لهم نفعاً أو ضرّاً. والمقصود بهم هنا غير أهل الكتاب.
الاستدلال على نجاسة أهل الكتاب روائيّاً، ومناقشتها
قد وصل الحديث بنا إلى استعراض الروايات التي استدلّ، أو يمكن أن يُستَدَلّ بها على النجاسة الذاتيّة لأهل الكتاب.
ونظراً لأهمّيّة البحث وشهرته نذكر هنا جميع الروايات التي قد توهم إثبات هذه الفتوى، ونتعرَّض لها سنداً ودلالة.
ثمّ إنّ المحدِّث العاملي قد عقد في الوسائل باباً خاصّاً حاول أن يجمع فيه كلّ الروايات التي قد يستدلّ بها على النجاسة، ونحن نذكر كلَّ ما ذكره في هذا الباب، وبعض ما ذكره لا يدلّ على المطلوب، بل فيه ما يدلّ على العكس تماماً. وكذلك فإنّنا نضيف إلى ما ذكره في هذا الباب ما تسنَّى لنا العثور عليه في الأبواب المتفرّقة، والروايات المبثوثة في ثنايا الكتاب وغيره:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ الكليني في الكافي، وهو في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ× عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْمَجُوسِ، فَقَالَ: لا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ، ولا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبَخُونَ، ولا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ»([26]).
سند الرواية واضح الصحّة؛ لأنّ كلّ رجاله من رجال الصحيح بالاتّفاق.
وأمّا الدلالة فإنّه قد يستدلّ بالرواية على النجاسة الذاتيّة؛ بدعوى أنّ كون الأواني لمَنْ ذكر من الذمّي والمجوسيّ ظاهرٌ في أنّهم هم الذين نجَّسوها بمزاولتهم لها. هذا غاية ما يمكن أن يُقال في تقريب الدلالة.
إلاّ أنّك خبيرٌ بعدم ظهور الرواية ـ فضلاً عن دعوى صراحتها ـ في ما ذكر؛ والسرُّ في ذلك أنّ مجرّد النهي عن الأواني لا يدلّ على النجاسة الذاتيّة؛ إذ لعلّه من جهة عدم تورُّعهم عن النجاسات، ومنها: أكل الميتة، وشرب الخمر، وغيرهما ممّا يستحلّونه، بل إنّ ذيل الرواية يشير إلى ذلك، عندما ذكر الإمام× ما هو بمثابة التعليل والبيان بقوله: «التي يشربون فيها الخمر».
هذا بالإضافة إلى أنّ النهي هنا وإنْ كان ظاهره البدويّ هو التحريم، ولكنْ لا بُدَّ من رفع اليد عن هذا الظهور؛ بما صرَّحت به صحيحة إسماعيل بن جابر، من أنّه نهيٌ تنزيهيّ في المورد، وليس تحريميّاً.
والنتيجة أنّ هذه الرواية ـ إنْ لم نعدّها من الروايات المشيرة إلى الطهارة الذاتيّة ـ ليست من أدلّة النجاسة.
الرواية الثانية: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ، وحَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ، أَيَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلا أُوَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ، وأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلادِكُمْ»([27]).
سند الرواية معتبرٌ؛ حيث إنّ الكليني يرويها عن شيخه محمد بن يحيى الثقة الجليل. وبقيّة السند إلى الكاهلي صحيحٌ. وأمّا الكاهلي فقد صرَّح النجاشي بأنّه كان وَجْهاً عند الإمام الصادق×، وهو يكفي للتوثيق عندنا. وكذلك فإنّ ابن أبي عمير وغيره من بعض أصحاب الإجماع يَرْوُون عنه. فالسند لا ينبغي التوقُّف فيه.
وأمّا الدلالة على المدَّعى فقد يقال بدلالة صدر الرواية على النجاسة من جهة ترك الإمام× مؤاكلة المجوسي.
إلاّ أنّك خبيرٌ بعدم صحّة هذا الكلام، وأنّه× تحدَّث عن الترك لنفسه، ولم يتحدَّث عنه كقاعدةٍ عامّة، وهذا وحده لا يفيد في الحكم لغيره.
هذا مضافاً إلى أنّ هذا الكلام برمّته ممّا لا معنى له بعد تصريح الإمام× بأنّه يكره أن يحرِّم عليهم شيئاً يصنعونه في بلادهم. ولو كان حراماً فلا مجال لهذا القول منه×، وهو المبلِّغ الأوّل للأحكام الشرعيّة.
هذا كلّه مضافاً إلى تصريح الإمام× بعدم البأس في المؤاكلة معهم إذا غسلوا أيديهم. وهو قرينةٌ واضحة على المراد هنا، وأنّ التنزّه هنا من جهة النجاسة العرضيّة المحتملة.
الرواية الثالثة: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ×، فِي رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلاً مَجُوسِيّاً، قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ، ولا يَتَوَضَّأُ»([28]).
سند الرواية واضح الصحّة، وكلُّ رجاله من المتَّفق على وثاقتهم.
وأمّا دلالتها فتقريرها بأن يُقال: إنّ الأمر بغسل اليد التي صافح بها المجوسي ظاهرٌ ـ بل كالصريح ـ في أنّها نجسةٌ، والحمل على النجاسة العرضيّة ـ مع كون الأصل عدمها ـ خلاف الظاهر. فقد يُقال: إنّها من خيرة الأدلّة على النجاسة الذاتيّة للمجوس، ونتعدّى إلى بقيّة أهل الكتاب ـ فضلاً عن بقيّة الكفّار ـ من جهة عدم القول بالفصل. مضافاً إلى ما سيأتي في الرواية القادمة من التنصيص على الغسل من مصافحة اليهودي والنصراني.
هذا غاية ما يُذْكَر في تقريب دلالة الرواية على النجاسة الذاتيّة للكافر الكتابي وغيره، ولكنْ مع ذلك لنا أن نتأمّل في ما أفيد في المقام:
أوّلاً: إنّ الرواية وأختها الآتية قد فرَّعتا الأمر بالغسل على مجرّد المصافحة معهم، مع أنّ النجاسة ـ بالإجماع ـ لو كانت هي المرادة لا تنتقل إلاّ مع الرطوبة المسرية، فيدور الأمر هنا بين أن نحمل الرواية على خصوص حال وجود الرطوبة المسرية، فيتمّ الاستدلال، ولكنّه ـ كما نرى ـ من الحمل على الفرد النادر؛ إذ في الغالب لا تكون هذه الرطوبة موجودة؛ وبين تركها على ظاهرها، وأنّ مجرّد المصافحة ـ ولو من دون هذه الرطوبة ـ تستوجب الغسل المذكور، فلا يكون المراد الغسل من النجاسة الماديّة العينيّة، بل لعلّه من قبيل: النجاسات المعنويّة لملاقاة اليد مع الكافر، نظير: الجنابة وغسل مسّ الميت وغير ذلك، وهو احتمالٌ قد يعدّ غريباً في بادئ النظر، ولكنّه فرضيّة ممكنةٌ في المقام، ومعها لا يتمّ الاستدلال. وحيث إنّه لا معيِّن لأحد الاحتمالين لا نستطيع الاستدلال بالرواية على المطلوب.
ثانياً: يمكن حمل الأمر بالغسل في الروايتين على التنزيه؛ وذلك بقرينة رواية القلانسي الآتية، والتي صرَّحت بعدم لزوم الغسل لليد بمصافحة الذمّي مطلقاً، بل أمرَتْ بالمسح بالتراب. ولعلّ هذا يؤيِّد ما ذكرنا من أنّ القذارة هنا معنويّة، تُزال بالماء والتراب في خصوص موضع الملاقاة، وإلاّ فمن الواضح أنّ المسح بالتراب ليس من المطهِّرات هنا، ولو كانت النجاسة مادّيّة.
الرواية الرابعة: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «عَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْقَلانِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ×: أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي، قَالَ: امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وبِالْحَائِطِ، قُلْتُ: فَالنَّاصِبَ؟ قَالَ: اغْسِلْهَا»([29]).
سند الرواية يبدأ بالضمير، وهو راجعٌ الى أبي عليّ الأشعري شيخ الكليني الثقة. والحسن بن عليّ الكوفي هو ابن عبد الله بن المغيرة الثقة. والعبّاس بن عامر ثقة جليل. وأمّا عليّ بن معمر فلا توثيق له، وإنْ وثّقه السيّد الخوئي؛ لكونه من رجال تفسير القمّي؛ لأنّ المبنى غير تامٍّ عندنا. وأمّا خالد القلانسي فهو ثقةٌ قد وثَّقه النجاشي. وعليه فالسند غير تامّ.
وأمّا الدلالة فإنّ الرواية دالّة على نجاسة الناصب ظاهراً، وأمّا غيره فهي على عدم النجاسة أدلّ؛ إذ إنّ مسح اليد بالتراب أو الحائط ليس من المطهِّرات بالإجماع.
الرواية الخامسة: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «وعَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا×، فِي مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّ والنَّصْرَانِيَّ، قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ»([30]).
سند الرواية صحيحٌ؛ لأنّ جميع رجالها من الثقات.
وأمّا دلالتها فقد تقدّم في الرواية الرابعة ما ينبغي قوله هنا، وأنّ الرواية غير دالّة على النجاسة الماديّة إلاّ على تقديرٍ غير تامّ. هذا مضافاً إلى أنّ المصافحة لو كان المراد منها أنّها منجّسة لليد لكانت من وراء الثوب منجِّسة له؛ فكأنّ نفس المصافحة يداً بيد فيه حزازةٌ خاصّة غير قضيّة التنجيس المادي.
الرواية السادسة: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى×، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وأَرْقُدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وأُصَافِحُهُ؟ قَالَ: لا»([31]).
سند الرواية واضح الصحّة، ولا كلام فيه.
وأمّا الدلالة فتقريبُها أنّ النهي عن المؤاكلة مع المجوسي في قصعةٍ واحدة ـ وكذا النوم معه على فراشٍ واحد، والمصافحة معه ـ ظاهرٌ جدّاً في نجاسته؛ لأنّ ذلك لا يجتمع في الظاهر مع القول بالطهارة. والتعليل بالنجاسة العرضيّة هنا قد يُعَدّ بعيداً؛ لأنّ الأصل عدم وجود مثل هذه النجاسة.
إلاّ أنّ التأمُّل في هذه الرواية ـ مع الالتفات إلى ما ذكرنا في ذيل الرواية الثالثة السابقة، والجمع بين المؤاكلة والمصافحة على الإطلاق، ولو من دون الرطوبة، وكذلك النوم على فراشه ـ قد يفيد أنّ الحزازة ليست في مجرّد النجاسة الماديّة، بل قد يكون الملحوظ هو التحرُّز من المجوسيّ مطلقاً، ولو من جهة الحزازة المعنويّة في مباشرته ومعاشرته عن قرب في الشؤون الحياتيّة.
هذا ويمكن عدّ رواية الكاهلي ـ وهي الثانية المتقدِّمة ـ قرينة على أنّ النهي هنا ليس من جهة النجاسة، أو أنّه ليس نهي تحريم على الأقلّ، ولو من جهة أنّه× صرَّح في تلك بأنّه يكره أن يحرّم عليهم شيئاً يصنعونه في بلادهم. وكذلك فإنّه سيأتي في سياق هذه الروايات أنّ النوم في فراشهم جائزٌ بنصّ الصحيحة الأخرى لعليِّ بن جعفر×.
والحاصل أنّه لا يمكن القول بأنّ الرواية ناظرة إلى النجاسة الماديّة، وإنْ كان ذلك محتملاً فيها بمستوىً لا يرقى إلى الظهور الموجب لحملها عليه.
الرواية السابعة: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «وعَنْهُمْ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ×: إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ، فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ قَالَ: لا»([32]).
سند الرواية هو العدّة من أصحابنا، عن ابن مهران. وابن زياد هو ابن أبي عمير، ويروي عن ابن خارجة. ورجال السند كلّهم من الثقات. فالرواية صحيحة.
وأمّا الدلالة فإنّه قد يُستفاد من النهي عن الأكل من طعامهم نجاستُهم.
إلاّ أنّه قد صار واضحاً ممّا تقدَّم هنا، أنّ النهي إمّا تنزيهي؛ وإمّا يراد به النهي عمّا ينتابهم من النجاسات العرضيّة، التي لا يتورَّعون عنها بحسب عقيدتهم وممارساتهم.
فالرواية وما كان مثلها لا تصلح دليلاً على النجاسة.
الرواية الثامنة: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «وعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ: لا»([33]).
سند الرواية صحيحٌ؛ لوثاقة كلّ رجالها بلا كلام.
وأمّا دلالتها فإنّه يقال: إنّها نهَتْ عن سؤر اليهودي والنصراني، وهو ظاهرٌ جدّاً في أنّ السبب هو مباشرتهم له، وهو من القليل الذي ينفعل بالنجاسة.
غير أنّه يمكن أن يُقال: إنّ النهي غير المعلَّل بالنجاسة لا يكون دليلاً عليها إلاّ إذا لم تكن هناك علّةٌ أخرى مفترضة في المقام قد اقتَضَتْه.
ولكنْ يمكن القول: أوّلاً: إنّه يمكن أن يكون للشرب خصوصيّة من جهة النجاسة المعنويّة للكفّار، والتي هي أجنبيّةٌ عن النجاسة الماديّة المبحوث عنها هنا. وهذا في حدّ ذاته محتملٌ، وإنْ لم يَرْقَ إلى درجة الظهور. وقد أشَرْنا إلى نظيره في بعض الروايات السابقة عند الحديث عن مسح اليد بالحائط أو التراب؛ لملامستها لهم.
ثانياً: قد يكون النهي من جهة ما لا يتورَّعون عنه من مساورة النجاسات، التي لا ينفكُّ عنها أحدهم عادةً، من شرب للخمر أو أكل الميتة بحَسَب فقهنا الذي لا يستحلّ ذبائحهم.
ثالثاً: لا بُدَّ من حمل النهي هنا على التنزيه، لا الحرمة؛ وذلك من جهة الرواية التي أباحت التوضُّؤ بأسآرهم، وهي موثَّقة عمّار الساباطي.
هذا وقد اتَّضح بما ذكرناه هنا ما ينبغي أن يُقال في الرواية الرابعة عشرة الآتية.
والمتحصِّل أنّ الرواية لا تُعَدّ من الأدلّة على النجاسة الذاتيّة.
الرواية التاسعة: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، وهو في الوسائل: «وبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ× عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي الْحَمَّامِ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ، إِلاّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى الْحَوْضِ، فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ. وسَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ أَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاةِ؟ قَالَ: لا، إِلاّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ»([34]).
سند الشيخ الطوسي إلى عليّ بن جعفر صحيحٌ، فالرواية صحيحة.
وأمّا دلالتها فهي تعتمد على القول بظهورها في نجاسة الكتابي من جهة النهي عن الاستحمام معه في الحمام، والذي يجعلها دالّة على نجاسته الذاتيّة بالظهور؛ لأنّ التعليل بالنجاسة العرضيّة خلاف الظاهر، والله العالم.
الرواية العاشرة: ما رواه الطوسي أيضاً، وهو في الوسائل: «وبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ×، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، ولا يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا. وقَالَ: لا يَأْكُلِ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، ولا يُقْعِدْهُ عَلَى فِرَاشِهِ، ولا مَسْجِدِهِ، ولا يُصَافِحْهُ. قَالَ: وسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ، هَلْ تَصِحُّ الصَّلاةُ فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ»([35]).
هذه الرواية صحيحة؛ لصحّة طريق الشيخ إلى ابن يحيى، وهو صاحب نوادر الحكمة. وبقيّة رجال السند من رجال الصحيح.
وأمّا الدلالة فلا يوجد كلامٌ مهمّ زيادةً على ما تقدّم في الرواية السادسة المتقدّمة. وأمّا إباحة النوم على فراش اليهودي والنهي عنه على فراش المجوسي فهو ـ والله العالم ـ محمولٌ على تفاوت درجات الكفر والقبح المعنويّ.
أمّا النهي عن الصلاة في الثوب الذي نشتريه من غير المسلم فلا بُدَّ من حمله على التنزّه عنه، والاحتياط المستحبّ للصلاة التي هي عمود الدِّين، وإلاّ فإنّ الروايات المجوِّزة عديدة، وهي قرينةٌ على ما ذكرنا.
الرواية الحادية عشرة: ما رواه الطوسي أيضاً، وهو في الوسائل: «وعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا×: الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدِمُكَ وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لا تَتَوَضَّأُ ولا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، تَغْسِلُ يَدَيْهَا»([36]).
الضمير في بداية السند يعود إلى ابن يحيى صاحب النوادر، وقد تقدَّم في الرواية السابقة أنّ طريق الشيخ إليه صحيحٌ. وبقيّة السند من رجال الصحيح.
وأمّا الدلالة فإنّ الرواية كالصريحة في عكس المطلوب، ولا أدري لماذا عدَّها المحدِّث العاملي من الروايات الدالّة على النجاسة، مع أنّ التعليل بأنّها لا تتوضّأ ولا تغتسل من الجنابة يدلّ على ارتكاز السائل في أنّ المانع والموجب للسؤال هو النجاسة العرضيّة.
والمؤكِّد لهذا الفهم هو جواب الإمام× بأنّها تغسل يديها. وهذا بمثابة التصريح بطهارتها الذاتيّة، وإلاّ فإنّ غسلها ليديها لا يزيدها إلاّ نجاسةً مع الرطوبة المسرية لو كانت نجسة العين. فالرواية نِعْمَ الدليل على الطهارة الذاتيّة في موردها.
الرواية الثانية عشرة: ما رواه البرقي في المحاسن، وهو في الوسائل: «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ×، فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ، قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ»([37]).
سند الرواية معتبرٌ؛ لأنّ كلّ رجاله من الأجلاّء والموثَّقين، كما جاء في المحاسن.
وأمّا الدلالة فقد يُقال: إنّ المقصود من الأمر بغسل أواني المجوس بالماء هو كونها متنجِّسة؛ لمزاولتهم لها، وهو يُنبئ عن نجاستهم.
إلاّ أنّك خبيرٌ بأنّ هذا لازمٌ أعمّ؛ إذ لعلّ الغسل بالماء من جهة ما لا ينفكّون عنه من مساورة النجاسات التي يستحلُّونها.
الرواية الثالثة عشرة: ما رواه البرقي في المحاسن، وهو في الوسائل: «عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالا: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ×: لا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ، ولا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ»([38]).
الرواية من المحاسن للبرقي أيضاً. وهو يرويها عن أبيه محمّد بن خالد الثقة الجليل. ولكنّ الأب يروي عن ابن سنان، وهو محلّ خلاف في الرجال من جهة الوثاقة، ونحن نتوقّف فيه؛ لتعارض الجرح والتعديل فيه. وأمّا بقيّة السند فلا مشكلة فيه. فالرواية محلّ توقّف من حيث السند.
وأمّا من حيث الدلالة فإنّها دالّةٌ على تحريم ذبيحة اليهود، وهو المشهور عندنا، ولكنّه لا ربط له بمحلّ الكلام هنا. وأمّا النهي عن الأكل في أوانيهم فقد تقدّم في الرواية السابقة، أنّ ذلك لا يدلّ على النجاسة الذاتيّة، فراجِعْ.
الرواية الرابعة عشرة: ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، وهو في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ× عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ، أَيُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ؟ قَالَ: لا»([39]).
سند الرواية هو طريق الشيخ الصدوق إلى الأعرج، وهو صحيحٌ بالاتفاق.
وأمّا الدلالة فقد تقدَّم ما ينبغي أن يُذْكَر حولها مفصَّلاً في نظيرتها، ولعلَّهما رواية واحدة، بل هو الظاهر، فراجع ما تقدَّم في الرواية الثامنة من هذا السياق.
الرواية الخامسة عشرة: ما رواه الشيخ الكليني في الكافي، وهو في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وتَوَضَّأَ فَلا بَأْسَ»([40]).
سند الرواية واضح الصحّة بلا كلام.
وأمّا دلالتها فقد يُقال: إنّ مفهوم الرواية تدلّ على أنّ الأكل من طعامهم غير جائز، وهو ظاهرٌ في نجاسته؛ لمساورتهم له.
إلاّ أنّك خبيرٌ بأنّ الرواية دالّةٌ على عكس ما تقدَّم تماماً؛ حيث إنّها لو كانت تريد أن تقول: إنّهم على النجاسة ذاتاً فما معنى أن يُباح الطعام معهم إنْ توضّأوا ولم يأكلوا من طعامهم؟! أليس في هذا إشارة ـ بمثابة التصريح ـ إلى أنّهم غير قذرين ذاتاً، وإلاّ فما معنى أن تجوز مؤاكلتهم بعد التوضُّؤ؟!
وأمّا عدم الحِلّ من طعامهم فلعلّ السبب فيه ـ بل هو الظاهر ـ عدم تورُّعهم عن النجاسات. على أنّ أصل الحكم محلُّ توقُّف. وفي الروايات ما يصلح قرينةً على أنّ النهي غير تحريمي.
الرواية السادسة عشرة: ما رواه الشيخ الطوسي، وورد في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ، وسَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ؟ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ فَلا بَأْسَ»([41]).
الرواية السابعة عشرة: ما رواه الشيخ الحميري في قرب الإسناد، وهو في الوسائل: «عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ×، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ، لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يُصَاحِبَهُ؟ قَالَ: لا»([42]).
سند الرواية محلُّ توقّف من جهة أنّ عبد الله بن الحسن لم يذكر في كتب الرجال، ولا في كتب الرواية، في غير كتاب قرب الإسناد. ومع الغضّ عنه فنفس نسخة قرب الإسناد الواصلة إلى المتأخِّرين محلّ كلامٍ لا يَسَعه هذا المختصر.
وأمّا من حيث الدلالة فلا يوجد كلامٌ نضيفه هنا إلى ما تقدَّم في الروايتين السادسة والعاشرة من هذه الروايات، بل الظاهر أنّها نفس الرواية، وقد نُقلت عن مسائل عليّ بن جعفر بشيءٍ من التغيير غير المغيِّر للمعنى، والله العالم.
الرواية الثامنة عشرة: ما رواه البرقي في المحاسن، وهو في الوسائل: «وعَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ أَفَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ قَالَ: لا»([43]).
أمّا سند الرواية فهو صحيحٌ، كما هو واضح.
وأمّا دلالتها فقد تقدَّم نظيرها مكرَّراً هنا، وقد اتَّضح أنّها لا تدلّ على النجاسة الذاتيّة لمَنْ ذُكر فيها، فراجِعْ.
الرواية التاسعة عشرة: ما رواه الشيخ الصدوق، وهو في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ×، فِي حَدِيثٍ، قَالَ: وإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ؛ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ والنَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وهُوَ شَرُّهُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ، وإِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لأنْجَسُ مِنْهُ»([44]).
الرواية معتبرةٌ بالاتّفاق.
وأمّا دلالتها فقد يُقال: إنّها أصرح ما في الباب على النجاسة الذاتيّة لمَنْ ذُكر فيها؛ وذلك من جهة أنّ لزوم الاجتناب قد فرّع على اغتسالهم بأنفسهم في الحمّام، من دون إشارة إلى وجود أيّ نجاسةٍ خارجيّة. مضافاً إلى أنّ التعليل في ذيلها يدلّ على ذلك، من جهة إثبات النجاسة الأشدّ للناصب لأهل البيت×، ممّا يعني وجودها في مَنْ هو مذكورٌ فيها بدرجةٍ أقلّ شدّةً.
إلاّ أنّه يمكن التشكيك في هذه الدلالة، التي قد يدَّعى وضوحها، بما يلي:
أوّلاً: من الواضح أنّ الغسالة هنا لم تطلق بحسب الشائع المتعارف ـ وهو الماء المجتمع نتيجةً لتطهير شيءٍ من الأشياء ـ؛ حيث إنّ هذه العناوين لو فرضت نجاستها فمن الواضح أنّها لا تطهر بالغسل في الحمّام، بل ينحصر تطهيرها باختيارها للإسلام.
وعليه فما يجتمع في بئر الحمام من هذه المياه، التي تحصل نتيجة الاغتسال، إنّما تطلق عليها الغسالة من جهة المعنى اللغويّ، وهو ما يلحق الماء نتيجة الغسل به من التقذُّر العرفي؛ وذلك أنّ الغسالة أطلقت هنا على كلّ الماء المجتمع نتيجة الاغتسال، ولم يخصّص بهذا العنوان خصوص ما ينتج من اغتسال العناوين المذكورة.
ثمّ إنّه ينبغي الالتفات إلى أنّ اغتسال هذه العناوين في الحمّامات لا يشكِّل العنصر الغالب، بل هو من القليل النادر عادةً، حتّى وإنْ كانت الحمّامات تستقبل العلوج وغيرهم من الوافدين إلى البلدان الإسلاميّة، وكذلك النصّاب الذين لا يشكِّلون بالمعنى المصطلح إلاّ العدد القليل من أبناء المجتمع الإسلامي.
ومن جهةٍ أخرى فإنّ ماء البئر المذكورة هي من المياه الكثيرة جدّاً، ولا يتصوَّر عادةً كونها قليلة إلاّ عند بداية تأسيس الحمّام، وهو الفرض النادر؛ وذلك أنّ الكلام ليس عن الحمّامات الخاصّة في البيوت، بل عن الحمّامات العامّة التي يرتادها العشرات على الأقل يوميّاً.
من كلّ ما تقدَّم نستنتج أنّ ماء البئر لا ينفعل بوقوع النجاسة فيه؛ لكونه بئراً، ولكونه كرّاً، بل أكراراً. وعليه لا بُدَّ من حمل النجاسة المذكورة على أنّه ليس المراد منها النجاسة الماديّة، بل ما يشمل القذارة العرفيّة، وهي ممّا اهتمَّ الشارع المقدَّس بها كثيراً في الكثير من الأدلّة، والتي سنشير إلى بعضها في بعض الأجوبة الآتية.
ثانياً: قد ورد في سياق الروايات المتحدِّثة عن النهي عن الاغتسال من غسالة الحمّام عناوين لا شَكَّ في طهارة أصحابها، ممّا يمنع حمل مثل هذه الرواية على أنّ المراد بها النجاسة الماديّة المتعارفة شرعاً في باب النجاسات.
هذا وقد عقد المحدِّث العاملي باباً خاصّاً لهذا الموضوع، وذكر فيه عدّة روايات، ننقلها ليتَّضح ما ذكرناه هنا، وليشرف الباحث على الموضوع عن كثب. ونحن نسردها من دون البحث التفصيلي في أسانيدها؛ لأنّ الهدف هو الإشراف على الجوّ الذي ذكرت فيه مثل هذه الرواية:
فمنها: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، وهو في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ×، قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ، وغُضَّ بَصَرَكَ، ولا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ ووَلَدُ الزِّنَا والنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وهُوَ شَرُّهُمْ»([45]).
الرواية غير نقيّةٍ سنداً، ولكنّها تشير بوضوح إلى ما ذكرنا من ضمّ غير النجاسات بالاتّفاق؛ لوضوح أنّ غسالة الجنب ليست نجسةً إذا لم تشتمل على النجاسة الخارجيّة، والحديث هنا عن نفس غسالة غسله. وكذلك ولد الزنا؛ فإنّه غير نجس العين على ما هو التحقيق في محلّه، بل نجاسته ـ على تقديرها ـ معنويّة، وليست من سنخ النجاسات المادّيّة. ولعلّ التعبير بأنّ الناصب شرُّهم يشير إلى ذلك، والله العالم.
ومنها: ما رواه الشيخ الكليني في الكافي، وهو في الوسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا×، فِي حَدِيثٍ، قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلا يَلُومَنَّ إِلاّ نَفْسَهُ، فَقُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ×: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ، فَقَالَ: كَذَبُوا، يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ والزَّانِي والنَّاصِبُ، الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا، وكُلُّ مَنْ خَلَقِ اللهُ ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ»([46]).
لو تجاوزنا البحث السندي نقول: من الواضح أنّ الحديث هنا في هذه الرواية برمّته ليس سوى حديث عن القذارة المعنويّة، أو الماديّة الأجنبيّة عن النجاسة المصطلحة في باب النجاسات، وخصوصاً أنّ الحديث في ذيلها عن غسالة الزاني والجُنُب من الحرام، وهما ليسا من النجاسات العينيّة. وكذلك إضافته× بعد ذلك غسالة كلٍّ من خلق الله، وذلك في إشارةٍ واضحة إلى القذارة المتوقَّعة في مثل هذا الماء.
ومنها: ما رواه الكليني أيضاً، وهو في الوسائل: «وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ×، فِي حَدِيثٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا، ويَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا والنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وهُوَ شَرُّهُمْ»([47]).
هذه الرواية تصبّ في نفس الجوّ السابق، ولا تحتاج إلى التعليق الخاصّ بها بعد ما تقدَّم.
ومنها: وهي من أهمِّها، ما رواه الكليني أيضاً، وهو من الوسائل: «وعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ× قَالَ: لا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا، وهُوَ لا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ؛ وفِيهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ، وهُوَ شَرُّهُمَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ، وإِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنَ الْكَلْبِ»([48]).
فإنّ التعبير عن ولد الزنا بأنّه لا يطهر إلى سبعة آباء لا يُراد منه فقهيّاً الطهارة الماديّة المصطلحة في كتاب الطهارة، وعليه فلا يُراد من النجاسة هنا ما يقابل الطهارة المصطلحة، بل الأعمّ، وتكون أنجسيّة الناصب ـ الذي عبّر عنه بأنّه شرُّهم ـ بنفس المعنى.
أقول: بعد كلّ ما تقدّم من الروايات لا شَكَّ في إجمال الكلام هنا في روايتنا المبحوث عنها؛ من جهة حمل النجاسة فيها على النجاسة الماديّة الخاصّة في باب النجاسات. ومعه لا نتمكّن من جعل الرواية من أدلّة النجاسة، لا في الكتابيّ ولا في الناصبيّ.
وبعد ما تقدّم لا يمكن التمسُّك بتعبير الأنجسيّة والأشرّيّة للناصب ـ والمراد هو النجاسة بالمعنى الخاصّ ـ؛ كي تصبح الرواية من أدلّتها في أهل الكتاب وغيرهم.
خلاصة القول
1ـ قد عرفْتَ ممّا تقدّم عدم تماميّة دلالة هذه الأدلّة من الآية والروايات على نجاسة أهل الكتاب الذاتيّة.
2ـ اتَّضح أنّ مدلول النهي في بعض هذه الروايات نهيٌ تنزيهيٌّ، وأنّ المغزى فيها هو في الاجتناب عن الأشياء المرتبطة بهم؛ لعدم اجتنابهم عن النجاسات، وعدم تورُّعهم عنها.
3ـ إنّ بعض هذه الروايات كانت قرينةً على المراد بالأخرى، كما في موردٍ كان يأمر بغسل اليد، وفي موردٍ آخر يأمر بمسح التراب أو الحائط.
الهوامش
(*) هذا المقال هو عرضٌ وتلخيص لكتاب «الكرامة الإنسانيّة، دراسةٌ في طهارة الإنسان على ضوء الفقه الإسلامي»، للسيد أبو الحسن نوّاب، الأستاذ المساعد ورئيس جامعة الأديان والمذاهب بمدينة قم. وقد أعدّه الباحث عماد الهلالي، المتخصِّص في دراسات الأديان المقارنة. من العراق.
([1]) ويقصد منه السيد أبو القاسم الخوئي(1992م).
([2]) محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 324.
([3]) ابن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن 10: 142؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 6: 1781؛ تفسير الثعلبي 5: 30؛ الفراء، تفسير البغوي 2: 284.
([4]) الخميني، كتاب الطهارة 3: 298.
([5]) المصدر نفسه.
([6]) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 6: 77.
([7]) الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 16: 34.
([8]) الكليني، الكافي 2: 398؛ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 27: 127؛ شرف الدين العاملي، الفصول المهمّة في تأليف الأمّة 1: 525. وراجع: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 11: 111.
([9]) المجلسي، بحار الأنوار 9: 98، 30؛ الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبير 17: 92؛ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن 5: 43؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين 2: 209؛ الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن 10: 147؛ تفسير الثعلبي 5: 34.
([10]) الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن 5: 23.
([11]) الكليني، الكافي 2: 398؛ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن 5: 23.
([12]) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 9: 245.
([13]) الخميني، كتاب الطهارة 3: 296.
([14]) الحكيم، مستمسك العروة الوثقى 1: 369.
([15]) الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 16: 37.
([16]) الكليني، الكافي 2: 397.
([17]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 27: 127، ح33388.
([18]) الكليني، الكافي 2: 398؛ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 27: 127؛ شرف الدين العاملي، الفصول المهمّة في تأليف الأمّة 1: 525. وراجع: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 11: 111.
([19]) تفسير العيّاشي 2: 353؛ المجلسي، بحار الأنوار 69: 301.
([20]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 68.
([21]) المجلسي، بحار الأنوار 81: 348.
([22]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 71.
([23]) النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل 1: 109.
([24]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 1: 69.
([25]) الشهيد الثاني، منية المريد: 317؛ مسند أحمد بن حنبل 5: 428.
([26]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 3: 419، ح4040.
([27]) المصدر نفسه، ح4041.
([28]) المصدر نفسه، ح4042.
([29]) المصدر السابق 3: 420، ح4043.
([30]) المصدر نفسه، ح4044.
([31]) المصدر نفسه، ح4045.
([32]) المصدر نفسه، ح4046.
([33]) المصدر السابق 3: 421، ح4047.
([34]) المصدر نفسه، ح4048.
([35]) المصدر نفسه، ح4049.
([36]) المصدر السابق 3: 422، ح4050.
([37]) المصدر نفسه، ح4051.
([38]) المصدر السابق 24: 212، ح30369.
([39]) المصدر السابق 24: 210، ح30363.
([40]) المصدر السابق 24: 208، ح30358.
([41]) المصدر السابق 24: 209، ح30361.
([42]) المصدر السابق 24: 207، ح30357.
([43]) المصدر نفسه، ح30356.
([44]) المصدر السابق 1: 220، ح560.
([45]) المصدر السابق: 219، ح556.
([46]) المصدر نفسه، ح557.
([47]) المصدر نفسه، ح558.
([48]) المصدر نفسه، ح559.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي