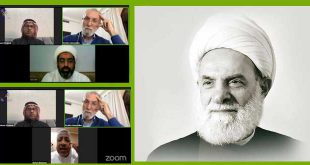الاجتهاد: الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي “رحمهما الله”.
عاد العلامة شمس الدين عام 1969م إلى لبنان وتولّى رئاسة الاتحاد الخيري الثقافي الذي أسس عام 1966م و باشر بنشاطات ثقافية وفكرية وتبليغية. من مؤلفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، بين الجاهلية والإسلام وغير ذلك.
إنّ الوفاق ضرورة يمليها الإسلام نفسه على المسلمين، ولو لم تدع إليه ضرورة حفظ الذات، ورعاية المصالح ، وردّ عادية العدو ؛ لأنّ الوفاق بين المسلمين ووحدتهم من مقتضيات عقيدة التوحيد، ومن مقتضيات شريعة الإسلام، ومن لا يؤمن بهذه الوحدة ولا يدعو إليها ولا يحرص عليها ، ولا يدفع عنها عوامل الفرقة، فإنّ إسلامه منقوص؛ لأنّه يخالف تكليفاً شرعياً أمر الله تعالى به، ونهى عن معصيته في القرآن الكريم في آيات محكمات بيّنات،
منها قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (٢)، (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ) (٣) ، (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) (٤) ، (وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) (٥) ، وغيرها. وفي السنّة الشريفة الصحيحة من هذا كثير.
فكيف إذا كانت الوحدة ضرورة للسلامة والكرامة والعزّة في مواجهة مؤامرة يحيك الغرب شباكها وفخاخها منذ خمسة قرون ، وينفذ فيها فصلاً بعد فصل ، ومرحلة بعد مرحلة بهدف الاستيلاء على ثروات الأُمّة الإسلامية والتحكّم فيها بمنعها كلّها ، ومنع أيّ قوم منها ، من أيّ دور في العالم ، بل من أي دور في اختيار صيغة حياتها ، واختيار التصرّف في ثرواتها وأرضها وسمائها.
وأعظم وسائله إلى هذا الهدف هو ضرب وحدتها بتعطيل دور الإسلام التوحيدي في حياتها ، وذلك بتفكيك علاقات الوجدان والتاريخ والمصالح ووحدة المصائر بين أقوامها، ثمّ بتفكيك هذه العلاقات داخل كلّ قوم، مستخدماً عوامل القومية تارة، وعوامل الوطنية تارة، وعوامل المذهبية الطائفية تارة، خالقاً المخاوف عند كلّ فريق من كلّ فريق، وفي جميع مراحل هذه المؤامرة، يستخدم قوته ونفوذه في بناء أنظمة للمصالح القومية والوطنية والقطرية، والمذهبية الطائفية، ويدفع بكلّ نظام إلى بناء قوّته الخاصّة التي تعتمد على الغرب وإلى ربط اقتصاده بالغرب ، ثمّ إلى ربط أمنه واستقراره بالغرب.
إنّ الوحدة لم تعد مجرد واجب ديني إسلامي مقدّس من مكوّنات إيمان المسلم ، بل غدت ضرورة حياتية يدركها العقل لضمان الحدّ الأدنى من سلامة الأُمّة وبقاء الكيانات التي تتشكّل فيها دولاً ومجموعات إقليمية فهي من الناحية الموضوعية المصلحية المحضة ، ليست ترفاً يقتضيه ويبرّره الاكتفاء، بل ضرورة تقتضيها المصلحة.
إنّ المصلحة السياسية والأمنية والاقتصادية تقتضي بالتوحّد، والبحث الجاد المخلص عن وسائله وأساليب تحقيقه بالتدرّج الذي يتسع للتنوعات ولا يلغي الخصوصيات.
وإنّه لمن عجائب حركة التاريخ أن نشهد أوروبا وهي تتوحدّ أمام أعيننا ، وتلملم شتاتها وتلغي تناقضاتها ، ملقية وراء ظهرها بتاريخ يزيد على ألف عام من العداءات وأنهار من الدماء ، وركام من البغضاء. أوروبا ذات القوميات العدوانية المفترسة ، أوروبا الكاثوليكية ـ البروتستنتية ـ الأرثوذكسية ـ العلمانية الملحدة ، أوروبا الرأسمالية والاشتراكية ، وأوروبا ذات اللغات الشتّى.
وأن نشهد المسلمين ـ بل العرب ـ وهم يتفتتون ويتمزّقون ويتعادون ويتناحرون، بل ويتحاربون، فتسيل بينهم أنهار من الدماء، وتتعالى جبال من البغضاء، ملقين وراء ظهورهم بتاريخ من التوحد والتكامل ـ بشكل أو بآخر ـ يمتد إلى ما يزيد على ألف عام.
وليس هذا وذاك من أقدار الله الحتمية التي اختصّ الله بغيبها وحجب عن البشر العلم بسننها ، بل هو قدر جعله الله تعالى رهناً باختيار البشر.
إنّه سنّة من سنن حركة التاريخ التي كشف عنها في محكم كتابه المجيد ، إنّه عقلنة علاقات الإنسان والمجتمع على أساس عدم اتباع الأهواء الذاتية الشخصية والعرقية في صياغة هذه العلاقات وإدارتها ، بل اتباع ما تقضي به مصلحة المجتمع والأُمّة العامة في قضية الوحدة ، والتكامل، والتنوّع وبذلك تحفظ مصلحة الأفراد والجماعات داخل المجتمع والأُمّة ، واتباع الطريق المخالف ، وهو مصلحة الأفراد والجماعات في صياغة العلاقات وإدارتها يضيع مصلح الأُمّة كلّها ، وتضيع ـ في النهاية ـ المصلحة الخاصّة نفسها للأفراد والجماعات.
وقد بيّن الله الحكيم العليم سبحانه هذا القانون في آيات كثيرة ، وفي بعضها أمثلة تطبيقية من تاريخ الأُمم ، ومن ذلك ما بيّنه سبحانه من شأن اليهود والقلّة في تفرّقهم وتناحرهم في بعض حقب التاريخ ، ومنها عصر الرسول محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ قال تعالى في شأنهم : (بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ) (١).
وعلَّة كونهم هكذا أنّهم قوم لا يعقلون ، وليس لأنّ الله تعالى قدر عليهم أن يتفرّقوا ويتناحروا من غير سبب عملته أيديهم وأوجدوه بإرادتهم واختيارهم. وها هم اليهود الآن موحّدون متّحدون على مشروع واحد ، استطاعوا إنجاز جانب كبير منه على الرغم من العرب جميعاً والمسلمين جميعاً الذين ابتلاهم الله ـ باختيارهم وإرادتهم ـ بنفس ما شنع به على اليهود من الفرقة والتناحر والقلوب الشتّى ، لنفس ما أدّى باليهود في الماضي إلى هذا المصير وهو أنّهم لا يعقلون.
إنّ بيت المقدس الذي انتهك ، نخشى عليه مزيداً من الانتهاك ، وهو وحدة الأُمّة ، لابدّ من إعادة الحرمة إليه ، وتحصينه وترسيخه في وعي المسلمين وسلوكهم ، وصونه من عوادي الفتن.
وهذا أمر لا يتأسّس على السياسة وحدها ، بل يتأسّس ـ قبل السياسة على (فقه الوفاق) و (فكر الوفاق) :
أ ) ـ أما ( فكر الوفاق ) : فكر الوحدة فهو مسؤولية المثقّفين والمفكّرين المسلمين ، ولابدّ من إعادة تكوين هذا الفكر على هدى الكتاب والسنّة ـ وهما العامل الثابت فيه ـ والتاريخ والواقع المعيشي ، وهما العامل المتغيّر فيه.
ووظيفة هذا الفكر أن يربّى المسلم على أخطار الانقسام وبركات التوحّد ، بحيث تكون ( الوحدة الإسلامية ) تعبيراً طقسياً يمارس بعقلية وروح الواجب ، بل ثقافة معيشة بنحو تلقائي في حياة المسلم.
ومن أجل بلوغ هذا المستوى من تكوين شخصية المسلم على فكر الوحدة ، لابدّ أن يجعل هذا الفكر زاداً يومياً لأجيالنا الجديدة في المدرسة والمسجد وسائر وسائل التثقيف والإعلام بحيث يشبّ عليه الصغير ، ويشيب عليه الكبير.
إنّ هذا الفكر غائب عن مجتمعاتنا ، وحتّى عن معظم النخب في هذه المجتمعات ، بل إنّ الأخطر من ذلك أن تسود ـ في بعض الأحيان ـ في هذا المجتمع أو ذلك تيارات ( فكر الخلاف ) الذي يفلسف اتّجاهات التشرذم والتفرّق السياسي والمذهبي.
ب ) ـ وأمّا ( فقه الوفاق ) : فهو مسؤولية الفقهاء ، ومراكز البحث الفقهي ، والمرجعيات الدينية الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
إنّ مسؤولية الفقهاء المخلصين الواعين ، ومراكز البحث الفقهي والمرجعيات الدينية للمسلمين هي بلورة فقه الوفاق والوحدة ، ليكونوا دعاة ورواد وفاق ووحدة ينقذ الله وعجل الله تعالى فرجه بهم المسلمين من التفكّك والتفرّق.
ولا يعفيهم من المسؤولية أن يقفوا موقف المتفرّجين ، وهم يرون الأُمّة تتمزّق ، ويقع جزء منها بعد جزء فريسة لعامل الشرّ والفتنة الداخلية تارة ، وفريسة لعدوان الأغراب تارة أخرى.
إنّ تخلي الفقهاء والمفكِّرين المخلصين الورعين الأكفاء والواعين عن التصدّي لترشيد الأُمّة على مستوى المذاهب الفقهية ، وترشيد الأُمّة على مستوى الحركة الإسلامية، قد أخلى الساحة أمام بعض علماء الدين إلى أن يتخذوا مواقف تنحدر إلى مستوى الجريمة الكبرى والخيانة العظمى في حق الإسلام والأُمّة ، وذلك حين يشرع هؤلاء ـ باسم الإسلام ـ استعمال أساليب العنف ضد مخالفيهم في المذاهب أو في الفهم السياسي، ويستحلّون صياغة خطاب سياسي وتعبوي مشحون بعناصر الإثارة والاستفزاز ودواعي العداء والخصومة ، وعوامل الفرقة والانقسام.
فهل بعد هذا الشرّ من شرٍّ؟
أو لا يكفي بعض هذا مجمل الحاملين لرسالة الإسلام وشريعته من فقهاء ومرجعيات فقهية أن يخرجوا من أطرهم المذهبية والمحلّية ، متفاعلين مع أشدّ حاجات الأُمّة إلحاحاً وهي المصالحة مع الذات والوفاق والوحدة ، مستجيبين في ذلك لنداء الله تعالى في كتابه المجيد في قوله وعجل الله تعالى فرجه في سورة النور : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (١).
إنّ الأُمّة المسلمة عامة ، وكلّ شعب من شعوبها في أمسِّ الحاجة بل أشدّ الضرورة إلى إعادة ترميم ما تصدّع من وحدتها بما هي أُمّة ، وإلى ترميم وحدة كلّ شعب من شعوبها ودولها في إطار الوحدة العامة ، لأنَّ هذه الوحدة لم تعدّ شأناً من شؤون العقيدة فقط ، وهي كذلك بلا ريب ، بل غدت ضرورة من ضرورات السلامة السياسية والاقتصادية والثقافية ، للتحصّن من آثار الهجمة الشرسة الشاملة التي تشنّها قوى كبرى كثيرة على العالم الإسلامي والأُمّة المسلمة، من دون وجود أيّ موقع دولي يمكن أن يجد فيه المسلمون أو أيّة دولة من دولهم حليفاً لهم يتيح المناورة في الأزمات، وذلك بعد التغيّر العميق والشامل الذي حدث في السنتين الماضيتين في النظام الدولي وولادة ما يسمّى ( النظام الدولي الجديد ) الذي بدأت تتصاعد لهجة المنظّرين له والناطقين باسمه في حقول السياسة والاقتصاد والثقافة بالحديث عن الإسلام باعتباره العدو الأوّل ، بل الوحيد أمام الصيغة السياسية التنظيمية والحضارية لهذا النظام العالمي الجديد ، واضعاً الأُمّة المسلمة بين خيارين : إمّا السلّة وإمّا الذلّة أي إمّا القمع ، وإمّا الاستحواذ. ومعالم هذا الموقف تبدو كما نرى ظاهرة في جميع أرجاء العالم الإسلامي.
المصدر: كتاب: المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوى – المؤلف: عبد القادر الإدريسي السوداني
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي