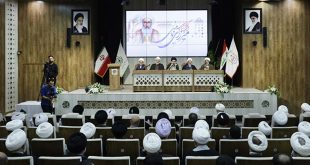نتيجة للأحداث التي كانت تشهدها الحواضر العلميّة الشيعيّة وتنقلها من مكان إلى آخر، فقد أدّى ذلك إلى عدم القدرة على تأسيس صرح علمي دائم الحضور والفعالية، يحفظ فيه التراث العلميّ في الوقت الذي نرى فيه أنّ بعض الصروح العلميّة تدوم مئات السنين فيؤدي ذلك إلى التواصل مع ماضيها والاستفادة بشكل أكبر من روّادها وعلمائها. بقلم: الشيخ الدكتور محمد أحمد حجازي العاملي
الاجتهاد: إن أكثر الأمور التي من شأنها أن تعيق تقدّم أيّ حركة علمية باتجاه مستقبل حافل بالنتاجات المعرفية هو عدم قدرتها على إيصال إرثها العلميّ إلى الأجيال اللّاحقة، أو أنّها تصل مجتزأة غير تامة، ومشوّهة غير واضحة. وذلك بسبب ما تتعرض له من تشريد أربابها العلماء وقتلهم، أو مصادرة كتبهم وحرقها وإغراقها، مما يسبب بإحداث ثغرة عظيمة في طريق التواصل بين الماضي والحاضر، وتصيبها بشلل كبير يمنعها من تطوير النظريّات العلميّة.
لذلك، وعند احتدام الصراعات العسكرية بين الشعوب، نلاحظ – وعلى مر التجارب التاريخية للمجتمعات الإنسانية – أن الطرف الغالب يعمد إلى القضاء على أهم الآثار التابعة للدولة المهزومة، وأهمها العالم” و “الكتاب”، لأنّهما الوسيلتان اللتان تنقلان المضمون التاريخيّ إلى الوعاء العلميّ المستقبلي.
وهذه المسألة لم تأخذ شكلاً مذهبياً أو طائفياً، إنما انسحبت على جميع الشعوب والحضارات القديمة إلى يومنا هذا. ومن تلك البلاد التي ابتليت بهذا الأسلوب الحاقد بلاد الشام، وذلك أيام العثمانيين والأيوبيين الذين صبّوا جام حقدهم على علماء الشيعة ومكتباتهم، فضلاً عن المناصرين لهم ومن هو محسوب عليهم
والذي يظهر من التواريخ أنه إبان حكم “السلاجقة” وآخر الحكم “العباسي”، بدأ التشريد والقتل والإبادة لمنتحلي مذهب “أهل البيت” علیهم السلام ورواد المدارس الشيعية، فلقد “غلب السلاجقة على الأمور، وقد كانت جذور الحياة القبلية راسخة في أعماق نفوسهم، مما أثر في دولتهم، وكانوا غير مثقفين، ولم يحاولوا الاستعانة بالحكماء والعلماء كثيراً، بل غلبت عليهم الصبغة العسكرية، فقد أدت قوة النظام القبلي إلى إثارة الفتن والقلاقل، كما أثّرت بداوة السلاجقة في تعصبهم الشديد للمذهب السني الذي يرعاه الخليفة العباسي في بغداد، فاستغلوا ذلك في سبيل القضاء على آل بویه – الديالمة – الوزراء المتمسكين بالمذهب الشيعي، فتم لهم ذلك “(۱).
وقد أدت سيطرة هؤلاء الجهلة المتعصبين، ومن تلاهم من الأمراء “الخوارزمية” و “الأيوبية” – في الشام – إلى أن يتعرّض الشيعة إلى اضطهاد في قرنين من الزمن، من نصف القرن الخامس إلى نصف السابع للهجرة (۴۵۰ – ۶۵۰ه ۱۰۵۸م – ۱۲۵۲م)، وكانا من أشد الفترات العصيبة في تاريخ الإسلام عموماً، والتشيع خصوصا”(۲). “مما ساعد على ابتلاء الأمة، بأشكال من العصبيات المقيتة، وسيطرة القبائل البعيدة عن الثقافة، كالسلاجقة والأيوبيين، من الذين استغلوا اختلاف المذاهب، في إثارة الطائفية بين الأمة الإسلامية، والتمسك بالحنبلية والتشدد باسم التدين، واعتمادهم سياسة القمع المذهبي، والمحاسبة على العقائد إرضاء لأفكار العامة الجهلة، كل ذلك دعماً لكراسيهم، وتحكيماً لسيطرتهم. فكان على أثر ذلك أن تعرضت مدارس الشيعة ومراكزهم العلمية وعلماؤهم الكبار إلى أشكال من الهجوم والتهجير والإبادة.
وهذا هو السبب المباشر في شحة المصادر المتكفلة بالحديث عن تاريخ هذه الفترة، وكذلك ضیاء التراث الذي أنتجته عقول مفکریها ومؤلفيها. مع أن الشذرات الباقية، سواء من المصادر التاريخية، أو التراث الفقهي المتبقّي، تدل على ضخامة الثروة وعظمة الجهود المبذولة، في سبيل إبقاء الحضارة، والحفاظ على استمرار حياتها”(۳).
وفي القرن السابع للهجرة، اشتدّت الحملات الطائفية الطائشة، بكل ضراوة، واستهدفت الشيعة في الشرق والغرب، وتمكنت من القضاء على معالم أثرية لهذه الطائفة، فحرقت مكتبات، وهدمت مدارس وقتل أعداد من المسلمين المنتمين إلى هذا المذهب.
ومن الأمثلة على جرائم السلاطين، وارتكابهم إبادة جسدية ومعنوية بحق الشيعة وعلمائهم، ما حصل في “حلب”، فلم يوفرها الظلم الأيوبي، إذ “دخل صلاح الدين الأيوبي إلى حلب عام (۵۷۹ه ۱۱۸۳م) وحمل الناس على التسنن وعقيدة الأشعري. ووضع السيف على الشيعة فقتلهم وأبادهم مثل ما عمله في مصر إلى حد يقول الخفاجي: “فقد غالى الأيوبيون في القضاء على كل أثر للشيعة”(۴).
ثم تضاءل الشيعة الحلبيون في “ضعف أمرهم غير أنهم ما برحوا يجاهرون بمعتقداتهم إلى حدود عام (۶۰۰ه ۱۲۰۳م) فأخفوها. وذكر أن “مصطفى بن يحيى بن قاسم الحلبي” الشهير “بطه زاده” فتك بالشيعة حدود الألف فأخفوا أمرهم. وقلّ بعض مما كان يفعله الحلبيون مع الشيعة، من الأعمال الوحشية والمخازي والقبائح التي سودت وجه الإنسانية ويخجل القلم من نقلها.
ومن المعلوم أن أهل حلب كانوا في الأصل شيعة، وإلى أواخر زمان الخلفاء العباسية كانوا على مذهب الإمامية، والظاهر أنه في زمان انتقال تلك الولاية إلى حكم السلاطين العثمانية أجبروا على ترك مذهبهم. وما مر من فعل “طه زاده” يؤيد ذلك، فإن استيلاء العثمانيين على “حلب” كان في أوائل المائة العاشرة.
وبالجملة فإن سبب انقراض المسلمين الشيعة من حلب هو ظلم الملوك وجورهم وتعصب العامة، وقد كان ابتداؤه أوائل القرن السادس، وشدته في القرن السابع، وتناهيه في أوائل القرن العاشر “(۵).
ومن المظالم الكبيرة التي عرفها علماء الشيعة ما حصل في جبل عامل أيّام الحاكم الظالم “أحمد باشا الجزار” الذي عمد إلى قتل العلماء وتشريدهم، وقد عمد إلى إفراغ مكتباتهم العلمية من التصانيف والكتب النفيسة، وبعث بها إلى أفران “عكا، حتى قيل إن أفرانها بقيت تشتعل بكتب علماء الشيعة لمدة أسبوع(۶)
وهذا الأمر يذكرنا بما حصل لبني عمار الشيعة “منتصف القرن الخامس الهجري” في طرابلس لبنان، حينما دخل الصليبيون عليهم وقتلوا منهم أربعين ألفاً، وأحرقوا ما يزيد عن عشرين ألف کتاب و مخطوطة(۷).
هذا ناهيك عن صدور فتاوی متنقلة بين منطقة وأخرى، من القضاة الظالمين بحق علماء الشيعة وعوامهم بوجوب ملاحقتهم وقتلهم، وذلك كما حصل في الأناضول أيام السلطان سليم، وفي بلدة “أنصار” العاملية حينما أمر “ملحم بن الأمير حیدر” بالهجوم على “جبل عامل” عام (۱۰۴۸ه ۱۶۳۸م)، فانتهكت الحرمات، واستبيحت المحرّمات حتى قتل في وقعة أنصار (۱۵۰۰) وأسر (۱۴۰۰) من أبناء “جبل عامل “(۸).
ومن المحن التي شهدتها الحوزة العلميّة في عصرنا الراهن، ما حلّ بحوزة النجف الأشرف من أبشع الجرائم على يد النظام البعثي الظالم الذي وضع خطة لإنهاء هذه الحوزة العظيمة التي دامت ما يزيد عن الألف عام. وقد بقي على مدى ثلاثين عاماً وهو يقوم بسجن العلماء وتعذيبهم أشد أنواع العذاب، واغتيال العلماء وقتلهم والقضاء على الفكر الشيعي برمته.
ومن أشدّ تلك المحن والمآسي التي وقعت على أرباب حوزة النجف الأشرف هو ما عمد إليه “الظالم صدام حسین” بقتل العالم التحریر صاحب “حلقات الأصول” السيد “محمد باقر الصدر” (فيلسوف العصر) وعشرات العلماء من آل الحكيم، وبقية العائلات العلمية وغيرهم من هذه الثلّة الطاهرة. مما أدّى إلى إضعاف الحوزة في النجف، وشلّ قدراتها العلميّة وانتقالها إلى مدينة “قم المقدسة” في “إيران”. واليوم هناك محاولات جادّة لأجل إعادة هذه الحوزة إلى سابق عهدها عسى أن يوفق أربابها لذلك.
وليس بعيداً عن العراق، فقد كانت بلاد “إيران” في زمن “الشاه البهلوي” تعاني ظلماً شديداً من السياسات التعسفية التي هدفت إلى القضاء على الإسلام برمته.
وقد تنبه لذلك مؤسّس الحوزة العلميّة في “قم المقدسة” “الشيخ عبد الكريم الحائري “رحمه الله، فتصدى للحملة المسعورة ضد الحوزة وحماها، ف “حنكة الحائري وإخوانه وصبرهم على المكاره وتحملهم للصعاب قد حال دون ذلك، وقد كان في قم على عهد الحائري من العلماء الكبار عدد غير قليل، منهم: الشيخ أبو القاسم الكبير، و”الشيخ أبو القاسم الصغير”، و”الميرزا جواد الملكي، و”السيد حسين الكوچه حرمي”، و”الميرزا صادق التبريزي، و “السيد فخر الدين القمي (شيخ الإسلام)”، و “الميرزا محمد الكبير”، و”الميرزا محمد الفيض”، و”الشيخ مهدي القمي”، و”السيد محمد باقر القزويني ، و “الشيخ محمد تقي الإشراقي”، و”الشيخ محمد تقي البافقي اليزدي”، و”الشيخ محمد علي الحائري، والشيخ نور الله الأصفهاني”، وعشرات ممن أسهم بقسط كبير في التدريس وفي مساندة ودعم الشيخ الحائري ومشایعته في الرأي.
وقد تعرض معظم من ذكرناهم لصنوف الإرهاب والتعذيب من لدن الملك الجاهل وحاشيته وحكومته الجائرة، كل ذلك من أجل هدم ما بناه الشيخ وإضعافه.
وكان الشيخ واثقاً بأنه هو المقصود، وأن تلك الاستفزازات تستهدف شخصه، فقد كانوا يستفزونه بين الآونة والأخرى، لعلهم يجدون ذريعة يحتجون بها عليه، ليواجه المصير المرسوم، في وقت لا تتوفر فيه إمكانيات المواجهة والتصدي، لكنه كان يقظاً على ذلك وغير غافل عنه في ذلك الوقت، وتلك الظروف”(۹).
ثمّ لمّا وصلت الأمور إلى ذروة الطاغوتيّة والظلم في عهد ولده “الشاه محمد رضا”، تصدّى له “الإمام روح الله الخميني”، وأحدث ثورة عظيمة لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلاً لها، وقد استطاع أن يؤسّس دولة قائمة على أسس الإسلام المتين، مما ساعد في تقوية حوزة أهل البيت علیهم السلام في “قم المقدسة” ونشر المفاهيم التربويّة الصادقیّة في ربوع العالم الشرقي والغربي.
وهكذا تحمّل تلاميذ مدرسة النبوة والعترة الطاهرة صنوف العذاب والقهر والتشريد في سبيل ترسيخ نور الحق في جبين هذه الأمة المريضة، وهي مصرة على مقتهم و قطيعة أرحامهم، فحللوا قتل الشهيد الأول، ولم يكتفوا بذلك، بل جرهم حقدهم إلى صلبه وحرق جسده، وهذا ليس ببعيد عنهم فقد حللوا دم سید الشهداء عليه السلام وذبحوه كما تذبح الشاة، وسبّوا نساءه وهن ریاحین الرسالة، فضرب الشؤم هذه الأمة فلم تفلح في شيء قط، وهي بعد عزّها واستخدامها لنساء الروم أصبحوا عبيداً لأمريكا وأضرابها وتخلفوا في العلم والمعرفة فوسموا بالفضيحة والعار وكانوا مثال قوله تعالى: [فاستخفّ قومه فأطاعوه إنّهم كانوا قوما فاسقين](۱۰).
ونتيجة لهذه الأحداث التي كانت تشهدها الحواضر العلميّة الشيعيّة وتنقلها من مكان إلى آخر، فقد أدّى ذلك إلى عدم القدرة على تأسيس صرح علمي دائم الحضور والفعّالية، يحفظ فيه التراث العلميّ في الوقت الذي نرى فيه أنّ بعض الصروح العلميّة تدوم مئات السنين فيؤدي ذلك إلى التواصل مع ماضيها والاستفادة بشكل أكبر من روّادها وعلمائها.
إنّ أخطر ما تكبدته الحوزة العلميّة هو ذهاب الكثير من الآثار العلميّة، وابتلاؤها بمحاربة علمائها لمنعهم من التصدي المباشر لكافة البدع والمفاهيم التي تدسّ من حين إلى آخر في الجسم العلميّ، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر ترك أثراً سلبياً على التواصل العلمي مع تراث العلماء وجهودهم التأسيسيّة وأدّى إلى خسارة الكثير من الطاقات العلميّة والكتب النفيسة التي لو كانت في يدنا اليوم لكانت وفّرت على العلماء الكثير من المتاعب والمصاعب العلمية.
الهوامش
(۱) محمد حسنين، عبد النعيم، سلاجقة إيران والعراق، لاط، لام، لا ت، ص۴۲ – ۴۳.
(۲) مجلة تراثنا، مرجع سابق، ۳۴/۱۳۷.
(۳) المرجع نفسه، الموضع نفسه.
(۴) الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع، ط۱، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، ۱۴۱۷ه، ۱۹۹۶، ص ۱۰.
(۵) الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ۱ /۲۰۱ .
(۶) المصدر نفسه، ۳۳۳/۱۰ ؛ الأمين، محسن، خطط جبل عامل، مرجع سابق، ص۷۴.
(۷) المصدر نفسه، ۱۸۶/۱.
(۸) العاملي، علي بن يونس، الصراط المستقيم، مرجع سابق، ۱۴/۲ ؛ الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق،۴ /۱۸۲.
(۹) الحائري عبد الكريم، درر الفوائد، ط۵، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، لات، ۲۵/۱.
(۱۰) الزخرف: ۵۴.
⬅المصدر: كتاب: فلسفة التربية الفقهية عند الإمام الصادق “عليه السلام” المجلد الثاني، للمؤلف الشيخ الدكتور محمد أحمد حجازي العاملي – الصفحة: 273
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي