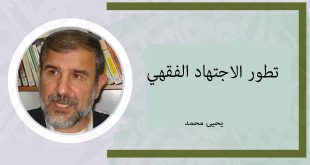الاجتهاد: ليس بين المذاهب الفقهية من اطلق العقل كمصدر من مصادر الكشف عن التشريع صراحة غير مذهب الإمامية الاثنى عشرية، وكذا ما ينسب إلى بعض المعتزلة والفقهاء.
فبحسب إستقراء نجم الدين الطوفي ان أدلة الشرع بين العلماء تنحصر بتسعة عشر باباً القليل منها متفق عليه، واغلبها موضع اختلاف بين الأخذ والرد، وليس بين هذه الأدلة المطروحة عنوان خاص باسم العقل. فهي عبارة عن: الكتاب، السنة، إجماع الأُمة، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، الإستصحاب، البراءة الأصلية، العوائد – العادات -، الإستقراء، سد الذرائع، الإستدلال، الإستحسان، الأخذ بالأخف، العصمة، إجماع أهل الكوفة، إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة[1].
قد يقال ان عنوان العقل ورد ضمن أنواع الأدلة التي توصل للحق. فمن الناحية التاريخية نجد ان مؤسس المذهب الاعتزالي واصل بن عطاء هو أول من حدد المصادر العامة لطريقة الانتاج المعرفي لكل من علم الكلام والفقه معاً. إذ يقول الجاحظ في حقه: (وكل أصل نجده في ايدي العلماء في الكلام وفي الأحكام فانما هو منه).
فالجاحظ يعتبر واصل بن عطاء (هو أول من قال: الحق يعرف من وجوه أربعة؛ كتاب ناطق، وخبر مجمع عليه، وحجة عقل، واجماع من الامة). وقد تصور الاستاذ علي سامي النشار ان الوجوه الأربعة التي ادلى بها واصل؛ تساوي حتماً اصول الفقه الأربعة: القرآن والسنة والقياس والاجماع[2].
ومن حيث التحقيق يلاحظ ان حجة العقل لا تساوي القياس الفقهي. فمن جهة ان تلك الحجة اعم من اعتبار الجانب العقلي أو الإجتهادي للقياس الفقهي. كما من جهة أخرى ان القياس يحمل دلالة الارتباط بالنص خلافاً لما هو الحال في حجة العقل الذي له دلالة الاستقلال، فأحدهما لا يعني الآخر.
ومنه نفهم لماذا لم يرادف العلماء بينهما، حيث وضعوا العقل كمصدر أساس للعقيدة والكلام ولم يضعوا القياس، ووضعوا القياس كمصدر للفقه ولم يضعوا العقل. وبعضهم ميّز، وهو ينص على سبر اصول الأدلة، بين القياس والعقل، كما هو الحال مع الباقلاني الذي عدد اصول الأدلة وحصرها بخمسة، وكان منها أصل العقل، وكذا أصل القياس والإجتهاد، فضلاً عن الكتاب والسنة والاجماع[3].
مع هذا لا ينكر ان المعتزلة أقروا مبدأ تشريع العقل في القضايا الرئيسة لأجل تصحيح العقيدة ضمن علم الكلام، كوجوب النظر والشك وشكر المنعم ودفع الضرر عن النفس وما اليها[4]. علاوة على ما نُسب إلى بعضهم من إقرار التعويل على العقل في الأحكام بدلاً عن الأخذ بأخبار الآحاد، لأنها لا تفيد علماً ولا توجب عملاً، كالذي نقله ابن السمعاني، معتبراً ان بعض الفقهاء قد تلقف هذا القول من القدرية والمعتزلة الذين أنكروا أخبار الآحاد، وعولوا على القرآن والحديث المتواتر ودليل العقل[5].
وسبق للشافعي في كتابه (الأم) ورسالة (جماع العلم) أنْ حكى مقالة جماعة من المعتزلة ينكرون الأخذ بأخبار الآحاد باعتبارها لا تفيد علماً أو يقيناً، مما جعله يرد عليهم[6].
العقل عند الإتجاه السني
أما في الوسط السني بعيداً عن أجواء المعتزلة، فمن الواضح أن رجاله يحصرون التشريع في النصوص دون العقل. وعلى رأيهم ان هذا الأخير لا يمكنه إدراك أدلة الأحكام بذاته[7].
فهذا هو الموقف العام لأهل السنة، حيث لا نجد من يعترف بدور العقل المستقل في التشريع الا من شذّ منهم، كالعز بن عبد السلام (المتوفى سنة 660هـ) الذي رأى بأن مصالح الدنيا كلها تُعرف بالعقل من خلال الضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرة، وذلك على خلاف مصالح الآخرة التي لا تدرك الا بالشرع، فعلى حد قوله: (من أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله، بتقدير ان الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك الا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته)[8].
مع أنه صرح قبل ذلك بسطر أو سطرين ما يبدو أنه مناقض للتقرير الذي نقلناه، حيث قال: (أما مصالح الدارين واسبابها ومفاسدها فلا تعرف الا بالشرع)[9].
ويتسق الرأي السابق مع اعتبار الأحكام الشرعية الدنيوية لم تصدر عن الشرع بعنوان التأسيس كما هو الحال في التعبديات، وانما صدرت عنه بعنوان الإمضاء والتبعية[10].
كما نقل الشاطبي ما ذهب اليه جماعة اعتقدوا باكتفاء ما يرد في النفس من إطمئنان يخص جملة من الأحكام، ونقد ذلك من حيث ان التعويل عليه لا يستقيم مع الأخذ بما أمر به الله من العمل بالكتاب والسنة. وعلى رأيه ان احكامه تعالى لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته[11]، اتساقاً مع ما ذهب اليه الأشاعرة من نفي الدلالة العقلية للحسن والقبح.
كذلك نقل عن جماعة أنهم عوّلوا على إدراك مصالح العباد طبقاً لمقاصد الشرع الكلية المستخلصة بالإستقراء، حيث جردوا المعاني وطرحوا خصوصيات الالفاظ، بل وردّوا كل خاص يخالف العام المستخلص بالإستقراء، وقد عرفوا بأصحاب الرأي[12] . الا ان ذلك ليس له علاقة بالعقل، إذ الإستقراء المحكي عنه إنما هو الخاص بالشرع لا غير.
نعم جعل الغزالي عنوان العقل ضمن اصول الأدلة الفقهية، وهي عنده عبارة عن الكتاب والسنة والاجماع، مضافاً اليها دليل العقل والإستصحاب الدالين على براءة الذمة في الأفعال قبل ورود السمع[13].
لكن كما هو واضح أنه يعد هذا الدليل مقيداً بالحال قبل ورود الشريعة، وهو ما يطلق عليه (البراءة الأصلية)، أما مع وجودها وورودها فليس للعقل شأن يمكن ان يستكشف به الحكم مستقلاً. لهذا فمن الناحية المبدئية ان الإتجاه السني لا يعترف بدور العقل في استكشاف موارد التشريع والأحكام، وهو أمر يتسق مع نظرية الحسن والقبح الشرعيين التي يميل اليها أغلب أهل السنة، مثلما هو حال التفكير الأشعري، سواء لدى المتقدمين منهم أو المتأخرين.
واذا كنا نعتقد بأن قسطاً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق الأشاعرة في ابطالهم لدور العقل في التشريع أو الكشف عن الأحكام، بسبب التنظير الذي آلوا اليه في قاعدة الحسن والقبح الشرعيين؛ فإن القسط الآخر من المسؤلية يتحمله – قبلهم – الشافعي، باعتباره المنظر الأول لأصول الفقه. فبحسب المعطيات المتوفرة لدينا اليوم هو ان تنظير الأدلة الشرعية وتقعيدها لم ينشغل بهما فقيه مسلم قبل هذا الإمام القرشي، أو على الأقل أنه لم يصلنا شيء واضح ومقطوع به قبله[14] .
والعديد من العلماء يعتقدون أنه أول من صنف في ذلك العلم، كالذي نصّ عليه ابن خلدون وابن تيمية والزركشي ومن قبلهم الإمام الجويني[15]. وكان أحمد بن حنبل يقول: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي[16].
مع ذلك فإن هذا الإمام الذي مارس التنظير والتقعيد لم يعط أي دور مميز للعقل في التشريع والاستكشاف. فغياب العقل هو الظاهرة البارزة في مشروعه. ذلك أنه يلتزم بالبيان التام لنص الخطاب فلا يدع مجالاً لمشاركة غيره في التشريع؛ باستثناء القياس للضرورة والاضطرار، كما نصّ على ذلك مرات عديدة، مثل قوله: (ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها)[17]. وقوله ايضاً: (ليس لأحد ابداً ان يقول في شيء: حلّ ولا حرُم الا من جهة العلم.
وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس)[18]. وكذا قوله: (العلم طبقات شتى.. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من اعلى)[19].
هكذا نرى غياب العقل من مشروع الشافعي، مثلما نشهد موته لدى الأشاعرة، وكل ذلك له انعكاساته الخاصة التي مازلنا نعاني منها حتى يومنا هذا.
ويلاحظ أنه حتى لو أوّلْنا مبادئ الإجتهاد التي تقول بها بعض المذاهب الإسلامية واعتبرناها مبادئ عقلية تتباين في الاستقلالية من حيث علاقتها بالنص، كالقياس أو المصالح المرسلة أو الإستحسان أو الإستصحاب أو البراءة الأصلية أو غيرها، فانها مع ذلك تظل مهملة غير فاعلة الا عند غياب النص، بل غالباً ما يكون العمل بها على نحو الاضطرار أو تبعاً لضغط الحاجات الزمنية.
فعلى الأقل ان رؤساء المذاهب الإسلامية قد صوروا الأمر على هذا النحو من الاضطرار، مثلما يعترف بذلك أصحاب المذاهب الأربعة، حتى من عُرف منهم بشدة العمل بالإجتهاد – سيما القياس منه – كأبي حنيفة النعمان[20].
فهم يرجحون العمل بالنص رغم كونه لا يرقى – في الغالب – إلى درجة أقوى من الظن، سواء من حيث الصدور أو الدلالة. على هذا يظل العمل بمبادئ الإجتهاد متأخراً رتبة عن العمل بالنص.
وهو أمر ينطبق حتى على من يعترف صراحة بمبدأ العقل في استكشاف الحكم الشرعي، إذ لا يرى له مرجعية تتقدم على مرجعية النص، رغم ما يعتري النص من مشكل عدم افادته العلم واليقين في الغالب، خاصة الحديث منه، حيث يشهد مشاكل اضافية تتعلق بالسند والتقطيع وإحتمالات الزيادة والنقصان، فضلاً عن مشاكل أخرى تلوح المتن ذاته.. كالذي يلاحظ عند مذهب الإمامية الاثنى عشرية التي تعد العقل مصدراً أخيراً لمصادرها التشريعية الأربعة (الكتاب والسنة والاجماع والعقل)، بدءاً من بداية عصر التنظير الشيعي، كما ينص عليه الشريف المرتضى، ومن ثم جاء الآخرون يؤكدون مقالته في حجية العقل بعد النص والاجماع.
والامامية وإن اختلف علماؤها حول ما يريدونه من المعنى الخاص بالعقل كمصدر استكشاف وتشريع، الا ان ما استقر عليه المتأخرون هو أنه ينحصر مستقلاً في دائرة التحسين والتقبيح العقليين.
من هنا يتضح ان مكانة العقل – أو الرأي والإجتهاد تسامحاً – في علم الفقه تختلف عما هي عليه في علم الكلام، فكثيراً ما يُحتج به في القضايا العقائدية قبال ظواهر النصوص للكتاب والسنة، فينتهي الأمر بهذه النصوص إلى التأويل والتوجيه، أو الترك والإبطال.
مما يعني ان اعتبار العقل في علم الكلام هو اعتبار تأسيسي، أو ان له جعلاً على نحو التأسيس لا التبعية، سواء كان التأسيس خارجياً لاثبات الخطاب الديني من حيث الاصل، أو داخلياً يراد منه توجيه معاني نصوص الخطاب بما يتفق ومداليله الخاصة. لهذا كان متهماً من قبل النزعات البيانية بانه يقوم بدور مناهض لنصوص الخطاب وبيانها، مثلما ذهب اليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن ابتعدوا عن الطريقة العقلية الكلامية[21].
أما في الفقه فالامر يختلف تماماً، ذلك ان هذا العلم لا يحتاج إلى العقل للتأسيس من الخارج، فتأسيس الخطاب الديني بالعقل هو في حد ذاته يصحح عمل البناء الفقهي.
والاهم من هذا هو ان علم الفقه لم يجعل العقل موضعاً للتعارض مع النص كما فعله علم الكلام، إنما الإعتماد على بيانية النصوص هي الحالة الراكزة والمستقرة، رغم المفارقة في الامر! إذ كان العقل الكلامي يمارس حالة التوجيه والتأويل بتأسيس الخطاب من الداخل في النصوص القطعية الصدور (الايات القرآنية)، في حين أُهمل العقل في الفقه ولم يسمح له بممارسة حالة التأويل والتوجيه للنصوص؛ بما فيها نصوص الحديث رغم أنها ظنية الصدور والدلالة.
ولو انا طبقنا عليها منطق الإحتمالات لكانت الأحكام المنتزعة منها في غاية الضعف لما ينتابها من مشاكل متنوعة على صعيد السند والمتن، كالذي التفت اليه أصحاب دليل الانسداد في الإتجاه الشيعي.
هذا هو حال الفقه ليس له زاد ولا معين يطمأن اليه وهو في صورته التقليدية تلك. الأمر الذي يحتاج إلى نوع من التعويض المسدد، وذلك بالتعويل على الاعتبارات الموثوقة لتشييد الأحكام واستكشافها، كاستخدام مبدأ العقل ومبدأ الواقع ونظام الخلقة، وكذا مقاصد الشرع وكلياته العامة.
إن إهمال العقل في الفقه جعل الممارسة الإجتهادية تصطدم أحياناً بالنتائج العقلية القطعية دون ان تشعر، أو أنها تجاهلت ذلك طبقاً لمسلكها الاستصحابي في إبعاد العقل عن الاستكشاف والنفي والإثبات. وهنا بيت القصيد !
فحتى الإتجاه الشيعي رغم اعترافه بمرجعية العقل للكشف عن التشريع ورغم ما صرح به بعضهم كالشيخ النائيني من أنه (لو عزل العقل عن الحكم لهدم أساس الشريعة)[22]؛ الا أنه من الناحية العملية ظل هذا الإتجاه يتعامل مع العقل تعاملاً سلبياً.
العقل عند الإتجاه الشيعي
لقد خضع الدليل العقلي القطعي المعد كاشفاً عن الحكم الشرعي والمعبر عنه بقضية التلازم بين العقل والشرع طبقاً لقاعدة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع).. خضع هذا الدليل لتفسيرات عديدة بين الأصوليين الشيعة. فقد فسّره بعضهم بالبراءة الأصلية والإستصحاب، وقصره بعضهم على الثاني، فيما ذهب بعض آخر لتفسيره بلحن الخطاب وفحواه ودليله، مضافاً إلى وجوه الحسن والقبح[23].
وأضاف آخرون كلاً من مقدمة الواجب واجبة، ومسألة الضد[24]، واصل الاباحة في المنافع والحرمة في المضار، وكذلك البراءة الأصلية والاستصحاب، وما لا دليل عليه، ولزوم دفع الضرر المحتمل، وقاعدة شغل الذمة اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً، والأخذ بالاقل عند الترديد بينه وبين الاكثر[25].
وقدّر البعض بأن من ضمن الأحكام العقلية اعتبار الضرورات تبيح المحظورات، وان الضرورة تقدر بقدرها، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولزوم اختيار أهون الشرين اللذين لا مناص من أحدهما، والعلم بوجود التكليف يستدعي العلم بطاعته وامتثاله، واصل المشروط عدم شرطه، والاذن بالشيء اذن بلوازمه[26].
لكن هناك من قصد بالدليل العقلي بأنه حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابث شرعاً أو عقلاً وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما[27]، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة.
أما المستقلات العقلية فقد حصرها في مسألة واحدة هي التحسين والتقبيح العقليين باعتبار ان الشرع لا يشارك حكم العقل العملي الا فيها[28].
وتنص هذه القضية كما يقول ابو القاسم القمي: (ان كل ما يدرك العقل قبحه فلا بد ان يكون من جملة ما نهى الله عنه، وما يدرك حسنه فلا بد ان يكون مما أمر به، فاذا استقل العقل بادراك الحسن والقبح.. فيحكم بأن الشرع ايضاً حكم به كذلك، لأنه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن)[29].
وفي قضية المستقلات العقلية يفترض ان يكون للعقل العملي حكم إزاء ما يدركه بغض النظر عن الشرع، كالحكم بقبح قتل الأبرياء، كما يفترض ان تكون هناك ملازمة نظرية بين الحكمين العقلي والشرعي، وهي ما يدركها العقل النظري، والتي تقول ان كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فاذا كان العقل يحكم بقبح قتل الأبرياء؛ فإن الشرع يحكم بذلك ايضاً، كما هو واضح من صيغة التحريم[30].
واعتبر البعض ان من وظائف العقل إدراك المصالح والمفاسد، وان الأحكام تابعة لها، مما يعني صحة استكشاف العقل لهذه الأحكام تبعاً لإدراك تلك المصالح والمفاسد، فكما يقول صاحب (فوائد الاصول) من (انه لا سبيل إلى انكار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وان في الأفعال في حد ذاتها مصالح ومفاسد كامنة مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه وانها تكون عللاً للأحكام ومناطاتها، كما أنه لا سبيل إلى انكار إدراك العقل لتلك المناطات)[31].
وكذا قول بعض المعاصرين: (ان المصالح والمفاسد علل للأحكام، فاذا ادرك العقل المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال فلا بد من ان يكون للشارع حكم في ذلك الفعل لوجود علته، فيكون العقل كاشفاً عن الحكم الشرعي)[32].
والبعض جعل اطباق العقلاء على مصلحة الشيء أو فساده هو الضابط الوحيد المعول عليه في اقرار الملازمة بين العقل والشرع. فالشيخ المظفر يقول: (اذا ادرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في اخر، ولم يكن إدراكه مستنداً إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكها جميع العقلاء؛ فإنه لا سبيل للعقل ان يحكم بأن هذا المدرك يجب ان يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل ان هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل، أو ان هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل وإن كان ما ادركه مقتضياً لحكم الشارع)[33].
لكن هذا التقرير هو في حد ذاته يبرر حالة الفصل بين الحكمين العقلي والشرعي. فحتى لو حصل الضابط الذي ذكره المظفر واجمع العقلاء على حكم من الأحكام العقلية؛ فإن ذلك لا يمنع – تبعاً لما افاده الشيخ – ان يحتمل وجود (ما هو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل، أو ان هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل وإن كان ما ادركه مقتضياً لحكم الشارع). فهذه هي حالة الفصل بين الحكمين العقلي والشرعي، والتي نجدها شائعة لدى الفقهاء الأصوليين من الشيعة.
ويلاحظ من كل ما ذكرنا ان الدليل العقلي وضع – في الغالب – بصورة غير مستقلة عن البيان أو النص، فهو يعتمد عليه وموظف لخدمته. فالاتجاه الشيعي يقر بأن العقل في الفروع بخلاف الأصول يعجز عن الكشف عن الحكم الشرعي بشكل مستقل، باستثناء حالات خاصة وقليلة كتلك المتعلقة بالحسن والقبح.
لكن حتى في هذه القضية الواضحة نجد بعض المتأخرين الشيعة قد انفرد ونفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؛ رغم قوله بنظرية الحسن والقبح العقليين، كما هو الحال مع صاحب كتاب (الفصول)، حيث يقول: (الحق عندي ان لا ملازمة عقلاً بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه).
وقد صور الشيخ محمد علي الكاظمي – في تحريره لافادات استاذه النائيني – هذا الرأي من انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بقوله: (ان العقل وان كان مدركاً للمصالح والمفاسد والجهات المحسنة والمقبحة الا أنه من الممكن ان تكون لتلك الجهات موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع ولم يصل العقل إلى تلك الموانع والمزاحمات، إذ ليس من شأن العقل الاحاطة بالواقعيات على ما هي عليها، بل غاية ما يدركه العقل هو ان الظلم مثلاً له جهة مفسدة فيقبح، والاحسان له جهة مصلحة فيحسن، ولكن من المحتمل ان لا تكون تلك المفسدة والمصلحة مناطاً للحكم الشرعي)[34]. وقد أيّد الشيخ ضياء الدين العراقي هذا الرأي الذي ذهب اليه صاحب (الفصول)[35].
لكن ذلك لا يتسق مع ما يكاد يتفق عليه علماء المدرسة الأصولية من الشيعة في صحة العلم الوجداني القطعي من حيث أنه حجة ذاتية غير قابلة للجعل الشرعي[36]. فهو والعلم التعبدي يعدان – عندهم – كامل حجية المجتهد[37]. وقد زاد بعضهم على ذلك بأن اعتبر العلم العادي (الإطمئناني) مما لا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوع الأدلة في نظر العقلاء[38]. بل رغم هذا الاعتراف نلاحظ ان هناك تضييقاً لحدود هذين العلمين.
ففي العبادات يعول المجتهد على الأخبار لكثرتها رغم مشاكل الحديث المعترف بها. أما في المعاملات فالمجتهد يعول على القواعد الأصولية والكبريات الواردة فيها[39]. وفي كلتا الحالتين لا نجد مساحة يعتد بها للعمل بالوجدان العقلي المستقل، ومنه ذلك المزود بخبرة الواقع.
نعود مرة أخرى لنقرر أن ما صوّره الشيخ الكاظمي من انكار الملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي؛ هو ذاته قد هيمن على السلوك الشيعي من الناحية العملية، بل وعلى السلوك الإسلامي قاطبة.
فالإتجاه الشيعي يعد العقل غير قادر على الإدراك القطعي للمصالح والمفاسد الحقيقية في الواقع. ويندرج تحت هذا التعامل جميع القضايا الفقهية تقريباً، سواء كانت بسيطة عادية، أو عظيمة خطيرة، ومنها ما يتعلق بنظام السلطة والحكم واعتبارات الحرية الفردية والاجتماعية والتعامل مع الحقوق العامة للانسان.
فهذه القضايا وغيرها لا تبحث ضمن إطار المصالح والمفاسد العقلية المندرجة تحت عنوان الحسن والقبح، وإنما تبحث بحسب ما يؤدي اليه النظر المنبثق من التفكير البياني، رغم ان هذا النظر لا يفضي في الغالب إلى ما هو أقوى من الظن، وهو الظن المعبّر عنه بالمعتبر، تمييزاً له عن الظن العقلي المبعد.
فبنظر الفقهاء تكون الأحكام تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها، كما نصّ عليه العلامة الحلي في (النهاية)[40]، وان العقلاء قد يتوهمون ما هو أقرب إلى واقع الشرع على أنه ابعد، وما هو أبعد عن هذا الواقع على أنه اقرب، وبالتالي فلا مجال لكشف الحقائق الا عن طريق الشرع؛ لكونه محيطاً بكل الجهات وعالماً بكثير مما لم تصل اليه العقول.
فمع ان المعول عليه عندهم كون المقياس في باب الحجج هو الأقربية إلى واقع الشرع، الا ان معرفة هذه الأقربية لا يمكنها ان تكون بالنظر العقلي المنفصل عن الشرع ولو على نحو السلب، وذلك من حيث العلم بعدم ردع الشارع عن الأخذ بما يعتقد أنه أقرب إلى ذلك الواقع[41].
لكن بحسب هذا المنظور تصبح الأحكام تعبدية لا تُعلم مصالحها بالنظر العقلي، وأنه لا معنى للاستدلال على ظرفية بعض الأحكام أو تخصيصها بوقائع محددة أو اعتبارها مما تقع تحت دائرة الأحكام المولوية القابلة للتغيير، اذا ما كانت ظواهر النصوص الدالة على مثل هذه الأحكام تتصف بالاطلاق والعموم دون وجود ما يخصصها ويقيدها بحسب القرينة اللفظية، حيث أنها يمكن ان تُبرر بنفس تلك الحجة، فيُفترض وجود مصالح خفية تجعل العقل عاجزاً عن الكشف عن ظرفية الأحكام أو تقييدها وتخصيصها.
الأمر الذي يجعل من الأحكام أحكاماً تعبدية لا تقبل التوجيه والتفسير بغير ما يفيده الظاهر الاطلاقي للنص. مما يعني بالتالي وجود التعارض بين ما يدركه العقل المستقل من فهم واضح معلل، وبين ما ينطق به النص من حكم ظاهر مخالف.
والمسألة لا تتوقف عند حدود القضايا المعيارية من الأحكام الشرعية، وانما يمكن ان تنسحب وتطال الأحكام التقريرية التي لها علاقة بالكشف عن الواقع الموضوعي، ذلك أنه بنفس تلك الحجة من إحتمال وجود مصالح حقيقية خافية على العقل البشري، يمكن ان يدّعى وجود حقائق خفية يعجز العقل عن إدراكها وراء ما ينطق به النص الذي ظاهره يخالف ما يدركه العقل من القضايا الموضوعية والخارجية.
فمثلاً ان بعض النصوص تنهانا عن التعامل مع بعض الاجناس البشرية بحجة أنهم من الجن. لكن عقلنا وادراكنا الواقعي يكذّب ذلك، إذ ليس فيهم ما يختلفون به عن غيرهم من البشر.
وقد يحتج صاحب فكرة الحقائق الخفية بأنه حتى لو لم يظهر أي تمايز بين هؤلاء الاجناس وبين غيرهم فإن ذلك لا يمنع من كون العقل لم يدرك بعض التمايزات الخفية التي تجعل من مثل هؤلاء من الجن. لذا يصبح من الصعب أو المحال الرد على مثل هذه الحجة التشكيكية.
لكن كل ما يقال هنا يمكن ان ينسحب على قدرة العقل على الإدراك الموضوعي برمته، ذلك أنه بحسب هذا المنطق يمكن ان يقال ايضاً بأن كل ما يقرر من إثبات للقضايا الدينية، وعلى رأسها القضايا الأصولية، يواجه ايضاً نفس المصير.
فإحتمال وجود حقائق مخالفة تخفى على العقل وتجعل معرفة الحقيقة الدينية من المحالات أمر وارد[42]؛ مثلما لا سبيل لمعرفة القضايا التقريرية التي تخالف ما تنطق به النصوص، وكذا لا سبيل لمعرفة المصالح الحقيقية التي يتوخاها العقل في القضايا المعيارية من الأحكام وغيرها.
إذاً لا داعي لجر القضايا بمثل هذا المنطق الخطير، بل لا بد من الثقة العقلائية الوجدانية في الكشف عن الحقائق والتسليم بها ما لم تُعارض بما هو أقوى منها حجة واعتباراً.
الهوامش
[1] نجم الدين الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة، نشرت خلف كتاب مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 1970م، ص109ـ110.
[2] علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، الطبعة السابعة، 1977م، ج1، ص395.
[3] ابو بكر الباقلاني: الانصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مؤسسة الخانجي، الطبعة الثانية، 1963م، ص19ـ20.
[4] انظر: عبد الجبار الهمداني: شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، حققه وقدم له عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الاولى، 1965م، ص64. والمجموع في المحيط بالتكليف، نشر وتصحيح الأب جين يوسف اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ج1، ص42. كذلك: يحيى محمد: منطق الإحتمال ومبدأ التكليف في التفكير الكلامي، دراسات شرقية، باريس، عدد9-10، 1411هـ ـ1991م. والعقل والبيان والإشكاليات الدينية، مؤسسة الانتشار العربي (تحت الطبع).
[5] جلال الدين السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، تعليق علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، بيروت، ص149 و161.
[6] الشافعي: الأم، عن شبكة المشكاة الالكترونية، ج7 (لم تذكر ارقام صفحاته). وجماع العلم، عن شبكة المشكاة الالكترونية (لم تذكر ارقام صفحاته).
[7] يس سويلم طه: مختصر صفوة البيان في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، مكتبة الكليات الأزهرية، 1393هـ ـ1973م، ج1، ص29.
[8] العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عن شبكة المشكاة الالكترونية، فصل في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون (لم تذكر ارقام صفحاته). وقد نقل الشاطبي النص الذي أدلاه العز بن عبد السلام دون ذكر اسمه، وعلّق عليه المرحوم عبد الله دراز معتبراً رأيه اشبه بمذهب المعتزلة (الموافقات، ج2، ص48).
[9] وهو قد صرح قبل ذلك بأن (معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، ولا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع ان تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وكذا ان تقديم ارجح المصالح ودرأ افسد المفاسد عند التزاحم هو محمود حسن ايضاً) (نفس المصدر والفصل السابقين).
[10] كشاهد على ذلك سُئل بعض الاعراب فقيل: كيف عرفت ان محمداً رسول الله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. وقد عد ابن القيم هذا الشاهد احد الردود على الذين انكروا حسن الأشياء وقبحها لذاتها وليس لأن الشرع اعتبرها كذلك مثلما تقول الأشاعرة، حتى قال: (فهذا الاعرابي اعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء، وقد أقرّ عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته). كما قال: (فمن جوز عقله ان ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل، وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها، من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وانواع المجون وامثال ذلك، فليعز في عقله، وليسأل الله ان يهبه عقلاً سواه.. ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ((ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث))، فهذا صريح في ان الحلال كان طيباً قبل حله، وان الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم.. ومما يدل على ذلك ايضاً قوله تعالى: ((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق))، وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها.. وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم ان القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة) (ابن القيم الجوزية: مفتاح دار السعادة، عن شبكة المشكاة الالكترونية، لم تذكر ارقام صفحاته ولا فقراته، ضمن فصل: الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في العقول). كذلك: محمد محمد المدني: أسباب الخلاف بين ائمة المذاهب الإسلامية، مجلة رسالة الإسلام، نشر الاستانة الرضوية، مشهد، 1411هـ ــ1991، ج8، ص178ـ179.
[11] الشاطبي: الاعتصام، دار المعرفة، لبنان، ج2، ص347 وما بعدها.
[12] الموافقات، ج3، ص230.
[13] ابو حامد الغزالي: المستصفى من علم الاصول، المطبعة الأميرية، مصر، الطبعة الاولى، 1322هـ، ج1، ص100 و217ـ218.
[14] نعم هناك من اسماء الكتب التي نُسبت لبعض العلماء قبل الشافعي ما يشير إلى إحتمال تأسيس هذا العلم سلفاً. ومن ذلك ما ذكره ابن النديم من ان لمحمد بن الحسن الشيباني – تلميذ ابي حنيفة واستاذ الشافعي – كتاباً بعنوان (اصول الفقه). فلو صحت هذه النسبة لكان الشيباني سابقاً للشافعي في تأسيسه لهذا العلم (انظر: ابن النديم: الفهرست، اعتناء وتعليق ابراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الاولى، 1415هـ ـ1994م، ص254). كذلك ما نقله بعض علماء الإمامية من ان أول من صنف في هذا العلم هو هشام بن الحكم (المتوفى سنة 179هـ أو 199هـ) وهو تلميذ الإمام الصادق، حيث له كتاب بعنوان الألفاظ ومباحثها (حسن الصدر: تأسيس الشيعة، شركة النشر والطباعة العراقية، ص310).
[15] مقدمة ابن خلدون، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ص455. وابن تيمية: رسالة في الحقيقة والمجاز، عن شبكة المشكاة الالكترونية، فقرة عن اصول الفقه (لم تذكر أرقام صفحاتها). وبدر الدين الزركشي: البحر المحيط، شبكة المشكاة الالكترونية، لم تذكر ارقام صفحاته، فقرة 3.
[16] البحر المحيط، فقرة 3.
[17] الشافعي: الرسالة، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، 1979م، ص20.
[18] الرسالة، ص39 .
[19] الشافعي: الام، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ ـ1983م، ج7، ص250. والرويشد: قادة الفكر الإسلامي عبر القرون، مكتبة عيسى البابي وشركاه، ص61 . وابو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، ص460.
[20] انظر بهذا الخصوص ما فصلناه في: مدخل إلى فهم الإسلام، دار أفريقيا الشرق، الطبعة الثالثة.
[21] لاحظ تفاصيل ذلك في الفصل السادس من: (مدخل إلى فهم الإسلام(.
[22] محمد جواد مغنية: مع كتاب محاضرات في اصول الفقه الجعفري للشيخ ابي زهرة، رسالة الإسلام، عدد10، نشر الاستانة الرضوية المقدسة، مشهد، 1411هـ ـ1991م، ص42 .
[23] المقصود بلحن الخطاب هو ان تدل قرينة (عقلية) على حذف لفظ، مثل حذف (فضرب) في قوله تعالى: ((أن اضرب بّعصاك البحر فانفلق)) الشعراء/63. أما فحوى الخطاب فهو مفهوم الموافقة أو ما دلّ عليه التنبيه، كما في قوله تعالى: ((فلا تقل لهما أُفٍّ)) الإسراء/23. أما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة الذي يعني تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، كقوله في سائمة الغنم الزكاة. علماً ان هذه الأمور تبحث ضمن حجية الظواهر من علم اصول الفقه، وتؤخذ من فهم البيان اللغوي لا العقل كأمر مستقل (انظر: نجم الدين الحلي: المعتبر في شرح المختصر، لجنة التحقيق باشراف ناصر مكارم، نشر مؤسسة سيد الشهداء، 1364هـ.ش، المعجم الفقهي الالكتروني، ص6 ).
[24] وتعني: (كل فعل واجب شرعاً يلزمه عقلاً حرمة ضده شرعاً).
[25] يوسف البحراني: الحدائق الناضرة، تحقيق محمد تقي الايرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1409هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج1، ص40ـ41. كذلك: محمد رضا المظفر: اصول الفقه، مؤسسة الاعلمي، ج3، ص122ـ123.
[26] محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق، دار التعارف، الطبعة الرابعة، 1402هـ ـ1982م، ج6، ص381 .
[27] يقصد بقاعدة الإجزاء: (كل ما يأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلاً الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار). ويقصد بقاعدة مقدمة الواجب واجبة: (كل فعل واجب شرعاً يلزمه عقلاً وجوب مقدمته شرعاً) (اصول الفقه، ج2، ص210).
[28] اصول الفقه، ص197 .
[29] عن: رشدي محمد عرسان عليان: العقل عند الشيعة الإمامية، مطبعة دار السلام، بغداد، الطبعة الاولى، 1973م، ص185.
[30] لاحظ: كاظم الحائري: مباحث الاصول، تقرير ابحاث السيد محمد باقر الصدر، مكتب الاعلام الإسلامي، قم، 1408هـ، القسم الثاني، ج1، ص479.
[31] فوائد الاصول، ج3، ص59.
[32] هاشم معروف الحسني: المبادىء العامة للفقه الجعفري، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية، 1978م، ص240.
[33] اصول الفقه، ج2، ص239-240.
[34] محمد علي الكاظمي: فوائد الاصول، من افادات الميرزا محمد حسين النائيني، تعليقات ضياء الدين العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ج3، ص60 . والعقل عند الشيعة الإمامية، ص188ـ189.
[35] فوائد الاصول، ج3، هامش ص61.
[36] بل ان البعض كالمفكر محمد باقر الصدر أقرّ حجية القطع سواء كان القطع موضوعياً يستند إلى البديهة أو الدليل، أو كان ذاتياً لا يستند إلى ذلك مثلما يكثر لدى عوام الناس (محمد باقر الصدر: دروس في علم الاصول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الرابعة، 1417هـ، ص134).
[37] أبو القاسم الخوئي: الإجتهاد والتقليد، ضمن التنقيح في شرح العروة الوثقى، تحرير الميرزا علي الغروي التبريزي، مقدمة عبد الرزاق الموسوي المقرم، مطبعة الآداب، النجف، ص243 و91 .
[38] المصدر السابق، ص289 و208.
[39] المصدر السابق، ص369 . كما انظر: مرتضى اللنكرودي: رسالة الإجتهاد، ضمن رسائله الثلاث، مطبعة الإسلام، قم، 1380هـ، ص9 .
[40] حسن بن زين الدين العاملي: معالم الدين وملاذ المجتهدين، اخراج وتحقيق وتعليق عبد الحسين محمد علي بقال، منشورات مكتبة الداوري، قم، ص373 .
[41] مرتضى الشيرازي: شورى الفقهاء، ايران، الطبعة الاولى، ج1، ص320-328.
[42] بالفعل ان بعض العلماء الإخباريين لجأ إلى هذا المعنى في معارضته للاتجاهين الكلامي والاصولي الذين يتقبلان الحجج العقلية. فالشيخ يوسف البحراني اعترض على مقولتهم القائلة (اذا قام الإحتمال بطل الاستدلال)، حيث اعتبره كلاماً شعرياً والزاماً جدلياً. وعلى رأيه ان بذلك ينسد باب الاستدلال، حيث لا قول الا وللقائل فيه مجال، ولا دليل الا وهو قابل للإحتمال، وبالتالي لقام العذر لمنكري النبوات فيما يقابلون به أدلة المسلمين من الإحتمالات الممكنة، وكذا منكري التوحيد وجميع أصحاب الفرق والمقالات (لاحظ: يوسف البحراني: الدرر النجفية، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ص63).
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي