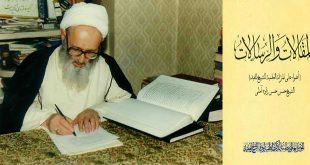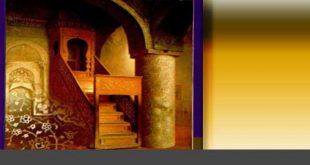الاجتهاد: الفارق بين الحق والحكم في اعتبار بعض الفقهاء أن ما يقبل النقل وغيره هو حق، وما لا يقبله هو حكم شرعي، وهذا يتوقف على تعريف كل من الحق والحكم ./بقلم آية الله الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني (ره)
إن المفاهيم التي تحكي عنها الألفاظ على أربعة أقسام:
الأول: الحقائق الخارجية التي لا دخل لاعتبار الإنسان فيها وتصويرها في الذهن، وهي بحسب النظر البرهاني عند الفلاسفة قسمان: جوهر وعرض، ويعبرون عن أقسامها بالمقولات العشر.
الثاني: المفاهيم الذهنية: أي: ما يتصوره الذهن عن تلك الأمور الخارجية والتي يعبر عنها بالوجود الذهني إذ أنه موجود في صقع الذهن انعكاساً عما هو خارج الذهن.
الثالث: المفاهيم التي لا وجود لها عيناً إلاّ بانتزاعها عما يلازمها في الخارج، ويعبر عنها بـ (المعقولات الثانية) وهي: موضوع البحث في علم المنطق، وفي قسم المباحث العامة في الفلسفة، وهذا القسم موجود في ظل وجود القسمين الأولين، بحيث لا يكاد ينكره من تصوره، وهو من الملازمات العقلية مثل: الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة، بل يسري هذا إلى جميع الأعداد من الواحد إلى ما لا نهاية، فإنها ليست موجودة في الأعيان، بل ملازمة لها عقلاً، أي: كلما عقل الإنسان تلك المفاهيم الخارجية يعقل معها هذه المفاهيم المنتزعة بالضرورة، وليس له أن يعقل ويعتبر خلافها، فليس للعقل أن يتصور الأربعة فرداً والثلاثة زوجاً.
الرابع: الاعتبارات المحضة التي لا وجود لها خارجا ولا ذهنا ولا في ظرف الملازمة، إلاّ في الاعتبار البشري، وليس لها وجود سوى هذا الاعتبار الذي يعتبره الإنسان لحاجة ماسة في اعتبارها في حياته الاجتماعية؛ وليست هي أوهاما صرفة لا واقع لها ولا فائدة فيها، بل هي موجودة في اعتبار العقلاء يرتبون عليها آثاراً شتى لا تقل عن آثار الأشياء الواقعية، وذلك مثل: الملكية والمالية للأشياء.
وهذا القسم من المفاهيم هو محور كثير من المسائل الشرعية التي تشمل المعاملات والأحكام، سواء التكليفية منها والوضعية؛ فالأحكام التكليفية الخمسة ـ وهي: الوجوب وأخواته ـ ليست سوى اعتبار الشارع شيئاً من العبادات والمعاملات واجبة أو محرمة أو غيرهما.
والأحكام الوضعية: مثل الصحة والفساد، والشرطية والسببية، والاقتضاء والمنع، إلى غيرها مما شاع في الفقه والأصول والحقوق وفي حقل الحكومة والسياسة والمعاهدات ونحوها.
ويعبر عن هذا القسم بالاعتبارات المحضة؛ فرقاً بينها وبين الثلاثة الأولى، حيث إن لها نحواً من الوجود خارجاً أو ذهناً لا يتوقف على الاعتبار.
وهذا البحث يكتمل بالتنبيه على أمور:
الأول: يجب أن يكون في الاعتبارات غرض معقول للعقلاء ينتفعون بها في حياتهم الاجتماعية، فلا اعتبار بها إلاّ في ظرف الحاجة إليها ووجود الفائدة فيها. ففي الوقت الذي كان نوع الإنسان منحصراً في آحاد معدودة، وكانت الدنيا بما فيها من الخيرات والثمرات تحت يده يأكل منها رغداً حيث يشاء، لا ينازعه فيها أحد ـ حين ذاك ـ لم يكن في اعتبار الإنسان أن شيئاً ملك أو مال له.
فلما كثرت النفوس وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وظهرت المعارضات وعمت المنازعات حول الأرض والشجر والماء والكلاء والأنعام والمتاع، حينذاك، تأتى للإنسان أن يحل المشكلة معتبراً اختصاص كل نفس بشيء منها؛ كما مست الحاجة إلى اعتبار الأسباب الناقلة للملك من نفس لأخرى مثل: البيع والإجارة والدين، والعارية، والرهن إلى كثير من أمثالها، كما شاعت التقاليد في أسباب الملك من الحيازة أو الشراء أو الإرث ونحوها.
الثاني: أن الاعتبارات في أصلها هي تقاليد بشرية مارستها الأقوام طيلة حياتها، وبنت عليها نظام معيشتها ولا يعلم لها واضع خاص، كما أنها لا توجدها حدود متميزة، وإنما هي مفاهيم مبهمة حتى عند من يعتبرها من الناس، ثم تصل النوبة إلى الرؤساء والملوك والقادة ممن له سلطان على الناس، حتى انتهى الأمر إلى الحكماء المقننين والأنبياء المرسلين، حيث حملوا على عاتقهم تتنظيم المجتمع البشري بسن قوانين وأحكام.
وينبغي أن نلتزم فيما وضعوه بشروط وحدود أكثر مما تلتزم به التقاليد العامة ولاسيما في حقل شريعة السماء؛ حذراً من اعتقاد نقص أو لغو في ما صدر عن الأنبياء عليهم السلام.
الثالث: أن كثيراً من العناوين الشرعية في غير العبادات سواء العقود والإيقاعات الأحكام كانت في الأصل تقاليد بشرية، وجاء الدين فاعتبرها وأمضاها حسب التقاليد، أو رفضها رأساً، لما رأى فيها من الفساد، أو تصرف فيها بإضافة شرط أو قيد إليها حتى بلغت إلى هذا الحد من الكمال، ربما لم يكن يصل إليه العقل البشري لولا الشريعة.
وهذا هو المراد من قولهم: (إن المعاملات إمضائيات) فليس هي من صنع الدين؛ فقد (أحل الله البيع وحرم الربا) والبيع هو البيع عند الناس والربا كذلك، فالدين إنما حرم وأحل ما شاع عند الناس ولم يخترعه، بل لا يوجد شيء من المعاملات يختص به الدين من غير أن يسبقه تقليد بشري عام أو خاص، سوى ما ندب إليه الدين مثل: القرض الحسن والهبات ونحوها؛ كما أن بعض الحقوق والأحكام في غير المعاملات كذلك ـ والظاهر أن كثيراً منها جاء به الإسلام ـ لم يسبقه سابق كأحكام الإرث الخاصة والقضاء الإسلامي إلى غيرها؛ وإن لا ننكر وجود نحو من الإرث والقضاء قبل الإسلام.
وأما العبادات؛ فقد كانت موجودة في الأديان السماوية بنفس الأسماء كما يشهد به القرآن، إلاّ أن الدين الإسلامي مع الاحتفاظ على الأسماء تدخل في كيفية العمل، فغير وبدل منها ما شاء، وحرم منها ما شاء، وربما أضاف إليها أشياء حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية مما ليست في وسع الإنسان الإحاطة به.
والظاهر أن التقاليد التي كانت متبعة في جزيرة العرب هي التي بنى عليها الإسلام نظام المعاملات، فاعتبرها إطلاقاً، أو رفضها إطلاقاً، أو قيدها بقيود وشروط، أو اعتبر ما يشابهها حتى كملت ووافقت المصلحة تماما بما يخرج تشريعها عن طاقة البشر. والتقاليد الجارية في غير الجزيرة لابد أن تطبق على ما أمضاه الشارع فيرفض ما عداها. وهذا ما قام به علماء المذاهب الفقهية في الإسلام.
وكذلك التقاليد الحادثة في عصرنا في حقل الحقوق والمعاملات مثل: التأمين واليانصيب وأحكام البنوك وغيرها ـ وهو كثير ـ لا ينبغي رفضها رأسا بحجة عدم وجودها في الفقه الإسلامي، بل يجب على الفقيه أن يزنها بميزان الفقه، وفي مثلها تظهر ثمرة فتح باب الاجتهاد، وأنه ضرورة لابد منها في الإجابة على الحوادث على نطاق جميع المذاهب الإسلاميّة، وكما تعلمون، فإن باب الاجتهاد مفتوح عند الإمامية إلى الآن في جميع الأحكام، سوى الضروريات وما اتفق عليه المسلمون، من غير أن يمنعهم تقليد سابق لمجتهد من العلماء السابقين عن إبراز رأي جديد.
الرابع: لما كانت المفاهيم الشرعية في المعاملات مأخوذة غالبا عن التقاليد العامة للناس ولم تكن واضحة ومحددة عندهم، ولا يعلم كيف اعتبرها الناس أو الشارع، فلذلك اختلفت آراء الفقهاء في تعريفها، وطال الشجار بينهم في تحديدها، فالبيع مثلا عرف تارة بـ (مبادلة مال بمال) وأخرى بـ (تبديل مال بمال) وثالثة بـ (نقل المال بعوض) ورابعة بـ (تمليك العين بعوض) ـ وهو الأشهر بين المتأخرين من فقهائنا ـ وخامسة بـ (انتقال المال بعوض) وسادسة بـ(إنشاء التمليك بعوض) وسابعة بـ(أنه عقد يقتضي بعض ما ذكر) إلى غيرها من الأقوال.
وربما يتعجب الباحث من سعة شقة الخلاف وتضارب الآراء في مثل هذا الأمر العام البين لكل رجل عامي كيف تطرق الخلاف فيه إلى هذا الحد بما عندهم من النقض والإبرام في كل واحد منها؟ فيتبادر إلى خلده بأنها تعريفات لفظية من قبيل (شرح الاسم) وينكر أن يكون هناك خلاف جوهري، وليس كذلك؛ ولو كان الأمر كما زعم فما وجه هذه الإطالة فيها بالرد والإبرام بين الأئمة الأعلام؟
بلغني أن أحد المدرسين الكبار بعد أن صرف أياماً في تحديد البيع أنشأ في ختام البحث شعر الحكيم السبزواري في تعريف الوجود:
> مفهومه من أظهر الأشياء * * * * وكنهه في غاية الخفاء
والواقع أن اختلافهم في الأغلب إنما نشأ عن جهلهم بما اعتبره العرف العام، ثم بما اعتبرته الشريعة الغراء، وليس الخلاف دائماً في (شرح الاسم) ولا هو من البحث اللفظي في شيء إلاّ القليل منها. وبعد هذه المقدمة (2) ندخل في صميم الموضوع:
الفرق بين الحق والحكم
طرح الفقهاء عندنا هذا البحث للفرق بين ما يقع من الحقوق الشرعية عوضاً أو معوضا في البيع ونحوه، وبين ما لا يقع؛ لاتفاقهم على أن ما كان حكما شرعيا لا يقبل المعاوضة عليه، وما كان حقا فهو قابل لها إلاّ ما منع منه الشرع.
وحاصل ما حققوه: أن الفرق بينهما مفهوما واضح ومصداقا صعب. بيان ذلك:
أنك تجد في أبواب الفقه حقوقا كثيرة: ففي البيع: حق القبض والإقباض، وحق الشفعة، وحق الخيار؛ وفي الأراضي: حق التحجير، وحق الشرب، وحق المرور؛ وفي الرهن: حق الرهانة؛ وفي المكان: حق السبق، فمن سبق إلى مكان من الأماكن العامة فهو أحق به؛ وفي الدين: حق الغرماء في تركة الميت؛ وفي النفس: حق القصاص؛ وفي الطفل: حق الحضانة؛ وفي الزوجة: حق القسم، وحق المضاجعة، وحق النفقة؛ وفي الوالدين والأولاد: حقوقهما؛ وفي الوالي والرعية حقهما؛ وفي أقارب الميت: حق الإرث إلى كثير من أمثالها.
فهذه الحقوق وأمثالها أي منها قابل للنقل والانتقال بعوض أو بغير عوض أو للإسقاط، وأي منها لا يقبل ذلك؟ وما هو الفارق بين القسمين في واقع الأمر؟
الفارق بينهما في اعتبار بعض الفقهاء (3) أن ما يقبل النقل وغيره هو حق، وما لا يقبله هو حكم شرعي، وهذا يتوقف على تعريف كل من الحق والحكم .
فالحق نوع من السلطنة للشخص على شيء يتعلق بعين أو بعقد. فالأول: كحق التحجير وحق الرهانة وحق الغرماء في تركة الميت، والثاني، أي: المتعلق بعقد مثل: حق الخيار وحق الشفعة، حيث إن ذا الخيار وصاحب الشفعة لهما الحق في فسخ العقد؛ لاستيفاء حقوقهما المتعلقة بالمبيع والثمن.
ومن الحقوق ما هو سلطة على شخص: كحق القصاص، وحق الحضانة، وحق القسم ونحوها، ويمكن أن يقال: إن الحق مرتبة ضعيفة من مراتب الملك أو نوع منه،وإن صاحب الحق مالك لشيء ويكون أمره إليه، كما أن مالك الشيء عيناً أو منفعة مسلط عليه ويكون أمره بيده.
فلنلاحظ حق الخيار في العقود اللازمة، حيث جعل الشرع لصاحب الخيار حقا، وحقيقته أنه جعل للمتعاقدين أو لأحدهما سلطة على العقد أو على متعلقة وحكم بأنه مالك لأمره، فله الإمضاء والفسخ، وله الرد والاسترداد.
وأما الحكم: فإنه مجرد رخصة أو إلزام في فعل شيء أو تركه، أو الحكم بترتب أثر على فعل أو ترك، وذلك مثل: الحكم بالجواز في العقود الجائزة، فإنه مجرد ترخيص من الشارع للمتعاقدين بفسخ العقد أو إبقائه، ولا تعتبر هناك سلطة جعلها الشارع لأحد الطرفين أو كليهما.
والحكم بالجواز فيها نظير الحكم بإباحة شرب الماء وأكل اللحم، ومعلوم أن مثل هذا لا يعتبر سلطة للشخص على شرب الماء وأكل اللحم، بل ليس إلاّ حكما شرعيا محضا. فلا يقال: إن الإنسان المكلف له حق في الماء واللحم بمجرد حكم الشرع بجواز الانتفاع بهما، والماء واللحم في محل البحث ليسا إلاّ أنهما وقعا موردا ومتعلقا للحكم.
وبالموازنة بين الجواز في العقود اللازمة التي فيها خيار للطرفين أو لأحدهما وبين الجواز في العقود الجائزة رأسا نستطيع أن نفهم ونعقل الفرق بين الحق والحكم ، وأن الشارع اعتبر في العقود اللازمة سلطة لذي الخيار على العقد أولا وبالذات، وعلى العوضين ثانيا وبالعرض لتعلق العقد بهما وأما في العقود الجائزة: فلم يعتبر الشارع سلطة لأحد الطرفين، سوى أنه أجاز لهم فسخ العقد، فالفارق بينهما هو كيفية اعتبار الشارع لهما، والمرجع في ذلك الأدلة الشرعية، وفي كثير من الحقوق والأحكام المرجع هو: العرف العام.
فللشارع أن يعكس الأمر ويعتبر في الحقوق اللازمة حكمه بالجواز، وفي العقود الجائزة له أن يجعل سلطة للطرفين على فسخه، ولا مانع عقلي من ذلك أصلاً، إلاّ أن المفهوم من سياق الأدلّة أو من نظر العرف هو الفرض الأول.
وحاصل الفرق: أن الشارع جعل سلطة لذي الحق في الحقوق، وحكم بحكم تكليفي في الأحكام من دون جعل سلطة فيها لأحد.
ولا ينبغي الغفلة عن نكتة وهي: أن نفس الخيار هو حق لذي الخيار، أما تشريعه من قبل الشارع فهو حكم، فإن الأحكام على قسمين: تكليفي (وهو: الأحكام الخمسة) ووضعي وهو كثير، والحكم بالخيار حكم وضعي ينتزع منه حكم تكليفي، وأما الحكم بالجواز فهو: حكم تكليفي قد ينتزع منه حكم وضعي وهذا هو الفارق بين الأمرين.
ثمرة البحث:
وأما الثمرة في هذا البحث: أن الحكم لا يقبل الانتقال قطعاً، وهذا من القضايا التي قياساتها معها؛ لأن أمر الحكم بيد الحاكم، وليس للمحكوم عليه إسقاطه ولا نقله؛ لأن المفروض أنه لم يجعل له السلطة على شيء، ولم يملكه حقا حتى يكون أمره بيده.
وإسقاط الحكم أو نقله تدخل من العبد في سلطان الرب، فكما لا يجوز أن يقول أحد؛ إن شرب الماء جائز لي فأجوزه لفلان، كذلك ليس لأحد أن يقول في عقد جائز كالهبة غير المعوضة: إنه يجوز لي الرجوع في هبتي فأجوزه لغيري، أو يقول: الرجوع جائز لي وأنا أسقطه وأحرمه على نفسي، فإن ذلك تشريع للحكم، وهو محرم كالبدعة في الدين تماما.
نعم، لو كان الحكم معلقا على موضوع وكان المكلف داخلا في ذلك الموضوع فله الخروج عنه ليرتفع الحكم، كما لو وقف الرباط على المسافرين وكان هو مسافراً ثم توطن في المحل فيسقط عنه الحكم، لكنه ليس من باب الإسقاط، بل من قبيل تبديل الموضوع وبينهما بون بعيد.
هذا شأن الحكم، وأما الحق ـ لما كانت حقيقته عبارة عن سلطة للإنسان على شيء أو على شخص فمقتضى طبيعته جواز نقله وإسقاطه، لأن المفروض: أن صاحب الحق جعل مالكا للأمر ومسلطا عليه، ومعنى ذلك: أن الأمر بيده يتصرف فيه بما يشاء ما لم يشمله منع من الدين الذي فرض له هذا الحق.
فهذا يشبه تماما ما يملكه الإنسان من الأرض والمتاع، حيث إن معنى: ملكه له أن أمره بيده، فله أن يعمل فيه بما يشاء إلاّ ما ورد النهي عنه؛ مثلاً: للإنسان أن يبيع متاعه ممن يشاء، وليس له أن يفسده أو يهدمه عبثاً؛ لأنه إسراف محرم، ولا أن يبيع مثلا ـ سيفه وسلاحه إلى المحارب للدين؛ للنهي عنه، ولأنه خسارة وضرر على الإسلام والمسلمين، أو يبيع المصحف مثلا إلى الكافر؛ للنهي عنه، ولأنه إهانة للمصحف، وله أمثله شتى.
وبالجملة: فالحق بحسب طبيعته يقبل النقل كما يقبل الإسقاط مثل: الملك تماما، فإذا شمله منع فهو لأحد أمرين.
الأول: أن الشارع الحكيم لا حظ مفسدة في النقل أو الإسقاط فحرمه كما عرفت.
الثاني: أن يكون هناك قصور في الحق بحسب جعل الشارع، مثل: أن يكون الحق متقوما بشخص خاص: كحق التولية في الوقف وحق الوصاية وحق الحضانة، فإن الواقف أو الموصي إذا كلف شخصا معينا للقيام بأمر الوقف أو العمل بالوصية ـ لما رأى فيه من الصلاح والكفاء ـ فليس لهذا الشخص أن يحوله إلى غيره، إلاّ إذا نص الواقف أو الموصي على شخص آخر فيجوز له أن يحوله إليه لا إلى غيره.
ومثله: حق الوكالة، فليس للوكيل نقله إلى غيره إلاّ بتجويز من الموكل، إما بشرطٍ في نفس العقد أو بإذن له في أثناء العمل.
ومقتضى القاعدة في جميع المناصب أن نجريها مجرى الولاية على الوقف والوصاية والوكالة: كولاية الحاكم المنصوب من قبل إمام المسلمين، فليس له أن يحولها إلى غيره إلاّ بإذن ممن نصبه.
وينبغي أن يستثنى منه ما كان من المناصب العامة لمن توفرت فيه شروط: كالإمامة على المسلمين، أو القضاء بينهم في زمانٍ لا يتمكن الناس من الاتصال بالإمام، فعند ذلك يجوز لمن تصدى لمنصب القضاء أو ولاية الناس من عند نفسه من دون نصب أحدٍ إياه حيث رأى أنه أهل لذلك، فيجوز له أن يتركها لغيره ممن توفرت فيه صفات القاضي والوالي، إلاّ أن هذا لا يعتبر نقلاً لمنصبه إلى غيره، بل يعد تركاً للعمل والتخلي عنه ليقوم به آخر مكانه بحجة أنه أيضاً أهل لذلك مثله، وأنه من مصاديق من أذن له الامام إذناً عاماً بالقضاء والإمامة.
ومثل ذلك: ما إذا نصب النبي أو إمام المسلمين رجلاً لإمارة الجيش وقال: إذا مات أو قتل فيقوم مقامه رجل من المسلمين، أو من له سابقة في قيادة الجيش، أو من اجتمع الجيش على إمارته وله نظائر لا تحصى.
ومن الحقوق التي لا تقبل النقل؛ حق المضاجعة بالنسبة إلى غير الزوج والزوجة، بل جميع حقوق الزوجين فيما بينهما من هذا القبيل، وهذا لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه مقتضى طبيعة الزواج.
ومنه؛ حق الشفعة، فيجوز إسقاطه، ولا يجوز نقله إلى غير الشريك، لأنه جعل إرفاقا بالشريكين، فليس لهما نقله لآخر.
أقسام الحقوق من حيث قبولها للنقل والإسقاط:
ثم إن الحقوق بحسب صحة النقل أو الإسقاط أو الانتقال القهري بإرث ونحوه أقسام:
فمنها: ما لا ينتقل بالموت ولا يصح إسقاطه مثل: حق الأبوة، وحق الولاية للحاكم، وحق الاستمتاع بالزوجة، وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال، وحق الوصاية ونحوها، ولا يبعد أن يكون جملة منها من الأحكام دون الحقوق.
ومنها: ما يجوز إسقاطه ولا يصح نقله ولا ينقل بالموت كحق الغيبة، أو الشتم، أو الإيذاء بإهانةٍ أو ضربٍ ونحوها، بناءً على وجوب إرضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة في سقوطها.
ومنها: ينتقل بالموت ويجوز إسقاطه ولا يصح نقله كحق الشفعة.
ومنها: ما يصح نقله و إسقاطه وينتقل بالموت إلى الوارث: كحق الخيار، وحق القصاص، وحق الرهانة، وحق التحجير، وحق الشرط ونحوها.
ومنها: ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض: كحق القسم على بعض الأقوال، والمراد به: أن ينتقل حق الزوجة إلى ضرتها بأن تعوضها بمال، فقد جوزه بعضهم بلا عوض وبعضهم بعوض أيضاً، وكذلك لو عوضها الزوج بمال لتتخلى عن حقها.
ومنها: ما هو محل الشك، وعد منه حق الرجوع في العدة الرجعية، وحق النفقة في الأقارب: كالأبوين والأولاد، وحق فسخ النكاح بالعيوب، وحق السبق في إمامة الجماعة، وحق المطالبة في القرض والوديعة أو العارية، وحق العزل في الوكالة، وحق الرجوع في الهبة، وحق الفسخ في العقود الجائزة كالشركة والعارية ونحوهما. والحق أن كثيراً منها من قبيل الأحكام دون الحقوق.
طريق العلاج في موضع الشك:
قد سبق أن الفرق بين الحق والحكم بحسب المصاديق والصغريات صعب جداً، لان ما فرقنا به بين الأمرين يرجع إلى كيفية اعتبارها حقاً أو حكماً، وكلاهما محتمل في مورد الاشتباه، وأن المرجع فيها العرف العام، ثم نصوص الكتاب والسنة، وكثيراً ما لا يتبين الأمر بذلك، فما هو العلاج؟
فنقول: إذا علمنا من الشرع أنه جوز النقل أو الانتقال في مورد فنحكم بأنه حق يترتب عليه آثاره، إلاّ ما ثبت خلافه؛ إما بمنع شرعي، أو بما اقتضته طبيعة الحق: كالولايات والوصايا وتولية الأوقاف، وحقوق الزوجين والآباء والأمهات مما تقدم الكلام فيها.
وإذا لم يثبت ذلك فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصل، وهو مختلف بحسب الآثار، فلو شك في جواز النقل أو الإسقاط فالأصل عدمهما؛ لأنهما مسبوقان بالعدم والشك في وجودهما، فالأصل العدم. ولو كان للحكم أثر وجودي فالأصل العدم أيضاً.
وبالجملة: لو شك في كون شيءٍ حقاً أو حكماً فلا يجوز إسقاطه ولا نقله؛ لاحتمال كونه حكماً، وإن علم كونه حقاً وعلم المنع من نقله أو كونه قائماً بشخص أو عنوان خاص فكذلك لا يجوز نقله، وإن شك في المنع فمقتضى العمومات صحة التصرف فيه؛ وكذا لو شك في قيامه بالشخص أو عنوان خاص شرعاً بعد إحراز القابلية للنقل عرفاً فمقتضى عموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود( (4) ( وأحل الله البيع( (5) وقوله عليه السلام: (الصلح جائز بين المسلمين) و(والمؤمنون عند شروطهم) و(الناس مسلطون على أموالهم) ونحوها صحة التصرف فيه بعد فرض أن عناوينها صادقة عليها نعم، لو شك في إحراز القابلية عرفاً فلا يجوز التمسك بالعمومات، والكلام في هذا طويل وعميق فلنضرب عنه صفحاً.
والحق أنه يجب الرجوع في كل مورد إلى بابه من الفقه قبل ان ندرجه تحت القاعدة التي أسست للفرق بين الحق والحكم.
وفي الختام: عن لي بمناسبة البحث عن الاعتباريات في الفقه أن أحكي لكم أيها الكرام كلاماً بنصه للمغفور له العلامة الكبير الامام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في مقدمة كتابه (تحرير المجلة) (6) أي: مجلة العدل، قال رحمه الله:
إن مدار القعود والمعاملات على الأموال، وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر الأعيان تتمحض في المالية تمحض سائر الأنواع في حقائقها النوعية، وإنما هو: حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات الخارجية التي تتقوم بها معايشهم، وتسد بها حاجاتهم الضرورية والكمالية، فمثلاً؛ الحبوب والأطعمة مال؛ لأن البشر محتاج إليها في أقواته وحياته، وهكذا كل ما كان مثل ذا من حاجات الملابس والمساكن ونحوها قد انتزع العقلاء منها معنى وصفياً عرضيً يعبر عنه بـ (المال) وهو: من المعقولات الثانوية باصطلاح الحكيم (7).
ولما كانت مدنية الإنسان لا تتم إلاّ بالحياة المشتركة وهي تحتاج إلى المقايضة والتبادل في الأعيان والمنافع وكان التقايض بتلك الأعيان ـ وهي العروض ـ مما لا ينضبط أرادوا جعل معيار يرجع إليه في المعاملات، ويكون هو المرجع الأعلى والوحدة المقياسية، فاختاروا الذهب والفضة، وضربت سكة السلطان عليها لمزيد الاعتبار في أن يكون عليهما المدار، فما ليتهما أمر اعتباري محض، لا فرق بينهما وبين سائر المعادن وغيرها من حيث الذات والحقيقة؛ ولذا في هذه العصور حاول بعض الدول قلب الاعتبار إلى الورق، ولكن مع الاعتماد عليهما.
ومهما يكن الأمر: فإن المال لما كانت حقيقته تقوم على الاعتبار فكما اعتبروا الأجناس الخارجية مالا فكذلك اعتبروا ذمة الرجل العاقل الرشيد مالاً، ولكن مع
الالتزام والتعهد، فإذا التزم الثقة الأمين بمالٍ في ذمته وثقت به وجعلته كمالٍ في يدك أو صندوقك، وكذا العقلاء: يعتبرون أن لك مالاً عنده، أما من لا عهدة له ولا ذمّة: كالسفيه والمجنون والصغير، بل والسفلة من الناس الذين لا قيمة لأنفسهم عندهم الذي يعدك ويخلف ويحدثك فيكذب ويلتزم لك ولا يفي بالتزامه فهؤلاء لا ذمّة لهم ولا شرف، والتزامهم عند العقلاء هباء، ولا يتكون من التزامهم عند العرف مال.
فالمال إذاً نوعان: خارجي عيني (وهو: النقود والعروض) ـ وقد علمنا أن ماليتها اعتبارية ـ واعتباري فرضي (وهو: ما في الذمم والعهدة)، والالتزام تأثيره لا ينحصر بالمال، بل يتمطى ويتسع حتى يحتضن جميع العقود بل وكافة الإيقاعات، ألا ترى أن البيع إذا صهره التمحيص لم تجد خلاصته إلاّ تعهداً والتزاماً بأن يكون مالك للمشتري عوض ماله الذي التزم أنه لك، فيترتب على هذا الالتزام مبادلة في المآلين بانتقال مال كل واحدٍ إلى الآخر، ويتحقق النقل والانتقال كأثرٍ لذلك الالتزام.
وهكذا الإجارة والجعالة، بل والإيقاع: كالعتق والإبراء، بل والنكاح والطلاق كلها تعهدات والتزامات وإبرام ونقض وحل وعقد تباني عقلاء البشر من جميع الأمم والعناصر على اتباعها، والعمل بها كقوانين لازمةٍ ودساتير حاسمةٍ يسقط عن درجة الإنسانية من لا يلتزم بها في كل عرفٍ ولغة.
ثم لما انبثق نور الإسلام بشريعته الغراء أكدت وأيدت تلك الوضعية الحكيمة والقاعدة القويمة، وأقرت العرف على معاملاتهم والتزاماتهم بتعهداتهم والتزاماتهم بعمومات (أوفوا بالعقود) و(تجارة عن تراضٍ) ونظائرها، إلاّ ما ورد عنه النهي بالخصوص: كبيع الربا وبيع الضرر وأمثاله…) إلى آخر كلامه أعلى الله مقامه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
________________________
1 ـ بحث طرحه في ندوة (الحقوق في الإسلام) المنعقدة في الأردن.
2 ـ تلخيص من رسالة لي باسم (المعيار في الحدود الفقهية) ألفته حين حضوري درس الأستاذ الأكبر فقيد الإسلام السيد محمد الحجة الكوهكمري في قم بلد العلم والإيمان الذي تكونت بها الثورة الإسلاميّة في إيران بقيادة زعيمها الامام الخميني رحمه الله.
3 ـ هو العلامة الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأنصاري: ص 55.
4 ـ المائدة: 1.
5 ـ البقرة: 275.
6 ـ طهران عام 1359 هـ ص 8.
7 ـ قد ظهر في أول المقال أن هذا القسم اعتباري صرف، وليس انتزاعياً، ولا من المعقولات الثانية، وأن المعقولات الثانية هي الملازمات العقلية للحقائق الخارجية المنتزعة عنها عقلاً، وليست باعتبارية.
المصدر: مؤسسة الصدرين للدراسات الإستراتيجية
#الحق والحكم
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي