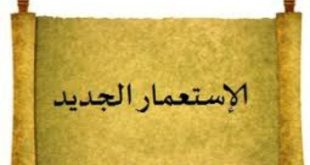الاجتهاد: إن الاهتمام بحقوق الإنسان يعود في جذوره إلى موضوع تحقيق العدالة، وأهمية قيمة العدالة في إعلاء كرامة الإنسان، وتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي، والسعي إلى عمارة الأرض، إلا أن موضوع حقوق الإنسان يدفعنا لطرح مجموعة تساؤلات مهمة من وجهة نظري وأهمها:
1. ما هو منشأ هذه الحقوق والواجبات، ومرجعيتها المعيارية؟
2. ما هي علاقة حقوق الفرد بحقوق الجماعة وبالتالي أيضا واجبات الفرد والجماعة؟
وقبل الإجابة على هذه التساؤلات نقف قليلا مع توضيح بعض المصطلحات المهمة.
مفردة الحق:
المستفاد من معنى كلمة الحق في دائرة الحقوق مفهوم اعتباري كحق الرجل وحق المرأة، والمقصود من اعتبارية المفهوم هو أنه ليس له عين خارجية، ويطرح فقط فيما يرتبط بالأفعال الإرادية لأفراد الإنسان، فعلى الإنسان الحر والمختار أن يقوم بمجموعة من الأعمال ويحترز من مجموعة أخرى، وفي إطار (ما ينبغي وما لا ينبغي) الحاكم على سلوك الإنسان تتولد مفاهيم نظير ” الحق” و ” التكليف”. والحق هو أمر اعتباري يجعل لشخص(له) وآخر(عليه).
ولكن يكمن الخلاف الجوهري بين الباحثين الحقوقيين في كون هل الحقوق خطاب إرشادي إمضائي، بمعنى أن الحقوق أمرا كان متداولا بين العقلاء بحسب سيرتهم وقامت الشريعة المقدسة بإمضائه، أم أنه خطابا تأسيسيا مولويا أحدثه الشارع المقدس (الشريعة الإسلامية) ولم يكن متداولا بين العقلاء لولا أمر الشريعة به؟
(إن أفضل ما يعبر عن الإجابة على هذا التساؤل هو أن” الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية” .
بمعنى أن التكاليف (ما ينبغي وما لا ينبغي) والتي تنظم الحياة الإنسانية، والتي وضعت من قبل الله تعالى في الشريعة الإسلامية ألطاف بحق عباده لكي يتعرفوا على واجباتهم العقلية.) ففي إطار الشريعة نفسها، فإن ماهيّة الحقوق والتكاليف كلّها ليست ناشئة من الشّريعة بشكل محض، إذ أن طائفة منها لها وجود في الواقع، وما وضع التّنازع لها وجعلها نصّا شرعيّا إلا من قبيل ضمان استقامتها. فبعض هذه الحقوق يمكن معرفته عن طريق الوجدان والعقل، وبعضها الآخر تنحصر طرق معرفته ببيان النص الموضّح لوجود المصالح والمفاسد الواقعيّة، وهذا هو طريق لِفَهْم حقوق الإنسان وتكاليفه الواقعيّة .
فالحقوق ليست مجرّد اعتبار تشريعي، بل هناك سلسة أسس ومعايير أعلى من القوانين الوضعيّة، وهي لا تأخذ مشروعيتّها من القانون، وإنما هي ميزان حقّانيّة القانون وقبوله، يعني أن مشروعيّة عمل المُقَنّن رهن بمدى انسجامه مع هذه الحقوق. فوجود العدالة والحقوق متقدّم على وضع أي قانون في الدنيا، ولا يمكن تغيير ماهيّة العدالة وحقوق الإنسان بالقانون. وهذا يجيب على سؤال ما هو منشأ هذه الحقوق ومرجعيتها المعيارية كإجابة أولية عامة.
ويرى الدكتور مرتضى مطهري (١٩١٩م – ١٩٧٩م) أن للحق وفق هذا المعنى خصوصيات يمكن تعريفه بها تمييزا له مما يقرب منه في المعنى، كالحكم والملك والتكليف مثل:
1. إن الحق أمر اعتباري، ومرتبط بظرف عمل الإنسان، واعتباره كأي اعتبار آخر كالملكية مثلا، يظهر في أن منشأ الاعتبار ليس له وجود حقيقي، ولا تترتب الآثار المقصودة منه ترتبا كونيا.
2. والحق يكون للشخص بخلاف التكليف (الواجب) يكون عليه، وتلاحظ في الحق الحاجات والرغبات البشرية، ما يجعله نوعا من الرفق بالشخص وامتيازا له.
3. يتعلّق الحق بالفعل، بخلاف الملك الذي يتعلق بالعين. فالحق ليس مجرد إباحة شرعية، بل هو صلاحية قانونية ترتبط بأعمال تترتب عليها نتائج معينة أو تزال بها النتائج الأوليّة لعمل ما.
4. زمام أمر الحق بيد صاحبه، فيقبل الاسقاط أو الاعراض، كما يقبل النّقل والانتقال، ولا يحق لأحد سلبه.
5. التمتع بالحق غير مربوط بالقدرة والتّمكّن، بخلاف التكليف (الواجب) الذي هو مربوط بهما. وعليه، حق الأفراد العاجزين ولم يولد بعد يبقى محفوظا.
ومن المهم أن نشير إلى نقطة مهمة في موضوع شمولية حقوق الإنسان وعالميتها في التنظير الإسلامي، وهي أن حقوق الإنسان بلحاظ طبيعتها الإنسانية، لا يمكن أن تتغير من زمن إلى زمن أو من منطقة إلى أخري، فمستوى حقوق الإنسان من الناحية القانونية أرفع من مستوى القوانين التي تتحرك من زمن إلى زمن أو مكان إلى آخر، فحقوق الإنسان هي أساس التقنينات وليس العكس. أي أن المرجعية للتقنين هي الانطلاق من فهم منظومة حقوق الإنسان، وعلى ضوئها يتم تقنين القوانين التي تخدم وتحفظ هذه الحقوق.
وتكمن أهمية موضوع الحقوق الإنسانية والواجبات، وتوفير سبل العيش الكريمة في بعديهما المادي والمعنوي، في أنهما المقدمة الضرورية لتحقيق الكرامة واحترام الذات، أيضا في كلا البعدين المادي والمعنوي.
من وجهة نظري هناك دعامات أساسية ومحورية تعتبر العامود الفقري لحقوق الإنسان، والعمل على ترسية هذه الدعامات وتثبيتها وتحقيقها، يؤدي تباعا لازما لقيامة باقي الحقوق، وما أعنيه تبعية لازمة، هو أن تحقق هذه الدعامات الأساسية التي تعتبر كالهيكل العظمي الأساسي لموضوع الحقوق، هو المقدمة الضرورية التي ما إن تتحقق ستتداعى باقي الحقوق بشكل حتمي لارتباطها بها ارتباطا عضويا تابعا
وهذه الدعامات هي:
1. الحرية؛
2. العدالة؛
3. الكرامة.
وسأركز في هذه الدراسة على مفهوم الحرية لأنه البوابة الرئيسية والأداتية لتحقيق القيم الفوقية الغائية، وإصلاح المقدمات هو تمهيد لسلامة النتائج.
أما العدالة والكرامة فقد تناولت المفهومين – وخاصة الأول – بإسهاب في كتاب عقلنة الثورة وتأصيل النهضة، فليراجع.
الحرية:
الحرية هي تجربة نفسية تبدأ من اللحظة التي تدرك فيها الذات الإنسانية وجودها، فهي تشكل جوهر التجربة الإنسانية. ولكن العقل الإنساني لا يكتفي بهذا الشعور وهذه الحقيقة. فمنذ اللحظة الأولى التي يشعر فيها الإنسان بأنه حر يتبادر إلى ذهنه عدد من التساؤلات والأفكار مثل: الصدفة والضرورة والقضاء والله والمصير وحتمية قوانين المادة، إلخ.. مما يجعله يعيد التفكير متسائلا ” هل حقا أنا حر؟”
فالحرية كتعريف لغوي كما ورد في معجم المعاني الجامع: هي الحالة التي يكون عليها الكائن الحي غير خاضع لقهر أو قيد أو غلبة، ويتصرف طبقا لإرادته وطبيعته، خلاف العبودية، فهو يمتلك القدرة على التصرف بملء إرادته واختياره.
أما الحرية في الفقه الإسلامي: المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء، تمكينا لهم من التصرف على خيرة من أمرهم دون الإضرار بالغير، واستند هذه التعريف على قاعدة فقهية تقول: ” الأصل في الأشياء الإباحة”.
إيمانويل كانط (١٧٢٤م – ١٨٠٤م) يعتبر أن “الحرية هي الاستقلال عن كل شيء سوى القانون الأخلاقي”، وأرسطو (٣٨٤ ق.م – ٣٢٢ ق.م) أكد على أن “الحرية تعني قبول قوانين الدول المختلفة التي تحكم بالتناوب”.
“أما الامام روح الله الخميني (١٩٠٢م – ١٩٨٩م) فقط توسع بالحرية إلى مجال من عدم التدخل وله حدان:
أولا: عدم الاخلال بالأصول الدينية؛
ثانيا: عدم الاخلال في شؤون الدولة والمؤسسات المدنية”
والقوانين المدنية الحاضرة لما وضعت بناء أحكامها على أساس التمتع المادي، أنتج ذلك حرية الأمة في أمر المعارف الاصلية الدينية من حيث الالتزام بها وبلوازمها (أي أن الأمة لها حرية الاختيار في الالتزام بالدين من عدمه) وفي أمر الاخلاق وفي ما وراء القوانين من كل ما يريده ويختاره الإنسان من الإرادات والاعمال، فهذا المراد بالحرية عندهم، أما الحرية في الإسلام فقد وضع قانونه على أساس التوحيد ثم في المرتبة التالية على أساس الأخلاق الفاضلة، فلا شيء مما يتعلق بالإنسان أو يتعلق به الإنسان إلا وللشرع الإسلامي فيه قدم او أثر قدم، فلا مجال ولا مظهر للحرية بالمعنى المتقدم .
ويقول السيد محمد باقر الصدر (١٩٣٥م – ١٩٨٠م) في كتابه بحوث إسلامية: الحرية الرحيبة في الإسلام تبدأ من العبودية المخلصة لله تعالى، لتنتهي إلى التحرر من كل أشكال العبودية المهينة، حيث يجعل الإسلام علاقة الإنسان بربه الأساس المتين الثابت لتحرره في علاقاته مع سائر الناس ومع كل أشياء الكون والطبيعة.
ويذكر الشيخ جعفر السبحاني أن جوهر الحياة الإنسانية يكمن في حفظ الكرامة والعزة، لهذا منع الإسلام من أي عمل يضر بهذه الموهبة وبعبارة أكثر وضوحا إن أي نوع من التسلط على الآخرين، وكذا قبول السلطة من الآخرين ممنوع من وجهة نظر الإسلام منعا باتا، فلا بد أن يعيش المرء حراًّ كريماً بعيداً عن أي شكل من أشكال الصغار والذل”
ويؤكد السيد محمد باقر الصدر في بحوث إسلامية “أن الحرية في الحضارة الغربية، هي حرية مادية اكتفت بمنح الإنسان الحرية الظاهرية في سلوكه العملي المتمثل بحرية آلة الجسد للقيام بكل ما تأمر به الغرائز الحاكمة عليه، والشهوات المسيطرة على إرادة إنسان هذا الجسد، ولقد قامت الحضارة الغربية بتوفير كل الإمكانيات والمغريات للاستجابة لهذه الشهوات الغرائزية، مما أدى أن تقضي هذه الحضارة تدريجيا على حرية الفرد الإنسانية، في قبال حرية شهواته الحيوانية الكائنة في أعماقه.
ولذلك أصبح هذا الفرد أداة تنفيذ لشهواته وأصبح مملوكا لشهواته وغرائزه منقادا لها ليس له إرادة في قبال هذه الشهوات. فسلبت منه العنصر الفعال في حريته الفطرية والتكوينية وهي الإرادة الباعثة للعمل المتوافق مع مركز وعيه المتمثل بالعقل، وعلى أثر ذلك تم تعطيل العقل الموجه للإرادة الحرة للإنسان واستعباد الشهوة الغرائزية لهذا العقل لتعطل الإرادة العاقلة المؤسسة لحريته وكرامته ليتم استعباده من مركز الشهوة ليصبح مملوكا لذاته ورغباته وشهواته مسلوبا للإرادة بالكلية.
ويرى الإسلام أن الحرية على هذا الأساس، أمر يستوجب نوعا من التكامل الإنساني، فالحرية في هذا المنظار حق إنساني ومطلب ناتج عن القابليات والطاقات الإنسانية؛ وتحرر هذه القابليات والميول العالية عن أي مانع أو تزاحم، نابع عن تكامله وسيره في هذا الطريق. ولقد بيّن الإسلام مسألة الحرية في قالب التوحيد، وأن تقيّد الإنسان والتزامه وطاعته لأوامر الله بيان لأسلوب تكامل الإنسان ودعوته إلى نفي مطلق الطاعة لغير الله، بأي نحو، وبأي وسيلة كانت، فالموحّد الحقيقي هو الإنسان الحرّ الذي لا يخضع لأي حكم وسلطة .
وعلى مر التاريخ وفي جميع الأديان السماوية كان دأب الأنبياء والمرسلين هو تحرير الإنسان من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، ومن عهودهم للعباد إلى عهودهم لله، ومن طاعة العباد إلى طاعة الخالق، ومن ولاية عباده إلي ولايته عز وجل.
فالحرية في الإسلام لا تنفك البتّة عن تعهد الإنسان أمام الله وحده، والتزامه بولاية الله والتسليم لما أرسله من قوانين وتشريعات وأحكام.
فالغرب ركز على التحرير الظاهر الجسدي المادي، في قبال رق أبدي للروح والمحتوى الداخلي للإنسان للشهوات والغرائز دون أدنى إرادة أمامها فسلب حريتها.
والحرية ذات أصلين:
1. فطري موجود بالقوة في كل البشر؛
2. كسبي، بمعنى يكتسبه الفرد كل حسب وعيه لذاته، ووعيه لواقعه المحيط ولدوره ووظيفته، وسعيه الدؤوب نحو الحرية.
وللحرية بعدان:
1. البعد التكويني والذي يطلق عليه (الحرية التكوينية والتي تعني أن الإنسان بحسب خلقته موجود ذو إرادة له أن يختار لنفسه ما يشاء من الفعل ويترك ما يشاء باختياره فهو مطلق العنان إلى الفعل والترك بحسب الفطرة غير مقيد بشيء) .ولقد نظمت هذه الإرادة أو هذه الحرية التكوينية؛
2. بالبعد الثاني وهو الحرية التشريعية” التي حررت السلوك العملي للفرد من عبودية الشهوات أو عبودية الأصنام، حيث ليس لأحد من بني نوعه أن يستعلي عليه فيستعبده ويتملك إرادته، والإسلام يسمح بحال التصرف للفرد كما يشاء على ألا يخرج عن حدود الله. فيضع الكون جميعا بأسره تحت تصرف الإنسان وحريته، ولكنها حرية محدودة بالحدود التي تجعلها مع تحرره الداخلي من عبودية الشهوة والالتصاق بالأرض في عبادة الأصنام، والتخلي عن الرسالة الحقيقة الكبرى للإنسان في الحياة، فهذا مالا يأذن به الإسلام لأنه تحطيم لأعمق معاني الحرية في الإنسان .
وكذلك للحرية أوجه مهمة يتكامل بعضها مع بعض، ويضبط أحدها الآخر لعدم السقوط بين فكّي الإفراط والتفريط:
1. وجه مادي متعلق بحرية الجسد؛
2. وجه معنوي متعلق بحرية العقل والإرادة والاختيار.
3. والحرية بوجهها المادي يتم ضبطه بالوجه المعنوي، لذلك نستطيع القول إن جذر الحرية يكمن في تحرر العقل والروح من الاستعباد، لأي وجه من وجوه الاستعباد خاصة المادية والغرائزية منها.
لذلك نجد أن الوجه المادي للحرية لابد أن يخضع للوجه المعنوي، وهذا يتطلب التربية على الحرية وفي ذات الوقت على المسؤولية، فمفهوم الحرية يستدعي معه مفهوم المسؤولية، فحس المسؤولية أحد أهم الضوابط التي تضبط إيقاع الحرية بوجهها المادي.
والحرية كممارسة، ليست خطابا يُلقَى، أو ادعاء يُدّعى، وإنما هي إرادة إنسانية صلبة تتجه نحو التمسك بالحرية ومقتضياتها، وحيث تتوفر الإرادة الإنسانية المتجهة صوب الحرية، تتحقق بذات القدر حقائق الحرية. فحجر الزاوية في مشروع ممارسة الحرية، هو الإرادة الإنسانية. من هنا ينبغي الاهتمام بمفهوم “التربية على الحرية”، إذ أن المهمة العامة الملقاة على كاهل جميع النخب هي تربية شرائح المجتمع المختلفة على الحرية.
والتربية على الحرية تحتاج إلى:
1. استعداد نفسي تام للقبول بكل مقتضيات الحرية؛
2. الاطلاع والتواصل الثقافي مع المنجز الثقافي الإنساني الذي يؤسس لخيار الحرية، يبلور مضامينها؛
3. الموازنة الواعية بين ثقافة الطاعة وثقافة المسؤولية.
هذا يدفعنا لطرح التساؤل التالي:
ما هي علاقة الحرية كمفهوم بالاعتقاد أو بالعقيدة، وهنا لا أعني حرية الاعتقاد، بل أعني دور العقيدة والاعتقاد في توجيه مفهوم الحرية ورسم دلالاته وتطبيقاته؟
الاعتقاد والحرية:
تكمن أهمية الاعتقاد في عدة أمور:
1. دور الاعتقاد في تشكيل الأفكار والمنظومة الفكرية للإنسان؛
2. تأثر الاعتقاد عند تشكيله في الذهن بسلسة معقدة من العوامل، كالخبرات والاعتقادات المسبقة، والرغبات، والميول، والانفعالات.
3. خطورة عدم استيفاء الاعتقاد شروط الصحة، بالتالي تأثيره على سلوك الفرد وانعكاس هذا السلوك على المجتمع، أي الضرر الناتج عن الاعتقادات التي لا تستوفي شروط الصحة المنطقية، سواء على مستوى المجتمع أو الفرد، واليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي يتعدى الضرر المجتمع الواحد إلى عدة مجتمعات.
ويجب أن نميز بين أمرين مهمين:
الأمر الأول: تارة نحن نتحدث عن الاعتقاد كأمر “داخلي قلبي” لا يترتب عليه أثرا عمليا في الخارج، وهذا الشكل من الاعتقادات ليس داخلا في موضوع الحقوق، ولا يترتب عليه الأثر القانوني.
الأمر الثاني: تارة نحن نتكلم عن الاعتقاد بما هو “سلوك اجتماعي”، يترتب عليه أثرا عمليا في الخارج، وهذا الشكل من الاعتقادات هو داخل في دائرة الحقوق، وخاضع لما يسمى “القوانين الحقوقية” التي توضع لتنظيم العلاقات الاجتماعية.
فالأمور التي لها صبغة فردية وشخصية محضة وتقع ضمن المجال الخاص للأفراد، ليس لها ارتباط بالحقوق، وإنما تقع ضمن مجال الأخلاق، ومن الممكن أن تتعلق بها الأوامر والنواهي الأخلاقية القيمية، لكن القانون الحقوقي لا يوضع في مجالها .
إضافة إلى ذلك تارة نتحدث عن الاعتقاد بمنهج وصفي، وتارة بمنهج معياري، فالأول هو التعرف على الموضوع محل البحث “الاعتقاد”، ووضعه في إطاره الصحيح، وتفسير جميع الظروف المحيطة به، ثم الوصول إلى النتائج المتعلقة بموضوع البحث وهنا الموضوع هو الاعتقاد، إذا هنا نحاول فهم مبررات الاعتقاد، والمؤثرات التي ساقت هذا الاعتقاد، والظروف المحيطة ودراستها لفهم الأسباب والطرق والوصول إلى نتائج، فهو يبدأ من الجزئيات لينتهي بالكليات. بينما المنهج المعياري يبدأ من الكليات وينتهي إلى الجزئيات، فهو منهج قائم على وضع معايير وقواعد حول كيف يجب أن نعتقد، وما هي معايير الاعتقاد السليم، وما هي القواعد الكلية للاعتقاد السليم، فهو ينأى عن الوصف، ويهتم بوضع الأسس والقواعد والمعايير الكلية حول موضوع البحث.
وموضوع الاعتقاد وأثره في تشكيل مفهوم الحرية يتطلب الاستعانة بالمنهجين المعياري والوصفي، فوجود معايير وقواعد لتشكيل المعتقد بشكل سليم، ومقارنة تلك الكليات المعيارية والقواعد مع ما هو موجود من خلال اتباع المنهج الوصفي في فهم كيفية تشكل الاعتقادات الراهنة في كل مجتمع، وما هي المؤثرات التي أثرت في تشكل تلك الاعتقادات، وما هي المرجعيات المعرفية التي أثرت في تشكيل الاعتقادات، تعتبر من المسائل المهمة في فهم آليات تشكل مفهوم الحرية ودلالاته في كل بيئة ومدرسة فكرية ومعرفية، وأثر ذلك على عولمة ذلك المفهوم، ومحاولة فرض هذه المدرسة لفهمها الخاص على باقي المدارس التي تختلف معها في مصادر المعرفة، وفي القواعد الكلية والمعيارية في تشكيل المعتقد، وبالتالي تشكيل مفهوم الحرية ودلالاته وتطبيقاته، وتقنين القوانين الناظمة بناء على ذلك.
ومفهوم الحرية: تارة نتحدث عن حرية الفرد في الاعتقاد الداخلي القلبي، وهذا ليس مورد بحثنا كونه لا يخضع هنا لموضوع الحقوق، فالإنسان تكوينيا حر في اعتقاداته الداخلية القلبية، وتارة نتحدث عن مفهوم الحرية على مستوى السلوك الاجتماعي، ودور الاعتقادات التي تشكل هذا المفهوم في الخارج من حيث ما يترتب عليه من تشريع قوانين، أو عن حرية تعبير تترتب عليها تداعيات اجتماعية سلبية أو إيجابية، وكل ما يتعلق بمفهوم الحرية على مستوى السلوك الاجتماعي، فهو محل بحث موضوع الحقوق والقوانين الحقوقية.
وقد ذكر وليم كليفورد في مقالته الموسومة “بأخلاقيات الاعتقاد” أن اعتقاد الإنسان الفرد ليس أمرا خاصا به يهمه وحده، بل إن حياتنا مسيّرة من قبل ذلك التصور الكُلّي لسلسلة الأحداث التي تشكّلت بواسطة المجتمع لأهداف اجتماعية. إن ألفاظنا – كما يقول كليفورد – وقوالبنا وعمليّاتنا، وطريقة تفكيرنا هي ملكٌ عام، تم تطريزه وضبطه من عصر إلى عصر، وكأنه ملكٌ متوارثٌ ترثه الأجيال المُتعاقِبة كوديعة ثمينة ووثيقة مقدّسة يُسَلّمْه كل جيل لمن يليه، ليس غير متغيّر، بل متوسّع ومُنَقّى، مع بعض العلامات الواضحة للعمل اليدوي المتقن الذي أُجْرِىَ عليه .
فاعتقاد الشخص ليس شأنا شخصيا يتعلق بالفرد وحده، بل ينعكس تأثيرا على أفراد المجتمع كافة، ومن جيل إلى جيل، فاعتقادات السابقين تراكمت وتدحرجت من جيل إلي جيل، وكل جيل كان له بصمته الخاصة، حتى وصلت إلينا تلك الاعتقادات وأثرت فينا، وبالتالي أثرت في القوانين والتشريعات والحقوق، وفي استقرار المجتمعات من عدمه، لذلك موضوع الاعتقاد موضوع بالغ الأهمية والخطورة.
ولأهمية الاعتقاد بلحاظ الدور الذي يلعبه عند إصدار القرارات، أو على باقي الاعتقادات، لذا لا يمكن أن نتعامل بلا مبالاة تجاه أي اعتقاد، لأن مصير البشرية مرهون بترشيد اعتقادات البشر. فالاعتقاد ليس ملكنا، بل ملك البشرية فهو كيان مقدس له أهمية ذاتية من ناحية، وأهمية بلحاظ الدور الدي يلعبه من ناحية أخرى.
لذلك أي اعتقاد يشكل المفاهيم الكلية التي تؤثر على الواقع الخارجي والسلوك الاجتماعي والتقنين والتشريع، وتلعب دور وظيفي محوري في رسم الخطوط العامة والعريضة التي تنظم سلوك البشر، فلا بد لهذا الاعتقاد أن يُبنى على أسس سليمة منطقية غير خاضعة للتحيزات والانفعالات والتبعيات من جهة، ومن جهة أخرى يأخذ في حسبانه قاعدة الاحتمال وليس قاعدة القطع واليقين، بمعنى أن يبقي باب الاحتمال بنسب وإن صغيرة مفتوح في كون اعتقاده يشوبه خلل وليس قطعيا، وكون اعتقادات الآخرين المختلفين أيضا قد تكون صحيحة وصادقة، فيحترمها ولا يفرض اعتقاداته حول المفاهيم على الآخرين كأنها مقدسا لا يمكن المساس به أو نقضه.
إن التسرع والانفعال في قبول الاعتقادات التي تشكل المفاهيم، لن يحقق النهضة في مسار الانسان، بل قد يحقق تدميرا منهجيا تتحمله الأجيال اللاحقة، فقد أتبنى كفرد أو كمجتمع أو كدولة اعتقادا يشكل لي مفهوم الحرية على سبيل المثال، وتقنن على ضوء هذا الاعتقاد قوانين، قد يعيش الجيل المعاصر لهذه القوانين الجانب الإيجابي الآني اللحظي لها، ولكن على المدى البعيد الطويل تبدأ إرهاصات هذه القوانين النابعة من تلك الاعتقادات التي شكلت مفهوم الحرية، تبدأ بالظهور ليتحمل تبعاتها الأجيال اللاحقة التي لم يكن لها دوراً في تشكيل تلك المعتقدات.
ومسؤولية التحقق من الأمور قبل الاعتقاد ليست واجبة من الناحية الأخلاقية فقط على النخب والمثقفين والقيادات، بل هي واجبة على كل إنسان عاقل كل وفق قابليته وسعته وقدراته وما يتاح له من مُكْنة عملية في هذا الصدد. فالقابليات متفاوتة والقدرات كذلك، فلا نستطيع تحميل كل فرد ذات المسؤولية الأخلاقية في وجوب التحقق أخلاقيا، بل يمكننا التشجيع على ذلك كل وفق قدرته وقابليته وسعة إدراكه ووعيه، وكل وفق وظيفته.
فالاعتقادات إن كانت مرتكزة على أسس واهية، تعطي المرء شعورا بالقوة، لأنها توهمه بمعرفة الواقع على ما هو عليه. هذه القوة الواهمة تتحول في كثير من الأحيان إلى قوة تدميرية، قد يدفع الفرد والمجتمع ويبذل في سبيلها كل ما يملك حتي قد يبذل البعض حيواتهم في سبل هذه الاعتقادات، وهذا ما لمسناه في راهننا في كثير من المواضيع سواء الدينية أو غير الدينية، فالدينية كان لدينا نموذج داعش، وغير الدينية كان لدينا نموذج الدفاع المستميت عن حقوق الشاذين جنسيا باسم المثليين، وتداعيات هذا الدفاع علي النواة التأسيسية للمجتمع وهي الأسرة، وعلى تركيبة المجتمع واختلاط الأنساب وغيرها من القضايا التي يعاني منها المجتمعات، وسيعاني منها الأجيال في حال لم يتم إعادة النظر فيها على أسس منطقية استراتيجية مكينة علميا ومنهجيا ومنطقيا.
الاعتقاد ودوره في تشكيل مفهوم الحرية:
بعد هذه المقدمة الموجزة جدا، أود أن أميز بين مفهومين مهمين يؤثر أحدهما في الاخر ويسبق أحدهما الآخر سبقا رتبيا منطقيا، وهما مفهومي: المعرفة والاعتقاد.
فالمعرفة تتعلق بانطباق المفهوم الذهني على الواقع الخارجي انطباقا صادقا منطقيا مبرهنا، وبالتالي تشكل هذه المعرفة اعتقادا صادقا مطابقا للواقع الخارجي.
وإن لم تشكل تلك المفاهيم انطباقا مع الواقع الخارجي بشكل حقيقي، بل كان انطباقا واهيا وهميا، فإن ذلك لا يمكن وصفه بالمعرفة. والمعرفة بذلك تسبق الاعتقاد وتلعب دورا هاما في تشكيله، وبنائه.
والمعارف البشرية لها مصادر تم تنظيمها فيما يسمى ب “نظرية المعرفة” ، وتختلف هذه النظرية حول مصادر معرفة البشرية، وهناك مدارس كبري في هذا الصدد أثرت بشكل كبير على تشكيل المعارف والاعتقادات، بل أثرت على التشريعات والقوانين الحقوقية، التي نظمت العلاقات بين الإنسان والآخر، وبين الإنسان والسلطة، والإنسان والمحيط بما فيها الطبيعة.
وأهم هذه المدارس:
1. المدرسة التي اعتبرت أن الحس والتجربة هما مصادر المعرفة الوحيدين للإنسان، ويمكن تسميتها بالمدرسة التجريبية أو الوضعية.
2. المدرسة التي اعتبرت أن العقل هو المصدر الوحيد لمعارف الإنسان، وهي المدرسة العقلانية التي تعتبر أن معيار الحقيقة فيها فكريا واستنباطيا وليس حسيا.
3. المدرسة الميتافيزيقية التي تعتمد في المعارف على علوم ما وراء طبيعية.
4. المدرسة الإسلامية التي تعتبر أن مصادر المعرفة هي حسية وتجريبية وعقلية ونقلية ووجدانية، أي أن كل ما سبق يدخل في تشكيل معارف الإنسان.
هذه أهم المدارس في مصادر المعرفة التي تدرسها نظرية المعرفة، وكل مدرسة تفرعت عنها مدارس تراوحت شدة وضعفا في تبني مصدر معرفي على حساب مصدر آخر داخل بناها الفكرية.
فكل مدرسة شكلت لها مفهوما للحرية له مرجعيته الاعتقادية التي شكلتها مصادر معرفته، وبالتالي يختلف هذا المفهوم في دلالاته وبالتالي في مصاديقه والقوانين التي تشرع لأجله، وهذا لا يعني عدم وجود مناطق اشتراك، لكن هذه المناطق تتسع وتضيق وفق تلاقي هذه المدارس في مصدر من مصادر المعرفة، وبالتالي توافقها في جزئية ما على بعض الأفكار العقدية التي تؤثر في بناء مفهوم الحرية، لكن هذا الاشتراك في بعض المناطق لا يعني البتة تطابقا في دلالات مفهوم الحرية بشكل كامل، وهذا ما يثبته الواقع الراهن من حجم الاختلاف بين الغرب والشرق في تطبيقات مفهوم الحرية ودلالاته، رغم اتفاقهم على اللفظ لا المعنى.
وطالما أن محل البحث هو مفهوم الحرية، فإن أثر هذه الاعتقادات التي تنسجها المعارف ومصادرها، سيكون كبير جدا في رسم دلالات مفهوم المعرفة وتطبيقاته الخارجية.
وهنا نحن أمام ثوابت تحدد مفهوم الحرية ودلالاته وأمام متغيرات، أما الثوابت فأهمها:
1. الحقيقة والحق؛ إن وضوح الحق واستظهار الحقيقة يقيد الحرية ويحدد لها دلالاتها الواقعية والعملية، فمثلا عندما تتجلى حقيقة فساد منتجات مصنع ما من مصانع الأغذية في مكان ما، فإن التصرف الطبيعي هو إغلاق المصنع وتقييد حرية مالكه و مساءلته، وقد تؤدي المساءلة إلى سجنه ومعاقبته، فإن ظهور الحقيقة هنا أدى إلى تبدل مفهوم الحرية الذي خضع بشكل جلي هنا لمفهوم العدل، فإن من العدالة هنا تقييد حرية مالك المصنع لعدم التزامه بالاشتراطات التي تضمن صلاحية الغذاء، وعدم التزامه هذا سيؤدي ليس لضرر فردي وشخصي، بل سيؤدي إلي ضرر اجتماعي سيكلف الدولة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوي الصحي، فإن انتشار التسمم بين أفراد المجتمع كظاهرة سيؤدي إلى الضغط على المنظومة الصحية وسيكلف الدولة علاجات خاصة، وسيعطل بعض مؤسسات الدولة ومصالح الناس لغياب الموظفين المصابين، أي إن تصرف شخص دون مسؤولية وبحرية خارجة عن الضوابط، سيؤدي هنا إلى ضرر جماعي وتكلفة مادية باهظة. لذلك فإن ظهور الحقيقة والحق هنا ستدفع إلى تقييد حرية المالك ومساءلته وستكون هنا القيمة الحاكمة على مفهوم الحرية هي العدالة.
2. العدالة؛ وهي قيمة غائية تضبط قيمة الحرية بضوابط تمنع تحقق الظلم، سواء كان ظلما بكبت وتقييد الحريات، أو ظلما بإطلاق الحريات بشكل يحقق المفسدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
3. المرجعية المعرفية في فهم الحرية والتي تحدد المعايير التي في ضوئها يتشكل مفهوم الحرية. إن فهم الحرية ودلالاتها أي فهم أي مفهوم ومصطلح ولفظ هو خاضع لعدة اعتبارات على مستوى التطبيق والتأسيس. وأهم هذه الاعتبارات من وجهة نظري هي المرجعية المعرفية التي تحدد دلالات المفهوم وحدود تطبيقه. فمثلا حينما يعتبر الغرب أن مصادر المعرفة لديه التجربة والحس، فإن ذلك يعني أن الوعاء المعرفي الذي سيشكل مرجعية تحدد مفهوم الحرية ودلالاته وتطبيقاته هي التجربة والحس، ولن يؤخذ في الحسبان أي اعتبارات ومرجعيات معرفية أخرى، وهنا يفقد الغرب بذلك زوايا نظر أخرى، ويخرج من دوائره المعرفية مصادر للمعرفة معتبرة لدى مجتمعات أخرى تعطي مفهوم الحرية أبعادا دلالية أخرى.
أما المتغيرات فأهمها:
1. مساحة تدخل الدين في حياة الفرد والمجتمع؛ فرغم أن الدين مازال مؤثرا وبشكل كبير في حياة الفرد والمجتمع، إلا أن مساحات تفاعله مع الفرد والمجتمع والسلطة تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي يختلف باختلافه مساحات التضييق والتقييد. هذا فضلا عن اختلاف فهم النصوص الدينية ودلالات المتن في النص الديني، وهو ما يبرز في المدارس الإسلامية الكثيرة والمذاهب المختلفة، بالتالي سيؤدي ذلك إلى ظهور أفهام مختلفة لمفهوم الحرية ودلالاته، وتطبيقاته الميدانية.
2. العرف والعادات والتقاليد؛ وهو متغير مع الزمن ووفق تغيره يتغير مفهوم الحرية وتقييداته شدة وضعفا.
3. اللغة والدلالة؛ فاللغة تتطور ودلالاتها على ضوء تطورها أيضا إما تتطور أو تتغير.
4. التجربة والتطبيق؛ فالتجربة البشرية أحد مصادر المعرفة البشرية وهي ليست ثابتة غالبا، وبالتالي عدم ثبات أغلبها يؤدي لعدم ثبات تطبيقات مفهوم الحرية في الواقع الخارجي. حيث يتفاعل فهم الإنسان للحرية ودلالاتها مع الواقع ويطور أو يقيد كل منهما الآخر مع التقادم وفق التجربة في زمن ومكان محددين.
5. العلاقة بين الفرد والمجتمع وهي علاقة بين أصالتين، مجتمعات تحكمها أصالة المجتمع، وأخرى أصالة الفرد، وفي كل أصالة ينشأ فهما مختلف المساحات والحدود لمفهوم الحرية.
الحرية في فكر الإمام الرضا عليه السلام:
ببيوغرافي:
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.
ولد الإمام عليه السلام في عصر المأمون العباسي في المدينة المنوّرة في ١١ ذي القعدة ١٤٨ هـ، وبعد استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام، في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام.
وبرز الإمام الرضا عليه السلام على مسرح الحياة السياسية والإسلامية كألمع سياسي عرفه التأريخ الإسلامي في ذلك العصر. أطروحة مذهب أهل البيت عليهم السلام.
تولى ولاية العهد في عصر المأمون العباسي، بعد تهدي مبطن له بالقتل، فاغتنم الفرصة ونشر معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيت عليهم السلام.
استشهد الإمام الرضا عليه السلام في خراسان بعد دس السم له على يد المأمون العباسي، حسب ما رواه الكليني في شهر صفر سنة ٢٠٣ هـ.
مقدمة:
محاولة استقراء مفهوم الحرية من زاوية معاصرة، يدفعنا عملانيا للعودة إلى النصوص التاريخية، خاصة النصوص المقدسة المتعلقة إما بالقرآن الكريم، أو بالروايات الشريفة الصحيحة.
والعودة إلى تلك النصوص تحتاج أيضا عودة لغوية، بحيث أن اللغة هي وسيلة تواصلية بين الخطيب والمُخاطَب، والتي من خلالها يوصل الخطيب مراده ورسالته للمخاطب.
فالمفهوم القرآني كي نستسقي دلالاته التي تحدد مراد المتكلم، تتطلب العودة للغة التي نزل بها القرآن، ولغة القوم الذين خاطبهم القرآن، ودلالات المفاهيم لتلك اللغة في ذلك العصر، حتى نستطيع استشفاف أقرب دلالات للمفهوم، بل أقرب معني للكلمة وفق سياقاتها المطروحة، وزمانها ومكانها.
لذلك قد لا يمكننا الانطلاق من مفهوم الحرية الحديث، لاستقراء دلالات هذا المفهوم في النص المقدس، بل يجب أن ننطلق من النص المقدس وكيف طرح مفهوم الحرية وإن بألفاظ أخرى تؤدي نفس المعني لكن باختلاف الدلالة والمقصد والمطلوب.
• القرآن الكريم ومفهوم الحرية:
فلو انطلقنا من النص القرآني وهو الثقل الأكبر، والمرجعية المعرفية الضابطة للنصوص الروائية، سنجد أن المحور الذي انطلق منه القرآن كمفهوم تحَرّري للإنسان إرادته واختياره هو مفهوم العبوديّة.
أ. “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ, وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النار”
ب. قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ ولا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ولا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
في الآية الأولى عدة توجيهات أهمها:
1. تظهير مفهوم الحب وجوهره الداعي إلى تحقيق كمال الإنسان.
2. تظهير مفهوم الاتباع وأنواعه، وآثار كل نوع على مستقبل الكمال الإنساني.
ولو عدنا إلى علاقة الحب والاتباع إلى القرآن لوجدناها تتجلى في الآية التالية:
“قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ”
وهنا وضح بشكل جلي علاقة الحب بالاتباع، ووجهها بشكلها السليم، ثم رسم معالم أثر هذا النوع من الحب المقرون بحقيقة الاتباع، على مستقبل الكمال الإنساني.
ولمزيد من التوضيح:
إن حقيقة الحرية في السياق القرآني هي في حقيقة العبودية، وحقيقة العبودية هي في حقيقة الحب، وحقيقة الحب يكمن جوهرها وسيرها في السياق السليم لهذه السلسلة هي حقيقة الاتباع، والاتباع هنا مقرون بشرط أن يكون على الصراط المستقيم، لا اتباع للضالين ولا للمغضوب عليهم كما ورد في سورة الفاتحة في مطلع ومفتتح سور القرآن الكريم.
فنحن هنا أمام خارطة طريق مهمة في رسم استراتيجية مفهوم الحرية وفق التأسيس القرآني الكريم:
1. حب (جوهره العبودية).
2. اتباع.
3. صراط مستقيم شرط للاتباع القويم، لا للضالين ولا للمغضوب عليهم.
فتحرير إرادة الإنسان واختياره من كل أنواع العبودية المادية، التي تهيمن علـي فكره وإرادته وفعله واختياره، وتخلصه ن كل مصاديق الطاغوتية والفرعونية، تتمثل في حقيقة العبودية لله وحده لا شريك له، وهي الحقيقة التي تجلت بادئ ذي بدء في جوهر الدعوة النبوية عبر تاريخ الأنبياء والمرسلين، وهي الدعوة إلى التوحيد ب “لا إله إلا الله”، وهذه ال “لا” الرافضة لكل أنواع الشركاء مع الله، هي جوهر تحرير الأنسان وتحقق حريته الواقعية في الخارج.
وهذه لا تتحقق إلا من خلال الحب، أي العبودية القائمة على الحب، وليس على علاقة العبيد أو علاقة التجار، بل على علاقة الأحرار، الذين يتبعون ويعبدون الله وحده لأنه أهلا للعبادة وحبا له.
ولكن كيف يتجلى هذا الحب وهذه العبودية سلوكا وعملا، فعقل الإنسان محدود كي يدرك المصالح والمفاسد الشاملة والمحيطة به، والتي تتناسب ووجوده في هذه الدنيا، لذلك كان لا بد من رسم معالم طريق الحب، فربط حب الله الحقيقي باتباع نبيه ص، حتى يتحقق حب الطرف المحبوب وهو الله تعالى.
هذا التحقق في واقع الحال الإنساني يتمظهر سلوكيا في الحياة من خلال وجود العديد من الأنداد والأضداد لمفهوم العبودية لله المنطلق من الحب، فحينما تتحقق العبودية من الحب، ويصبح وجود الإنسان سلوكا وعملا من خلال اتباع النبي ص، فإن ذلك يلزمه كثير من اللوازم في الحياة الدنيا، وقد يضرر مصالحه وينغض عليه رفاهه وراحته واستقراره، لأن هذا الحب والاتباع كثيرا ما سيتعارض مع مصلحة الأنداد والأضداد، وهو ما يدفعهم لمحاربة هذا الخط الغارق في عبوديته لله وفق المنهج النبوي، فيبدأ هنا تجلي مشاهد الأنداد والأضداد، وقدرة كل طريق على جذب أمثاله وأشباهه إليه، وقدرة كل جهة على إقصاء الجهة الأخرى من مسرح الحياة لتتصدر هي المشهد.
وهذا المشهد الذي يتضاد فيه مسارات وطرق، لا تتجلى آثاره الواقعية إلا في الآخرة، حيث يظهر عيانيا للجميع أثر عظيم جدا هو انعكاس تام للصورة في الحياة الدنيا، التي كان يتضاد و يتصارع فيها أتباع الله وأتباع الأنداد، وكان في تلك المشهدية يتبرأ كل طرف من رب الطرف الآخر في صراع تسقط فيه كثير من القيم والمبادئ والأرواح على طريق التحرر الحقيقي للإنسان، وتتجلى فيه قيم الصبر والثبات والبصيرة عند أتباع الحق، بينما يحاول أتباع راية الطاغوت وفرعون أن يسخروا كل طاقاتهم وكل قدرتهم في تمويه حقيقة مرادهم من خلال شعارات وهمية تتفق مع شعارات أهل الحق، لكنها تختلف في الجوهر والغاية والمقصد، والأدوات التطبيقية والمرادات والآلات.
فمفهوم الحرية عند أتباع الله وأحباؤه، لابد له أن ينبت من تربة الله تعالى ومفاهيمه وقاعدته المعرفية، التي تهدف لبسط سلطة الله وشريعته لتحقيق العدل للجميع، وتهدف لتحرير الإنسان وتحقيق كرامته التي بها ينهض في الأرض، ويقيم شرع الله وينفي كل الأنداد والسلطات القهرية التي تمنع نهضة الإنسان واندفاعه نحو مساره التكاملي في عمارة الأرض بالخير وعبادة الله بالحب.
وأتباع راية الباطل ليس بالضرورة هم من خارج جسد الأديان، فنحن أمام رايات أهم من يقودها هم:
أ. راية واضحة في عدائها لله ولرسله وأنبيائه وأديانه، محورها تسلط الإنسان على الإنسان، وغرورهم ب “بأنا” الإنسان المطلق، وهذه راية المغضوب عليهم.
ب. راية تتلبس الدين، وجل حراكها بثوبه، وعباءته، ومظلته، لكنها تدلس وتخلط الغث بالثمين، وتحرف الدين عن غاياته ومقاصده، وتضلل الناس، وهذه راية الضالين.
وحين يتلبس كثير منهم فهما للدين يتبع أهواءهم، ويتبع أربابهم من الطواغيت تحت شعارات دينية، هنا يصبح مأزقنا مأزق عقلي، يتطلب العمل المتواصل على تأصيل أسس المعرفة، ومناهجها، ومنابعها، ومصادرها، وتزويد الإنسان بأداتها كي يستطيع الصيد من المياه النظيفة ويترك المياه الآسنة باسم الدين.
والمعرفة هي:
(أ) الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل شخص من خلال التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو العملي لموضوع؛
(ب) مجموع ما هو معروف في مجال معين؛ الحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي اكتسبتها من الواقع أو من القراءة أو المناقشة؛
(ج) المناقشات الفلسفية في بداية التاريخ مع أفلاطون صياغة المعرفة بأنها “الإيمان الحقيقي المبرر”. بيد أنه لا يوجد تعريف متفق عليه واحد من المعارف في الوقت الحاضر، ولا أي احتمال واحد، وأنه لا تزال هناك العديد من النظريات المتنافسة.
(د) والمعرفة أيضاً هي ثمرة التقابل والاتصال بين الذات المدركة وموضوع مدرك، وتتميز من باقي معطيات الشعور، من حيث إنها تقوم في آن واحد على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين.
وكل معرفة تنعكس مباشرة على سلوك الإنسان ووعيه وفهمه لله والإنسان والكون هو من المعرفة.
وتكمن أهمية المعرفة في أنها:
1. تُشَكّل الأفكار.
2. تدير السّلوك في بعده الفردي والاجتماعي.
3. لها تأثير مباشر على وعي الإنسان وإدراكه.
4. لها تأثير كبير في الاعتقاد، وتغييره سلبا أو إيجابا.
لكن ما هي مصادر المعرفة:
وبعد هذا العرض السريع حول المعرفة نقف عند أهم مصادر المعرفة وهي النص الديني، والمتمثل بالقرآن الكريم، وبالنصوص الروائية المنقولة من تراث الأئمة صلوات الله عليهم، ونركز هنا على أحد مصادر هذا التراث العظيم وهو الإمام علي الرّضا عليه السلام.
فكيف جلّى الإمام الرضا عليه السلام الآية الأولى في ربط الحب بالاتباع، والتّبري من كل الأنداد الظاهرين والخافين على الناس؟
• الحرية في النص الروائي: الحرية في فكر الإمام الرضا عليه السلام والانطلاق من الذات:
“وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ, وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النار”
سأذكر هنا أهم محطات في حياة الإمام الرضا عليه السلام يمكنها أن تشير وتجيب على هذا السؤال:
– المحطة الأولى توضيح الموقف (العبودية الحقة ورفض الأنداد):
حينما ورد الإمام عليه السلام مرو، عرض عليه المأمون أن يتقلد الأمر والخلافة فأبى الرضا عليه السلام، وجرت مخاطبات كثيرة وبقوا على ذلك نحوا من شهرين، وكل ذلك يأبى عليه أبو الحسن علي بن موسى الرضا أن يقبل ما يعرض عليه..
وبعد ذلك كان هناك عدة مخاطبات من المأمون للإمام الرضا ع:
1. أن يخلع المأمون نفسه من الخلافة ويقلدها للإمام الرضا ع، فأبى الإمام الرضا ع ورفض ذلك بشكل قاطع وأنكره تماما.
2. فعرض عليه ولاية العهد إن أبى تقلد زمام الخلافة، فأبى الإمام عليه السلام إباء شديدا أيضا ورفض ولاية العهد كذلك.
ثم استدعاه وخلا به مع الفضل بن سهل ذو الرياستين، ودار حوار مطول بينهما انتهى بعد أخذ ورد حول الخلافة وولاية العهد وإباء الأمام رفضه لكليهما، انتهـي بقول موجه من المأمون للإمام الرضا ع كالتهديد له على الامتناع عليه، مستشهدا بشورى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب التي جعلها في ستة، ومن خاف منهم فيضرب عنقه، ثم أتم استشهاده بطلب شديد اللهجة بأنه لابد لك من قبول ما أريده منك، فإنني لا أجد محيصا عنه، فقال الإمام ع أجيب إلى ما تريد من ولاية العهد على أنني “لا آمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أولي ولا أعزل ولا أغير شيئا مما هو قائم”، فأجابه المأمون إلى ذلك كله .
ويمكن تحليل موقف الإمام ع على ضوء الآيات الكريمة السابقة بالتالي:
1. قبول الإمام للحكم هو قبول للمنهج العباسي في تأسيسه وترسية قواعده وقيمه وأصوله، ولكنه يعلم أن أسس قيامة الدولة العباسية التي رفعت شعارات دينية لغايات سياسية سلطوية، تبلورت بعد وصولهم إلى السلطة، هذا القبول يخالف منهج الآية الأولى “ومن يتخذ من دون الله أندادا..” لأن الإمام سيقيد بسلطة الحكم الخفية، والتي أسس بنو العباس قواعدها ومد أذرعتها على وجه البسيطة، بالتالي محاولة التغيير هنا لا يمكن أن تكون فجأة وبشكل صدامي مع المجتمع، مع وجود تعقيدات اجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية كثيرة، لا يمكنها أن تساعد في عملية التغيير التي يمكن أن أسميها عملية انتحارية بامتياز، وعدم قدرة الإمام لا تأتي بعدم فاعليته، بل من عدم قابلية المحيط لهذه الفاعلية، والتي تتطلب جهدا متراكما وطويلا وتأسيسا على مدى عقود لإعادة سليقة الناس إلى فطرتهم، و هدي النبي ص، لذلك وجوده في أعلى سلطة يعني إما شرعنته للمنهج الخاطئ، بالتالي وأده لخط النبوة والإمامة، أو اغتياله معنويا وجسديا، وبالتالي انقطاع الجاذبية لخط النبوة والإمامة الذي يجسد منهج التوحيد وترسية الأسس الإلهية. وهذا نقض لغرض الإمامة كليّا.
2. قبول الإمام بولاية العهد مع رفض أي نوع من السلطة التشريعية أو التنفيذية، والاكتفاء بها شكليا، واستغلالها فيما بعد كما سيتضح لاحقا، في ترسية معالم الطريق مجددا، وإعادة صواب كثير من العلماء كما سنرى لاحقا، وصواب كثير من النخب وعامة الناس، إلى منهج الاتباع والعبودية السليم، وتحرير إرادتهم من تبعية غير الله، وتوجيه قابلياتهم باتجاه الله الأوحد، ورفض كل ما دونه من أنداد. وهذا الرفض لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية، هو استبعاد أي غطاء شرعي من قبله، ممكن أن يعطى للعباسيين ونهجهم، خاصة مع معرفة المأمون بكثرة أتباع الإمام ومحبيه، ورغبته في استغلال هذا الجمهور لصالح شرعنة سلطته، بالتالي تحقيق الاستقرار في عهده، ومنع الاضطرابات التي عانى منها الأمويين نتيجة ثورات العلويين الكثيرة بعد استشهاد الإمام الحسين ع، والثورات التي تسلق عليها العباسيين وخبروا قدرة العلويين في زحزحة أي سلطة، لذلك كان أحد أهداف المأمون هو شرعنة سلطته، وكسب الشارع العلوي بكل توجهاته إلى صالحه، بالتالي تحقيق الاستقرار، وضمان سريان السلطة في العباسيين بعد ذلك، من خلال القتل المعنوي والجسدي لخط الإمامة، ووأد أصل الفكرة في ذهن الناس بكل أطيافهم.
– المحطة الثانية تجلية المسار (الحب والاتباع):
وقد برزت هذه المحطة في رحلته الأخيرة إلى نيشابور والتي تحققت فيها شهادته ع، فقد استوقفه ثلة من العلماء المتفقهين في الدين في ذلك الزمن، حينما دخل إلى نيشابور عرض له من أهل الأحاديث والدراية وهما أبو زرعة الرازي، ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما خلائق كثيرة من أهل الحديث وأهل الرواية والدراية فقالا:
أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد ص، نذكرك به، فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلة عن القبة وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة … فصاحت معاشر الأئمة والعلماء والفقهاء: معاشر الناس اسمعوا وعوا وأنصتوا لسماع ما ينفعكم لا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكائكم وكان المستملي أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي فقال علي بن موسى الرضا عليهما السلام : حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر ع، عن أبيه زين العابدين ع، عن أبيه الحسين ع شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب ع أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثني جبرئيل قال: سمعت رب العزة سبحانه تعالى يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي، ثم أرخى الستر على القبة وسار. فعدوا أهل المحابر والدّوي الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا..”
لابد من الإشارة هنا قبل تحليل إشارات الإمام الرضا ع في هذا الحديث إلى أمر غاية في الأهمية وهو:
1. موقع أهل البيت ع كان موقعا حساسا، لأنه موقع يقتضي التفرد في المرجعية السياسية والعلمية المعنوية، وبذلك فإن هذا الموقع يهدد السلطة السياسية القائمة، كما يهدد العقيدة الغالبة في أساط المسلمين المبنية على مشروعية الخلافة ونفي تميّز أهل البيت عليهم السلام، واصطفائهم من هذه الأمة.
2. الأئمة من خلال تتبع سيرتهم وتراثهم وأصداء شخصياتهم لدى سائر المسلمين ليس هناك شك في أنهم بعد الإمام الحسين عيه السلام لم يكونوا بصدد القيام بالثورات المسلحة ضد السلطات القائمة، لأنهم كانوا يعلمون أن هناك خللا في تفكير المجتمع واتجاهه، ولن تنجح ثرة عامة في البلاد الإسلامية تنشد العدل والشرع حقا على منهاج رسول الله صلى الله عليه واله، دون منهج الخلفاء الأولين، وتنطلق من حق أهل البيت عليهم السلام، ومراتبهم التي رتّبهم الله فيها، وذلك لغلبة الشّبهة واستقرارها لدى الاتجاه الغالب للمسلمين، حيث إن هذا الاتجاه لن يقدّس أحدا بعد الإمام الحسين عليه السلام، والذي كان منصوصا على مقعه المميز من رسول الله صلى الله عليه وآله.
3. أن المهم في مرحلة الأئمة عليهم السلام هو تأسيس تراث جامع وفق أسس أهل البيت عليهم السلام في العقيدة الفقه والتفسير والأخلاق، ثم الاهتمام بتنمية هذه العلوم بين المؤمنين.
4. كانت سياستهم عليهم السلام تجاه جمهور المسلمين وسائر العلويين والهاشميين قائمة على حسن التعامل والمداراة مع علمائهم وعامتهم، وتجنّب إثارة الفتنة والبغضاء بما يؤدي إلى تشويه دعوتهم عليهم السلام، وتفرقة المسلمين.
الحديث السابق يسمى حديث السلسلة الذهبية، حيث أوضح فيه الإمام عدة أمور، إما مباشرة أو غير مباشرة:
1. إعادة برمجة الذاكرة الجمعية للعامة والعلماء حول أصل الأصول وهو “التوحيد”، وهذا ليس لأن ذلك غير حاضر في أذهانهم، بل الحضور هو حضور منفصل عن واقع المسلمين، وواقع علمائهم، بمعنى أن قول “لا إله إلا الله” لها شرطها وشروطها، ففي هذا الجمع الكبير، وهذا الحضور النوعي المتنوع من العلماء والعامة والنخب، حينما يصر العلماء على شخصية كالإمام ع لقول شيء يفيدهم في الدنيا والآخرة، فإن أي إعلان أو كلام من الإمام يفترض أن يكون ذا أهمية بالغة جدا، بل تعتبر من أوليات الأمة، بالتالي هو يريد إما أن يعالج خللا، أو يؤكد ثابتا، أو يحي ذاكرة غابت عنها ما أقرت به قولا، ثم انحرفت عنه عملا وتطبيقا.
2. إثارة التساؤلات ولفت النظر من خلال تأكيد المؤكد، فيمكن لسائل أن يسأل خاصة أمام هذا الحضور المكثّف للعلماء والفقهاء، لماذا أكد الإمام على أمر هو من مسلّمات المسلمين، وفي حشد وجمع من المسلمين يعتبرون مبدأ التوحيد مبدأ مسلّما به؟ ولماذا هذا التأكيد بهذه الطريقة، وما هي الرسالة التي يريد أن يقولها الإمام من خلال هذه الجملة؟
هذه الطريقة من قبل شخصية كشخصية الإمام هي طريقة دلالية غير مباشرة تخضع التفسير لعقول الناس قابلياتهم، وهي طريقة الاعتماد على ما يسمى بالقواعد العامة الحاصرة بدلا من التعيين أو التصريح المباشر، والإفهام بالأفعال بدلا من الأقوال، أو بوجوه الإشارات بدلا من التلويح، والكناية بدلا عن الإعلام والإعلان، وبالتسريب المقصود بدلا عن المخاطبة وهكذا.. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكن الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الحكمة في كلامنا لتنصرف على سبعين وجها، لنا من جميعها المخرج” . وعنه عليه السلام: “أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، وإن الكلمة لتنصرف على وجوه، فل شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب”.
3. حديث الإمام عليه السلام بهذا التسلسل، منه إلى الله تعالى، هو تأكيد للمرجعية الدينية والمعرفية وحتى السياسية، أنه لا يحدث عن الله، إلا نبي أو وصي، فأن يربط سلسلته بالنبي ص، ثم يوصلها بالله تعالى عبر جبرئيل ع، في هذا الجمع الغفير من العلماء والطلبة والنخب والعامة، وفي مسيره الأخير الذي استشهد بعده، وكأنها وصية، والموصي لا يوصي إلا بما هو أولوية، وبما أن الموصي هو شخص الإمام ع، فتصبح الوصية بالنسبة له أولوية إلهية وليست عادية. بالتالي هو ثبت المرجعية ومعيارها، وأشار بطريقة ذكية إلى أحقية الإمام ع واتصال هذا الحق بالنبي ص مباشرة وبالله عبر جبرئيل الوحي الذي ختم وحيه بالنبي ص.
4. توضيح المسار الذي يتحقق فيه التوحيد الحق، والذي يحقق الاتباع القرآني، فإن كنتم تتدعون حب الله، فعليكم اتباع ما أراده الله من خلال اتباع النبي ص، ومن نص عليه النبي ص من بعده، فكون القائل الإمام الرضا ع، وهو من سلسلة الذهب المتصلة بالله في التبليغ، وكون ما قاله متعلق بأصل الأصول وهو التوحيد، بالتالي هو يوضح مسار الصراط المستقيم القائم على الاتباع والحب، وهو مسار غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعم الله به على خاصّته ومن اختاره هو جل وعلا.
5. أما التركيز على مبدأ التوحيد، فهو من وجهة نظري أصل الأصول في تحرير إرادة الإنسان من العبودية لغير الله، الخروج على كل أنواع العبوديات السياسية، والدينية، والاجتماعية، والفردانية. وهو توضيح لأهل العلم، أن الفضل الحقيقي لا يكمن في الادّعاء، بل في حقيقة الاتباع الذي من خلاله يتحقق مبدأ التوحيد، وأن الاتباع يتطلب التّخلّص من كل أنواع العبوديات وأهمها عبودية الأنا، والقبيلة والعشيرة والحاكم، والجاه والموقع، وغيرها من العوائق التي تزيغ بصر الإنسان وبصيرته عن التوحيد القائم على حقيقة الحب والاتباع.
فوفقا للآية الأولى “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ, وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النار”
والتي من خلالها استقرأنا حراك الإمام عليه السلام في ظلها، حيث يتحرك الثقل الأصغر في ظل الثقل الأكبر ففيها عدة نكات وأهمّها:
1. أن الحرية تبدأ من تحرير إرادة الإنسان، وتحرير داخل الإنسان المتمثل بعقله وفكره، وهذا التحرير لا يتم إلا بعد أن يخضع لمبدأ التوحيد الحق.
2. أن الخضوع لمبدأ التوحيد الذي هو أصل الأصول، وانطلاقة الإنسان الأوّلى نحو حقيقة الحرية والتحرير، لا يتم إلا من خلال منهج وشروط، وهذا المنهج خاضع لإرادة الله وتشخيصه، وله شروطه، ولا يمكن أن يكون إلا من خلال من أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم، أما التوحيد الذي يحيد عن هذا الصراط، ويكون وفق منهج الضالين أو المغضوب عليهم، فهو لن ولم يحقق التحرير الحقيقي، ولا الحرية القائمة على الحب والاتباع.
3. إن الخلل في هذه المرحلة من التحرير والحرية، سيترتب عليه خللا في المنهج والسلوك، لأن المرجعية المعرفية التنظيرية التي تؤسس للبنيان الأولي لمبدأ التوحيد، ولجوهره المعرفي، الذي ينطلق منه الإنسان نحو تطبيق أسسه في الحياة الخارجية، هذا الخلل سينعكس على التطبيق الخارجي للحياة الإنسانية، ومع التراكم الزمني من الانحراف، سيؤدي إلي تقييد الإنسان، واستعباده لا تحريره وتحررّه، إضافة إلى عدم قدرته على تحقيق العدل والعدالة، بل سينحرف هذا المنهج بالإنسان عن المنهج الصحيح في تحقيق العدالة الحقة، وهو ما يؤدي إلى هدر كرامته التي وهبه إياها الله تعالى، وإعادة استعباده وسلب إرادته، وتقييد خياراته، وتوسع قابليات استعباده.
والخطير في هذا الموضوع، أن يحدث كل ما سبق دون أن يشعر، أو باعتقاد مضلل أن هذا هو طريق الحق، وطريق التوحيد القويم، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، حيث أن طريق الباطل واضح جدا، ولكن من يتلبس بثوب الحق، وجوهره منحرف أو ضال، فإن ذلك سيكون مدعاة للتيه، وابتعاد الناس عن الحق وجادته، إما لانحراف هذه الفئة عن المنطق الرباني، بالتالي انكماش الناس من حولها وانجذابهم لمناهج أخرى منحرفة بل مناهج باطلة لقوتها المادية أو لقدراتها الاقناعية ومواكبتها للأجيال، أو لابتعادها هي بالناس ( من أتباعها) عن المنطق الرباني، وتأثيرها على الآخرين، حيث سيزداد اللاحقين بركبها، وتبتعد الأجيال مع التقادم أكثر عن جادة الحق، وهو ما يغرق البشرية في الظلم وللعبودية للسلطات السياسية أو الدينية أو الاقتصادية وبشعارات دينية منحرفة وإن كانت باسم الدين.
الحرية في فكر الإمام الرضا عليه السلام والآخر:
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ ولا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ولا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
مماس سبق كان تأسيسا لأصل الأصول العقدية في الداخل الديني، وآليات تحرير النفس (كتحليل من وجهة نظري القاصرة) وتأسيس لمبدأ الحرية.
ولكن كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع الآخر، وأسس من خلاله مبدأ للحرية في الاعتقاد؟
كان للإمام الرضا عليه السلام بحكم موقعه السياسي والعلمي مساحة من الحرية في حوار الأديان الأخرى، وقد استطاع الإمام من خلال هذه الحرية المتاحة طرح منهجه الاعتقادي والفكري في هذه الحوارات.
هذه الحرية التي سمح بها المأمون لها عدة تفسيرات أهمها:
1. بعض التفسيرات كانت ترى أن المأمون منح الإمام عليه السلام مساحة من حرية الحوار مع الأديان ظنّا منه أن بهذه الطريقة الحوارية أمام الملأ مع كبار رجال الدين من الأديان الأخرى، قد تحرج الإمام ع وتظهر عجزه العلمي حينما لا يجيب على بعض الإشكاليات العميقة التي يطرحها هؤلاء، بالتالي إظهار هذا العجز يقط هيمنته المعرفية، ويسقط أحقيته في الإمامة، وبالتالي يحدث ثغرة كبيرة في العقل الشيعي، حول مفهوم الإمامة، والتي كانت تتميز بالقدرة والإحاطة العلمية والشرعية والمعرفية، بل تشكل مرجعية ناجزة عند كل المذاهب، فحينما تغلب الإمام على المذاهب الإسلامية بقدرته العلمية، كان لابد من إظهار ضعفه على مستوى الأديان الأخرى، وفق فهم المأمون لذلك. وينقل في عيون الأخبار شيئا من ذلك: وكان هدف المأمون – كما يرى الشيخ الصدوق ـ هـو الحرص على انقطاع الرضا عليه السلام عن الحجة مع واحد منهم، وذلك حـداً مـنـه له ولمنزلته من العلم.
2. أن المأمون منح هذه الحرية للإمام عليه السلام ظنّا منه واعتقادا أنه الأجدر في مواجهة هذه الإشكاليات العقدية، والتي يطرحها كبار رجال الأديان الأخرى، حيث عرف المأمون بشغفه العلمي والمعرفي، وجمعه لكثير من العلماء في مجلسه عادة، فلم يجد أجدر من الإمام عليه السلام في الإجابة على هذه الإشكاليات المطروحة من قبلهم، وهو ما قد يؤثر على عقيدة الأجيال الشابة، ويضعف سلطة الدين التي يحكم بها المأمون عليهم وبالتالي تضعف سلطته السياسية، خاصة مع وجود الخطر المسيحي الكنسي، والذي كان يمكنه إضعاف الجبهة الداخلية للجسد الإسلامي، من خلال تفكيك منظومة الشباب العقائدية بالإشكالات، ومن ثم الانقضاض على الدولة، فكان الأجدر في هذا التأسيس المعرفي، وتفتيت وتقويض هذه الإشكاليات بالمنطق العلمي هو الإمام الرضا عليه السلام.
• مناظرة الإمام لأهل الأديان والمذاهب:
كان لهذه المناظرات درا هامّا في التأسيس لمنهج الحرية العقدية، ووضع أسس رصينة لها، وسترى بعد عرض هذه الحوارات ونستخلص منها هذا المنهج وهذه الأسس من وجهة نظر تحليلية قد تكون قاصرة.
أمر المأمون الفضل بن سهل أن يجمع للإمام أصحاب المقالات: ومنهم: الجثليق وهو رئيس الاساقفة (معرب: كاثوليك) ورأس الجالوت عالم اليهود، ورؤساء الصابئين، وعظماء الهنود من أبناء المجوس، وأصحاب زردشت، وعلماء الروم، والمتكلمين، وقد احتج الإمام بالكتب المعتبرة عندهم، وقد اعترف الجميع بأعلمية الإمام ، بعد أن فنّد ،حججهم، فأذعنوا لقوله، واعترفوا بصحة افكاره و آرائه .
وبعد جدال ونقاش طويل قال الجثليق: «القول قولك، ولا إله إلا الله» وبعد حوار طويل أسلم عمران الصابي وقال: «اشهد أن الله تعالى على ما وصفت ووحدت، وأشهد أن محمداً عبده المبعوث بالهدى ودين الحق ثم خرّ ساجداً نحو القبلة».
ولما نظر المتكلمون الى كلام عمران الصابي، وكان جدلاً لم يقطعه عن حجته أحد منهم قط، لم يدن من الإمام عليه السلام أحد منهم ولم يسألوه عن شيء . وفي مجلس آخر بعث المأمون على الإمام ليناظر متكلم خراسان سليمان المروزي، فتناظرا في البداء، وصفات الله تعالى والفرق بين صفات ذات الله وصفات فعله، فأجابه الإمام عليه السلام على جميع اسئلته، وكان يقطعه في الحجج إلى أن سكت لا يستطيع أن يجيب على آراء الإمام، فقال المأمون عند ذلك: “يا سليمان هذا أعلم هاشمي”
وفي مجلس آخر جمع المأمون عدداً من علماء الأديان وأهل المقالات، فلم يتكلم أحد إلا وقد ألزمه الإمام عليه السلام حجته، وقام اليه علي بـن محمد بن الجهم، وأثار الشبهات حول عصمة الأنبياء ع اعتماداً على الآيات المتشابهة الواردة في القرآن الكريم، واثار الشبهات حول عصمة رسول الله، فأجابه الإمام وأزال الشبهات عن ذهنه، وأثبت له بالعقل والنقل عصمة جميع الأنبياء ع ، فبكى علي بن محمد بن الجهم وقال: يا ابن رسول الله أنا تائب الى الله عزّ وجلّ من أن أنطق في انبياء الله عليهم السلام بعد يومي هذا إلا بما ذكرته.
وفي مجلس آخر تساءل المأمون عن عصمة الانبياء وأورد الآيات عليه السلام جواباً شافياً، وأوّل له تلك الآيات على خلاف ظاهرها، فقال المأمون: “لقد شفيت صدري يا ابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً علي”.
• منهج الإمام عليه السلام في التأسيس لحرية الاعتقاد:
1. المحاورة وفق مبدأ قرآني هو: “ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”
2. الاعتماد على لغة العقل والمنطق بالدليل والبرهان، بعيدا عن التعصب والتحيز المعرفي والعقدي.
3. إلزام المحاوَر في حال كان من “أهل الكتاب” بما يؤمن به هو، من خلال اعتقاداته المودة في كتبه، ثم بناء الشيء وفق مقتضاه، وتفنيد تلك المعطيات التي يؤمن بها الطرف الآخر، بالعقل والمنطق.
4. التركيز في محاورة أهل الكتاب على مبدأ التوحيد كأصل الأصول الاعتقادية، وبوابة الفتح المبين، لمنع تسلّط فئة على أخرى، من خلال تكريس العبودية النفسية والأخلاقية والوجودية لله تعالى، فتمتنع بذلك السلطات المعرفية أو السياسية أو الدينية من موقع المتوفق والعلو الديني لأي جهة، وتلغي أي محاولة لتكريس السلطة الأخلاقية والقيمية لتصبح هي المرجعية المعيارية الفعلية المفروضة على الآخرين.
لذلك فند الإمام عليه السلام الشبهات، وأزال الغشاوة عن العقول والقلوب، ومن ثم منح العقل دوره في تلقي المعارف وفق الدليل والبرهان العقلي، ثم بعد إقرارهم، ثبت المبدأ الأساس وهو “الكلمة السواء بيننا” ألا نعبد إلا الله، وعدم الشرك به، وعدم ربوبية جهة على جهة، ويقصد بها ربوبية سلطوية تلغي وتقصي الآخر، فإن لم يقروا بذلك، فأعلن هويتك الخاصة التي تميزك عنهم وعن منهجهم السلطوي، بأنك من المسلمين الذين سلموا لرب واحد، وأقروا بعبوديتهم له وحده لا شريك له، فتبرؤوا من عبودية هؤلاء وكل أنواع سلطتهم خاصة المعرفية والعلمية، وبالتالي تميز بذلك الهوية الإسلامية بجوهرها العبودي لله وحده لا شريك له، فتحرر إرادة المسلم من كل أنواع الشرك والعبوديات.
5. إلزام المحاوَر من المسلمين من المذاهب الأخرى، بما يؤمن به من كتبه، ومن ثم تفنيده بالعقل والمنطق البرهاني والنقل، أي النص القرآني الحديثي.
6. تأكيد أن الاعتقاد لا يقوم إلا علي الدليل والبرهان، وليس على التقليد واتباع الماضين، وهو منهج الإمام في نقده عقليا بناهم العقدية، ثم الاستدلال وفق المنطق والبرهان على العقيدة الحق.
وقد أنتجب هذه الحوارات المهمة:
1. تحدي أرباب الأديان والمذاهب، وإثبات التفوق العلمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام الرساليّة.
2. فتح الباب لانتشار ثقافة أهل البيت في أوساط المجتمع الإسلامي.
3. توجيه المسلمين الى خط أهل البيت الرسالي ودعوتهم للانشداد بهم دون غيرهم دعوة صامتة.
4. دعم الدولة الإسلامية لأنها قدمت للإنسانية الرصيد العلمي الذي تمتلكه الحضارة الإسلاميّة.
5. ولا نستبعد أن تكون هذه الفتوحات الكبيرة سبباً من أسباب الإسراع في القضاء على شخص الإمام الرضا عليه السلام، لأن تفوقه واشراقه يعود بنتائج سلبية على شخص الخليفة، فيكون وجوده مزاحماً لمثل المأمون الذي يحمل أكبر الآمال في إحكام السيطرة على العالم الإسلامي.
خلاصة وخاتمة:
إن السياق المعرفي الذي تشكل عند الغرب، هو نتاج تراكم فلسفي من جهة أثرت فيه الفلسفة اليونانية بعمق، وتراكم تجريبي، مرت فيه الشعوب الغربية بتجربة دينية خاضت خلالها مخاضات عقدية ومعرفية مريرة، هذا إضافة إلى عوامل أخرى شكلت العقيدة المفاهيمية للغرب، وشبكة المعارف، والتي بدورها أسست للنظام الغربي القانوني والحقوقي، ومع امتلاك مقومات القوة والاستطاعة والاكتفاء الذاتي والتفوق العلمي والتكنولوجي والصناعي، والنزعة الاستعمارية والاستحواذية على الثروات، اندفع الغرب لعولمة قيمه ومعارفه ونظامه الحقوقي والقانوني من موقع المقتدر القوي، ومن موقع المتفوق الحضاري وفق فهمه للحضارة والتفوق، خاصة بعد أن تكبّد خسائر جمّة في الاستعمار العسكري، مما دفعه لابتكار طرق استعمارية أخرى، يهيمن فيها على الوعي، فيفتت مُحْكَماتِه بالمتشابهات، ومن ثم يعيد بناءه وفق معطياته وقواعده المعرفية والعقدية، خاصة في بعدها القانوني والحقوقي.
ولأن في الوطن العربي والإسلامي، يوجد إسراف في هدر الكرامة، وتضييع حق الإنسان وقهره ماديا ومعنويا، وضلوع حكومات مستبدة عديدة في الهيمنة، والإيغال في الاستبداد ونهب ثروات الشعوب، هذا فضلا عن دور هذه الحكومات الوظيفي المتواطئ مع القوى الكبرى التي ما فتئت تستخدم ورقة حقوق الإنسان لأجل تحقيق مخططها كما تريد، ولكل ما سبق إضافة لعوامل كثيرة أخرى، منها قابلية الاستعباد المعدية عند الشعوب العربية، وأخلاقية الهزيمة، فإن التأثر برياح الغرب الثقافية يكون أسهل وأسرع وأقل كُلْفة.
هذا التأثر بات اليوم يهدد الهوية بشكل حقيقي ومُحْكَم الحلقات، ويسعى بكل الوسائل – خاصة الإعلامية منها – لاستلاب هذه الهوية، و تغيير معالمها الأصيلة، وتمييع قيمها ومحكماتها، لا بما هو بديل صالح، بل بمجرد شعارات تجعل من الفرد العربي والمسلم نسخة طبق الأصل في بعده المادي، من لباس ومسكن ونظام حياة، نسخة طبق الأصل للطريقة الغربية في ذلك النظام، لكن من الممنوع أن يفكر هذه الفرد ويبدع بذات الطريقة التي يمكن للغربي أن يفكر ويبدع فيها، وينتج ويستقل ويكتفي ذاتيا، إلا في حالة واحدة، وهي في حالة هجرة هذه العقول إلى الغرب للاستفادة منها واستغلالها لصالح الأنظمة الغربية.
ولهذا نحن مجددا أمام تيه جديد تعيشه الأمة والشعوب العربية والمسلمة، تيه يستهدف وجودها وامتدادها التاريخي، ويتطلب القيام بما يسمي “جهاد التبيين” وهو جهاد سلاحه المعرفة والثقافة، يستهدف الوعي ليستجلي له الحقائق، ويدحض الشبهات بالدليل، ويوضح له تهافت البديل وسطحيته، ويبين متانة وأصالة هذه الهوية، آخذا في الحسبان عوامل التجديد الحقيقية دون حرج منه في النقد والتقييم، وفي ذات الوقت دون استحياء في التبيين والدحض بالدليل والبرهان، لتلك الحرب الناعمة على الهوية ومنظومة القيم والمعايير. وجهاد التبيين ليس عملا سطحيّا يقوم به أي شخص، بل يجب أن يتم التأسيس لهذا المفهوم وبناء لبناته التّحتيّة والفوقيّة، وعمل دراسة استراتيجية في كيفيّته وأدواته على ضوء التحديّات المعاصرة من جهة، وتحديّات الجغرافيا الخاصة بكل منطقة من جهة أخرى، وتحديّات كل مجتمع في منطقته الجغرافيّة من جهة ثالثة، واختيار النخب الفاعلة في هذا الصدد وعدم السماع للانفلات الثقافي والمعرفي دون منهج أو متكئ منهجي صحيح يتم الانطلاق منه، والبعد عن الشعارات والنزعات السطحية التقليدية في مواجهة هذه التحديّات الكبرى، وعدم تصدّي غير الكفاءات العلميّة في هذه المواجهة الكبرى.
وهذه المواجهة تتطلب عمل مؤسسي وليس عمل فردي أو أفراد، وليتم هذا العمل فإننا بحاجة لعدة أمور كمقدمة:
1. نبذ الخلافات الإثنية، مذهبية كانت أو عصبوية أو قومية، والالتفاف حول هدف ومشتركات مصيرية ووجودية يشترك فيها الجميع، وأهداف عُليا يتفق عليها الجميع، وأعني بالجميع هنا، جميع النخب المهتمة لمواجهة الاستلاب.
2. التركيز على الأهداف العليا، وعدم خوض معارك جانبية لا تحقق الغاية الكبرى في “جهاد التبيين”، هذا التركيز يتطلب ترك النزعة الخلافية ضمن إطار “إما” “أو”، والانتقال لمنهج الاحتمال خاصة المعرفي منه والثقافي، الذي يعمل على ترجيح احتمال على آخر وفق المعطيات الميدانية والأدلة الموجودة، مع إبقاء الباب مفتوحا على الاحتمالات الأخرى، التي قد تكشف التجربة رجاحتها مع التقادم، وهو ما يفتح الباب أمام كل النخب الصادقة والمهتمة بمختلف انتماءاتها الفكرية، لتصب جهودها في هذا الصدد.
3. القبول بالنقد والتقييم للموروث الثقافي والمعرفي، وفق أسس وقواعد منهجية من قبل المتخصصين، وتضافر الجهود لتبين زوايا النظر في ذلك، وعدم اقتصار ذلك على متخصص دون آخر، هذا فضلا عن بناء مشروع تجديدي منصف، لا يعادي التراث بالمطلق، ولا يرفض النظر والاستفادة من التجربة الغربية والبشرية بشكل عام بالمطلق، بل تكون القاعدة ” أين يميل الدليل نميل”، فالبرهان منطق قرآني في إثبات الحقائق، وكبريات القضايا، والبناء وفق هذه الحقائق المنهج الذي يمكن أن يُقَوّم مسار الأمة والشعوب.
وهذا أيضا لا يتم بجهد فردي، بل بتظافر الجهود المخلصة وهو ما يتطلب الانتقال من ثقافة المصلحة الذاتية، إلى مبدأ المصلحة العام، الذي تذوب في سبيله كل المصالح الخاصة، وهل هناك مصلحة أهم من الدفاع عن كينونة هذه الأمة بين الأمم وهويتها وثوابتها وقيمها ومعاييرها المرجعية، التي تحفظ ماضيها وحاضرها ومستقبلها، بل تحفظ حاضريّتها بين الحضارات والأمم الأخرى؟ فما هي أهمية المصلحة الذاتية وما هو حجمها أمام أهمية وحجم هذه المصلحة العليا؟
4. رسم حدود تَدخّل الدين، وحدود تدخل العقل، وعدم رفض أي مصدر معرفي من مصادر المعرفة، بحجج مستوردة من تجارب أخرى، بل فهم طبيعة ما يمكن للدين أن يقدمه من خير للبشر، وما يمكن للعقل أن يقدمه من خير للبشر، وهو ما يجعل معارفنا أشمل وأوسع وأكثر إحاطة بالواقع.
5. العمل على بلورة نظرية معرفية منتزعة من سياقنا العربي والإسلامي المعرفي والثقافي في المجال الديني والثقافي السياسي والاقتصادي، مع الاستفادة من تجارب الآخرين نقدا وتقييما، فكما خاض الغرب مخاضاته المعرفية والتجريبية الخاصة وبلور وفق هذه التجربة رؤيته حول الكون والطبيعة والإنسان، فمن حقنا كذلك أن نبلو رؤيتنا الخاصة حول الكون والإنسان والطبيعة، ونعمل على تنظيم حياتنا وفقها، من منطلق التعدد لا الإقصاء، ومن منطلق الاحترام والندية، لا الفوقية والاستعلاء. ومن الثابت جدا اختلاف الرؤية الكونية بين العالم العربي الإسلامي وبين العالم الغربي، هذا الاختلاف الواضح والبيّن يجب أن يقر به الجميع، وهذا الإقرار ليس فقط على مستوى النظر، بل على مستوي التقنين والحقوق والسياسات العامة، أي على مستوى الفعل من خلال احترام حقنا في بلورة نظرة حقوقية وقيمية تتناسب ورؤيتنا الكونية.
وقد تكون هناك نقاط أخرى غابت عني، ولكن هذا ما أراه كأهم محاور ونقاط اشتراك لوضع خطة عملانية، وفق السياق التاريخي الراهن، وإشكالياته المعيقة للنهضة والتقدم، وأدرك أن ما طرحته أمنيات خُطّت على هذه الوريقات، قد تجد طريقها إلى التنفيذ في راهننا، أو في القادم من الأيام، أو حتى مع الأجيال اللاحقة، والله أعلم.
السيرة الذاتية للكاتبة إيمان شمس الدين:
• كاتبة وباحثة في الفكر:
(حقوقي، سياسي، ديني)
• عضوة في منظمة front line defenders
• بكالوريوس ميكروبيولوجي ومساند كيمياء حيوي
ماجستير علم اجتماع سياسي وعنوان البحث ” المرأة والعمل السياسي في الحضارات والأديان – التكون والصيرورة.”
• مهتمة في المجال الحقوقي، من ناحية بحثية.
المؤلفات:
– في قضايا التجديد والمعاصرة (دار القارئ – مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة).٢٠١٩
– التغيير والاصلاح مطالعة في التأسيسات والمقومات والإشكاليات (دار الانتشار العربي) ٢٠١٩.
– المثقف وجدلية القهر والاستبداد (دار الانتشار العربي)٢٠٢٠.
– عقلنة الثورة وتأصيل النهضة: محاولة لقراءة الواقعة من زوايا مطلبية معاصرة (دار الانتشار العربي)٢٠٢١.
– الهوية والاستلاب: اغتراب الإنسان المعاصر.. دار روافد للطباعة والنشر، بيروت ٢٠٢٢.
– حوار حول الدين والانسان، دار روافد للطباعة والنشر، بيروت ٢٠٢٣.
– الغاية من الزواج ومسألة الرشد: مدخل إلى الإشكاليات المعاصرة، دار روافد، ٢٠٢٣.
– المثقف والاشتباك …قيد الطباعة.
Biography:
Eman Shamsaldeen
-Writer and researcher in the fields of thought (Human rights, political, religious pluralism)
⁃ Front line defender’s member
– Microbiological bachelor and biochemical as assistant branch
– Master of Political Sociology and Research.
– Interested in the field of human rights, and a human right
activist specially in the Bidon file
(Stateless).
Author of:
– In the issues of renewal and contemporary (Dar Al-Qarier – Ain Centre for Contemporary Studies and Research).Najaf 2019
– Change and reform read in the establishments, components, and problems (Arab Spread House) Beirut 2019.
– Intellectual between the dialectic of oppression and tyranny (Arab Spread House) Beirut 2020.
– Rationalizing the revolution and rooting the renaissance: an attempt to read the incident from
contemporary demand angles (Dar Al-Arab Spread) Beirut 2022.
– Identity and Disengagement: The Alienation of Contemporary Man. Rawafed House for Printing and Publishing, Beirut 2022.
– Dialogue on Religion and Man, Dar Rawafed Printing and Publishing, Beirut 2021.
– The Purpose of Marriage and the Question of Progence: An Introduction to Contemporary Problems, Dar Rawafed, 2021.
– Intellectual and clash, Dar Rawafed,2024.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي