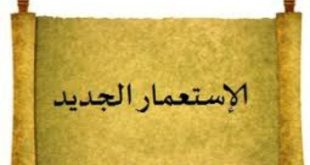لعلّ السبب الأساس في أن الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني لا تزال متعثِّرة، هو أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّل رؤيتهم ضمن هذا السياق.
الاجتهاد: الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني ليست دعوةً جديدة، بل أطلقها عددٌ من القيادات الدينية الواعية منذ مطلع العصر الحديث، كالسيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، وصولاً إلى السيد محمد باقر الصدر والإمام الخميني والسيد محمد الشيرازي والسيد فضل الله والشيخ شمس الدين والشيخ محمد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي وآخرين من أعلام السنّة والشيعة.
ولا ينكر أثر الجهود التي بذلها هؤلاء وأمثالهم في إعادة الثقة بالدين في أوساط أبناء الأمة، وإظهار جدارة الإسلام بقيادة الحياة، وتغيير مساحة من ذهنية وتفكير الوسط الديني.
لكنّ هذه المحاولات لا تزال متعثِّرة، ومرتبطة بجهود وإمكانات أصحابها، دون أن تتحوَّل إلى مسار ومنحى في مراكز القرار والفتوى والإدارة الدينية على مستوى المجتمعات الإسلامية.
ولعلّ السبب الأساس أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّل رؤيتهم ضمن هذا السياق.
صحيحٌ أن علماء معاصرين قد أطلقوا مقولات ونظريات جديدة في علمي الفقه والأصول، لكنّها لم تتبلور، ولم تشقّ طريقها إلى العقل الفقهي العامّ. ومن نماذجها: مقولة تأثير الزمان والمكان على عملية استنباط الأحكام، ومقولة الفرز بين الأحكام التشريعية والتدبيرية، ومقولة منطقة الفراغ التشريعي، ومقولة تاريخية النصّ الديني.
ونشير هنا بإيجاز إلى الفكرة التي دعا إلى مناقشتها الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وهي أنّ النصوص الدينية المرتبطة بحركة الحياة قد لا تكون مطلقة وعامة في الزمان والمكان والأحوال، كما هو الحال في النصوص الشرعية المرتبطة بالعبادات. وقد درج الأصوليون والفقهاء على اعتبار أنّ الوضع الأصلي للنصّ هو الوضع الذي وصل إلينا، إنْ كان عامّاً أو مطلقاً فهو كذلك أبداً، وإنْ كان خاصّاً أو تعبّداً فهو كذلك أبداً، ولا يرفع اليد عن إطلاقه أو عمومه أو خصوصه إلاّ بدليلٍ مخصِّص، أو مقيِّد، أو ملغٍ للخصوصية، يسمح بالتعميم والإطلاق.
ويرى شمس الدين أنّ هذا المبدأ الأصولي لا غبار عليه، ولا رَيْب فيه، لكنّه يدعو للنظر والمناقشة في إطلاقية هذا المبدأ وثباته بالنسبة إلى جميع النصوص التشريعية.
ويتساءل: هل جميع نصوص السنّة ـ في غير العبادات ـ تُعبِّر عن تشريعات ثابتة في عمومها أو إطلاقها أو خصوصها أو تقييدها، بحيث لا يمكن تكييفها بتخصيصها أو تقييدها بالحالات الطارئة على المجتمع والأمّة، لا بالعناوين الثانوية، بل باعتبار أصل التشريع؟
ففي الشريعة نصوصٌ تشريعية ثابتة ومطلقة في الزمان والمكان والأحوال، وفيها نصوص تعبِّر عن تشريعات اقتضتها ظروف الزمان أو المكان أو الأحوال، فهي نسبية بنسبية ظروفها وأحوالها ومكانها وزمانها.
وفي هذه الحالة يرى شمس الدين أنّ على الفقهاء ـ في عملية الاجتهاد والاستنباط ـ أن لا ينظروا إلى النصّ على أنه تشريعٌ مطلق على كلِّ حالٍ، عليهم أن يفسحوا مجالاً للنظر في كونه تشريعاً «نسبيّاً» لحالٍ دون حال، وظرفٍ دون آخر، وأن يبذلوا جهودهم في اكتشاف حقيقة الحال من هذه الجهة، وأن لا يكتفوا بكون النصّ وصل إلينا مطلقاً ومجرَّداً عن الخصوصيات في الحكم بإطلاقه في الزمان والمكان والأحوال والأقوام، وشريعة للأمّة كلّها في جميع أزمانها وأحوالها وظروفها وتقلُّباتها، فيجمدوا عليه كذلك في مقام الاستنباط.
ويضيف شمس الدين: إنّ ممّا ينبغي أن يُعزِّز هذه النظرة «المتحرّكة» إلى النصوص التشريعية ما نصّ عليه كثيرٌ من أعاظم الفقهاء من أنّ «التعبُّد الشرعيّ» المقتضي للجمود على النصّ معلومٌ في باب العبادات فقط؛ وأما في أبواب المعاملات بالمعنى الأعمّ فإنّ «التعبُّد الشرعيّ» غير معلوم الثبوت فيها، بل معلوم عدم الثبوت في جميعها([49]).
هذه المقولات وأمثالها لو بذل جهدٌ كافٍ في الوسط العلمي لمناقشتها وبلورتها وتقعيدها علميّاً؛ لتصبح كسائر القواعد والمباني الأصولية والفقهية، لأمكن لها أن تعطي دَفْعاً وزَخْماً كبيراً لتوجُّهات التطوير والتجديد.
وهناك عوامل أخرى تجب معالجتها على هذا الصعيد. ومن أبرزها عاملان، هما: غياب مؤسّسات البحث العلمي؛ وصعوبات التعبير عن الرأي الجديد.
المصدر: نصوص معاصرة، قسم من مقالة بعنوان: الثابت والمتغيِّر في الأحكام الشرعيّة للشيخ حسن الصفار
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي