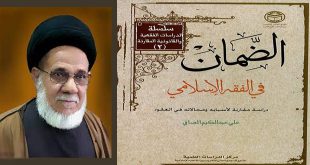الاجتهاد: هناك موضوع لم يُناقَش في الفقه بشكل مستقل وشامل وكامل، وهو: هل الضمان يشمل عمر الإنسان؟ فإذا أتلف الشخص عمر إنسان آخر فهل هو ضامن أم لا؟ وهل هناك ضَمان بالنسبة للطالب الذي سُجن لفترة طويلة -عن حق أو عدواناً- وبسبب ذلك خسر سنة دراسية من حياته؟ وإذا قلنا بالضمان في كل هذه الحالات، فكيف يُحسب مقدار الضمان؟ وما هو أسلوب قياس قيمة الوقت والعمر بالنسبة للطالب، أو العامل، أو التاجر؟ إن هذه الأسئلة وعشرات غيرها تتطلب فتح باب جديد في الفقه للبحث عن ضمان الزمن وضمان العمر (على غرار ضمان المال)، ذلك لأنّ العقل يحكم بأنّ عمل الحرّ مضمون، وأنّ أي إضرار به يستوجب الضمان وجبر الخسارة.
الضمان موضوع عقلي – شرعي، يُبحث عادة في عدد من الأبواب الفقهية والحقوقية كالغصب والبيع والإجارة و… ومن الثوابت أن من أتلف شيئاً من أموال الغير بأي شكل من الأشكال فهو ضامن، وقد استدل الفقهاء بروايات عديدة على هذا الموضوع، واستخرجوا منها القاعدة التالية: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» وقد عُرفت هذه القاعدة في الدراسات الفقهية بقاعدة «مَنْ أتلف» أو «قاعدة الإتلاف»، وهي قاعدة صحيحة تطابق العقل، وتُعدُّ عصارة مجموعة من الروايات في هذا المجال.
وفي باب «الغصب» يُصرِّح الفقهاء بأن الغاصب يتحمل مسؤولية وتبعات عمله بأشد الوجوه حيث يجب عليه إعادة المال المغصوب إلى مالكه مهما كلَّف الأمر. من هنا فقد قالوا: لو غصب حجراً ووضعه في قاعدة عمارة، أو غصب خشباً واستخدمه في بناء سفينة وكان الحجر أو الخشب باقياً غير تالف، كان على الغاصب ردهما إلى المالك حتى لو أدى ذلك إلى خراب البناء، أو تضرّرت السفينة. أما إذا كان الشيء المغصوب تالفاً كان عليه ردّ القيمة أو المثل إلى المالك وفق شروط مفصّلة مذكورة في الفقه. كل هذا يكشف عن مدى حرمة أموال الناس في الإسلام.
ومن جهة أخرى فإن جسم وحياة الإنسان يحظيان باهتمام الشريعة الإسلامية أيضاً، ولذلك فإن ضمان الجسم والحياة من الموضوعات التي يناقشها الفقه في أبواب الديات والقصاص، حيث يتم البحث عن دية الجراح بأنواعها المختلفة ودية الأعضاء، والجوارح كلها، وبالتالي دية القتل.
كل ذلك يدل على أن الإنسان وكل ما يرتبط به له قيمته في الإسلام، وأن أي إضرار أو إتلاف يُلحَق به أو بما يتعلق به يوجب الضمان.
إلاّ أن هناك موضوعاً آخر لم يُناقَش في الفقه بشكل مستقل وشامل وكامل، وهو: هل الضمان يشمل عمر الإنسان؟ فإذا أتلف الشخص عمر إنسان آخر فهل هو ضامن أم لا؟ فمثلاً: شخص تاجر يكتسب رزقه من خلال محل تجاري يملكه، فسُجن في قضيةٍ ما وعُطِّل محله التجاري، ثم تبيَّن أن إيداعه السجن كان خطأً ولم يكن مذنباً، فهل الزمن الذي ضاع منه، والفُرَص التي خسرها، تكون مضمونة؟
وهكذا الأمر بالنسبة لعامل أو موظف خسرا أعمالهما بسبب السجن خطأً أو عدواناً، فما هو حكمهما؟ وهل هناك فرق بين عامل عادي يبحث عن العمل بشكل حر، وبين العامل الموظّف رسميًّا الذي يعمل في دائرة حكومية أو شركة خاصة وبراتب معين؟ ذلك لأن وقت العامل الثاني له قيمة معينة، وحرمانه من العمل يؤدي إلى الإضرار به ضرراً معنيًّا واضحاً. وأيضاً: هل هناك فرق بين السجين الذي يُجبر على العمل في السجن، وبين السجين العاطل عن العمل في داخل السجن؟
وهل هناك ضمان بالنسبة للطالب الذي سُجن لفترة طويلة -عن حق أو عدواناً- وبسبب ذلك خسر سنة دراسية من حياته؟ وإذا قلنا بالضمان في كل هذه الحالات، فكيف يُحسب مقدار الضمان؟ وما هو أسلوب قياس قيمة الوقت والعمر بالنسبة للطالب، أو العامل، أو التاجر؟
إن هذه الأسئلة وعشرات غيرها تتطلب فتح باب جديد في الفقه للبحث عن ضمان الزمن وضمان العمر (على غرار ضمان المال)، ذلك لأنّ العقل يحكم بأنّ عمل الحرّ مضمون، وأنّ أي إضرار به يستوجب الضمان وجبر الخسارة.
عمر الحر.. هل له قيمة؟
لم يقدّم الفقهاء السابقون أي دليل مقبول على رأيهم بعدم ضمان الحر وعدم ضمان وقته وعمره. قال بعضهم: إتلاف مال الغير له ضمان، ولكن عمل الحر ووقته ليس مالاً. والجواب عن هذا القول: أن قاعدة «من أتلف» قاعدة عقلائية وهي ترتبط بالأموال، ولكنها لا تشمل وقت الأشخاص لا نفياً ولا إثباتاً. وقالوا أيضاً: إنّ عمل الحر لا يخضع للقياس والتقييم، ولكن يُجاب عليهم: لقد أصبح اليوم كل شيء ممكن القياس والتقدير، وبالإمكان الالتزام بالمعدّل (أو الحد المتوسط) قاعدةً للحكم.
ويمكن القول: إنّ قيمة عمل الحر ووقته هي أغلى وأسمى من معاوضتها بالمال. ولكن الرد على ذلك أنه عندما يبادر الحر إلى تأجير نفسه ويبيع عمله كل يوم للآخرين بإزاء مال معين، فإن باستطاعة الحاكم الإسلامي أيضاً أن يتعامل معه كذلك انطلاقاً من قاعدة «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، ذلك لأن قاعدة الإلزام هي الأخرى قاعدة عقلائية ينبغي البحث حولها وتنقيحها في موضع آخر.
على كل حال، فإن المهم هنا هو ضرورة فتح باب جديد في الفقه للبحث عن هذا الموضوع، حتى يمكن عرض آراء الموافقين والمخالفين لضمان الوقت، وبحث الفروع والصور المختلفة للمسألة وتنقيحها بشكل كامل.
وهنا لابد من الإشارة إلى نقطتين:
1- لا يجوز أن تستولي علينا الخشية من الولوج في هذا النوع من الأبحاث، بدعوى أن مثل هذه الموضوعات سيؤدي إلى ظهور «فقه جديد»، وبذلك نلقي المسؤولية عن كاهلنا ونتهرّب من الموضوعات الجديدة أو نُدين البحث فيها، ذلك لأن موضوع «الغصب» نفسه الذي يُعدّ اليوم من المسائل الفقهية المهمة، كان في البداية موضوعاً محدوداً جدًّا، بحيث لو وُجد في الكتب الفقهية المتقدمة للاحظنا أن بحثه لم يتجاوز عدة سطور فقط،
والروايات الواردة حول الغصب هي قليلة وعامة، وإنّ توسّع الموضوع في الكتب الفقهية المعاصرة، خاصّة في كتاب جواهر الكلام (حوالي 240 صفحة)[2] إنما جاء بسبب طرح المسائل العقلية المتعلقة بالغصب وإضافة تفريعات جديدة. والجدير بالذكر أن الروايات القليلة الواردة حول الغصب يمكن الاستفادة منها في مجال ضمان الوقت وغيره أيضاً.
2- يقول بعض الفقهاء: إن سبب عدم ضمان عمل الحر (أو وقت الحر وعمره) هو أنه لا ينضوي تحت عنوان الغصب، ذلك لأن الغصب هو التصرف العدواني أو التصرف بدون حق في مال الغير. والإنسان الحر وكذلك وقته وعمره ليس مالاً حتى يُعدّ التصرف فيه من دون حق غصباً، إذن فالضمان منتفٍ من جهة الغصب، لا أنه لا وجود للضمان أصلاً[3].
يقول المرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي في كتاب «العروة الوثقى»:
«مسألة: إذا استأجره لقلع ضِرْسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، وكان المؤجِّر باذلاً نفسه استقرت الأجرة، سواء كان المؤجِّر حرًّا أو عبداً بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول، لأنّ منافع الحر لا تُضمن إلاّ بالاستيفاء، لا وجه له. لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالاً للمستحِق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه.
مع أنّا لا نُسلِّم أنّ منافعه لا تُضمن إلاّ بالاستيفاء، بل تُضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنه فوّت عليه كذا مقداراً. هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد، لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذٍ»[4].
باستطاعتنا أن نستخرج من هذه المسألة عدة أدلة لموضوع ضمان الزمان. ولأن الفقهاء المعاصرين يعلّقون عادة على كتاب العروة الوثقى، فباستطاعتنا الحصول على آرائهم في هذا المجال أيضاً.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا العنوان هو موضوع مستنبط ومن تفريعات مسألة الضمان، ولا يوجد هذا العنوان في الآيات والروايات، رغم وجود بعض الأدلة العامة من الكتاب والسنّة التي يمكن لهذه المسألة أن تُعتبر من الجزئيات المشمولة بها، وسوف نشير إليها فيما بعد. وهدفنا في هذه الدراسة هو الإشارة إلى بعض الأدلة بإجمال، حتى يُفتح الطريق لبحوث ودراسات أعمق من قِبَل الباحثين والمحققين.
عبارة العروة:
جاء في المسألة السالفة ما يلي:
«إنّا لا نُسلِّم أن منافعه [أي منافع الحر] لا تُضمن إلاّ بالاستيفاء، بل تُضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك…».
هذه العبارة صريحة في أنه إذا أتلف شخص عُمْر إنسان حر آخر كان باستطاعته أن يقوم بعمل نافع ومفيد في ذلك الزمان التالف، وكان العمل متوفراً أيضاً، كان المتلف ضامناً للمكاسب التي كان باستطاعة الحر الحصول عليها في ذلك الزمان.
وبهذا الرأي الفقهي تتضح لنا الإجابة على الكثير من التساؤلات التي طرحناها في المقدمة، وانطلاقاً من هذا يمكن القول: لو تم -مثلاً- حبس طبيب يكسب كل يوم مائتي دولار في عيادته الطبية ومنعه عن مزاولة عمله لعدة أيام، فالحابس يضمن للطبيب مائتي دولار عن كل يوم.
وهكذا الأمر بالنسبة لحبس عامل يكسب كل يوم عشرة دولارات أجراً على عمله، فإذا حبسه شهراً واحداً وكان العامل يعمل عشرين يوماً في الشهر، فعلى الحابس أن يدفع مائتي دولار عن حبسه ومنعه من اكتساب الأجرة خلال هذه الفترة.
ويُفهم من عبارة العروة أن حبس الإنسان العاطل عن العمل لا ضمان له، ذلك لأنه لم تكن له منفعة حتى تُفوَّت عليه. والنقطة الأساسية التي تُستنبط من عبارات العروة أن قيمة أوقات الأشخاص المحبوسين والممنوعين عن العمل ليست متساوية، بل يتوقف تحديدها على مقدار ما كان باستطاعة كل شخص أن يكتسب من فوائد في الحالات العادية.
ولقد راجعنا تعليقات أكثر من عشرين فقيهاً معاصراً على «العروة والوثقى» ووجدنا أن سبعة منهم فقط يعارضون ضمان الحرّ ولا يرون ثبوت الضمان في حالة تفويت منفعته، وعباراتهم هي من قبيل: «مُشكل، بل الظاهر عدم الضمان»، أو «في ضمانه نظر»، أو «الأظهر عدم الضمان، فإنّ مجرد صدق التفويت لا يوجب الضمان»، أو «التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان، وعليه فلا ضمان على الأقوى»[5].
وقبل مواصلة البحث نلفت انتباه القارئ إلى أمرين مفيدين:
أولاً: إن عدد الفقهاء الموافقين مع نص العروة الوثقى حيث لم يعلِّقوا عليها هو أكثر من عدد المخالفين.
ثانياً: إن المخالفين لم يكن لهم دليل قاطع على رأيهم، بل هم مترددون في القبول أو الرفض، ولذلك فقد استخدموا عبارات الترديد، من مثل: «مشكل» أو «الأظهر كذا» أو «الأقوى كذا» ويبدو أنهم يستندون في موقفهم هذا على أن التفويت ليس من أسباب الضمان، وسوف نتحدث فيما بعد عن هذا البُعد.
وأطول تعليق على المسألة هو ما كتبه الشيخ ضياء الدين العراقي (المتوفى 1361هـ) وذلك بعد عبارة «بل تُضمن بالتفويت» حيث يقول:
«في ضمانه نظر، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم، فلا يشمله إتلاف مال الغير، وإن كان مثل هذه الأعمال والمنافع أيضاً من الأموال، ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد، وبذلك يفرق حبس الحرّ غير المستأجَر عليه من حبسه المستأجَر أو المملوك لغيره من العبيد والإماء بالتضمين في الأخيرين دون الأوّل»[6].
ويقول صاحب «العروة الوثقى» في المسألة المذكورة نفسها: «واحتمال الفرق بينهما (أي الحر والعبد) بالاستقرار في الثاني دون الأول؛ لأنّ منافع الحر لا تُضمن إلاّ بالاستيفاء لا وجه له، لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالاً للمستحق»[7].
هنا لابد من لفت النظر إلى أنّ العقد أمر اعتباري، وليس له أيّ دور في الأمور التكوينية، بل إنّ حاكميته لا تتجاوز الأمور الاعتبارية، من هنا فإذا قلنا بأن منافع الحر تصبح ملكاً للمستأجِر بعد العقد، فهذا يعني أن منافع الحر كانت مالاً قبل العقد أيضاً، ولكن بفارق أنها لم تكن مالاً للمستحِق (المستأجِر مثلاً) بل كانت عائدة للحر نفسه، لا أنّ العقد أضفى المالية على شيء لم يكن مالاً قبل ذلك. وعلى سبيل المثال: إنّ عقد البيع لا يحوِّل المبيع المعدوم إلى شيء موجود، بل تنقل المبيع الموجود والذي كان ملكاً للبائع إلى المشتري، وهكذا الأمر بالنسبة لعقد الإجارة حيث لا يؤدي العقد إلى إيجاد منفعة معدومة بل تنقل المنفعة الموجودة التي كانت من حق المؤجر، إلى المستأجِر.
بناءً عليه، ينبغي لصاحب العروة وسائر الفقهاء المعلِّقين على العروة، الذين لم يعلِّقوا شيئاً على هذه الفقرة من المسألة، أن يقبلوا بأنّ منافع الحر مال، وإتلاف المال بأي شكل من الأشكال يستوجب الضمان. وهذا هو «ضمان الزمان» الذي نسعى من أجل إثباته ونريد القول بأن إتلاف عمر الآخرين الذين كان بإمكانهم أو كانوا يريدون صرفه في تحصيل المعاش، يُعدّ إتلافاً لشيء ذي قيمة، يُنفق العقلاء بإزائه المال عادةً.
ولكن للفقهاء المتقدمين رأي آخر يختلف عن رأي صاحب العروة وسائر الفقهاء المعاصرين. فمثلاً: يقول المرحوم المحقق الحلّي في كتابه المعروف «شرائع الإسلام» في باب الغصب: «والحرّ لا يُضمَن بالغصب ولو كان صغيراً..
ولو استخدمَ الحُرَّ، لزمه الأجرة. ولو حبس صانعاً لم يضمن أجرتَه، ما لم ينتفع به، لأنّ منافعه في قبضته. ولو استأجره في عملٍ فاعتقله ولم يستعمله، فيه تردّد، والأقرب أن الأجرة لا تستقر، لمثل ما قلناه»[8].
يقول صاحب الجواهر في شرحه على (شرائع الإسلام) عند ذكر عبارة: «والحرّ لا يُضمَن بالغصب ولو كان صغيراً»:
«لا عيناً ولا منفعة [أي لا يُضمن لا عينه ولا منفعته] بلا خلاف محقَّقٍ أجده فيه، على معنى كونه كغصب المال الموجب للضمان، وإن مات حتف أنفه، بل ولا إشكال، ضرورةَ عدم كونه مالاً حتى يتحقق فيه الضمان»[9].
ويبدو من الأدلة التي يسردها صاحب الجواهر أنه لا يوجد نصّ خاص أو أي دليل تعبدي على هذا الرأي، بل لأنهم يرون الضمان في الأموال، وليس الإنسان الحر ومنافعه مالاً حسب رأيهم، ولذلك فإن الغصب لا يصدق عليه، وبالتالي فإن الضمان بوصفه حكماً وضعيًّا لا ينطبق عليه.
ويتّضح هذا الأمر بشكل أفضل من عبارات الشهيد الثاني في كتابه «مسالك الأفهام» عند شرح المسألة المذكورة نفسها في الشرائع، حيث يقول:
«المضمون بالغصب قسمان: أحدهما ما ليس بمال وهو الحرّ، فيُضمن بالجناية على نفسه وطرفه مباشرة وتسبيباً، والقول في هذا القسم محلّه الجنايات. وكذا يُضمن باستيفاء منفعته بأن استخدمه، ولا يُضمن بالفوات لأنّ الحر ليس مالاً فلا يدخل تحت اليد، فلا يضمنُ [الغاصبُ] نفسه بالهلاك، إذا لم يكن من قِبَل الغاصب، سواء مات من قِبَل الله تعالى أم بسبب من خارج كالحرق والغرق، لاشتراك الجميع في المقتضي»[10].
وواضح أنّ هذا الكلام ليس من الأحكام التعبّدية الإلهية، ولا توجد أية نصوص من الكتاب أو السنّة تدل عليه، بل مستندهم في ذلك هو: أنّ الحرّ ليس مالاً. من جهة أخرى إن (الإنسان الحرّ) المعنيّ في رأيهم هو القادر على الدفاع عن نفسه، وإلاّ لم يكن مبرّر لعبارة (ولو كان صغيراً). ويبدو أن المقصود بالمسألة في نظرهم هو الحبس الشخصي حيث يقوم شخص بحبس آخر ومنعه من مزاولة حياته العادية لعدة ساعات أو لعدة أيام، ولم يكن بحثهم متجهاً للسجون الطويلة العريضة الحكومية.
على أي حال، إن مستنَد هؤلاء الفقهاء كان في رأيهم بدرجة كبيرة من القوّة بحيث لم يعيروا أيّ اهتمام للرواية القائلة: «من استعار حرًّا صغيراً فَعِيبَ فهو ضامن»[11]. ولابد من الإشارة هنا إلى أنّ في سند الرواية ضعف، إذ فيها وهب بن وهب وهو أبو البختري الكذَّاب، ولكن عدم إعارتها أي اهتمام حتى الإشارة إليها يكشف عن قوّة دليلهم من وجهة نظرهم هم.
ولكننا نرى أنّ مستند الفقهاء العظام مخدوش، ذلك لأنهم لم يستندوا في رأيهم إلى دليل من الكتاب أو السنّة، بل استندوا إلى بعض الأدلة والاعتبارات العقلية فقط، ومن المستبعَد جداً بل من المحال في عصرنا هذا أن يقول عرف العقلاء: إذا قامت جهة ما (سلطان، حاكم، حكومة، عادلة أو ظالمة…) باعتقال شخص من أبناء المجتمع وإيداعه السجن لفترة (طالت أو قصرت) ثم ثبتت براءته من التهمة المنسوبة إليه، أو ثبت أن عقوبته كانت شيئاً آخر غير السجن، وقد أدّى حبسه إلى اضطراب حياته المعاشية، فلم يستطع حتى توفير نفقات عائلته العادية في تلك الفترة، ولكن لأن السجين كان إنساناً حرًّا فإن السجّان (أيًّا كان) لا يتحمل أية مسؤولية تجاهه. فلا أحد من العقلاء يقبل بأن حبس حماره -مثلاً- يستوجب الضمان وباستطاعته مطالبة الحابس بالأجرة، أما حبسه هو فلا يستوجب أيّ ضمان!
المطلوب: تأسيس القاعدة
إن قاعدة «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» تكشف عن أنّ حرمة وقيمة دم الإنسان المسلم أصل ثابت لا يتغيّر، ولا يناقش فيه أحد، ولذلك فإنّ حرمة المال تُقاس على حرمة الدم، وقد نوقش في محلّه (في دراسات أخرى) أنّ كون الإنسان مسلماً ليس له موضوعية في هذه القاعدة بل إنّ دم كل إنسان له قيمة وحرمة في الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه.
ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن أساس الملكية الاعتبارية تنبع من الملكية الحقيقية، أي: لأن الإنسان هو مالك حقيقي لعينه، وأذنه، ويده، ورجله، وعمره، وعقله، وبواسطة هذه كلها يحصل على المال، فإنه يُعدّ مالكاً اعتباريًّا للمال، إذن فلا يمكن أن يكون الإضرار العمدي أو الخطأ بالعين والأذن والعقل وسائر الجوارح، وكذلك تفويت أو إتلاف المال يستوجب الضمان، في حين أن الضمان لا يشمل الزمان والعُمر الذي يصرفه الإنسان للحصول على المال.
بناءً على هذا فإنّ الأصل الأولي هو: كما أن دم الإنسان وأعضاء بدنه وأمواله ذات قيمة، وتفويتها يستوجب الضمان، فإن لوقت الإنسان قيمة أيضاً، كما أن إتلافه وتضييعه يستوجب الضمان. إذن، فإذا كان هناك من لا يرى قيمة لعمر ووقت شخص أو فئة اجتماعية معينة فعليه أن يُقيم الدليل على ذلك، وفي حالة عدم إقامة الدليل فإن الأصل الأولي الذي ذكرناه يكون هو الحاكم.
أجل، لو كان بين أيدينا دليل قوي وثابت من الشرع، لكان من السهل علينا القبول بهذه الفوارق، أما عندما لا نملك الدليل، بل إن الأدلة العامة في مجالات العدالة، والجزاء، والضمان وغيرها يُستلهم منها وجود الضمان بالنسبة للزمان والعمر، ومن جهة أخرى هناك الكثير من الروايات التي لا تسمح بإهانة وتحقير الجاني، بل تسمح للجاني أن يقتصّ من منفِّذ الحكم إذا ما أخطأ وضربه سوطاً إضافيًّا[12]، كل هذا يدل على أن مثل هذه الشريعة لا يمكن أن تحكم بعدم ترتب أي حكم وضعي على حبس الشخص ومنعه من مزاولة حياته المعاشية العادية، لمجرد أنه حرّ وليس بعبد، حتى لو مرض الشخص أو مات في السجن بسبب الأذى الروحي، والهمّ، والقلق، والاضطرابات النفسية وغيرها، فلا يكون الغاصب (الحابس) ضامناً لأنّ المرض أو الموت لم يكن بفعل مباشر منه.
ولو كان هناك دليل شرعي لذكره الفقهاء المتقدمون في كتبهم، ومع عدم وجود الدليل وإعادة الأمر للعرف والعقلاء، فإن العرف والعقلاء لا يقبلون هذا التحقير والظلم. وبالطبع ربما لا نستطيع أن نحكم على غاصب الحرّ (أو حابسه) بالقصاص، ذلك لأنه، إضافة إلى عدم وجود نية القتل لدى الغاصب، من المحتمل أن يكون الضعف الروحي للحرّ المحبوس له دور أيضاً في مرضه أو موته. إذن، فبعد القبول بأصل الضمان، فإن تحديد مقدار الضمان في كل مورد يتوقف على رأي خبروي دقيق. وفي عالم اليوم، وُضِعت قواعد دقيقة لقياس كل شيء، من ذلك القواعد الخاصة بالسجون، وكيفية بنائها، والمقادير التي ينبغي أن يتمتع بها المحبوس من الهواء، والضياء، والغذاء، والإمكانات الرفاهية، وغير ذلك مما له مدخلية مباشرة في تحديد مقدار الضمان، ولا شك في أنّ مثل هذه القواعد والمعايير هي مورد قبول العقلاء.
يقول المحقق الحلّي (رضوان الله تعالى عليه) في المسألة السابقة: «ولو حَبَس صانعاً لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به»[13].
ويقول صاحب الجواهر بعد هذه العبارة: «فضلاً عن غير صانع، بلا خلاف أجده فيه، بل في الكفاية هو مقطوع به في كلام الأصحاب»[14].
ويبدو من الفقرة التالية لعبارة المحقق الحلّي أن هذا الحكم هو الآخر ليس تعبديًّا، إذ إن أدلته اجتهادية وعقلائية، حيث يقول مستدلاً على رأيه: «لأنّ منافعه في قبضته».
ويعلِّق الشهيد الثاني على هذه العبارة قائلاً: «بخلاف العبد، فإنّ منافعه في قبضة سيّده، فكان غصبه كغصب منافعه»[15].
هنا لابدّ أن نقول: إذا اتضح لنا الفرق بين العبد والحرّ في هذا المجال، وإذا اتضح لنا المقصود بعبارة «منافعه في قبضته»، نكون قد خطونا خطوة مهمة في الموضوع.
ويبدو لنا اليوم أن الحكومات حينما تعتقل شخصاً ما وتودعه السجن، فإنه في الواقع يكون مسلوب الاختيار ولا تكون منافعه في قبضته، بل يلقى به في السجن عاطلاً عن العمل غير قادر على اختيار طريق للاستفادة من منافعه.
يقول صاحب الجواهر -مازجاً بين شرحه وبين عبارات المحقق الحلي-: «لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد على وجهٍ تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعاً، بل (منافعه في قبضته) كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان، وإن ظَلَم وأثمَ [الغاصب] بحبسه أو منعه عن العمل»[16].
ولأن الموضوع عقلي محض ولا يوجد أي تعبُّد في البين، فإننا نوضّح الموضوع بالمثال التالي: إذا غُصب عبدُ إنسان أو حيوانه، فكما يُعدّ العبد أو الحيوان مغصوباً فإن منافعه كذلك مغصوبة، وينبغي أن تُردّ على صاحبه كما يُردُّ هو، حتى إنّ منافعه غير المستغَلَّة لها الحكم نفسه أيضاً، ذلك لأن الغاصب بغصبه للحيوان أو العبد تسبب في إتلاف منافعه التي تُعدّ من أموال وممتلكات المالك التي يكسبها بالتدريج[17].
هذا الأمر يُعدّ مقطوعاً به بين كل الفقهاء تقريباً. أما إذا وضعنا الإنسان الحرّ مكان العبد أو الحيوان في المثال المذكور، نجد أن فتوى الفقهاء يقول بأنّ غصبه لا يستوجب الضمان لا بالنسبة لحبسه ولا بالنسبة لمنافعه. وإذا طالبناهم بالدليل الذي يبرِّر هذا الفارق الكبير بين الحر والعبد، أو بين الإنسان والحيوان، لسمعناهم يقولون: «لأنّ منافعه في قبضته كثيابه».
ولكن السؤال الكبير هو: هل في الحقيقة إن منافع السجين -المحبوس في سجون الحكومات- هي في قبضته؟ بل حتى ثيابه هل هي حقًّا في قبضته؟ بل إنّ السجان كما يجبره على خلع ثيابه وملابسه العادية ويُجبره على ارتداء ملابس السجن، كذلك فإنّ منافعه ليست في قبضته أيضاً، إذن فإنّ السجّان يفوِّت على السجين منافعه ويكون ضامناً لها.
والسؤال الآن: ما هو الفرق حقًّا بين العبد المحبوس والحرّ المحبوس؟ أليسا معاً يُحبسان رغماً عن إرادتهما؟ وكما استطاعت القوة الحكومية أن تسجنهما بالقهر والإجبار، فإنها تستطيع -إذا أرادت- أن تستغل منافعهما بالإجبار أيضاً، وفي هذا المورد لا فرق بين العبد والحرّ، فكما أن العبد المحبوس مسلوب الإرادة وخاضع لأمر السجّان، فكذلك الحرّ المحبوس، ولو كان الحرّ قادراً لامتنع عن دخول السجن.
وعلى كل حال فإن العقلاء لا يرون أي فرق بين الاثنين. إذن، فليس من الواضح مرادهم من أنّ «منافعه في قبضته» ذلك لأنه حين لا تكون نفس الحر السجين وحريته في قبضته، فكيف تكون منافعه في قبضته؟
من هنا، فإنّ من المحتمل قويًّا: نظراً لأنّ السلطة السياسية لم تكن بيد علماء الشيعة، ولأنّ العلماء -من جهة أخرى- كانوا يكتبون الفقه لبيان الواجبات والوظائف الفردية للمقلِّدين لا غير، فإنّ مرادهم من حبس الحرّ لم يكن سجن الأفراد على طريقة الحكومات المعاصرة، بل إنّ سجن الأشخاص لسنوات طويلة أو السجن المؤبّد لم يكن متصوّراً في تلك العهود.
إذن، فغاية ما يمكن نسبته إلى الفقهاء المتقدمين في هذه المسألة هو أنه: إذا قام شخص عادي (وليس سلطة حكومية) بحبس شخص آخر في مكانٍ مّا ولمدة قصيرة، ولم يكن قادراً على استيفاء منافع المحبوس، فإنه لا يكون ضامناً لا لمنافعه ولا أجرة عمله في هذه الفترة، وهكذا فإنّ رأي وفتوى هؤلاء الفقهاء ليست له أية علاقة بالسجون الحكومية المعاصرة التي يكون المحبوس تحت سلطة السجان بشكل كامل.
فحكم هؤلاء الفقهاء هو حكم موسمي ويرتبط بحبس الشخص ومنعه من مزاولة عمله لساعات -مثلاً- حيث يكون المحبوس فيها ذا سلطة على نفسه وثيابه وإرادته، و… وهذا التفسير الشخصي الفردي للمسألة واضح بشكل كامل في عبارة صاحب الجواهر.
وهناك احتمال آخر وهو: أن يكون المراد من حبس الإنسان الحرّ هو إتلاف وقته وعمره من دون مبرّر، كما لو طلب من الشخص أن يأتي إلى بيته لإنجاز عمل معين، ولكن عندما حضر لإنجاز العمل أشغله صاحب البيت بالكلام الفارغ ومن دون أن يتيح له مجالاً للقيام بالعمل المطلوب منه، فيكون بذلك قد أتلف وقته من دون أن يسمح له بالعمل. يبدو أنّ نزاع الفقهاء المتقدمين كان يدور حول هذا النوع من الحبس والإتلاف، وفي هذه الحالة فإنّ التفاصيل التي تُذكر في كتبهم حول المسألة من: تعيين الزمان، وهل أن الحرّ كان كسوباً أم غير ذلك، تعطي معناها الطبيعي. وإذا صحّ هذا الاحتمال فإن كلام الفقهاء المتقدمين حول عدم الضمان لا يرتبط بموضوعنا هنا.
ثم يقول المحقق الحلّي في الشرائع: «ولو استأجره في عمله فاعتقله ولم يستعمله، فيه تردد. والأقرب أن الأجرة لا تستقر لمثل ما قلناه، ولا كذلك لو استأجر دابّة فحبسها بقدر الانتفاع»[18].
أما المرحوم صاحب الجواهر، فإنّه يرى الفرق بين حالتين: بين ما «لو استأجره لعملٍ في زمانٍ مُعيَّن فاعتقله ولم يستعمله فيه» وما «لو استأجره على عملٍ (من دون ذكر الزمان) فاعتقله مدة يمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه، وبذل الأجير نفسه للعمل كذلك ولم يستوفه منه». ففي الحالة الأولى يقول: «استقرت الأجرة عليه قولاً واحداً» أي أنه يدعي الإجماع على ذلك.
ثم -بعد دعوى الإجماع- يسوق الدليل التالي: «بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن [بواسطة الأجير، وملك العمل بواسطة المستأجِر، والمفروض أنّ الأجير بذل نفسه للعمل في الزمان المعيَّن] وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر، وقد فات الزمان، والأصل عدم بطلانها [أي الإجارة] كما أنّ الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه».
أما في الحالة الثانية التي لم يُذكر فيها زمان معيّن للعمل، فيقول: «الأقرب أنّ الأجرة لا تستقر… لمثل ما قلناه من أنّ منافع الحرّ تُضمن بالاستيفاء لا بالفوات، فمنفعته في المدة المزبورة غير مضمونة على الحابس وإن بُذِلت له»[19].
هنا نطرح السؤال التالي على صاحب الجواهر: هل لتعيين الزمان في العقد أثر تكويني في الواقع الخارجي؟ وهل يُوجِد منفعةً أو يعدمها؟
فإذا كانت الاعتباريّات لا تؤثِّر شيئاً في التكوين، كما هو الحق، وإذا كانت للحر منافعه في كل الأحوال، سواء كان هناك عقد وتعيين أم لم يكن، ولكن في حالة تعيين الزمان والعمل في العقد، فإن العمل المعيَّن ينتقل إلى المستأجِر ويدخل في ملكه، في حين أنه في حالة عدم التعيين، فإن العمل والزمن يبقيان في ملك الأجير (ولو لم يكونا ملكاً له لما صحَّ عقد الإجارة عليهما) إذن، فكل من يُتلف هذا الملك وهذه القيمة الثابتة للحر، يكون ضامناً، ذلك لأن هذا الملك يُدفع المال بإزائه في عقد الإجارة أو غيرها.
أجل، قد يحدث أن يتشاجر الأجير مع المستأجر عندما يحضر لإنجاز العمل لأي سبب من الأسباب، وبسبب المشاجرة والنزاع فإن المستأجر يقرر حبس الأجير، ففي هذه الحالة يكون الأجير مذنباً -إذا ما كان هو سبب النزاع والمشاجرة- إذ يكون الممهِّد لحبسه ومنعه عن العمل، ولذلك ينبغي الرجوع إلى الخبراء والعرف، أو اللجوء إلى المصالحة بشأن الأجرة التي يستحقها في هذه الحالة.
وتعليقاً على عبارة الإرشاد التي تقول: «ولو استخدمَ الحرَّ ضَمِن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعاً» يقول المرحوم المقدس الأردبيلي: «ولعلّه ليس لهم فيه خلاف، وإن كان لِأخذ الأجرة مع منع الصانع الذي لو لم يحبسه ويمنعه لحصل كذا وكذا وجهٌ، وذلك لدفع المفاسد ودفع الضرر العظيم، فإنه قد يموت هو وعياله من الجوع، ولا يكون عليه في ذلك مانعٌ مع كونه ظالماً وعادياً، ووجود ما يدل على جواز الاعتداء بما اعتدى وجزاء سيئة سيئة»[20].
سنتحدث قريباً عن أدلته إن شاء الله، إلاّ أنّ ما ينبغي الإشارة إليه للمرة الثانية هنا هو: لأنه لم تكن هناك حكومة إسلامية شيعية من جهة، ولأنّ الفقهاء -من جهة أخرى- كان اهتمامهم منصبًّا على الإجابة عن المسائل والقضايا الفردية، يبدو أن تصوّر الفقهاء من الحبس والمنع وأمثال ذلك لم يكن السجون الحكومية المعاصرة التي لها سجّانون وإدارة ونظام غذائي وترفيهي خاص وما شابه ذلك، بل كان تصوّرهم من الحبس والمنع هو أن يقوم شخص بحبس شخص آخر في بيت أو غيره -مثلاً- حتى يمرض أو يموت هناك،
ولذلك فإن هؤلاء الفقهاء المتقدمين -كما سبق وأن ذكرنا- كانوا يقولون: «منافعه في قبضته» أو «منافعه لم تدخل تحت يدٍ كنفسه» أما اليوم فإن الشخص الحرّ كما تقع نفسه تحت يد وسلطة الحكومات فإن منافعه أيضاً هي في قبضتها وتحت سلطتها، وبإمكانها أن تستخدم الشخص وتستوفي منافعه أو تهمله وتضيِّع منافعه، بل بإمكان الحكومات المعاصرة أن تضع اسم الشخص المغضوب عليه على لائحة المنع في الكمبيوتر والإنترنت فتمنع من توظيفه وتضيِّع عليه كل فرص العمل في كل أرجاء الدولة الواحدة، بل حتى في كل العالم، رغم أن الشخص حرّ في الظاهر ويسير بحريته في الشوارع.
إذن، فإن عبارة «منافعه في قبضته» ترتبط بالحبس والمنع الفرديين، أما في العصر الحاضر فإن موضوع السجون يختلف تماماً عمَّا كان عليه الأمر في السابق، فكما أن السجين هو في قبضة الحكومة، فإن منافعه أيضاً هي تحت سلطتها وتصرّفها، ومن هذه الجهة فإن السجين الحرّ هو تماماً كالعبد في السجن.
من هنا، فإن حكم ضمان الزمان والعمر أو حكم ضمان الأجرة لا ينحصر بحالة حبس الشخص فقط، بل إذا قامت الحكومة -من دون حق- بمنع طبيب عن مزاولة عمله -مثلاً- أو طردت معلماً أو مدرساً أو أستاذاً جامعيًّا من عمله ثم منعت من توظيفه في أي مكان آخر، فإنها تكون ضامنة في كل هذه الحالات.
إشارة:
واستناداً إلى ما مرّ ربما نستطيع القول: إنّ مَن يضيِّعون أعمار الناس في الدوائر الحكومية ولا يقومون بواجبهم تجاه المراجعين، ضامنون لأوقات الناس الذين لهم أعمالهم وأشغالهم فتضيع أعمارهم ومكاسبهم بسبب تلكؤ الموظف الحكومي في القيام بواجباته ومسؤولياته،
وقد تصل الأمور ببعض المراجعين في الدوائر الحكومية بحيث تضطره لدفع (الرشوة) لإنهاء أعماله، في حين أن الموظف الحكومي يقبض راتبه الشهري من المال العام من الحكومة لكي يُنجز أمور الناس دون إتلاف أوقاتهم ودون أخذ شيء من المال منهم، ولا يمكن القبول بتبريرات من مثل: ضعف النظام الإداري، أو البيروقراطية أو ما شاكل، وكذلك قلة الساعات التي تضيع على المراجعين، كل ذلك لا يؤثر شيئاً على الضمان.
فكما أنه لا فرق في الحرمة والضمان بين غصب ريال واحد ومليار ريال، فكذلك فإنّ إتلاف ساعة واحدة من عمر الناس، أو إتلاف سنوات طوال لا يختلفان في أنهما يستوجبان الضمان.
أدلة ضمان عُمْر الأفراد
الدليل الأول: ملكيّة الإنسان لكل قواه
من الواضح أن الإنسان يملك قواه وأعضاءه وجوارحه ملكيّة حقيقية، وباستخدامها عبر الزمن فإنه يضاعف من علمه ووعيه وتخصّصه وقدرته، ومالكيته لهذه الأمور هي الأخرى ملكيّة حقيقية. والإنسان إنما ينشط في الطبيعة نظراً لهذه القوى والتخصصات التي يملكها.
والطبيعة قد لا تكون مستخدَمة ومملوكة لأحد، فيملكها الشخص بفعله وعمله، إذ قبل تصرّف هذا الشخص لم يكن للطبيعة مالك خاص، وكان بمقدور أي واحد أن يملكها بإيجاد بعض التغييرات فيها. وقد لا تكون الطبيعة كذلك، بل يكون هناك من عمل عليها واستأثر بملكيتها الاعتبارية، إلاّ أن هذا المالك الأول يطلب من شخص آخر أن يعمل على إيجاد تغيير جديد في الطبيعة، وفي الحقيقة تكون القوة والفكر من شخص، في حين أن البضاعة والطبيعة من شخص آخر، وهنا تبرز مجموعة مختلفة من العقود والمعاملات كالشركة، والإجارة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، وغيرها.
والأمر المهم هنا هو أن الاثنين مالكان: أحدهما يملك الفكر، والعلم، والقدرة على العمل، والآخر يملك الطبيعة والمواد الأولية. والفارق الوحيد بينهما «أن إحدى الملكيّتين موجودة في الخارج ومحسوسة بالفعل، والأخرى تظهر وتتحقق بشكل تدريجي وعبر الزمن عندما تظهر آثارها على الطبيعة والبضاعة».
من هنا، فإن كل إنسان يملك قواه، وقدراته، وتخصصاته العلمية والعملية، وباستطاعته أن يملّكها لغيره عبر الزمن، حيث يدفع العرف والعقلاء المال بإزاء ذلك، وقد قيل في تعريف المال: «المال ما يُبذَل بإزائه مال». إذن، فكما لو استولى شخص على ملك شخص آخر بشكل عدواني، فإنه يُعدّ غاصباً وعليه تعويض الأضرار الحادثة بسبب ذلك، فكذلك إتلاف عمر الآخرين الذي يؤدي إلى تعطيل قدرات وقوى وتخصصات الأفراد يستوجب الضمان، وعلى مُتلِف الوقت تعويض الأضرار الحادثة بسبب عمله، وإنّ انطباق أو عدم إنطباق عنوان الغاصب أو تعريف الغصب على هذا الشخص وعلى عمله لا يقلل على الإطلاق شيئاً من مسؤوليته وضمانه، ذلك لأنّ الضمان أعمُّ من الغصب.
وقد تبيَّن فيما سبق من فتوى صاحب العروة الوثقى والمعلّقين عليها أن أكثر الفقهاء يرون أنّ الحابس يضمن تفويت الأموال المحبوسة، واستشكل عدد من الفقهاء على ذلك، وحول سبب الإشكال قال الشيخ ضياء الدين العراقي: «لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكيّة إلى أنفسهم، فلا يشمله إتلاف مال الغير»[21].
ولكننا بيّنا أنّ الملكيّة والماليّة تصدقان على هذا النوع من المنافع أيضاً. وبالطبع فإننا نقبل أنّ الأموال على نوعين: النوع الأول هو جسم موجود في الخارج ومحسوس بالفعل. النوع الثاني هو المال الذي يوجد بشكل تدريجي ويُنتَفع به بمرور الزمن، ومنافع الشخص الحر هي من هذا القبيل، سواء تلك التي لها ضمان خاص أو غيرها.
الدليل الثاني: قاعدة العدل:
إنّ قاعدة العدل المُستلهَمة من الكتاب والسُنّة، تُعدّ من القواعد المهمة، بل من الأصول الأساسية للإسلام، وقد بُحث في مظانّه أنّ الإسلام دين عادل، لا بمعنى العدل الديني، بل بمعنى أن العقل والعقلاء يعرفون العدل أولاً، ولأنهم يجدون الدين مطابقاً للعدل فإنهم يتقبّلونه ويؤمنون به، لا أنهم يتحدثون عن العدالة لأن الدين يتحدث عنها.
يقول المرحوم الشهيد مطهري في هذا المجال: «العدل يقع في سلسلة علل الأحكام وليس في سلسلة المعلولات، فليس كل ما قال به الدين هو عدل، بل إن ما هو عدل يقول به الدين، فهذا هو معنى أن العدل مقياس الدين. إذن، فالسؤال المطروح هو: هل الدين هو مقياس العدل، أم العدل هو مقياس الدين؟
«التديّن الجامد يقتضي القول: إنّ الدين هو مقياس العدل، ولكن الحقيقة ليست كذلك. هذا هو نظير ما بُحث في موضوع الحُسن والقُبح العقليين بين المتكلّمين، فأصبح الشيعة والمعتزلة من العدلية، أي أنهم يرون العدل مقياساً للدين، وليس الدين مقياساً للعدل»[22].
من المسلّمات أننا ينبغي أن نؤمن بالدين عبر الدليل والبرهان وليس عبر التقليد للآخرين، ومن طرق إثبات الدين الإسلامي قاعدة العدل، فلأن الدين عادل فهو مقبول، إذن ينبغي الإيمان به.
وواضح أنّ العدل الذي هو معيار معرفة الدين، لا يمكن أن يُعرَّف بواسطة الدين أو القيادات الدينية، بل للعدل مفهوم عقلائي أوكِلَ للعُرف تعريفه وتحديده، وقد تم تعريفه بأنه « إنصاف المرء من نفسه » ولو كان تعريف العدل يُوكَل إلى الدين والقيادات الدينية، لكان كل دين وكل مدرسة فكرية تُعرِّفه بطريقة تتناغم مع تعاليم ذلك الدين أو المذهب الفكري، وفي هذه الحالة لم يكن بالإمكان معرفة الدين الصحيح من الدين غير الصحيح.
من هنا فإن القرآن والسنّة -رغم تأكيدهما المتزايد على العدل وتطبيقه- لم يُقدِّما تعريفاً خاصًّا له، حتى لا ينتهي بنا الأمر إلى طريق مسدودة في حالة الصيرورة إلى العدل الديني، بل أُوكِل أمر تعريف وتحديد العدل إلى العرف والعقلاء.
والآن، إذا ألقينا نظرة سريعة إلى العقلاء وقوانينهم في كل أرجاء العالم، لتبيّن لنا أنّ جميع الناس يعتبرون عمرهم ووقتهم أمراً ذا قيمة، ولا يسمحون بتضييع أحدهم لعمر الآخرين دون سبب ومبرِّر. من هنا نجد أنّ القوانين في بعض البلاد -الإسلامية وغير الإسلامية- تقرّر ضمان الوقت في حالة التأخير في مواعيد الطائرات أو القطارات وتفرض على الجهة المسبِّبة دفع غرامة التأخير، الأمر الذي يدل على أنّ إتلاف الوقت يستوجب الضمان عند جميع العقلاء لأنه يتنافى مع العدل.
الدليل الثالث: مثليّة العقوبة والجزاء
إنّ الآيات والروايات التي تدل على مثليّة العقوبة، تكشف في مجموعها عن اتجاه الشارع المقدس في حقوق الناس المتبادلة، ومن ذلك: ضمان الوقت والعمر، هنا نشير إلى بعض آيات الكتاب:
الآية الأولى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾( ٢٣
تدل الآية المباركة من جهات ثلاث على موضوع البحث:
أ: تتحدث الآية في بدايتها عن الأشهر الحُرم: فلأن المشركين لم يراعوا حرمة الشهر الحرام وهاجموكم في هذا الشهر، فلكم الحق أيضاً ألَّا تراعوا حرمة هذا الشهر وتهاجموهم من منطلق التعامل بالمثل.
ب: عبارة {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ تُبيِّن موضوعاً عامًّا آخر وهو أن كل الحرمات يجري فيها القصاص، سواء كان القتل في الشهر الحرام أو ارتكاب اعتداء آخر غير القتل.
ج: ونستلهم من المقطع الثاني من الآية: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ أن لكل اعتداء قصاص وعقوبة مماثلة، سواء كان في الأشهر الحرم أو في غيرها، سواء كانت نتيجة الاعتداء ضرراً ماليًّا أو بدنيًّا أو حبس الشخص ومنعه من الانتفاع بمنافعه.
الآية الثانية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى (24)
الآية الثالثة: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالأَنفَ بِالأَنفِ، .( وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾( 25)
الآية الرابعة: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾(26)
الآية الخامسة: {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ .( لَيَنصُرَنَّهُ﴾( 27).
(الآية السادسة: {وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ، جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾(28)
.( الآية السابعة: {وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا﴾( 29)
.( الآية الثامنة: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾(30)
عبر هذه الآيات ومثيلاتها نستطيع أن نتعرّف على اتجاه الدين في النظام الجزائي، فكل شيء له قيمة، لابدّ أن يكون له قصاص أو ضمان، ولا فرق بين أن يكون ذلك الشيء ذو القيمة شهراً حراماً، أو من أعضاء وجوارح الإنسان، أو ماله، أو عِرضه، أو أي شيء آخر.
وإن قال البعض: إنّ هذه الآيات لم تتحدث عن الزمان والعمر، لأجبنا:
أولاً: إنّ فقرة: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ومن ثم إطلاق الحكم الكلي: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ تشملان حالة إتلاف عمر الإنسان من دون أدنى شك.
ثانياً: إن الله تعالى بيّن لنا القواعد والأحكام العامة ثم أوكل أمر البحث عن المصاديق الجزئية وتطبيق تلك القواعد والأحكام على الجزئيات إلى المكلَّفين أنفسهم، كما نقرأ في الأحاديث : علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع »(31)
وهنا نستطيع مخاطبة من يدعي ” أنّ حبس الحرّ ظلم ومعصية ولكن ليس له عقاب وضمان” بأنّ هذا الزعم يخالف روح القرآن والقواعد العامة فيه، فهناك الكثير من الآيات التي تدل على قاعدة: مساواة العمل والجزاء.
ولكن يبقى السؤال التالي: ما هو الجزاء المساوي؟ هل يُحبس الظالم ساعة بإزاء حبسه ساعة واحدة لشخص آخر؟ أو أن هناك أموراً أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار؟ وهل بالإمكان تبديل الحبس بجزاء آخر؟ ربما أفضل الطرق للحصول على الجواب هو إيكال مثل هذه الأمور إلى عقلاء الأمة حتى يضعوا القوانين التي تضمن للجميع حقوقهم.
الدليل الرابع: الأولوية القطعية:
نعرف أنّ لكل إنسان الحق في أن يتصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرّف المباح، ولا يستطيع أحد أن يعارضه في ذلك، ولكن إذا أدى تصرّف الإنسان المباح في ملكه إلى إلحاق الضرر بمالكٍ آخر، فإنّ عليه غرامة الأضرار الحادثة. وفي هذا المجال توجد روايات كثيرة تدل على المطلوب منها صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق قال: سألته عن المملوك بين شُركاء فيعتق أحدُهم نصيبه، فقال ع يُقوَّم قيمةً فيُجعل على الذي أعتقه عقوبة،وإنما جُعِل ذلك عليه عقوبة لما أفسده(٣٢).
وبالرغم من أنّ عتق الرقيق له فضيلة جمّة في الشريعة، وأنّ الدين يؤكد ذلك في كل مناسبة وأنّ الكتب الفقهية تضمّ فصلاً مستقلاً تحت عنوان ” العتق” ما يكشف عن أهمية عتق العبيد، وبالرغم من أنّ الشريك -المشار إليه في الرواية السابقة- قد تصرَّف في ماله، إلاّ أنّ عليه أن يتحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقه بشركائه الآخرين بسبب تصرّفه هذا.
من هنا يتبيّن: أنه إذا كان تصرّف الإنسان في ماله الخاص وبطريقة شرعية يستوجب الضمان إذا أدى إلى إلحاق الضرر بالآخرين، فإنه بطريق أولى يكون حبس الشخص وسجنه الذي هو نوع تصرف في الآخرين، ويلحق الأذى والضرر بهم، كما أنه عمل مبغوض شرعاً بل قد يكون ظلماً ومعصية، يكون مستوجباً للضمان، وتوجد روايات كثيرة في هذا المجال(33).
كما يمكن استفادة هذه الأولوية أيضاً من الروايات الواردة في باب الغصب، تلك الروايات التي تدل على أنه لو أشعل الإنسان ناراً في بيته، أو أجرى الماء في ملكه فبسبب شدة النار أو شدة جريان الماء أو بسبب هبوب الرياح أضرّت النار أو الماء بملك الجار، فإنه يكون ضامناً،
وتوضيح ذلك: إذا أدى إشعال النار في ملكه إلى احتراق بيت الجار، أو أدى إلى ارتفاع كبير في حرارة الجو ما أدى إلى إلحاق الضرر بأشجار أو أثاث وملزومات الجار، فإنّ مَن أشعل النار يكون ضامناً حتى لو كانت النار في ملكه.
والآن، إذا تصرّف الشخص -خارج مِلكه- في نفس الجار وعمره، وحبسه عن مزاولة حياته الطبيعية حتى أتلف أو فوّت عليه منافعه، أو أدى -مثلاً- إلى تجويع أسرته، أو ضيّع عليه فرصة اكتساب مال كان من المفروض أن يكتسبه في هذه المدة، فإنه يكون ضامناً بطريق أولى، وعليه جبر كل الأضرار التي ألحقها بالغير.
الدليل الخامس: قاعدة “لا ضرر”
قاعدة “لا ضرر” هي الأخرى تدل على ضمان الزمان أو ضمان عمر الإنسان الحرّ.
وقد ثبت في مظانّه في كتب الفقه والأصول أنه « لا ضَرَر ولا ضِرار في الإسلام” ولا يختلف في الأمر بين أن نعدَّ قاعدة لا ضرر حكماً تعبديًّا قرره الرسول الأعظم ( ص) في قصة النزاع بين سمرة بن جندب مع الرجل الأنصاري أو في موارد أخرى، وبين أن نعدّ هذه القاعدة حكماً عقليًّا في الأساس. وسواءً اعتبرناها صادرة عن الرسول (ص) أو لم نقل بذلك، فإن هذه القاعدة -في كل الأحوال- أمر ثابت، عقلائي، عادل، ويحظى بتأييد وإقرار الشرع أو تأسيسه.
إذن، فلا نقاش في أصل القاعدة، أما مصاديقها التطبيقية في الخارج فيتم تحديدها بواسطة العقلاء.
ولا شك في أن حبس الإنسان الحر، وإتلاف عمره، ومنعه من العمل واكتساب الرزق، يُعدّ من أبرز مصاديق الضرر، ولا شك أيضاً في أنّ الشرع يقول بجبر مثل هذا الضرر.
وقد يكون موضع الاختلاف هو في مقدار مبلغ الضمان وتحديد كيفية الغرامة وتعويض الضرر فحسب، وهذا ما تحدده القوانين.
النتيجة: لأنه لا يوجد أي ضرر غير معوّض في الشرع، فإن الإضرار بالحر لابد أن يكون معوَّضاً: فالأضرار المادية تجبر بدفع أجرة المثل، والأضرار الروحية الناجمة عن الحبس تُجبر إما بالرّد بالمثل كحبس الحابس مثلاً، أو بوضع قوانين أخرى حسب رأي ونظر العقلاء.
الدليل السادس: مقتضى النظام الاجتماعي:
ومن أدلة ضمان الزمان هو ما يقتضيه النظام الاجتماعي، فإذا لم يستلزم حبس الحرّ وإتلاف وقته أي نوع من الضمان والرّد بالمثل وما شاكل ذلك، فإنّ كلّ شخص يسمح لنفسه أن يقوم بحبس الأشخاص بالقوة، وبالخصوص مَن يختلف أو يتنازع معهم، وإذا اعترض عليه أحد فإنه يجيب بأنه يتحمل مسؤولية عمله -إن كان ذنباً أو ظلماً- أمام الله سبحانه، أما في الدنيا فإن الشريعة الإسلامية لا تحمّلني أية مسؤولية وليس لها حكم بشأني.
إنّ انتشار مثل هذا التفكير والموقف في المجتمع الإسلامي يؤدي إلى إشاعة الظلم والاعتداء والفوضى في كل أرجاء المجتمع. وفي الحقيقة إن السبب الكامن وراء قرار المحاكم في البلاد الإسلامية باعتقال الناس بأصغر تهمة وأقل دليل، بل حتى أحياناً مع وجود الشواهد والقرائن ضد المدعي، وتعريض كرامة وشخصية المتهم الاجتماعية للإهانة والتحقير، هو عدم وجود أي ضمان في مثل هذه الحالات، ولا أحد يحاسب أحداً على هذا الكم الهائل من الاعتقالات العشوائية وحبس الأشخاص دون مبرر كافٍ.
في حين أنه لو كانت القوانين العادلة تدين القاضي أو المحكمة أو أية جهة تصدر قرار الاعتقال، وتعاقبه بدفع غرامة مالية معينة عن كل ليلة سجن غير مبرر، وذلك طبقاً لقوانين وحسابات معيّنة، لكانت القرارات العشوائية والعاجلة بزجّ الناس في السجون دون اتهامات حقيقية، ودون محاكمات مشروعة، تتوقف، كما أنّ أبناء المجتمع العاديين سوف يحترمون أوقات بعضهم بعضاً، ولا يقومون بإتلاف عمر الآخرين، وهكذا فإنّ نظاماً اجتماعيًّا عادلاً سيلقي بظلاله الوارفة على المجتمع والمؤسسات القضائية في آن واحد.
بين التفويت والاستيفاء
رغم وجود العديد من الأدلة على ضمان الزمان وضمان منافع الحر، فإنّ إشكالاً كبيراً يشغل ذهن بعض الفقهاء الذين يعبِّرون عنه بصور مختلفة، وقد يعبِّر عنه بعضهم بشكل ضمني وغير صريح.
هذا الإشكال هو على النحو التالي: إذا استخدم الغاصبُ أو الحابسُ أو الظالمُ، الإنسانَ الحرَّ واستوفى منافعه، فإنه تتبيَّن لنا في هذه الحالة نوعية منافع الحرّ، وما هي الأعمال التي كان بإمكانه إنجازها خلال فترة الحبس، كما أن منافعه، من جهة أخرى، لم تُهدَر بل تحققت في الخارج، إذن فإنّ الحابس ضامن للمنافع المستوفاة من المحبوس.
أما إذا لم تُستوفَ المنافع من الحرِّ المحبوس، فإن الطريق يبقى مفتوحاً أمامه لادعاء الخسارة، وهو باستطاعته أن يطالب بتعويضات كبيرة جدًّا. ومن جهة أخرى فإنه لم يتحقق أي عمل في الخارج، وإنّ أعضاءه وجوارحه وفكره لم تُستخدَم، من هنا فإننا نشك في حجم طاقات المحبوس، كما نشك في مقدار الضمان بإزاء حبسه، والأصل هنا هو: البراءة من الضمان.
ذلك لأنه لو كان الضمان بسبب منافعه بالقوّة، فإنّ الأمر يكون من باب الدوران بين الأقل والأكثر، أي: إننا نحتمل المنافع الأقل، وهو يدعي المنافع الأكثر، وفي هذا الدوران فإنّ الحابس لا يُكلَّف إلاّ بالأقل. أما إذا كان الضمان بسبب العمل الذي يتحقق في الواقع الخارجي بالفعل، فإنّ الضمان هو صِفر، لأنه لم يتحقق أي عمل في الخارج، إذن، فإن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يتوقف على دوران الأمر بين وجود الضمان وعدمه، وهنا أيضاً يكون أصل البراءة حاكماً.
والنتيجة: إن الضمان موجود بمقدار المنافع المستوفاة، أما أكثر من ذلك فهو أمر مشكوك فيه.
نقول في الجواب: إنّ الرجوع إلى التعويضات المتعارف عليها لدى العرف والرجوع إلى المِثل يمنع هذا النوع من الادّعاء، فإذا طالب أحد بتعويض كبير جدًّا، فإنّ هذه المطالبة تخضع للتقييم القضائي من خلال مقارنته بأمثاله من حيث طبقته الاجتماعية، وقدراته العقلية وطاقاته، وإمكاناته المالية، واليوم فإنّ كل شيء يخضع للتقييم الدقيق من خلال الإحصاءات وحساب الاحتمالات.
إذن، فإن إشكالية الجهل بحجم وقيمة المنافع المحتملة التي فاتت المحبوس، غير واردة بالمرّة.
وإشكال آخر يثيره البعض وهو أنه لم يتحقق أي عمل وأية منفعة في الخارج، فدفع المال للمجبوس بإزاء منفعة غير متحققة يُعد من مصاديق أكل المال بالباطل الذي تنهى عنه الآية الكريمة: {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (34)
والجواب: إنّ عدم تحقق العمل أو المنفعة في الخارج كان بسبب الحبس والظلم الذي مارسه الحابس بحق المحبوس، وليست له أية علاقة بالمحبوس نفسه.
نستنتج من كل ما سبق أنّ لعمر الأفراد -من أية فئة أو طبقة كانوا- قيمة، وينبغي العمل على عدم تضييع وإهداء عمر الأشخاص. وأنّ قيمة عمر الأشخاص هي أكثر من قيمة أموالهم، لأنّ الناس يصرفون من أعضائهم وجوارحهم وأعمارهم وعقولهم للحصول
على المال، وأنّ الأدلة التي تُثبت ضمان المال، تُثبت أيضاً ضمان العمر بالأولوية القطعية.
أما مقدار الضمان، فيتوقف على مقدار العمل الذي كان باستطاعة المحبوس أن يقوم به في حالة الحرية، أو يتم تقييمه وتحديده من خلال المقارنة بينه وبين أمثاله. إذن، فضمان إتلاف العمر ليس شيئاً ثابتاً كما هو الأمر بالنسبة لدية الأعضاء، بل إنّ ضمان العمر ينبغي محاسبته وتحديده عند الإتلاف، لأنّ قيمة أعمار الأشخاص تختلف من واحد لآخر.
بناءً على كل ذلك: إنّ إتلاف عمر الشخص الحرّ مضمون، والقانون هو الذي يحدد القيمة الدقيقة لكل ساعة من العمر التالف حسب طاقات وإمكانات وقوى الشخص ووضعه الاجتماعي، ذلك لأنّ هناك فرقاً واضحاً -من هذه الجهة- بين الشخص المتخصص وغير المتخصص، وبين الكسوب وغير الكسوب وغير ذلك من المميزات.
الهوامش
1 – الشيخ أحمد عابديني (أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في إصفهان، من إيران
2 – جواهر الكلام، ج ٣٧ ، طبعة دار الكتب الإسلامية – طهران.
3 – راجع: المصدر السابق، ج ٣٧ ، ص ٣٩
4 – العروة الوثقى، كتاب الإجارة، فصل ٣، مسألة ٣
٥- راجع: العروة الوثقى، ج ٥، ص ٤٠ ، هامش المسألة المذكورة (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة – مع تعليقات ١٥ من الفقهاء العظام).
6 – نفس المصدر
٧ – نفس المصدر، ص39.
8- شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٢٣٦ ، مؤسسة الأعلمي.
٩ – جواهر الكلام، ج ٢٧ ، ص ٣٦.
10- مسالك الأفهام، ج ١٢ ، ص ١٥٧
١١ – وسائل الشيعة، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، كتاب الديات، موجبات الضمان، باب ١٢ ، ح ٢.
12 – راجع: وسائل الشيعة،ج ١٨،ص ٣١١ – 313 (جاء في إحدى هذه الروايات عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبراً أن يضرب رجلاً حدًّا، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي عليه السلام من قنبر بثلاثة أسواط.
١٣ – شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٢٣٦.
١٤ – جواهر الكلام، ج ٣٧ ، ص ٣٩.
15 – مسالك الأفهام، ج ١٢ ، ص 120.
16 – جواهر الكلام، ج ٣٧ ، ص41.
17 – المصدر نفسه ج 38، ص166 وما يليها.
18 – شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٢٣٦.
19 – جواهر الكلام، ج ٣٧ ، ص41 و 42.
20 – مجمع الفائدة والبرهان ج ١٠ ، ص ٥١٣.
21 – العروة الوثقى، ج ٥، ص ٤٠ (طبعة مؤسسة النشر الإسلامي – قم).
22 – بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي (بالفارسية) ص ١٤ – 15.
23 – سورة البقرة، الآية ١٩٤ .
٢٤ – سورة البقرة، الآية ١٧٨ .
٢٥ – سورة البقرة، الآية ١٩٤
26- سورة النحل، الآية ١٢٦.
.٢٧ – سورة الحج، الآية ٦.
٢٨ – سورة يونس، الآية ٢٧ .
٢٩ – سورة الأنعام، الآية ١٦٠ .
٣٠ – سورة الشورى، الآية ٤٠.
31- عن الإمام الرضا ع وسائل الشيعة، ج ١٨ ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦، ح ٥٢ ، ص 40. وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق ع : إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرِّعوا. المصدر نفسه، ح ٥١ .
32 – وسائل الشيعة، ج ١٦ ، كتاب العتق، الباب ١٨ ، ح ١، ص ٢١
٣٣ – راجع: المصدر، الباب ١٨ من كتاب العتق الذي يضم ١٣ حديثاً آخر غير ما ذُكر.
34- سورة البقرة، الآية ١٨٨ ، وسورة النساء، الآية ٢٩.
فقه الضمان وقيمة عُمْر الحرّ* کتبه: الأستاذ أحمد عابديني – ترجمة: عبدالرحيم النجار – مجلة البصائر – العدد (42) السنة 19 – 1429هـ/ 2008م .- نشر المقال باللغة الفارسية في مجلة “فقه” العدد 48.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي