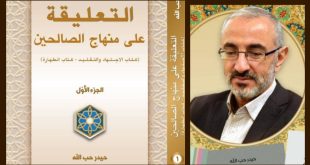الاجتهاد: طرح موضوع وباء كورونا على الفكر الديني أسئلة وتساؤلات، ويمكن أن ترجع أهمّ الإثارات هنا إلى محورين: المحور الأوّل: محور لاهوتي عقائدي فلسفي، وغالباً ما يدور حول علاقة الله بالشرور أو الآلام التي تواجه البشر، فقد أثار العديد من المفكّرين المعاصرين قضية الشرّ مجدّداً عقب ظهور هذا الوباء.
المحور الثاني: محور سلوكي عملي يتصل بموقف الأديان ونهج تعاملها مع قضايا الجسد الإنساني وحماية الحياة الإنسانية الماديّة على الأرض، فهل للأديان موقف سلبي من الجسد حتى توجّه أبناءها نحو إهمال مخاطر الصحّة والسلامة العامّة أو أنّ العكس هو الصحيح؟
لن يتسنّى لي في هذه المساحة المختصرة معالجة الموضوعين بإسهاب، لكنّني سأحاول رصد بعض المعالم الدينيّة فيهما ليس انطلاقاً من زاوية فلسفيّة محضة، بل من زاوية دينية.
أوّلاً: البعد اللاهوتي العقدي لفكرة الآلام والمعاناة
في الجانب الأوّل، تستوقفنا مجموعة من المفاهيم الدينيّة التي تضع أمامنا عدّة قواعد في بناء الحياة على الأرض أهمّها:
قاعدة تأثير السلوك الإنساني على سلميّة العلاقة مع الطبيعة، هذه القاعدة تؤكّد دينيّاً أنّ الإنسان يتحمّل ـ على الأقلّ ـ جزءاً من المخاطر والكوارث التي تحصل في الطبيعة. ولا يقف ذلك عند حدود تخريب الإنسان للطبيعة بسبب طغيانه وطمعه وتغوّله مادياً وسلطويّاً، وهو ما تواجهه اليوم مشكورةً المنظّمات البيئيّة الناشطة في العالم، بل يتخطّى ذلك نحو ارتباط الأمر بعلاقة الإنسان بالله وبأخيه الإنسان أيضاً،
فالنصّ القرآني كثيراً ما يربط سلوكيّات البشر وأخلاقيّاتهم بالعذاب النازل عليهم أو بالفساد الواقع في الأرض، ومن ثم فهو ينشؤ ارتباطاً وثيقاً بين سلوكنا نحن البشر في الخطيئة وبين ردّات فعل الطبيعة تجاهنا فيما تمثله من قضاء إلهيّ يتصل بالبشر عذاباً أو امتحاناً أو عقاباً نازلاً.
قال تعالى: ]وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ[([2])، وقال سبحانه: ]ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[([3])، وقال تعالى: ]وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ[([4])، وقال تبارك اسمه: ].. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ[([5])، وقال عزّ من قائل: ]مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.. [([6])، وقال عزّ وجلّ: ]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[([7]).
ليس ذلك كلاماً طوباويّاً ولا يعني زوال منطق الأسباب الطبيعيّة ولا تخطّي قواعد العقل الفلسفي أو العلمي في الروابط بين الأمور، بل يكشف النصّ الديني عن علاقة جديدة بين الأسباب والمسبَّبات تتصل بسلوك الإنسان، وكأنّ الطبيعة تعبّر عن غضبها أو انزعاجها ـ أحياناً ـ فيما أراده الله لها تجاه سلوكنا مع الله ومع الإنسان ومعها هي أيضاً، بما تمثله من حجر ومدر وشجر وحيوان وغير ذلك. إنّها واحدة من السنن الإلهيّة في الخلق لا تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً([8]).
فليس قصد الدين هنا إجهاض الأسباب الطبيعيّة التي تكشف عنها العلوم كما قد يخيّل لبعض العِلْمَوِيّين الذين يريدون افتعال خصومة بين الدين والعلم في هذه القضيّة، بل خلع معنى على الظواهر الطبيعيّة نفسها بأسبابها ومسبّباتها، فالأديان بطبعها تقوم بخلع المعاني على الأمور الصامتة انطلاقاً من أنّها تربط الظواهر الطبيعيّة بغايات في الخلق، على أساس أنّ فاعل هذه الظواهر في رأس سلسلة العلل والمعلولات هو الله الحكيم العاقل القاصد المريد، فليس من شيءٍ يقع بصمتٍ أو عبثيّة كما تؤكّده النصوص الدينيّة([9])،
لهذا فالدين بهذه القراءة يربط الوقائع الطبيعيّة المفهومة علميّاً بغايات قصدية ماورائيّة، وهذا شيء طبيعي لدى كلّ من يملك رؤية ميتافيزيقية متعالية من هذا النوع. وهو شيء يصعب على العلم أن يحدّده بالأدوات الطبيعيّة؛ لأنّ الغايات قصودُ العاقلين، فيما العلم يدرس الظاهرة بنفسها بوصفها حدثاً لا غاية.
هذه العلاقة نجدها في اللاهوت المسيحي واضحةً أيضاً عبر مفهوم الخطيئة الأولى ـ وليس فقط في العهد القديم عبر مفهوم العذابات النازلة على بعض الأقوام السابقين مثل سدوم وعمورة ـ تلك الخطيئة الكامنة في كلّ واحدٍ منّا؛ إذ كلّ واحد منّا هو آدم، وفي داخله تلك الخطيئة التي حصلت، والكتاب المقدّس يؤكّد أنّ ما نحن فيه من معاناة وآلام ناتجٌ عن فعل الخطيئة، وإلا فإنّ نصيبنا هو السعادة والجنّة والرخاء والديمومة.
جاء في الكتاب المقدّس ـ بعد شرح تحذير الله لآدم بأنّ أكله من الشجرة يجرّه للموت([10]): «وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلاَدًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ.وَقَالَ لآدَمَ: لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلاً: لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ. بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ. بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ»([11]).
إنّ القرآن يُلمح أيضاً لهذا الأمر حيث يقول: ]فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى[([12])، فالخطيئة هي التي كشفت ضعفنا وهوت بنا نحو عالم المتضادّات والمتزاحمات، عالم المعاناة والألم؛ لنتطهّر بالتجربة ونعيد الارتقاء ]وإليه ترجعون[.
وإذا أردت قراءة هذه المفاهيم الدينية في الأديان الإبراهيميّة الثلاثة قراءة اجتماعية ونفسيّة، بعيداً عن النقاش الفلسفي فيها والتحليل الانطولوجي، فإنّني أجدها تدفع الإنسان للإحساس بالمسؤوليّة تجاه وقائع العالم من حوله، فكونه على صورة الله([13]) وأنّه خليفة الله ]..إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.. [([14]).. مسؤوليّتان تفرضان عليه إحياء الضمير الأخلاقي والروحي لكي ينتظم شأن العالم، فالإنسان بعودته للروح الإيمانية والأخلاقيّة يساهم في صلاح الأرض والحياة، فعندما يعبد الله ويبرّ الوالدين فهو يبني أيضاً علاقة مع الطبيعة تجعلها مسالمة له ومتوالمة، وهذا مضمون فلسفي وجودي عميق تقدّمه الأديان في بناء العلاقة مع العالم والكون.
إنّ علاقة السلام مع الطبيعة ترجع لعلاقة سلام بين النوع الإنساني من جهة، والله المتعالي من جهة ثانية وما ينبثق عنه من جماد وحيوان وإنسان.
إنّها صورة مختلفة تقدّمها الأديان؛ فالعلاقة مع الطبيعة جزء من العلاقة مع الله والعكس صحيح، وهذا يعني أنّ الآلام والأمراض والفيروسات القاتلة قد تكون لها صلة أحياناً بعلاقة الإنسان منذ الأوّليّة مع ثلاثيّة: الله ـ إبليس ـ الذات.
وبربط القضية العامّة هذه بموضوعنا يتضح أنّ اللاهوت الديني يفهم ـ أحياناً على الأقل ـ مثل هذه الظواهر الوبائية والابتلائية التي تلحق البشر بمثابة نوع من العلاقة السلبية التي بناها البشر مع الله. لا نتألّى على الله ونجزم في هذه المفردة أو تلك كما يفعل بعض العامّة من الناس فيقول: هذا انتقام إلهي هنا وذاك عذاب ربّاني هناك لأجل كذا وكذا! بل نقول بأنّ واحدة من الفرضيات التي توفّرها الأديان لنا في كليّة النظام الكوني هي هذه الفرضية تماماً، الأمر الذي يدفعنا لليقظة الروحية والتنبّه لسلوكيّاتنا برمّتها.
إنّ المنطق الإلهي هنا يقضي بنزول مثل هذه الآلام على الإنسان نتيجة سلوكه السيء أو تراجع مستوى سلوكه الإيجابي، ليس بالضرورة بهدف الانتقام أو حتى التشفّي بالمعنى السلبي للكلمة، بل أحياناً بهدف إنهاض الإنسان وتحقيق يقظته وارتقائه بالعودة لله في لحظات الشدّة والعسر، بما يمثله الله من قمّة الضمير الأخلاقي للبشر، وهو ما يخبرنا عنه القرآن في بعض نصوصه منها:
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ[([15])، ومنها: وقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[([16])، فالمعاناة في التقدير الإلهي يمكن أن تكون سبيلاً لليقظة الروحيّة والأخلاقية وقيامة ضمير الإنسان مجدّداً ورجوعه لربّه وتضرّعه له؛ لأنّ الإنسان في لحظات الضعف يرجع للمطلق المتعالي سبحانه، فيعيد بناء العلاقة معه والتي ينجم عنها بناء علاقة أخلاقيّة صالحة مع نفسه ومع الإنسان الآخر ومع الطبيعة، لكنّ المؤسف أنّه إذا استجابت له الإرادة الإلهية فإنّه يعاود سلوك سبيل الغفلة فينسى الله مجدّداً!
هذا كلّه يعني أنّ الأديان تعتبر المعاناة ـ في بعض الأحيان ـ نتيجةً وفرصةً معاً، فهي نتيج سلوكنا، وهي فرصة للعودة للسلامة والصواب واليقظة. ومفهوما النتيجة والفرصة هنا يندكّان في مفهوم التطهّر، فالإنسان يتطهّر بهذه المعاناة عبر استغلالها للعودة لله وتصفية باطنه من القذارات والخبائث؛ ليعيد بناء علاقة التصالح مع المحيط كلّه.
المؤسف حقّاً ـ من وجهة نظر دينيّة ـ أنّ الإنسان الذي يُسيء العلاقة مع الله ومع الطبيعة ومع أخيه الإنسان يصبّ جامّ غضبه على الله عندما تلحقه نتائج سلوكيّاته هو في الأرض، فيعتبر الله فاعلاً للشر! فيكفر في لحظات الفرصة للتضرّع! كالولد العاقّ الذي يؤذي والديه ومحيطه حتى إذا ما وقع في نتائج أفعاله اتهم والدَيه بما بلغه من سوء! وهذا هو تعبير القرآن في توصيف حالة هذا الإنسان: ]اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ..[([17]). إنّه مفهوم الاستحواذ والسلطة المطلقة التي صارت للشيطان عليهم بفعل تمكينهم له من أنفسهم بالغيبوبة المطلقة عن الله عزّ وجلّ.
ثانياً: البعد السلوكي والموقف من سلامة الجسد
تعتبر ثنائيّة الروح والجسد من أكثر الثنائيّات جدلاً في تاريخ الفكر الديني والفلسفي معاً، قد لا يبدأ من الجدل في أصل الثنائية وجوديّاً عبر إنكار الروح أو إثباتها، ودراسة مفهوم التجرّد عن المادّة فلسفيّاً، ولا ينتهي أيضاً بالحديث عن الجانب العملي السلوكي في أولويّات الإنسان في الحياة بين جانب الجسد وحاجاته وشهواته وبين جانب الروح ومتطلّباتها، وما يفرزه هذا الثنائي من تعارض أحياناً بما قد يجعل الجسد يتطلّب شيئاً ترفضه الروح المتعالية أو تتطلّب الروح في حاجاتها الوجوديّة السامية ما قد لا يستجيب له الإنسان ببُعده الجسدي أحياناً أخرى.
ربما لم تكن قضيّة وجود الروح وطبيعة علاقتها بالجسد موضوعاً دينيّاً بامتياز، بل غلب عليه الطابع الفلسفي في القرون الغابرة والطابع العلمي ـ الفلسفي في العصر الحديث، لكنّ متطلّبات الروح والجسد كانت من القضايا المهمّة في الدين، في إطار رسم الأولويّات والمسارات.
فالأديان في نصوصها الأولى غالباً ما نلاحظها أكثر اهتماماً بالجانب العملي السلوكي، بل هي ترى أهميّة «العلم والمعرفة» في نتائجهما على حياة الفرد والجماعة، ربما على عكس بعض التصوّرات الفلسفية التي تعتبر أنّ «العلم» بذاته مطلوب، لهذا فما تقدّمه الأديان في مجال الروح والجسد له طابع عملي منهجي سلوكي يقوم على رؤية فلسفية تقف خلفه وتشيّده.
اعتادت الأدبيات الدينيّة على اعتبار كلّ ما له ربط بالعلاقة بين الإنسان والمتعاليات (الله ـ الملائكة ـ الأنبياء ـ القدّيسين..)، أو له علاقة بينه وبين القيم السامية (القيم الأخلاقية والروحيّة) منتمياً لدائرة الروح، فيما ينظر لما يتصل بالقضايا التي يكون الفاعل الأكبر فيها هو الجسد على أنّها جسديّة من نوع (الغرائز الشهويّة والمصالح المادية)، من هنا عندما تتعارض مصلحة جسدية شهويّة مع قيمة أخلاقية عليا، فإنّ الأديان تقف لصالح القيم الخلقية والروحيّة؛ لأنّها تعتبر أنّ الروح هي التي تقبل البقاء وأنّ تمكينها هو الذي يسمح للإنسان بالخلاص.
هذا الأمر يقوم فيما يقوم على ثنائية الدنيا والآخرة في الأديان الإبراهيميّة؛ فالدنيا ليست سوى مزرعة أو مسير للوصول للآخرة، وتحقيق النجاة في الآخرة يكون برعاية الروح وملئها بالخير كي تقدر على الاستعداد لوقائع يوم الدينونة؛ لأنّ جوهر الإنسان بروحه وبالأنا القائمة.
يعني ذلك أنّ الجسد ليس سوى الوسيلة التي يحيا بها الإنسان في الدنيا كي يقوم من خلال تحقّق الروح/الأنا الحقيقيّة فيه من النهوض بنفسه في الآخرة، وهذا ما يعطي الجسد في الأديان طابعاً أداتياً خدميّاً، فهو يخدم بقاء الروح في الدنيا بما يمثله هذا البقاء من حاجة للروح كي تملك فرصة التسامي في هذا العالم بغية نجاتها وخلاصها في الآخرة، وهذا معنى ما يقوله القديس ترتوليان/ترتلّيانوس (240م) بأنّه من خلال الجسد تمارس النفس عملها وتتمتع بعطايا الطبيعة([18]).
وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ الأديان لا تنظر للجسد بنظرة سلبيّة، ولا تعتبر أنّ الاهتمام به خروج عن الجادّة والصواب؛ إنّما قلق الأديان من أن يصبح الاهتمام بالجسد هو الأصل والأساس، فيما الاهتمام بالروح والمعنى والباطن هو الفرع، في الوقت الذي يكون الاهتمام بالجسد مجرّد وسيلة لفتح فرصة للروح للتسامي في هذا العالم كي تحقّق الفوز يوم الدينونة،
فالغرق في متطلّبات الجسد مع غفلة عن الروح وتغليب الجسد على الروح يُشبه حال شخص يسافر في البحر فيهتمّ بالسفينة التي تُقِلُّه، فإنّ هذا الاهتمام مطلوب كي يتمكّن من الوصول إلى برّ الأمان، أمّا الاهتمام بالسفينة ونسيان المسير نحو الهدف والبرّ، فهو مجرّد دوران في البحر وغرق في الأخشاب نفسها، وهو مرفوض تماماً.
من هنا يتخذ الجسد الإنساني طابع القداسة من حيث قداسة الروح التي تحلّ فيه من الله، ومن حيث قداسة الوظيفة التي يُراد له أن يقوم بها في هذا العالم، وربما يكون هذا من نتائج كلام القدّيس اكليمندس الاسكندري (215م) عندما تحدّث عن أنّ الله اهتمّ كثيراً بخلق (جسد) الإنسان، فأعطاه كرامةً بخلقه له باليدين الإلهيّتين معاً، أمّا سائر الحيوانات فخُلقت بالأمر الإلهي([19])، فكأنّ اليدين في مثل التعبير القرآني: ]قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ[([20])، استخدمتا لمزيد تشريف وعناية وخصوصيّة بالجسد الآتي من الطين وفقاً لفهم اكليمندس.
إنّ كلام اكليمندس يشي بأنّ الجسد له كرامة أيضاً، أو فلنقل بأنّ كرامة الإنسان تتضمّن كرامة جسده، لهذا فنحن في الأديان نحترم جسد الميّت؛ لأنّ ذلك تعبير عن احترام الميّت نفسه، ونمتنع عن قتل الآخرين كما جاء في القرآن([21])، وفي الوصايا العشر([22])؛ لأنّ قتله وإن كان لا يُفني روحه لكنّه يفني جسده بالمعنى العادي للكلمة، وهو مرفوض، فالعدوان على الجسد يتضمّن في الكثير من الأحيان عدواناً على الروح، وتكريم الروح يتضمّن أيضاً تكريماً للجسد بشكلٍ ما، فعندما تُعلن المسيحيّة([23]) والإسلام([24]) مبدأ الكرامة الإنسانيّة فهذا يتضمّن ـ نوعاً ما ـ قبولاً بكرامة الجسد؛ لأنّ التعامل غير الأخلاقي مع الجسد نوعٌ من إهانة الإنسان لنفسه أو لغيره والعدوان عليهما.
وعندما نلاحظ مفهوم الاهتمام بالجسد ورعايته في الدين تظهر بين أيدينا نصوص عدّة، من بينها قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا.. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[([25])، وفقاً لتفسيرها بأنّها تنهى عن قتل كلّ إنسان لنفسه، وليس تفسيرها بالفهم الاجتماعي عبر قتل كلّ واحد لغيره، محاكاةً لآيةٍ أخرى، وهي قوله تعالى: ]ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ..[([26]).
وكذلك قوله سبحانه: ]وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[([27])، إنّ رمي النفس في المهالك مرفوض. وحتى لو فسّرنا التهلكة هنا بأنّها التهلكة الاقتصاديّة عبر الإنفاق المفرط غير العقلاني، فإنّ هذا يرجع في نهاية المطاف إلى جعل النفس في معرض الهلاك والضرر، فالنصّ القرآني يؤكّد على ضرورة السلامة من الهلكات الجسديّة والاقتصاديّة وأمثالها.
ويمكن أن نعزّز الموقف الديني هذا بالنصوص الحديثيّة المرويّة في كتب المذاهب الإسلاميّة عن النبيّ وأهل بيته وصحابته، حيث لاحظنا بمراجعتها أنّ بعضها يُرشد إلى العلاجات والأدوية الخاصّة، وهو ما يُعرف بنصوص الطبّ النبويّ، وكأنّها تحاول تعليم الإنسان كيفيّة الاستفادة من الطبيعة لتحسين جسده وشفائه، وهو تأكيد على اهتمام الدين بالسلامة الجسديّة والصحّة البدنيّة.
كما أنّ بعض النصوص الحديثية يؤكّد على الدعوة للتداوي من الأمراض، ويحاول الفصل بين التداوي وبين عدم التوكّل على الله، وكأنّ فهم التوكلّ فهماً خاطئاً يمكن أن يجرّ الإنسان إلى ترك الأسباب الطبيعيّة ورعاية الجسد اعتماداً على كونه متوكّلاً على الله، فجاءت النصوص الحديثيّة لتؤكّد أنّ التداوي لا يخرق المبدأ الروحي التوحيديّ المسمّى بالتوكّل، بل إنّ مفاهيم الدعاء والتوكّل والإيمان تعمل على تعزيز حالة الشفاء الجسدي الآتي عبر الأسباب الطبيعيّة التي جعلها الله نفسه في الخلق، فلا تناقض بين الدين والعلم.
القاعدة الأخلاقية الذهبيّة ودورها في رعاية سلامة الآخرين
وإذا تخطينا موضوع رعاية الإنسان لسلامته البدنيّة نحو رعايته ومسؤوليّته عن عدم تعريض السلامة البدنيّة للآخرين، وهو ما نلاحظه في الأمراض المعدية ومسؤوليّة الفرد في الرعاية الصحية تجنيباً للآخرين الخطرَ والهلاك.. إذا تخطّينا الأمر سنجد القاعدة الأخلاقية الذهبيّة (Golden Rule)([28]) ماثلةً أمامنا تخاطبنا بأنّ كلّ ما نحبه أو نكرهه لأنفسنا فعلينا أن نتعامل فيه بالطريقة نفسها مع الآخرين، فكما لا نحبّ منهم أن يعرّضونا للخطر بعدوى مرضيّة معيّنة عبر استهتارهم بالرعاية الصحيّة، كذلك علينا فعل الأمر عينه معهم (احبب لغيرك ما تحبّ لنفسك واكره له ما تكره لها).
إنّ القاعدة الذهبيّة واضحة أو شبه واضحة في نصوص القرآن الكريم والسنّة الشريفة([29]) والكتاب المقدّس([30])، وقد أجاد الإمام النووي (676هـ) عندما علّق على حديثٍ نبوي من أحاديث هذه القاعدة، بقوله: «هذا من جوامع كلمه صلّى الله عليه وسلّم، وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمّة فينبغي الاعتناء بها، وأنّ الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحبّ أن يفعلوه معه»([31]).
هل يرفض الكتابُ المقدّس الجسدَ؟!
قد يحاول أحد أن يستغلّ بعض نصوص الكتاب المقدّس لتأكيد رفض الجسد، ويبدو أمامنا واقفاً نصُّ رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية حيث يقول لهم: «وَإِنَّمَا أَقُولُ: اسْلُكُوا بِالرُّوحِ فَلاَ تُكَمِّلُوا شَهْوَةَ الْجَسَدِ لأَنَّ الْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحُ ضِدَّ الْجَسَدِ، وَهَذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ تُرِيدُونَ وَلَكِنْ إِذَا انْقَدْتُمْ بِالرُّوحِ فَلَسْتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ»([32]).
يوحي هذا النصّ برفض الجسد ووضعه في خصومة مع الروح ثمّ الانتصار للروح عليه، فكأنّ الجسد لم تعد له قيمة وليس علينا الأخذ بمتطلّباته، وهو ما قد يدفع للاعتقاد بأنّ المسيحيّة تتخلّى عن الجسد تماماً وتتنكّر له ولا تعير أهميّةً أو بالاً لما يحتاجه ويدعو إليه.
لكن في تقديري لا يراد من الجسد هنا إلا العيش الفارغ من الإيمان ومن الولادة الحقيقيّة، إنّ الجسد هنا ليس هو البدن في مقابل الروح بوصفهما كائنين مخلوقين، بل هما الولادة الماديّة الخالية من المعنى والروح، وما يؤكّد ما نقول هو تكملة هذا النصّ حيث يشرح لنا بولس الرسول الفكرة الأساسية من الجسد وهو ذاك النمط من العيش الغارق في الدنيا وملذّاتها والبعيد عن الروح والإيمان والمحبّة والأمل.. إنّ بولس يعرّف الجسد هنا بالسلوك غير الإيماني وغير الأخلاقي معاً، حيث يقول فوراً:
«وَأَعْمَالُ الْجَسَدِ ظَاهِرَةٌ: الَّتِي هِيَ زِنىً عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ عِبَادَةُ الأَوْثَانِ سِحْرٌ عَدَاوَةٌ خِصَامٌ غَيْرَةٌ سَخَطٌ تَحَزُّبٌ شِقَاقٌ بِدْعَةٌ حَسَدٌ قَتْلٌ سُكْرٌ بَطَرٌ، وَأَمْثَالُ هَذِهِ الَّتِي أَسْبِقُ فَأَقُولُ لَكُمْ عَنْهَا كَمَا سَبَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضاً: إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ لاَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللهِ وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ صَلاَحٌ، إِيمَانٌ وَدَاعَةٌ تَعَفُّفٌ. ضِدَّ أَمْثَالِ هَذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ. وَلَكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَلَبُوا الْجَسَدَ مَعَ الأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ. إِنْ كُنَّا نَعِيشُ بِالرُّوحِ فَلْنَسْلُكْ أَيْضاً بِحَسَبِ الرُّوحِ. لاَ نَكُنْ مُعْجِبِينَ نُغَاضِبُ بَعْضُنَا بَعْضاً، وَنَحْسِدُ بَعْضُنَا بَعْضاً»([33]).
إنّ تعبير بولس واضح في أنّه يعني بالجسد الفناء في المادّة ومتطلّباتها والغرق في قضايا الدنيا بعيداً عن المعنى والروح، فيما يعني بالروح الولادة الجديدة بالإيمان والخلاص أو بتعبير بولس نفسه في موضعٍ آخر: «الخليقة الجديدة»([34])، إنّ بولس لا يتكلم عن رعاية الجسد لأجل الصلاة والعبادة ومحبّة الناس وخدمة المحتاجين ونشر الخير في الأرض، بل الجسد في مفهومه هو سلوك انحطاطي دنيوي مادي خالص.
وعلى أبعد تقدير فإنّ بولس يمكن أن يكون ناقداً لتحويل الدين إلى قضيّة جسديّة في طبيعة الطقوسيّة المادية والشريعة المحاكية لقضايا الجسد فقط (الختان و..)؛ لأنّه يريد أن يعيد إنتاج الدين من خلال الروح والمعنى، ليسكب دلالات الروح على الجسد، فيثمر الجسد صلاحاً في السلوك كما توحيه بعض كلماته الآنفة، وهو ما يخلع على الطقوس المادية معنى روحيّاً ويلتقي نسبيّاً مع مفهوم النصّ القرآني في قوله تعالى: ]لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ..[([35])، فالمسألة ليست مسألة لحم ودم فيما هي الذبيحة، بل مسألة فعل روحي ومكانة روحيّة، هي التقوى.
بهذا تتضح الصورة في موضع آخر من كلام بولس حيث يقول: «لاَ تَضِلُّوا! الله لاَ يُشْمَخُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ الَّذِي يَزْرَعُهُ الإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَحْصُدُ أَيْضاً. لأَنَّ مَنْ يَزْرَعُ لِجَسَدِهِ فَمِنَ الْجَسَدِ يَحْصُدُ فَسَاداً، وَمَنْ يَزْرَعُ لِلرُّوحِ فَمِنَ الرُّوحِ يَحْصُدُ حَيَاةً أَبَدِيَّةً»([36]). وكأنّ بولس يتكلّم هنا عمّن يريد الدنيا ومن يريد الآخرة وفقاً للأدبيّات القرآنيّة، حيث يقول: ]مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ[([37])، فالروح هو العمل للآخرة فيما الجسد هو العمل للدنيا ولا يُنتج إلا خسارة وفساداً. بل إنّ الشريعة إذا كانت تهدف تنظيم حركة الجسد في الدنيا فقط فلا قيمة لها ما لم تخلع على السلوك البدني معنى روحيًا، فهذه هي القيمة المعنويّة في الدين. هكذا نفهم الكتاب المقدّس في مواضع أُخَر أيضاً([38]).
وأختم بلفت النظر إلى أمر وهو أنّ النصوص الدينية في القرآن والكتاب المقدّس قد تشير لنزول الآلام والعذابات والضغوطات على المؤمنين بهدف ترقيتهم وتعليمهم وتهذيب نفوسهم وابتلائهم ونحو ذلك من المفاهيم والمصطلحات تبعاً للنص الديني هنا وهناك، لكنّ هذا لا يعني إطلاقاً أنّ النص الديني يرحّب بالآلام من الزاوية البشرية،
فهناك فرق بين أن يجعل الله العبد في ألمٍ وامتحان وصعوبة؛ لابتلائه واختباره وتطهيره وتشجيعه على التضرّع وتهذيب النفس، وبين أن يطلب الإنسان الألم أو يسمح به اعتماداً على الغاية نفسها، فالسنّة الإلهيّة التكوينيّة تقضي بأنّ الإنسان في الدنيا سيعيش الابتلاءات، لكنّ السنّة التشريعيّة لا تقضي بأنّ عليه أن يضع نفسه في الآلام والمصائب لمجرّد أنّها آلام ومصائب مع قدرته على تفاديها وعدم كونها في نفسها مطلوباً أخلاقياً أو شرعيّاً،
ولهذا نجد أنّ القرآن وأدعية الكتاب والسنّة توجّهنا للاستعاذة بالله من شرور الخلق من الإنس والجنّ وغيرهما، فلو كان النص الديني يدفعنا للترحيب بالآلام فليس بمعنى جرّ الألم والمصيبة إلى ديارنا، بل بمعنى أنّه إذا وقعت المصائب والآلام فإنّ العون عليها هو الله وأنّ على الإنسان أن يوظّفها لصلاحه لتنتقل من تهديد إلى فرصة؛ فإنها فرصة للعودة الى الله والتضرّع والانكسار أمامه وإثبات الثبات على الإيمان والمبادئ حتى في أصعب الطروف التي تواجه الفرد والجماعة،
فبهذا يتحقّق ما يريده الله من فلسفة الألم في الدنيا عبر استعانتنا به على الألم والعودة إليه عنده، لا عبر إيقاع أنفسنا في الآلام والتهاون في دفعها عنّا. كيف وقد جاء في بعض الأدعية طلب العافية: «اللهم إنّي أسالك العافية»([39]). فلسنا مدعوّين لأن نعيش حياة المعاناة في أبداننا وأموالنا، بل نحن نطلب العافية من الله ودفع البلاء عنّا، لكن لو جاءت التجربة والمحنة فإنّنا نتعامل معها بأخلاقيّة عالية وإيمان راسخ ولا نضعف روحيا وخلقيّاً معها.
المصادر والمراجع
1 ـ القرآن الكريم.
2 ـ الكتاب المقدّس (كتب العهد القديم والعهد الجديد)، دار الكتاب المقدّس في العالم العربي، 1983م.
3 ـ اكليمندس الاسكندري (215م)، تيتوس فلافيوس، كتاب المربّي، سلسلة آباء الكنيسة، فيلو باترون، الطبعة الأولى، 1994م.
4 ـ ابن ماجة القزويني (275هـ)، أبو عبد الله محمد بن يزيد، السنن، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
5 ـ ترتلّيانوس (230م)، كوينيتوس، قيامة الجسد.
6 ـ حب الله، حيدر، قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني في ضوء النص الإسلامي والمسيحي، الحقوق السياسيّة تطبيقاً، دار روافد، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2020م.
7 ـ [جمع] الشريف الرضي (406هـ)، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد، نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبده، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان [بدون تاريخ].
8 ـ الطبراني (360هـ)، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.
9 ـ الطوسي (460هـ)، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 1390هـ.
10 ـ القشيري النيسابوري (261هـ)، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم، الجامع الصحيح، المعروف بصحيح المسلم، دار الفكر، بيروت، لبنان.
11 ـ النووي (676هـ)، محيى الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحواربي الشافعي، شرح صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1987م.
12 ـ الهيثمي (807هـ)، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1988م.
13 ـ Catechism Of The Catholic Church
14 ـ Compendium Of The Social Doctrrine Of The Church, To His Holiness Pope John Paul II Master Of Social Doctrine And Evangelical Witness To Justice And Peace, Reprint Libreria Editrice Vatican, 2005..
15 ـ Flannery, AUSTIN, Vatican Council II, The Basic Sixteen Documents, Constitutions Decrees Declarations, First printing, U.S.A, 1996.
الهوامش
([1]) نُشر هذا المقال في مجلّة «أديان» الصادرة عن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في دولة قطر، العدد الرابع عشر، يناير عام 2021م.
([2]) الروم: 36.
([3]) الروم: 42.
([4]) الشورى: 30.
([5]) الشورى: 48.
([6]) النساء: 79.
([7]) الأعراف: 96.
([8]) الأحزاب: 62؛ والفتح: 23.
([9]) المؤمنون: 115؛ وآل عمران: 191.
([10]) سفر التكوين 2: 15 ـ 17.
([11]) سفر التكوين 3: 16 ـ 19.
([12]) طه: 117 ـ 119.
([13]) سفر التكوين 1: 27.
([14]) البقرة: 30.
([15]) الأعراف: 94.
([16]) الأعراف: 168؛ وانظر أيضاً: الروم: 41؛ والسجدة: 21؛ والزخرف: 48.
([17]) المجادلة: 19.
([18]) انظر: قيامة الجسد: 7.
([19]) انظر: كتاب المربّي 1: 19.
([20]) ص: 75.
([21]) الأنعام: 151؛ والإسراء: 33.
([22]) سفر الخروج 20: 13.
([23]) Catechism Of The Catholic Church, 1889, 1929-1933, 2260-2261, 2268-2301. Vatican Council II, 574. Compendium Of The Social Doctrrine Of The Church, 105-107, 132-134, 144-148, 152-154.
([24]) المتعارف الاستشهاد هنا بالآية رقم 70 من سورة الإسراء.
([25]) النساء: 29.
([26]) البقرة: 85.
([27]) البقرة: 195.
([28]) لقد بحثتُ بشيء من التفصيل في هذه القاعدة على وفق النصوص الدينيّة، فراجع: قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني في ضوء النص الإسلامي والمسيحي: 173 ـ 201.
([29]) راجع: المطففين: 1 ـ 4؛ والضحى: 6 ـ 11؛ والبقرة: 267؛ والمرتضى، نهج البلاغة: 397؛ والهيثمي، مجمع الزوائد 1: 48؛ والطبراني، المعجم الكبير 19: 441؛ وصحيح مسلم 6: 18؛ وسنن ابن ماجة 2: 1307.
([30]) راجع: سفر الخروج 22: 21 ـ 24، و 23: 9؛ وسفر اللاويين 19: 33 ـ 34؛ ومتّى 7: 12، و 19: 18 ـ 19؛ ولوقا 6: 27 ـ 38؛ وغلاطية 6: 1.
([31]) النووي، شرح صحيح مسلم 12: 233.
([32]) غلاطية 5: 16 ـ 18.
([33]) غلاطية 5: 19 ـ 26.
([34]) غلاطية 6: 15.
([35]) الحج: 37.
([36]) غلاطية 6: 7 ـ 8.
([37]) الشورى: 20.
([38]) انظر ـ على سبيل المثال ـ: رومية 8: 1 ـ 17.
([39]) صحيح مسلم 8: 78؛ والطوسي، تهذيب الأحكام 3: 79.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي