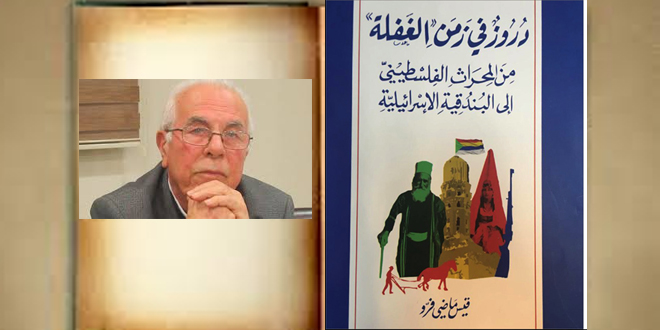الاجتهاد: يعتمد كتاب “دروز في زمن الغفلة” في الأساس، على الأرشيفات الإسرائيلية وعلى مصادر أولية أخرى، قسم منها استخدمته سابقاً في كتابي “الدروز في الدولة اليهودية” (1999) الصادر بالإنكليزية1، والقسم الأكبر منها مواد جديدة كشفت جوانب كثيرة لم يتطرق إليها كتابي السابق.
وفي هذا الكتاب الجديد (دروز في زمن الغفلة)، توسعت في عرض الأحداث التاريخية التي جرت في عهد الانتداب (1920 – 1948) وتحليلها. وقد سبقني مؤرخون إسرائيليون في دراسة ما سُمي العلاقات الدرزية الصهيونية في عهد الانتداب، معتمدين على الأرشيفات الإسرائيلية. ومع أنهم تعاملوا مع المادة الموجودة في تلك الأرشيفات على أنها أداة في الوصول إلى حقائق تاريخية، إلا إنهم – كما سنرى في فصول هذا الكتاب – بنوا سرديات تاريخية لا تعكس رؤية الناشطين الصهيونيين في عهد الانتداب فحسب، بل تبني هذه العلاقات طبقاً لحاضرها المتصوّر عندهم.
في هذا الكتاب، تعاملت مع الأرشيفات الإسرائيلية بحذر شديد من منطلق أن الأرشفة، في حد ذاتها، هي عملية انتقائية محكومة باهتمامات ورغبات فريق مشتغل فيها، وهي، بالتالي لا تنقل الأحداث كما جرت في الماضي، بل تنقل أوصاف أحداث من الصعب جداً أن يطابق المؤرخون بينها وبين ما حدث في الماضي.
فالمؤرخون على مختلف مشاربهم النظرية، يجمعون قرائنهم من المصادر الأولية ليبنوا سردية تاريخية معتمدين على منظور تاريخي يمنحهم القدرة على النظر إلى الأحداث الموصوفة من منظار حاضرهم حين يكون عندهم فكرة عن بداياتها ونهاياتها، ليضعوها في سلسلة سببية على شكل سردية تاريخية.
معنى ذلك أن القرائن التاريخية ليست قائمة بذاتها بمعزل عن عمل المؤرخين في بناء سردياتهم، ولا يصبح لها معنى في الكتابة التاريخية إلا بعد تدخل المؤرخين وتفعيلهم منهجيات معينة في تأويلها. من هذا المنطلق، أرى أن المواد الأرشيفية الإسرائيلية – كغيرها في سائر العالم – هي أوصاف أحداث تمتزج فيها نوازع واهتمامات واصفيها المتأثرين بالسياقات السياسية والثقافية التي عملت فيها الحركة الصهيونية على تحقيق أهدافها الاستيطانية.
وفي غياب مواد أرشيفية فلسطينية تنقل الرواية الفلسطينية عن الأحداث، سعيت للبحث في مواد الأرشيفات الإسرائيلية نفسها، عن معلومات تشير إلى هذه الرواية، والبحث عن مصادر أولية أخرى، يمكن أن تحرر الرواية الفلسطينية من سطوة الأرشيفات الصهيونية.
ولأنني أعتبر كشف المصادر ركناً من أهم أركان الكتابة التاريخية، لم أكتف بالبحث عنها في الأرشيفات والكتب، بل لجأت إلى استخدام الشهادات الشفهية، لا من منطلق أنها أصدق من المادة الأرشيفية، بل لكي أستفيد منها في تحليل الوثائق، وأسد ثغرات وجدتها في الأرشيفات الإسرائيلية. ومع أن المجال لا يتسع لعرض موقف المؤرخين الإسرائيليين من الشهادات الشفهية التي يعتمد عليها بعض المؤرخين الفلسطينيين، إلا إنني اخترت أن أتوقف عند موقفي مؤرخين إسرائيليين هما يوآف غلبر وبني موريس، وقد أشرت إليهما في بعض فصول كتابي.
فالأول، وبعد وجه نقداً شديداً إلى أصحاب هذه النظريات2 استخدم نقده هذا ليظهر عيوب الكتابة التاريخية الفلسطينية بسبب المصادر التي تعتمد عليها: «منذ سنوات السبعين كثر التوجه في الكتابة العربية عن الصراع إلى مصادر فولكلورية – شعر، أدب شعبي وشهادات شفهية …… .
إن الباحثين الفلسطينيين الذين كتبوا في السنوات الأخيرة عن قضية اللاجئين، لم يتجاهلوا المصادر ذات الصلة فحسب، بل تجاهلوا كذلك تأثير الحالة الاجتماعية – الاقتصادية في هروب العرب…. مرتكبين الأخطاء فيما يتعلق بالحقائق، وبالتسلسل الزمني للأحداث.3
أما بِني موريس – المعتمد كذلك في الأساس على الأرشيفات الصهيونية، فقد تناول الشهادات الشفهية في مقدمة كتابه: ولادة مشكلة اللجوء الفلسطيني، 1947 – 1948 من منطلق مشابه لمنطلق غلبر، لكنه لم ينفها نهائياً: «بعد تفكير حذر وطويل قررت أن أمتنع …. من استعمال المقابلات [الشفهية]…. كمصادر لجمع المعلومات وقد توصلت إلى إيمان بقيمة الوثائق. فبينما يمكن للوثائق من زمن الأحداث أن تكون مضللة ومشوهة وناقصة أو كاذبة….. فهي في تجربتي، نادراً جداً ما تستذكر أحداثاً مثيرة للجدل كما تثيرها المقابلات بعد 40 عاماً [من حصولها].
إن تجربتي المحدودة مع مقابلات كهذه كشفت ثغرات كثيرة في الذاكرة …. [لذلك] وجدت أن استخدام المقابلات مفيد للحصول على اللون وعلى صورة الأوضاع التي كانت سائدة فحسب. وفي حالات نادرة جداً، اعتمدت على التاريخ الشفهي في الوصول إلى حقائق [تاريخية].4
لقد استوحيت عنوان كتابي هذا “دروز في زمن الغفلة: من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية” من عنوان محاضرة قدمتها في يوم دراسي، في جامعة حيفا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، تناولت فيها الانتقال من العمل في الزراعة إلى العمل في سلك الأمن وتأثيره في سلوك أبناء الطائفة الدرزية في الدولة الصهيونية، وفي بعض نخبها التي تستخدم خطاباً يشبه خطاب المرتزقة في مطالبتها الحصول على حقوق متساوية.
وكنت قد وصفت هذا الخطاب على هذا الشكل في مداخلة قدمتها في مركز التعددية الثقافية بجامعة حيفا، في 8 نيسان / أبريل 2009، لمناقشة نتائج استطلاع رأي أعده، في أيار / مايو وحزيران/ يونيو 2008 باحثان لا ينتميان إلى الطائفة الدرزية، رصدا فيه مواقف أبناء الطائفة وبناتها من مؤسسات دولة إسرائيل ومن التجنيد الإجباري المفروض عليهم. وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع أن 73.2% من المستطلعين يعتبرون وضع الدروز من ناحية حقوقهم مشابهة أو أسوأ من وضع سائر الطوائف العربية في دولة إسرائيل (46.7% يعتبرونها مشابهة و 26.5% يعتبرونها أسوأ، بينما لم يبد 26.8% منهم رأياً في الموضوع).
كما أظهر الاستطلاع، أن 90.1% من المستطلعين اعتبروا مصادرة الأراضي عاملاً رئيسياً في ظهور حالات عدم رضا الدروز تجاه سياسة الدولة الصهيونية. أما في مسألة تجنيد أبناء الطائفة في الجيش، فقد أظهر الاستطلاع أن 46.6% من المستطلعين يطالبون بجعله اختيارياً، كما هي الحال عند سائر الطوائف العربية، وأن %17.3 يرفضون أي شكل من أشكال التجنيد، وأن 36.1 لا يبالون ببقاء طريقة التجنيد على حالتها.
وبعد مداخلتي اعترض أحد الحاضرين على مصطلح «المرتزقة»، معتبراً ذلك إهانة لأبناء الطائفة؛ فشرحت له أن كلامي لا يعني إلصاق صفة “المرتزقة” بالدروز، بل يقتصر على الإشارة إلى نوع الخطاب المستخدم عند النخب في المطالبة بحقوقها. ولكي أوضح مدلول كلامي سألته هل يستحق أبناء الطوائف العربية الذين لا يخدمون في الجيش مساواة في الحقوق مع يهود الدولة؟
فأجابني: لا، معللاً ذلك بأن المساواة مرتبطة بواجبات الخدمة العسكرية ودفعني جوابه إلى طرح السؤال التالي: هل يستحق الأميركيون الذين لا يخدمون في الجيش الأميركي الحصول على المساواة، مع أن نسبتهم من سكان الولايات المتحدة تتجاوز التسعين في المئة؟ لكن هذا المعترض لم يأبه لما أقصده، وبقي مصراً على موقفه في الربط بين المساواة والخدمة العسكرية.
ذكرني النقاش الذي دار في هذا اليوم الدراسي بحادثة جرت معي في سنة 1994، حين طلب مني محرر المجلة العبرية “طبيعة الأشياء” أن أكتب مقالة عن الدروز في الشرق الأوسط. وفي مقابلة معه تم الاتفاق بيننا أن يكون لي حق اختيار الصور المضافة إلى المقالة، وأن يرسل المقالة إليّ قبل نشرها وبينما كنت أنتظر لقاءه ثانية كي أختار الصور، رأيت المقالة منشورة في مجلته وقد استبدل عنوانها الأصلي “الدروز في الشرق الأوسط”، بعنوان من عنده هو “حلف الحياة، حلف الدم”، واختار بنفسه صوراً أبرزت في معظمها جنوداً دروزاً في الجيش الإسرائيلي، وذيلها بملاحظات.
ولم يكتف محرر المجلة بتغيير عنوان المقالة واختيار الصور، وإنما أضاف، إلى النص الأصلي مقدمة ومعلومات خطأ وتأويلات غير منطقية لأحداث تاريخية. هذه الإضافات قادته إلى اعتبار الدروز جماعة تعيش “في منطقة عرفت كثيرين من مجانين وأنبياء ومتنبئين وزعماء وصراعات وحروب وآمال وإحباطات، وأقليات في وجه أكثريات…. في منطقة قدر الله لها أن تُسقى بالدم والعرق والدموع لمن يتمسك بها، والتي يعيش فيها الشعب الدرزي…. الشعب / الطائفة/ الدين الذي ظهر ككيان مستقل في القرن الحادي عشر”.5
وفي خاتمة المقالة، أضاف هذا المحرر أن دروز إسرائيل يختلفون عن دروز سورية ولبنان لأن الحكومات في إسرائيل عرفت أن لهم كياناً خاصاً بهم…. ولأن علاقتهم [في الماضي) بمحيطهم كانت مزعزعة، الأمر الذي جعلهم يحافظون على أنفسهم…. وعلى الرغم من وجود خصائص مشتركة مع سائر الشعوب في الشرق الأوسط، مثل اللغة…. والثقافة فإنهم في إسرائيل نجحوا في المحافظة على خصوصيتهم الطائفية وعلى حدود كيانهم [المستقل].6
هدفت إضافات محرر المجلة في نظري إلى إبراز العلاقة الخاصة بين الدروز والدولة الصهيونية، كما تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومع أن هذا المحرر اعتذر لي بسبب تشويه مقالتي، إلا إنه بَرَّر تدخله فيها، زاعماً أنه أراد أن يبرز التناقض بين عدم مساواة أبناء الطائفة الدرزية “المخلصة لدولة إسرائيل” وخدمتهم الإجبارية في الجيش الإسرائيلي.
وأشار محرر المجلة في اعتذاره، أيضاً، إلى ما كتبته في ملاحظاتي أنني أنفي وجود مثل هذا الحلف وأعتبره وسيلة يستخدمها [صناع السياسة في إسرائيل] بهدف حث الدروز على التمسك بالولاء للدولة من جهة ويستخدمها دروز…. بهدف تحفيز الدولة على رد الجميل لهم من جهة أخرى.7
لم يكن تشويه مقالتي، في نظري، سوی نموذج لخطاب صهيوني يروجه صناع السياسة ووسائل الإعلام في إسرائيل. فلما وجد محرر المجلة أن مقالتي لا تلتقي مع هذا الخطاب، قرر التصرف، من دون استشارتي، مكرراً تشديده على “خصوصية درزية” قائمة على ثلاثة أضلاع: أمة وطائفة ودين، والتي تشبه خصوصية “الأمة اليهودية” التي يتحد فيها الدين والقومية، وعلى علاقة المحبة بين الدروز واليهود عبر التاريخ.
وقبل الانتقال إلى عرض فصول هذا الكتاب أرجو من القارئ أن يتحمل إكثاري من الاقتباسات وسرد تفصيلات الأحداث؛ فأنا أنطلق من إدراك معرفي بأن هذا الإكثار ساعدني في كشف – ربما عن طريق “المصادفة المحظوظة” – أحداث ومسارات كوّنت في نظري سردية تاريخية ذات صدقية.
وأرى أن مقياس هذه الصدقية لا يكمن في عرض الماضي كما كان، وإنما في تقديم عرض بديل من . هذا الماضي، وأن صدق عرض هذا البديل هو الذي يحدد في نظري جودة البحث التاريخي وكتابته. وبالقدر نفسه الذي يكون فيه البديل من الماضي أميناً للقرائن والشهادات التاريخية المتاحة، ومكثراً من استخدامها والاقتباس منها، يكون العرض صادقاً حتى لو كان على الدوام، قابلاً للتعديل والتحسين.
الهوامش:
1 . Kais M. Firro, The Druzes in the Jewish State: A Brief History (Leiden: Brill, 1999).
2. انظر: يوآف غلبر، «هيستوريا، زكرون، وتعموله: هدسیلینه ههستوریت بعولم وبآرتس» («تاریخ ذاكرة ودعاية: فرع علم التاريخ في العالم والبلاد) (تل أبيب عام عوفيد، 2007،) ص 257 – 263.
3. المصدر نفسه، ص 432 – 435
4 انظر: Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 2.
5. انظر: المجلة العبرية، طيبع هدبريم» («طبيعة الأشياء) العدد 8 شباط/ فبراير – آذار / مارس 1995)، ص 66.
6. المصدر نفسه، ص 94
7. انظر: اعتذار المحرر في المصدر نفسه، العدد 9 نيسان / أبريل – مايو/ أيار 1995)، ص 2.
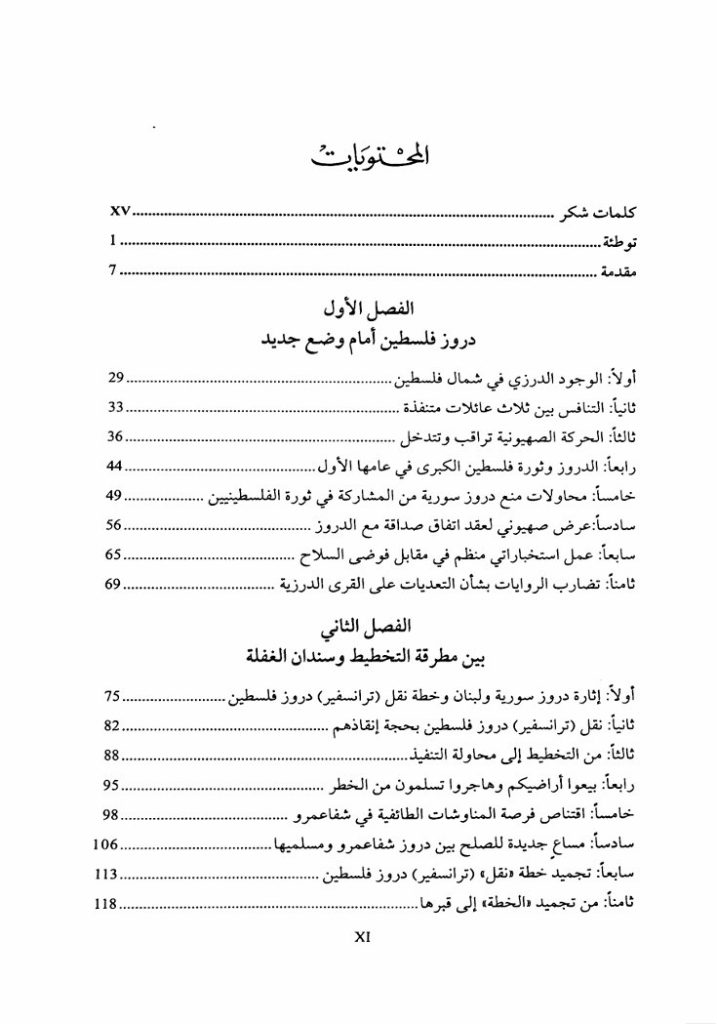
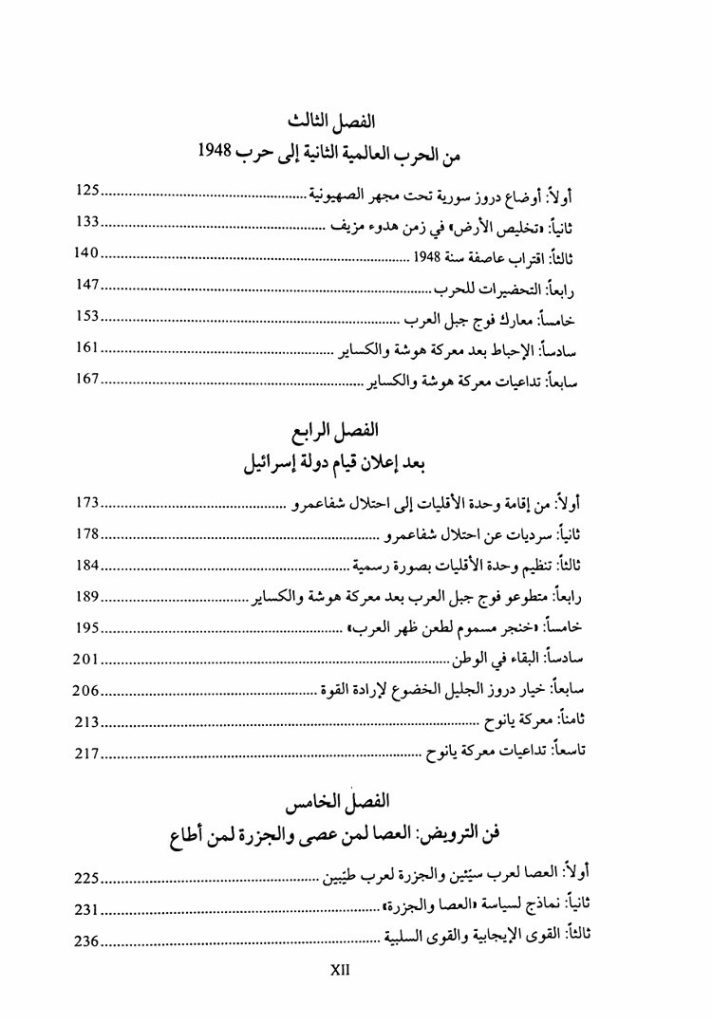
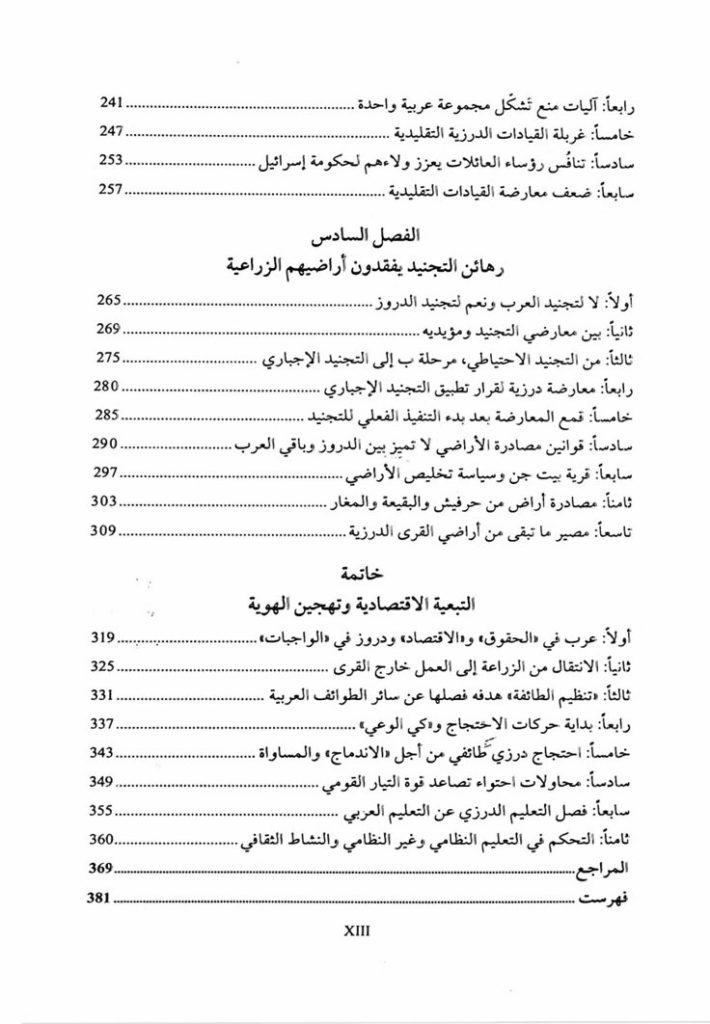
تحميل الكتاب:
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي