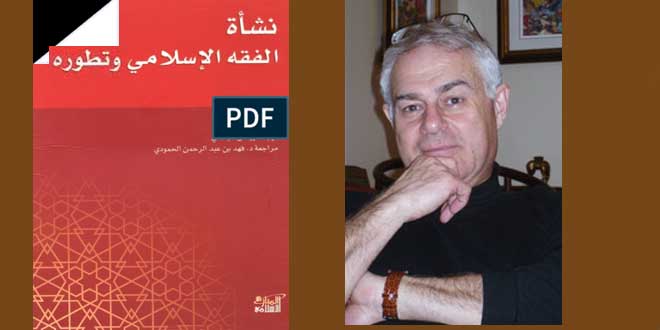الاجتهاد: لقد حاول وائل حلاق في كتابه ” نشأة الفقه الإسلامي وتطوره” أن يجذر الثقافة العربية الإسلامية في سياقها الحضاري العام، سياق ثقافة الشرق الأدنى بصورة عامة، تلك الثقافة التي كانت رافداً من روافد شرائع بلاد ما بين النهرين وفارس وغيرهما.
فكان على الكاتب إذن أن يتجاوز ما سعى الفكر الغربي إلى ترسيخه منذ عقود عديدة حيث روح أطروحة مفادها أن الفكر الإسلامي وخاصة الفقه ليس سوى امتداد للفكر والمنطق اليونانيين، وقد نجح حلاق إلى حد بعيد في تأكيد استفادة الفقه الإسلامي من شرائع ما بين النهرين وأعراف عرب الجاهلية وعاداتهم فضلاً عما جاءت به الأديان الكتابية الكبرى، إلى جانب قيامه على الهدي القرآني والسنة النبوية طبعاً.
وما من شك في أن الكاتب استثمر ما كشفت عنه الدراسات الأثرية والحفريات المعاصرة في الجزيرة العربية من قيام حضارة مدنية مكينة في عدد من نواحيها، عرفت حياتها استقراراً أفاد من نشاط حركة التجارة بالمنطقة وهو ما سهل تأثر القبائل العربية بغيرها مت لشعوب في الممالك المتاخمة بل حتى في الإمبراطوريات البعيدة.
وعلى هذا النحو ساغ له التشكيك في الصورة المتداولة عن الأعراب الرحل الذين يضربون في الصحراء بحثاً عن الكلأ والمرعى.
ثم وقف وائل حلاق عند مؤسسة القضاء في الفقه الإسلامي وكيفية تطورها منذ مرحلة البدايات حيث كان عمل القاضي امتداداً لما كان يعرف في العصور الجاهلية بدور التحكيم الذي ينهض به حكماء القبيلة وعقلاؤها، وصولاً إلى المرحلة التي بلغ فيها القضاء مرحلة النضج والاكتمال حيث صار القاضي يعين في هذا المنصب
ويلتزم به دون غيره من المهام فتحول موظفاً من موظفي الدولة يجري عليه مرتب شهري ويرتبط بجهاز منظم يرأسه قاضي القضاة الذي تعينه السلطة المركزية، فبدأ الحديث حينئذ عن ضرب من التراتبية الإدارية شبيهاً بما تعرفه كل المؤسسات عندما تبلغ أشواطاً من النضج متقدمة.
ويمثل هذا القسم من الكتاب في تقديرنا وجهاً من وجوه الطرافة إذ قلما وجدنا دراسة اعتنت بمجلس القضاء ومهام كل عضو من أعضائه ويبدو أن كتب تراجم القضاة وأخبارهم قد أسعفت الكاتب ببعض الإجابات التي أرقته بسبب ضياع محاضر القضاء وسجلات المجالس.
إن الفكرة المركزية لدى حلاق في جميع ما كتب من كتب ومقالات كما في كتابه هذا إنما مدارها على أن الفقه الإسلامي، في مستوى نشأة المذاهب وفي مستوى قيام مؤسسة القضاء جهازاً منظماً ومستقلاً وفي مستوى إرساء أصول الفقه علماً مكتملاً واضح المعالم، لم يتأسس إلا بعد مرور قرون من الزمان على مرحلة البداية الطبيعية الأولى،
ولعل المثال الأوضح الذي كثيراً ما يعتمد عليه الكاتب هو تأسيس علم أصول الفقه حيث يلقي ظلالاً من الشك حول ريادة الشافعي في هذا المجال أو حول اعتباره الأب الروحي المؤسس له بل إنه يؤكد أن هذا العلم لن يعرض نضجه واكتماله إلا مع القرنين الرابع والخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر للميلاد.
وكذا الأمر بالنسبة إلى المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة فإنها لم تتشكل بالمعنى الدقيق للكلمة حيث تحولت إلى أنساق في الفقه متمايزة إلا بعد عقود من موت مؤسسيها الافتراضيين الذين تنسب إليهم وهم في الحقيقة لم يرسوا سوى مذاهب شخصية تعبر عن آرائهم الفردية الخاصة دون أن تمثل نسقاً في البارزين تأليفاً وجمعاً حيث أسسوا فعلاً هذه المذاهب الفقهية ولكنهم لما كانوا في المذاهب ونسبوها إليهم فنجحوا حينئذ في كسب الأنصار خاصة إذا كان المذهب منسجماً مع الإرادة السياسية للسلطة المركزية.
لقد كشف الكتاب أيضاً عن علاقة الفقه بالسياسة في الحضارة الإسلامية ووقف عند تلك المعادلة العسيرة التي تجمع بين نزوات رجال السياسة ورغبتهم في توظيف الدين لصالحهم من ناحية ورغبة الفقهاء والعلماء في ترويض الساسة وكبح جماح تسلطهم خدمة للشرع من ناحية ثانية وقد أبان الباحث عن خيوط هذه المعادلة العسيرة وأدرك أنها ضرورية بالنسبة إلى الطرفين
فإذا كانت السلطة تجد في الفقه الرسمي سنداً لها ودعماً لمشروعيتها، فإن فقهاء الدولة وجدوا في السلطة اليد الطولى لتطبيق حدود الله وأحكامه بعد استنباطها من أصول الشريعة ولكن هذه المعادلة لم تخل في التاريخ الإسلامي من تصادم بدا في خضوع هذا الطرف إلى ذاك حيناً أو احتواء أحدهما لآخر حيناً آخر، فهل يمكن بعد هذا الحديث عن استقلالية الفقه في الإسلام عن الدولة استقلالية تامة؟
وهكذا لا يقدم كتاب حلاق تاريخاً للفقه الإسلامي وإضافة نوعية في مستوى الجدل السياسي/الديني في الثقافة والتاريخ الإسلاميين فحسب، وإنما هو بالإضافة إلى كل هذا تقييم دقيق للدراسات الغربية الحديثة والمعاصرة التي اهتمت بالفقه الإسلامي وتاريخه وتطوره،
بل إن المؤلف يسائل الكثير من الأفكار التي صارت من قبيل المسلمات الرائجة في الدراسات العربية والغربية كلتيهما، ثم إن الكتاب، فضلاً عن تعدد وجوه طرافته بالنسبة إلى القارئ العربي، يمثل نافذة على آخر ما كتب من بحوث حول التشريع الإسلامي في الجامعات الغربية وحلاق لا يكتفي بالعرض وإنما يصوب ويضيف
وينقد ما جاء فيها من أحكام حول تاريخ المذاهب الفقهية وما شهدته من تطور عبر العصور وما عرفته نظرية أصول الفقه من نضج واكتمال بفضل تراكم المعرفة عبر أجيال متلاحقة من الفقهاء والعلماء.
نبذة الناشر:
كتاب نشأة الفقه الإسلامي وتطوره هو الجزء الثاني من ثلاثية يمكن قراءة كل منها بشكل مستقل صدرت باللغة الإنكليزية عن منشورات جامعة كمبردج البريطانية وهي على الشكل التالي:
1-تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام.
2-السلطة المذهبية التقليدية والتجديد في الفقه الإسلامي.
3-نشأة الفقه الإسلامي وتطوره.
وتقدم هذه الثلاثية مشروعاً أكاديمياً تحقيقياً لمناهضة الخطاب الاستشراقي الغربي المعاصر في الدراسة الشمولية والتأصيلية لتاريخ الفقه الإسلامي. بحيث تحرص هذه الدراسة على محاكمة الفكر الاستشراقي من خلال منهجيته ونظام خطابه، موجهة للجمهور الأكاديمي الغربي في طبعتها الأصلية.
يبحث الجزء الأول النظرية العامة للشريعة الإسلامية كما تبلورت بتطور علم أصول الفقه، بينما يبحث الجزء الثاني ما قبل فترة التكوين للفقه الإسلامي حتى فترة النمو في القرون الهجرية الثلاثة الأول، في حين يبحث الجزء الثالث تطور الفقه في القرون الهجرية الخمسة التالية.
ومن المؤكد أن المثقف العربي والباحث العلمي في شؤون الفقه والحضارة الإسلامية عموماً سيجدان في هذه الثلاثية ما لا يجدانه لا في البحوث التراثية ولا حتى الغربية، ذلك لأن المؤلف الأستاذ الدكتور وائل خلاق حقق في ثلاثيته التاريخية هذه أصالة الانتماء للتراث العربي الإسلامي ودقة البحث العلمي على الطريقة التي يشترطها أهل العلم التأريخي الحديث، هذا ويؤمل أن تفجر هذه الثلاثية مسارات جديدة للنظر في تراثنا الحي وتقدم للباحثين أرضية جديدة لبحوثهم.
بعد أن قدم د. وائل حلاق دراسات عديدة عن التاريخ الوسيط للفقه الإسلامي وأصوله [1]، تناهض منظور كثير من الدراسات الاستشراقية التي كرَّست جهدها لدراسة مرحلة البدايات باعتبارها المبدأ والختام، وما بعدها إلا الجمود والتحلل ـ يستكمل في كتابه هذا دراسة ما يسمى «المرحلة التأسيسية» للفقه الإسلامي منذ بذوره الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى منتصف القرن الرابع للهجرة؛ وكعادته يطرح د. حلاق عددا من الأفكار المخالفة للسائد والمألوف ليس لدى المستشرقين فحسب ـ
كما يصور لنا المؤلف في المقدمات التي كتبها خصيصاً للطبعات العربية من كتبه ـ بل لدى كثير من الدارسين المسلمين لتاريخ التشريع الإسلامي.
يعرِّف المؤلف «المرحلة التأسيسية» بأنها تلك “الفترة التاريخية التي برزت فيها المنظومة الفقهية من خلال البدايات الأولى ثم تطورت إلى حدٍّ اكتسبت فيه ملامحها الجوهرية وهيئتها المخصوصة”. والملامح الجوهرية للفقه الإسلامي أو الصفات الأساسية التي تكسبه هيئته وهويته تتمثل في أربعة صفات:
1- تطورٌ قضائي تام، إلى جانب نظام فقهي، ومحاكم مكتملة الشروط، وتشريع يقوم على الأدلة والأصول.
2- استكمال وضع الأطر الفقهية (شرح كتب الفروع).
3- بروز علم منهجية التشريع والتأويل (أصول الفقه) بروزا كاملا.
4- استكمال ظهور المذاهب الفقهية [2].
وقد كان منتصف القرن الرابع للهجرة هو الفترة التي اكتملت فيها ملامح المرحلة التأسيسية، فظهرت الصفات الأربع جميعها، وكل التطور الذي حدث بعد ذلك بما فيه التحول في أصول الفقه أو التطبيقات إنما كان من قبيل السمات العرضية التي لم تحدث أثرا في بنية الشرع الإسلامي.
إشكالية البدايات في تاريخ الفقه الإسلامي
إن تحديد زمن نشأة الفقه الإسلامي أعقد بكثير من تحديد نهايته؛ فالمشاكل المتعلقة بإشكاليات «البدايات» كانت صادرة عن آراء غير مثبتة، أكثر من صدورها عن أدلة تاريخية قاطعة، ومن ثم اعتقد المستشرقون الكلاسيكيون أن المنطقة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معدمة ثقافيا، وأن العرب لما بنوا مدنهم المتطورة وإمبراطوريتهم وأنظمتهم التشريعية إنما استوعبوا عناصر ثقافات المجتمعات التي فتحوها، لاسيما البيزنطية الرومانية والفارسية الساسانية، ومعارفهم التشريعية.
وقد بينت دراسات حديثة ـ كما يقول المؤلف ـ أن هذه الآراء لا تزال عاجزة عن إيجاد أدلة قوية تقوم عليها، ذلك أن الثقافة العربية، شأنها شأن الثقافات الأخرى، وفَّرت مصدرا لأغلب الشرائع التي تبنّاها الإسلام. وقد بين المؤلف في الباب الأول أن الثقافة العربية قبل الإسلام كانت جزءا جوهريا من الثقافة العامة للشرق الأدنى،
فقد كان عرب شبه الجزيرة خلال اتصالهم الوثيق بعرب الشمال الذين كانوا يسيطرون على الهلال الخصيب يحتفظون بأشكال من الثقافة وثيقة الصلة بتلك التي كانت منتشرة في الشمال، وقد كان البدو أنفسهم جزءا من الخارطة الثقافية. وقد أسهمت المواطن الحضرية والزراعية في الحجاز بدور هام في الأنشطة التجارية والدينية في الشرق الأدنى؛
فبواسطة قوافل التجارة والدعوات الدينية والاتصال بقبائل الشمال عرفت قبائل الحجاز سوريا وما بين النهرين. ولما بدأت دولة المسلمين الجديدة في التوسع نحو الشمال والشمال الغربي والشرقي، فإنها لم تكن تغزو هذه الأراضي خالية الوفاض باحثة عن أشكال ثقافية جديدة أو هوية ذاتية؛ بل كانوا يملكون اطلاعا جيدا على ثقافة هذه المناطق وأغلب شرائعها.
هكذا انتظمت الأمة الإسلامية خلال العقود الأولى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي أساسيين: المبادئ الأخلاقية القرآنية، وأعراف عرب شبه الجزيرة وشرائعهم، وهي شرائع اعترتها تغييرات تاريخية تحت تأثير قيم الدين الجديد.
هنا ينبه المؤلف إلى فكرة بالغة الخطورة وهي أن النظر إلى المسلمين الجدد على أنهم سكان صحراء يعيشون حياة الترحال والقبائل المعدمة قبل أن يفتحوا بلادا جديدة، إنما يقوم على نظرية أساسها أن كل أشكال الثقافة لدى المسلمين،
بما فيها المؤسسات الشرعية، قد تم أخذها عن ثقافات الإمبراطوريات الشمالية ولاسيما البيزنطية، ومثل هذا النظر يوافق الرؤية المنتشرة عن المسلمين اليوم باعتبارهم متخلفين في حاجة دائمة إلى استيعاب الثقافة والقيم الغربية حتى يتمكنوا من مسايرة إيقاع الحداثة والتمدن. (ص54)
تطور الثقافة الشرعية حتى بدايات القرن الثالث
كرّس المؤلف أبواباً ثلاثة في كتابه للبحث في تطور المنظومة التشريعية الإسلامية من خلال تتبع نشاط طبقتي القضاة والفقهاء، وقد عني بنشاط القضاة على نحو خاص إذ رأى فيه أفضل مقياس يمكن أن يضبط به تطور مبادئ التشريع الإسلامي.
لقد عُيِّن القضاة الأوائل في مدن الأمصار دون غيرها حيث عملوا باعتبارهم محكِّمين وقضاة وقيِّمين على أمور اليتامى. وكان دورهم -في جزء من أجزائه- مواصلة لسنة التحكيم القبلي لعهود ما قبل الإسلام؛ فالكثير من هؤلاء تولوا القيام بذلك سابقا والقبائل العربية التي خضعت لقضائهم كانت معتادة على مثل هذا النمط من فضِّ النزاعات.
وقد طبَّق هؤلاء القضاة الأوائل شرائع القرآن بالتوازي مع خليط من الشرائع الأخرى المستقاة من السنن والممارسات العربية الشائعة وأحكام الخلفاء وآرائهم الخاصة. غير أن هذه الشرائع لم تكن تمثل أصنافا متمايزة؛ لأن عادات العرب كثيراً ما قامت على ما اعتبر ضربا من السنن التي كانت تجسد أعمال الخلفاء والرسول نفسه وصحابته الكبار.
لم تكن السنة النبوية (القائمة في جزء منها على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم) خلال نصف القرن الذي تلا وفاة الرسول سوى نوع واحد من عدة أنواع من السنن التي شكلت مصدرا تشريعيا معتمدا لدى القضاة؛
إذ لا نعثر على ما يشير إلى كونها متمايزة عن غيرها من السنن خلال هذه الفترة، رغم ما حظيت به من درجة من الوجاهة رفيعة. إلا أن هذه الوضعية سرعان ما شهدت تغيرا، إذ بدأ كثير من القضاة وأهل العلم منذ ستينيات القرن الأول في استحضار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارها جنسا شفويا منفصلا ومتمايزا عن سنن أبي بكر وعمر وغيرهما.
من هنا كانت بدايات التحول التدريجي الذي انتهى بجعل السنة النبوية مصدرا للتشريع يقوم على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم دون سواها. وكانت هذه البذرة الأولى لتطور آخر ذي دلالة، تمثَّل في ظهور تيار ما يُعرف بالمحدثين الذين تزايد نشاطهم ونقلوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأعمالهم،
واتخذوا موقفا سلبيا من الرأي وتبرموا به. في حين كان الرأي قبل ذلك جزءا لا يتجزأ من التدين والتعبد؛ لأنه كثيرا ما كان يعتمد على القرآن والنماذج التي طُلب الاقتداء بها.
هذه التطورات الأخيرة التي برزت بحلول العقد الثاني من القرن الثاني للهجرة رافقها بروز طبقة الفقهاء وتوسعها مع شروع المسلمين في الاهتمام بالجدل الديني والقص والتعليم بالمساجد، كما بدأ التخصص التدريجي في منصب القضاء، بعد أن كان أوائل القضاة مكلفين بفض النزاعات قبل 80هـ وبواجبات أخرى كإمامة المسلمين أو ولاية بلد ما،
كما بدأنا نشهد التداخل بين حقل الفقهاء والقضاة الذين كان بعضهم ينتمي إلى حلقات الفقهاء الناشئة، كما أصبح المختصون في الفقه جزءا من مجلس القضاء، وظهر تقليد جديد يتمثل في وجوب استشارة القاضي للفقيه.
ثم شهدت الفترة الممتدة بين العقد الثالث والعقد الثامن من القرن الثاني للهجرة نضج كل من منظومتي القضاء والفقه، فقد اتخذت الملامح الأساسية لكلٍ منهما شكلا نهائيا، ولن تشهد في القرنين التاليين إلا مزيدا من التدقيق والضبط.
ولعل من الملاحظات والأفكار المهمة التي أشار إليها المؤلف في دراسته لمصادر التشريع في هذه الفترة هي المكانة التي كانت تتمتع بها السنة العملية. فقد كانت السنة العملية (ما عليه عمل الرسول وصحابته والخلفاء الراشدين) مصدر التشريع الثاني خلال القرن الثاني للهجرة،
ورغم أنها لم تُحدد تماما معنى النصوص القرآنية فإنها أثَّرت في تأويلها، وحددت كذلك الأحاديث التي يجب قبولها وتلك التي وجب استبعادها، بحسب درجة توافقها مع السنة الفعلية (ما عليه العمل) أو تعارضها معها. وهكذا أسس كل إقليم من الأقاليم مثل الشام والعراق والحجاز ممارساته الفقهية الخاصة على أساس ما تم اعتباره سنن الأولين، سواء أكانت تعود للصحابة أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ساهمت أعمال الرسول في المدينة باعتبارها موطن إقامته في تأسيس ممارسة موحَّدة فيها.
ولكن خلال منتصف القرن الثاني للهجرة بدأت طبقة من المحدثين (أو أهل الحديث) تبرز بشدة، وكان شاغلهم الرئيسي هو جمع أحاديث الرسول وروايتها، وسرعان ما اكتسب الحديث منزلة أسمى من السنة العملية. ويقدم المؤلف تفسيرين لهذا التقدم من طرف الحديث على حساب السنة العملية:
الأول: أنه على خلاف السنة العملية التي لا تمتلك مستندا موضوعيا فإن الحديث كان يوثَّق بالاعتماد على الإسناد. الثاني: كان الحديث هيكلا من المعرفة شاملا، أنتجته وضبطته طبقة واسعة من علماء لم يكن لهم عموما أي ولاء خاص لأية ممارسة عملية. وقد لاحظ المؤلف ـ بحذق ـ أن ظهور الحديث قد تزامن مع تطور المجتمعات الإسلامية في المناطق غير العربية.
ولاسيما في الأقاليم الشرقية من بلاد فارس، تلك الأقاليم التي لم تكن تمتلك سنة عملية، فكان الحديث وسيلة مناسبة مكَّنت هذه المجموعات من اكتساب مصدر مناسب لعملهم التشريعي.
أصول الفقه والجمع بين أهل الرأي والحديث
من خلال دراسته لتطور الاجتهاد الفقهي خلال القرون الأربعة الأولى يكشف المؤلف عن تغير هام في مصادر التشريع وآلياته. فقد كان الرأي خلال القرن الأول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم محلَّ تحدٍ متزايد من قبل أهل الحديث، وتمثَّل ذلك في تكاثر السنة النبوية متجسدة في الحديث وقبولها تدريجيا.
وأصبح لأهل الحديث بين نهاية القرن الثاني للهجرة وحوالي أواسط القرن الثالث اليد الطولى التي تم التعديل من نفوذها بقبول الرأي المجرد في أطر محدودة. وبنهاية القرن الثالث للهجرة تم التأليف بين أهل الرأي وأهل الحديث من خلال علم أصول الفقه الذي بدأ في الظهور.
وكان القياس أهم مشغل من مشاغل أصول الفقه (حيث خُصص ما يقارب الثلث من المصنفات الأصولية)، وقد عكس هذا الاهتمام قيمة القياس باعتباره طريقة متقنة في التأويل جعلت التفكير البشري خاضعا خضوعا تاما لنصوص الوحي. وقد تجسد هذا الخضوع من خلال كل عنصر من عناصر هذه النظرية تقريبا.
وعليه رأى د. حلاق أن أهم خاصية في علم أصول الفقه تكمن في وجوب نهوض التفكير البشري بدور هام في التشريع دون أن يتعالى بأي حال من الأحوال على ما أتى به الوحي. إن هذا التوازن بين المجالين (التفكير البشري والنص المنزل) لم يُكتب له أن يستقر حتى منتصف القرن الرابع الهجري،
وهذا يفسر تجاهل نظرية الشافعي التي طرحت صيغة أولية لهذا التوازن من قبل الفقهاء خلال القرن الذي تلا كتابه، في حين بدأ الأصوليون يعيدون اكتشاف الشافعي في منتصف القرن الرابع وتقدير نظريته بل واعتباره المؤسس الأول لعلم الأصول.
لقد تمت صياغة نظرية أصول الفقه باعتبارها ثمرة لهذا التأليف بطريقتين: فقد كان علم أصول الفقه يصف الواقع ويضع الأحكام. ولم يكن ليكتفي بتفصيل مناهج الفقهاء وطرق عملهم في إقامة الشرع كما جسده المجتهدون، وإنما تولى أيضا بيان السبل المناسبة للتعامل مع الشرع، من أجل تحقيق غايته المتمثلة في استخراج أحكامٍ لما يمكن أن يطرأ من قضايا.
تكون المذاهب الفقهية
مع اكتمال ظهور أصول الفقه نحو منتصف القرن الرابع للهجرة أصبحت المرحلة التأسيسية في التشريع الإسلامي مكتملة باستثناء ميزة جوهرية واحدة وهي ظاهرة المذاهب الفقهية.
وقد بيَّن المؤلف أن كلمة «المذهب» في الاستخدام الفقهي لها أربعة معاني تطورت وظهرت تدريجيا:
أولها المبدأ الفقهي الذي ينطوي على عدد من المسائل التي تندرج تحته (مثل جبر الضرر)؛
وثانيها: هو المعنى الأول مقترنا بنسبته إلى فقيه ما؛
وثالثها: الآراء الفردية لأحد المجتهدين، سواء كان هذا المجتهد هو مؤسس المذهب أو كان أحد أئمته؛
ورابعها: الولاء التام لنظرية فقهية معينة ومكتملة وذات بعد جماعي من قبل مجموعة من الفقهاء، وتنسب هذه النظرية لعلم من الأعلام أو شيخ من شيوخ الفقه؛ على الرغم من أن هذه النظرية أو المنظومة الفقهية إنما قامت على إضافات ومساهمات متراكمة لأجيال من الفقهاء المشهورين.
ولكن كيف ارتقى مفهوم المذهب من معناه الأصلي الأساسي (الرأي الفقهي المنسوب إلى فقيه ما) إلى دلالته المتطورة باعتباره مذهبا فقهيا؟
لقد نشأ الاهتمام بالشرع وعلوم الفقه أول ما نشأ في إطار الحلقات العلمية، ولكن حتى منتصف القرن الثاني للهجرة لم يكن العلماء القائمون على التدريس فيها قد كوَّنوا منهجية واضحة في التشريع والتفكير الفقهي. ومع انتصاف القرن الثاني شرع الفقهاء في تطوير تصوراتهم الفقهية ومنهجياتهم، وجمع كل فقيه حوله من خلال تبنيه منهجية معينة عددا من الأتباع أخذوا فقههم وطريقتهم في التفكير عنه.
هكذا أصبحت كلمة «مذهب» خلال القرن الثاني تعني مجموعة من الطلاب والمشرعين والقضاة والفقهاء الذين تبنوا مذهب أحد أقطاب الفقه مثل أبي حنيفة أو الثوري. وهي ظاهرة أطلق عليها د.حلاق اسم «المذهب الشخصي».
بيد أن تبني فكر فقيه معين لم يكن يعني الولاء المطلق لذلك المذهب، فلم يكن من الشاذ أن ينتقل قاض من القضاة أو أيٌ من عامة الناس من مذهب إلى آخر، أو أن يتبنى خليطا من المذاهب تُنسب إلى شيخين من شيوخ الفقه أو أكثر. وإن كان بعض كبار الفقهاء قد حصلوا على أتباع أوفياء لهم التزموا آراءهم مثل أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري.
ولكن هذه المذاهب الشخصية لا تمثل ما يعرف في التشريع الإسلامي بالمذهب الفقهي الذي تطور بعد ذلك ليمتلك عددا من السمات تفتقر إليها المذاهب الشخصية، وهي:
أولا: أن المذاهب الشخصية كانت تحتوي على آراء مجتهد واحد في الفروع ، أما المذهب الفقهي فهو تراكم من الفروع الفقهية تكون فيه الآراء الفقهية للمجتهد، الذي يفترض أن يكون واضع المذهب، معادلةً لبقية الآراء ولاختيارات الفقهاء الآخرين الذين يعتبرون شيوخا داخل المذهب نفسه. بعبارة أخرى: كان المذهب الفقهي كيانا جماعيا ذا سلطة في حين بقي المذهب الشخصي مقتصرا على الآراء الفردية لفقيه واحد.
ثانيا: كان المذهب الفقهي كيانا منهجيا مثلما كان كيانا فقهيا، في حين لم يكن مثل هذا الوعي المنهجي متوفرا في المذاهب الشخصية.
ثالثا: لقد ضُبط المذهب الفقهي بحدوده المادية أي بجملة من الفروع الفقهية والأصول المنهجية التي ضبطت بوضوح الحدود الخارجية للمذهب، أما المذاهب الشخصية فلا تتوفر على مثل هذه الحدود فكان من المألوف فيها تجاوز هذه الحدود لصالح آراء ومبادئ فقهية أخرى.
رابعا: إن تجاوز الفروع الفقهية والمبادئ المنهجية أصبح يساوي الخروج على المذهب الفقهي في حين أن الوفاء للمذهب الشخصي لم يكن بذي أهمية كبيرة على كيانه.
ومن الملامح الجوهرية للمذهب الفقهي التي تميزه عن المذهب الشخصي أنه يؤسس محورَ سلطةٍ تنبني عليه منهجية كاملة في التشريع، وهذا المحور يتمثل في شخصية ما صار يعرف بالمؤسِّس، المجتهدِ المطلق الذي تنسب إليه المبادئ المتراكمة والجماعية للمذهب.
وقد أضيفت إلى هذا المؤسس صفات عديدة منها الاجتهاد المطلق وإنشاء منهجية ونظرية فقهية متكاملة (أصول فقه)، والمعرفة الشاملة، كما كان الفقيهَ الوحيد القادر على الخوض مباشرة في نصوص الوحي. وهذا التصور لا يمكن اعتباره حقيقة تاريخية بحال، بل كان اختراعا لاحقا أريد به بناء سلطتهم وتأسيسها. [3]
ولكن ما السبب الحقيقي وراء ظهور المذاهب الفقهية ، وتطور هذا النمط من المذهبية؟
في حضارات أخرى عظيمة ومتطورة كان الفقه ـ باعتباره نظام تشريع وتنفيذ ـ خاضعا للدولة، في حين لم يكن للقوى الحاكمة في الإسلام أيُّ علاقة بالسلطة الفقهية أو بوضع التشريعات ونشرها؛ لذلك ظهرت الحاجة في الإسلام إلى ترسيخ الفقه في منظومة ذات سلطة، ولم يكن ذلك مطلبا سياسيا، فالسلطة السياسية كانت تعد مثارا للريبة.
في هذا الإطار مثَّلت المذاهب الشخصية الخطوة الأولى لتوفير محور للسلطة الفقهية، ولكن الحاجة إلى محور سلطة مركزي ظلت قائمة. ثم بدا أن الاجتماع حول آراءٍ فقهيةٍ الوسيلةَ الوحيدة التي يكتسب المذهب الشخصي بها أتباعا أوفياء ويضمن الدعم السياسي والمادي، ولم يقتصر مثل هذا الدعم على مزايا مادية مباشرة تمنحها النخبة الحاكمة، بل امتدت إلى تعيينات لهم في مناصب قضائية رفيعة لم توفر دخلا محترما فحسب، وإنما أكسبتهم أيضا تأثيرا في السياسة والمجتمع.
وقد كان تأسيس صورة المجتهد المطلق باعتباره ذروة التطورات التي شهدها المذهب قد مثَّل طريقة لتجذير الفقه في مصدر من مصادر السلطة قام بديلا عن سلطة الجهاز السياسي.
في هذا السياق يطرح المؤلف سؤالا بالغ الأهمية كنا ننتظر الجواب عنه كما وعد في كتبه السابقة، وهو: لماذا لم تعش سوى أربعة مذاهب شخصية وتتحول إلى مذاهب فقهية كبرى في حين اندثرت عشرات المذاهب الشخصية التي ظهرت في القرن الثاني والثالث للهجرة ؟ ولماذا نجحت المذاهب الأربعة ؟
بدايةً، يقدم د. حلاق جوابا موجزا عن ذلك يتمثل في أن المذاهب الشخصية ـ عدا المذاهب الأربعةـ عجزت عن إقامة منظومة فقهية تقودها إلى الارتقاء بنفسها إلى مصافِّ المذهب الفقهي.
وبعبارة أخرى: اقتصرت هذه المذاهب الشخصية الفاشلة على جمع الآراء الفقهية التي تمثل الرأي الفردي للإمام، ولم تقم بعملية بناء سلطة فكرية يمكن أن تنتج تراكما في الفكر والمنهج أو ترتقي بشخصية الإمام إلى مكانة المجتهد المطلق.(ص232)
ولكن لماذا فشلت هذه المذاهب في الارتقاء إلى مستوى تأسيس هذه السلطة؟
يقدم المؤلف أربعة عوامل تفسِّر فشل هذه المذاهب في الارتقاء إلى مستوى المذاهب الفقهية، وفشلها في استمالة فقهاء ممن علا شأنهم واستطاعوا من خلال مساهماتهم الفقهية أن يرفعوا من شأن سلطة ما عرف بالإمام المؤسس في المذاهب الفقهية الحيَّة:
العامل الأول: يتمثل في الافتقار إلى السند السياسي؛ فلما مثَّل الفقهاء حلقة الربط بين الرعية والنخبة الحاكمة تلقوا مساندة السلطة السياسية بالمال وغيره من وسائل الدعم. وعلى سبيل المثال نجاح المذهب الشخصي للحنفية في العراق يعود أساسا إلى دعم العباسيين الذين وظَّفوا علماء الحنفية لحشد تأييد الرعية لهم.
كما يفسر الدعمُ السياسي للأمويين حوالي سنة 200هـ أيضا نجاحَ المالكية بالأندلس في إزاحة المذهب الشخصي للأوزاعي الذي كان مسيطرا قبل ذلك.
العامل الثاني: يتمثل في العجز عن الارتقاء بأفكار المذهب الشخصي إلى نموذج التوفيق بين أهل الرأي وأهل الحديث، وهذا يمثل بوضوح السبب المركزي وراء تلاشي المذهب الظاهري.
العامل الثالث: فتمثَّل في التحالف مع ما اعتبر حركات كلامية غير رسمية، وكثيرا ما كان فشل مذهب من المذاهب نتيجةَ انتماء أتباعه لمثل هذه الحركات. هكذا نجح المذهب الحنفي بانفصاله عن المعتزلة واندراجه في الماتريدية في حشد تأييد فقهي كبير، وكذلك الشافعية في تحالفهم مع الأشعرية. في حين انطفأ مذهب ابن جرير الطبري بسبب انتقاداته الحادة لابن حنبل بطل المحنة.
العامل الرابع: غياب ملامح فقهية مميزة توفر للمذهب الشخصي هوية فقهية مستقلة؛ فالأوزاعي مثلا لم يتأثر بمذهب أهل المدينة تأثرا شديدا فحسب بل كان غير قادر على المدى البعيد على تأسيس هويته الفقهية الخاصة، ولذلك عندما تبنى الأمويون بالأندلس المذهب المالكي مزيحين مذهب الأوزاعي لم يكونوا فقهيا قد انحرفوا كثيرا عنه.
هذه العوامل الأربعة ـ كما يرى المؤلف ـ هي الأكثر وضوحا في تفسير فشل المذهب الشخصي أو نجاحه، وقد تسهم مجتمعة أو منفصلة في هذا الفشل أو النجاح. بل يوجد أحيانا جدل بين هذه العوامل، فالتحالف مع تيار كلامي منشق يقلل من قدرة المذهب على استمالة أتباع جدد، وهذا ما يجعله أقل استمالة للسند السياسي،
لأن دوائر السلطة كانت بحاجة إلى التأثير في أعداد كبيرة من الناس من أجل تحقيق المشروعية السياسية. وعليه لم يكن من المتصور أن تحصل الجريرية (مذهب ابن جرير الطبري) على الدعم السياسي خلال تأسيس مذهبها لأن النخبة الحاكمة ببغداد كانت تعرف أن مثل هذا الدعم سيثير حفيظة الحنابلة في هذه المدينة.
لكن رغم التأثير الذي أحدثته السلطة السياسية في مسار تشكل المذاهب الفقهية من خلال الدعم المادي والسياسي الذي اختارت النخبة الحاكمة منحه أو منعه، فإن الإسلام التأسيسي (التشريع الإسلامي كما تجلى في نهاية مرحلته التأسيسية) قد وفَّر إطارا مناسبا لتطبيق مبادئ الشريعة؛
فكلما أذعنت النخبة السياسية لأوامر الشريعة، تلقت دعما أكبر من الفقهاء من خلال إضفائهم مزيدا من الشرعية على الساسة، وكلما تعاون الفقهاء مع الساسة حصلوا على الدعم المادي والسياسي. وهذه الحقيقة التي جعلت موافقة رجل الفقه ضرورية للعمل السياسي هي التي أعطت الإسلام التأسيسي ما نسميه اليوم «سيادة القانون».
وهذا يفسر لنا افتقاد الشرعية القانونية لأنظمة الدولة الحديثة في معظم دول العالم الإسلامي بعد أن تمَّ تفكيك الشريعة الإسلامية والمؤسسات الدينية والفقهية، وبذلك تم القضاء على كامل سلطة الشرع التي سادت ذلك المجتمع التقليدي قرونا طويلة بفعل توسط الفقهاء الموقَّرين بين العامة والسلطة السياسية.
بهذا الكتاب يكون د. وائل حلاق قد قدم لنا قراءة شاملة لتاريخ التشريع الإسلامي منذ نشأته وحتى عصوره المتأخرة، وهي قراءة متميزة بحق: إن لجهة اتساع المساحة التاريخية التي تعرض لها، أو لجهة الأصالة الفكرية وعمق الاطلاع الذي تكشف عنه،
أو لجهة النظرات النقدية التي قدمها في مختلف دراساته والتي ترقى إلى مستوى الثورة على الأفكار السائدة في التأريخ للتشريع الإسلامي لاسيما المنتشرة في دوائر المستشرقين، أو لجهة الأثر الذي يتوقع أن تتركه في الباحثين في هذا الحقل من بعده.
ـــــــــــــ
العنوان: نشأة الفقه الإسلامي وتطوره
تأليف : وائل حلاق، دار المدار الإسلامي، 2007 (319 ص)
_________
* أعد هذا العرض لموقع ببيليو إسلام
* نشر الكتاب للمرة الأولى باللغة الإنجليزية عام 2005.
[1] وذلك في كتابيه: تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، 1999؛ والسلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي، 2001؛ وقد سبق عرضهما على صفحات موقع ببليو إسلام.
[2] ص24.
[3] فصَّل المؤلف القول في ملامح تأسيس هذه السلطة المذهبية في كتابه السلطة المذهبية الذي سبق عرضه على صفحات هذا الموقع.
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي