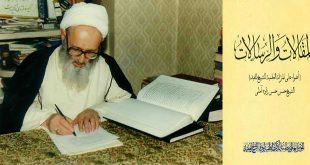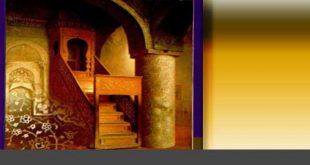تبدأ كتب مذاهب الفقه في أغلبها، بأحكام الطهارة والمياه وأنواعها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أحكام الصلاة،والزكاة،وبقية العبادات، وتنتهي غالباً بأحكام القضاء والحدود وما يتعلق بها. ولا تتناول تلك الكتب مسائل المياه بعد «باب العبادات» إلا بصورة موجزة في باب المعاملات مثل: المساقاة، والمزارعة، وإحياء الموات. بقلم : الدكتور إبراهيم البيومي غانم
موقع الاجتهاد: ثمة صورة معيبة ترسمها أغلب كتب مذاهب الفقه التي جرى تأليفها في عصور التقليد والجمود الفقهي عن الرؤية الإسلامية للمياه وأهميتها في الحياة، وبخاصة في مجالات الفنون والصنائع الجميلة.
فهذه الكتب، في أغلبها، تبدأ بأحكام الطهارة والمياه وأنواعها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أحكام الصلاة، والزكاة، وبقية العبادات، وتنتهي غالباً بأحكام القضاء والحدود وما يتعلق بها. ولا تتناول تلك الكتب مسائل المياه بعد «باب العبادات» إلا بصورة موجزة في باب المعاملات مثل: المساقاة، والمزارعة، وإحياء الموات.
وهكذا فعلت الموسوعات الفقهية الصادرة حديثاً؛ فهي لم تخرج لا عن الترتيب الموروث من عصور التقليد والجمود، ولا عن نوعية الموضوعات التي يكون الماء عنصراً من عناصرها، وكأن كل ما يعرفه الفقه الإسلامي عن المياه يتعلق فحسب بمجال العبادات من وضوء، واغتسال من الجنابة، أو تغسيل الميت.
وما أبعد ذلك عن حقيقة التراث العريق في شأن المياه وتغلغلها في مختلف جوانب التمدن الإسلامي؛ بما في ذلك الاستعمالات الزراعية والصناعية والمعمارية والجمالية للمياه وأحكامها. حتى إن كثيرين من قدماء الفقهاء والحكماء تركوا لنا علماً خاصاً بالمياه اسمه «علم الريافة»، وتناولوا قضايا المياه في مجالات الزراعة والصناعة والترفيه والزينة، وطوروا علم «العمائر المائية»، وأنشأوا «محكمة المياه» في بلنسية بالأندلس في سنة 318ه؛ وهي أول محكمة عرفها العالم مختصة بفض منازعات المياه وإقامة العدل في توزيعها.
ولا تزال مؤلفاتهم شاهدة على ما وصلوا إليه من ابتكارات ذات أهمية تطبيقية في التعامل مع الماء إلى اليوم، وبخاصة مع احتدام أزمات نقص المياه وتلوثها، إلى جانب «حروب العطش» التي تهدد ملايين البشر بسبب الصراع على مصادر المياه وبناء السدود وتوليد الطاقة.
يوضح تاريخ «علم المياه» أن علماء الحضارة الإسلامية بدأوا منذ أواخر القرن الثالث الهجري البحث والتأليف في موضوعات المياه باعتبارها عنصراً من عناصر الحياة المدنية، وليس فقط مادة للطهارة وشؤون العبادات. وكانت مؤلفاتهم في كيفيات «استنباط المياه الخفية» هي الأكثر أهمية، وشكلت تلك المؤلفات المبكرة ما بات يعرف في ما بعد باسم «علم الريافة»؛ أي كيفية استخراج المياه الجوفية، وتنمية الموارد المائية بتعبيراتنا المعاصرة.
وقد عرف طاش كبرى زاده (901 968هـ/1495/ 1561م) هذا العلم بأنه «علم كيفية استخراج المياه الكامنة وإظهارها، ومنفعته إحياء الأرضين وأفلاجها»، وصنفه ضمن فروع هندسة الري.
ويقول أصحاب فهارس الكتب إن أول كتاب في «علم الريافة» كان بعنوان «علل المياه وكيفية استخراجها وإنباطها في الأرضين المجهولة»؛ ألفه أبو بكر أحمد بن علي، ابن وحشية (ت:296هـ/909م). ولكن هذا الكتاب سقط من يد الزمن، فوصلنا خبره، ولم يصلنا نصه.
وفي منتصف القرن الثالث الهجري كتب «أبو يوسف الكندي» (ت:256هـ/873م) شرحاً على كتاب «في قَوْدِ المياه»؛ أي جرها، لفنيلون البيزنطي. ذكره أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي (عاش في القرن الخامس الهجري) في كتاب «المقنع في الفلاحة»، ونقل إلى كتابه فصلاً منه (في ما يعرف به قرب الماء من بعده وحلوه من مرِّه)، وقال في صفته: «هو أحسن كتاب ألف في هذا الشأن…».
ونجد أيضاً في رسالة الكندي «في العلة الفاعلة للمد والجزر» اكتشافه للدورة الهيدرولوجية، فيذكر عناصرها المعروفة في الوقت الحاضر تقريباً وهي: التبخر الذي يتم بتأثير الشمس. يليه التكاثف، الذي ينعقد سحاباً. ثم الهطل، ويصير مطراً أو ثلجاً أو برداً. ثم الجريان أو الانتقال: عائداً إلى الأرض سائلاً إلى البحار. ويشير في شكل واضح إلى دورية هذه الحوادث التي تشكل الدورة الهيدرولوجية للمياه.
ثم يشير إلى حقيقتين تتعلقان بالمياه الجوفية:
أولاً: أن المطر والثلج يشكلان المصدر الأساسي للمياه الجوفية.
ثانياً: وجود أجواف وخزانات في باطن الأرض تحتوي على المياه الجوفية.
ومن بين أهم الكتب أيضاً كتاب «أصول قسمة الأرضين» الذي ألفه في القرن الخامس الهجري أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي (ت:504هـ/1111م)، وهو من علماء الإباضية بتونس.
وقد احتوى كتابه على أول قانون مكتوب في شأن المياه في أفريقيا في زمنه. وقد بحث فيه موضوعات: ملكية ماء المطر والتصرف فيه، وعمارة الأرض بماء المطر، والاشتراك في الماء وقسمة الأرض، وصرف الماء من الأودية، والمساقي (عمارتها، وإصلاحها، وعمارة الأرض على المساقي، والتصرف في المساقي وتغيير خصائصها، والمصارف: إحداثها، وإصلاحها، وتغيير خصائصها، والمقاسم (آلات لقسمة المياه)، والجسور: إحداثها، وإصلاحها، وعمارتها وتغيير خصائصها، والآبار والمواجل (خزانات للمياه عرفت بهذا الاسم في تونس).
وتكشف لنا كتب التراث في عصور الازدهار أيضاً عن أن المؤلفات الكبرى في الزراعة والنبات قد اهتم مؤلفوها (وكان بعضهم من كبار الفقهاء) بالمياه، وبحثوا فيها بحثاً دقيقاً. فإضافة إلى كتاب المقنع في الفلاحة للإشبيلي، هناك كتاب الخراج لأبي يوسف (ت:182هـ/792م) الذي ذكر فيه أصول القواعد التي تتعلق بالمياه والتي يمكن أن نعدّها قوانين شرعية تحدد العلاقة بين الماء والأرض والإنسان، ومنها على سبيل المثال، أن تنفيذ أي منشأة مائية في ملكية خاصة يجب أن يكون بإذن من صاحب الأرض.
وكتاب «صورة الأرض» لابن حوقل (ت:367هـ/977م)، الذي تحدث فيه عن بعض المشاريع المائية الضخمة والقواعد المنظمة لها. وكتاب البيروني (ت:440هـ/ 1048م) بعنوان «الآثار الباقية عن القرون الخالية» وقد قدم فيه بياناً علمياً عن المياه الجوفية.
ويبدو أن القرن الخامس الهجري قد شهد نهضة كبرى في علم المياه مع اطراد ازدهار التمدن الإسلامي، فإلى جانب كتاب «أصول قسمة الأرضين» السابق ذكره، نجد كتاب «إنباط المياه الخفية» لأبي بكر محمد بن الحسن الكرجي (ت:409هـ). وكتابه هذا «موسوعة فنية في دراسة المياه الجوفية واستثمارها». ولفت كتابه انتباه المستشرقين، فترجموه إلى الألمانية، والفرنسية، والإنكليزية.
ومما يلفت النظر بشدة إلى كتاب الكرجي أنه تحدث فيه عن صفات الماء الصالح للشرب، والحافظ للصحة أيضاً، وقد حددها في: أن لا يثقل الماء على المعدة. وأن ينفذ نفاذاً سريعاً. وأن يقبل البرد والحر بسرعة. والماء الذي لا تتحقق فيه الشروط السابقة هو ماء (رديء وبيء) بحسب تعبير الكرجي.
ولا يخفى ما للمياه الملوثة من قدرة على نشر الأوبئة. ويتحدث الكرجي كذلك عن الماء العذب الذي يسميه الرقيق أو الخفيف، باعتباره الماء الصالح للشرب، والماء الثقيل أو الثخين أو الكريه، باعتباره الماء الملوث الذي لا يصلح للشرب. ويوصي بفحص الماء بالنظر والشم والتذوق. فالماء الصالح للشرب ليس له طعم ولا لون ولا رائحة ويقبل الحرارة والبرودة.
واستمر علماء التمدن الإسلامي يضيفون إلى علوم المياه إلى مشارف العصر الحديث، وكان من أواخر ما ألفوه رسالة خطها الشيخ محمد حسين العطار الدمشقي (1243-1177هـ/ 1827-1764م) تحت عنوان علم المياه الجارية في مدينة دمشق، أو رسالة في علم المياه.
وفيها شرح الشيخ العطار طرق حساب توزيع مياه نهر بَرَدَى على كل حارة وزقاق وبيت في دمشق وغوطتها، وهي تروي كل إنسان وحيوان ونبات على مدار العام، وقد خلص إلى أن العلم وحده ودقة الحساب توصل الحياة (المياه) إلى كل بيت، بعدالة وأمانة.
وألف الدمنهوري (المصري) أبو العباس بن عبد المنعم (ت:1182هـ)، كتاباً متميزاً بعنوان «عين الحياة في علم استنباط المياه». ألفه بناء على طلب فقيه تونسي اسمه يوسف بن محمد الزغواني. وأوضح الدمنهوري في كتابه «المواضع التي فيها ماء، والتي ماؤها قريب، والتي ماؤها بعيد، وما يستدل به على ذلك من أمارات ذكرها».
ولعل «الفقه الجمالي» هو أهم ما أسقطته مدونات الفقه التقليدية وموسوعاته المستحدثة. ويتسبب هذا الإسقاط في تشويه الوعي الإسلامي وبخاصة لدى الأجيال الجديدة. وقد ظهر هذا الفقه الجمالي مع تطور المدنية الإسلامية واستقرار المدن والأمصار؛ حيث أصبح الماء حاضراً بكثافة كأحد العناصر البنائية والجمالية في العمارة الإسلامية، وأضحى مجالاً للتنافس والابتكار، وأداة لترقية الذوق الإنساني.
كما تبلور فن قائم بذاته هو فن «العمارة المائية»، التي ازدهرت في الحواضر العربية والإسلامية، وبخاصة في الأندلس في قصورها الحالمة. واستند هذا الفن إلى مرجعية فقهية وتقنية رصينة.
و «العمارة المائـــية» اسم أطلقه قدماء المعماريين والفقهاء والمؤرخون المسلمون على مجمل العمائر والأبنية التي نشأت إما لجلب المياه، أو لتخزينها، أو لتنقيتها، أو لقياس منسوبها، أو للتحكم في توزيعها. وقد انتشرت هذه العمائر المائية في مختلف الأمصار. وكانت حتى مطالع الأزمنة الحديثة من أهم المرافق العامة التي تقاسمت الدولة والمجتمع المدني إدارتها وتمويلها وصيانتها من خلال نظام الوقف الخيري والإرصادات السلطانية.
وقد تنوعت هذه العمائر المائية ما بين: أسبلة مياه الشرب، وصهاريج تخزينها، والآبار الارتوازية، والمقاييس المائية، وشبكات القنوات الممتدة في الأحياء السكنية، والسقايات والحمامات العمومية. وكلها منشآت غاية في الروعة بما تحتويه من رسومات وتصاميم وألوان وزخارف بديعة.
أدرك المعماريون وكبار الفقهاء في الحضارة الإسلامية أن تأمل الماء في الطبيعة أو بين أسوار البيوت؛ أمر يستدعي في النفس الشعور بوجود الله واهب هذه النعمة. وإضافة إلى خرير الماء الذي يبعث السكينة والشعور بالأمان، فإن الماء ينقل المشاهد المتحركة إلى داخل البيئات المعمارية المغلقة ليحولها إلى حدائق غناء كما في البيوت الدمشقية والحلبية العتيقة التي يدمرها متوحشو العصر ويقتلون أهلها هذه الأيام.
إن الجنة التي تجري من تحتها الأنهار التي يتحدث عنها القرآن هي أسمى وعد بالسعادة والخلود. وقد حاول معماريو الحضارة الإسلامية استلهام هذه الجنة وأنهارها في القصور والمنشآت السكنية، وبلغ الأمر في الاهتمام بالماء باعتباره عنصراً جمالياً في العمارة مبلغاً أسطورياً كما يحكي الرواة والمؤرخون عن قصر المأمون حاكم طليطلة، وكما يشهد به إلى الساعة قصر الحمراء بغرناطة وهو النموذج الحي الباقي كاملاً ليشهد على ما وصلت إليه الفنون الجميلة وفقهها في عصور ازدهار التمدن الإسلامي.
إن طريق إحياء هذا التراث العظيم يبدأ بالخروج من أسر النظرة الضيقة التي تحصر فقه المياه في حدود حوض الوضوء، وتغسيل الموتى
المصدر: الحياة
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي