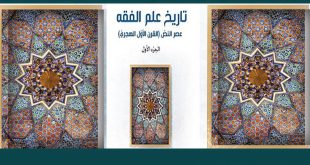الاجتهاد: تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن مسائل تتعلّق بثلاثة أدوار قديمة من تاريخ الشرع الإسلامي، وهي العصر الجاهلي – وليسمح لي بإدخاله في هذا النطاق الواسع – وعصر فقهاء المدينة السبعة، والعصر الذي تكونت فيه المذاهب الكبرى.
فالآن، ونحن مستمرون على السير بموجب الترتيب الزمني، ننتهي إلى دور تندر مصادره؛ فمن العجب أن نلاحظ أنه لم يبلغنا إلا القليل جداً من مؤلفات الزمن بين بدايات المذاهب (التي توجد لها مصادر معاصرة ولو لو تطبع كلها) والنهضة العظيمة التي بلغها علم الفقه في القرن الخامس للهجرة، ونتيجة هذا الدور لابد أن تكون ذلك بالتنظيم والتنسيق للفقه الذي نشاهد أكمل مظاهره عند المذاهب الثلاثة في وقت واحد تقريبا: للحنفية على يد القدوري، وللشافعية على يد الغزالي، وللمالكية على يد سيدي خليل.
ويلوح أنه ليس مستحيلاً أن نتمكن من اكتشاف وثائق أكثر تبياناً لهذا الدور الغامض، إذا ما وجدنا أن بعض مؤلفات أبي جعفر الطحاوي الفقيه المصري المشهور وبعض الكتب الأخرى التابعة لذلك العصر قد كانت حليفة البقاء.
وقبل أن يتحقق هذا الأمل علينا أن نقتبس معلوماتنا من الكتب التي تعالج اختلاف الفقهاء، وهي كتب هدتنا المصادفة الغريبة إلى عدد غير قليل منها راجع إلى القرن الرابع الذي نبحث عنه، وهذا مما يبرر بضع ملاحظات على هذا النوع من كتب الفقه على العموم.
فقد ذكرنا في محاضرتنا السابقة أول كتاب وضع في هذا الفن وهو كتاب الحجج لمحمد بن الحسن الشيباني.
فهذا الكتاب يشترك مع بضع رسائل للشافعي في غرض يحتمل أنه أحدث هذا الفن كله، وهو مجادلة المعارضين التي تستلزم بطبيعة الحال إبداء آرائهم.
وأما كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري الذي ذكرناه أيضاً قبلاً فيحل فيه محل هذا الغرض شيء آخر، هو المقارنة والموازنة بين أقوال المتقدمين تأسيساً لمذهب المؤلف نفسه؛ وأن هذا الكتاب أولى أن ينسب إلى القرن الثالث وإن كان مؤلفه قد مات في سنة ثلاثمائة وعشر.
وهذان النوعان من كتب الاختلاف ظلا قائمين إلى القرن الرابع، وإلى جانبهما قد نشأ نوع آخر، وهو نوع الكتب التي تُثبت الآراء المتنافسة لغرض علمي محض.
وأحياناً نجد المؤلف الواحد قد ألف في الاختلاف أكثر من كتاب واحد. من ذلك أن الطحاوي الذي أسلفنا ذكره ألف كتاب شرح معاني الآثار، وغرضه الراجح هو المجادلة بحيث أنه لا يذكر حتى أسماء خصومه، ولكن له أيضاً كتاب اختلاف الفقهاء الذي يدلي فيه برأيه الشخصي على أثر عرض الآراء المختلفة والأدلة الدالة عليها.
وقد ألف معاصره محمد بن إبراهيم بن منذر النيسابوري كتاب الاختلاف الذي يمثل هذا النوع الثاني، كما ألف أيضاً كتابين من النوع الثالث وهما كتاب الإشراف على مذهب أهل العلم، والكتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ وهذا الاهتمام العلمي المحض قد حمله أيضاً على أن يجمع في كتاب الإجماع المسائل التي لا اختلاف فيها.
أما المسائل المختلف فيها ضمن المذهب الحنفي فلدينا الروايات الثلاث لكتاب مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي، وهو أيضاً من النوع الثالث العلمي المحض.
وقد ذكرت كل تلك الكتب تفصيلا لأنها على العموم غير معروفة إلا للقلائل برغم أهميتها، ولأنها لم تطبع بعد إلا شرح معاني الآثار للطحاوي.
وأما أكثر الكتب المؤلفة في هذا الموضوع في زمن متأخر في القرن الخامس وما بعده، فلا يمكننا أن نوازي بينها وبين تلك المصادر القديمة، ولا ينبغي أن نعتبرها وسيلة يعتمد عليها في الحصول على معلومات جلَّية، لأن تلك الكتب كثيراً ما تناقض نفسها وتناقض حقيقة الأمر، أي أقوال المذاهب المشهورة. وذلك لأنها ليست قائمة على معلومات مباشرة بل يتوقف بعضها على بعض.
كذلك كتاب الميزان للشعراني ليس إلا تغييراً لكتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) للدمشقي، وهذا بدوره مختصر لكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبيرة إلى حدّ أن جميع الأغلاط الموجودة في ذلك الكتاب تتكرر في هذين.
وينبغي ألا نؤاخذ ابن هبيرة بشدة بهذه الأغلاط لأن كتاب الإشراف ليس إلا رواية مستقلة لفصل من كتابه الكبير المسمى بالإفصاح عن معاني الصحاح، وهو شرح مفصل للأحاديث الصحيحة، ومضمون كتاب الإشراف كله وارد في كتاب الإفصاح شرحاً للحديث النبوي المشهور: اختلاف أمتي رحمة
إن أخبار المتأخرين من المؤلفين عن مبادئ مذاهبهم وأقوال الفقهاء الأقدمين يجب أن تقابَل على العموم بتحفظ شبيه بالتحفظ الذي ينبغي أن تقابل به كتب الاختلاف الأحدث عهداً، حتى ولو كان أولئك المؤلفون من أصحاب المذهب الذي يتحدثون عن أئمته.
فإنا نشاهد في المذاهب ابتداء من القرن الخامس افتقاراً للروايات فيما يتعلق بأقوال أصاحبها الأولين، وهو مما يجعل دراسة مؤلفاتهم الأصلية أحرى وأوجب.
وإني لأستمدّ أمثلتي من كتاب المخارج في الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني السالف الذكر الذي لا ريب في صحته مقارناً له بشرح السرخسي المتأخر لأقوال محمد بن الحسن المروية في كتاب المبسوط. فالشيباني يقول في مسألة معينة على وجه الإجمال: (لا آمن أن يبرئه بعض الفقهاء.) ولكن السرخسي يعترف بأنه لا علم له بمن قال بهذا القول.
والشيباني يقول في التحليل: إذا قال واحد منهم هذه المقالة (أي لو قالت الزوجة تزوجني فحللني، أو قال الزوج الأول تزوج هذه المرأة فحللها لي، أو قال الزوج الثاني أتزوجك فأحلك لزوجك الأول) لم تحل للزوج بهذا النكاح الثاني)؛
فالسرخسي في تعليقاته على هذا الكلام يقول: إن النكاح الثاني عند الشيباني صحيح، لكن التحليل في هذه الظروف لا يحصل، في حين أن النكاح الثاني عند أبي يوسف فاسد غير صحيح؛ ولكن السرخسي في موضع آخر ينسب القول الأول إلى أبي يوسف، والقول الثاني إلى محمد بن الحسن الشيباني.
ويقول السرخسي في مسألة أخرى إنه يُنسَب إلى أبي يوسف قولان متناقضان دون أن يستطاع اعتبار أحدهما سابقاً، والآخر متأخراً، فهو مع ذلك يجهد نفسه في التوفيق بين القولين بوجه مفتعل.
ويقول السرخسي في الحيل المستعملة لمنع الشفعة: (وعند محمد رحمه الله هو مكروه أشد الكراهة) وهذا ليس صحيحاً لأن الشيباني قد جمع أمثال تلك الحيل في باب طويل من كتابه المتقدم ذكره نقرأ فيه كلاماً كهذا: (أرأيت رجلا يريد أن يشتري داراً، ويخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فكره أن يمنعه من ذلك فيظلمه، وكره أن يعطيه الدار فيدخل عليه ما يُكرَه. هل عندك في ذلك حيلة؟ قال: نعم الخ).
وإليكم مسألة تدل على أن رأياً نُسب خطأ إلى أبي حنيفة قد ظفر بأن يصبح مسلم به في المذهب كله: فنقرأ في الفتاوي العالمكيرية (الفتاوى الهندية): (فاعلم بأن الوقف على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يصح مضافاً إلى ما بعد الموت بطريق الوصية، هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، ومحفوظنا أن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله صحيح إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت أو كان موصى به) ومع ذلك فالخبر الذي ذكره الخصاف هو الصحيح، لأن هذا يظهر من قول الشيباني نفسه في كتاب المخارج في الحيل.
وقد أمكن أيضاً أن تتسرب أخبار ملفقة إلى حواشي كتب الشيباني حتى في زمن قديم جداً، وينبغي لهذا كله أن يتحاشى المرء قبول شهادة كتب أحدث عهداً في أقوال الأئمة الأقدمين من دون تمحيص.
وسبب تلك الأغلاط يرجع قبل كل شيء إلى تضاؤل الاهتمام بآراء فقدت أهميتها العملية بعد التدوين النهائي للأحكام في المذاهب، ويرجع أيضاً إلى الظن الطبيعي أن تلك الأحكام المدونة هي عين الآراء الشخصية للأئمة الأقدمين، ويرجع أخيراً إلى استبدال عبارات مثل (في قياس قول أبي حنيفة) بعبارات أخرى مثل (في قول أبي حنيفة) فحسب، وهو شيء نراه حتى في الكتب القديمة جداً
وأخرى المسائل التي سنبحث عنها هي مسألة القانون العرفي في بلاد الإسلام، فبينا أن العلاقة بين الأحكام الشرعية والأحكام العرفية – كما رأينا – وجهة مركزية من تطور الفقه نفسه في الأدوار الأقدم عهداً فإن هذه العلاقة تصبح بعد ذلك عندما استقر الفقه في صورته النهائية مطلباً مستقلاً.
ومن بينات القوة الروحية العظيمة التي استمتعت بها الشريعة أنها بلغت حد فرض نفسها على القانون العرفي؛ وإن كان هذا القانون قد بلغ من ناحيته أو كاد يبلغ حد احتكار العمل القانوني من الوجهة المادية؛ وهذا باد من أن الناس تحققوا وجود قانون عرفي يعارض كثيراً من الأحكام الشرعية، وأنهم فسروا هذا من الوجهة التاريخية بأن الأجيال المتأخرة لم تبلغ شأن السلف الصالح، ومن الوجهة الأخلاقية بمبدأ الضرورة التي أغنت عن العمل بالأحكام الشرعية.
وعلى هذا النسق أوجد عالم مصري معاصر فيما يتعلق بالخلافة التي تناءى تاريخها أصلا عن قواعد الشرع، قواعدَ ثانوية موجهة إلى التطبيق العملي ولكنها مع ذلك مصنوعة على طراز تلك القواعد الشرعية.
فأما ما يتعلق بالفقه فقد رأى أهله أن يوفقوا بينه وبين العرف على قدر المستطاع مما أفضى في التطور المتأخر للمذهب المالكي المغربي خصوصاً إلى أن يجيزوا عدة تصرفات عرفية لم تكن تعرفها الشريعة من قبل.
أما العمل العرفي فكثيراً ما حاول أصحابه أن يحتفظوا بمظاهر المطابقة للشريعة على الأقل، في حين أن حقائق الأمور كانت بعيدة عنها بعداً شاسعاً؛ وهكذا أقاموا في حالة أخذ السارق والسكران عند ارتكاب الجريمة حدود السرقة والشرب رأساً معتقدين اعتقاداً صميما أنهم يطبقون الشريعة ولكن دون أن يعنوا بالإجراءات الدقيقة التي فرضتها الشريعة، وهكذا ذهب بعضهم إلى حد ذبح مجرم يستحق الموت وفاقاً لقواعد ذبح الضحايا.
وأنظمة المحتسبٍ وناظر المظلم لا يراد بها إلا اجتياز الهوة التي تباعدت شقتها بين منطقة الشريعة ومنطقة الحياة القانونية العرفية، فلهذا ليست من الشريعة المحضة؛ ومنذ الزمن القديم كانت حاجة الشريعة محسوسة إلى أن يندمج فيها العرف القانوني وأن تتيح لمن يهمهم الأمرُ الوسائلَ لعقد تصرفات تقتضيها العادة مع مراعاة أحكام الشريعة الإلهية التي تجمع بين المخارج البسيطة والطرف الفقهية الأريبة.
فبهذه الحيل يصل المرء من طريق تصرفات شرعية إلى نتائج تطابق الحاجات العملية، ولكن لا تسّلم بها قواعد الفقه رأساً، فهي من جهة الفقه مخارج ومواضعات، ومن جهة العرف جهود في جعل العرف مقبولاً موافقاً للشرع
وقد أنشأ الحنفية هذا الفن من الفقه وتعهدوه، ونجد أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني على رأس سلسلة طويلة من الفقهاء قد ألفوا في الحيل؛ وقد انتهى إلينا كتاب محمد بن الحسن كاملا، (وهو المسمى بكتاب المخارج في الحيل الذي ذكرناه مراراً)، ويشتمل على مسائل عديدة نقلها صاحبه من كتاب أبي يوسف.
أما المذاهب الأخرى فالحيل فيها أقل شأناً منها عند الحنفية، حتى أن الشافعي والبخاري الذي كان نفسه شافعياً وغيرهما قد حاربوا الحيل حرباً عواماً.
ولم يمنع هذا أن المتأخرين من الشافعية قد أحسوا بالحاجة إلى تأليف كتب في الحيل على مثال كتب الحنفية وأن ينسبوا إلى الشافعي نفسه من المخارج العملية ما قد ورد في كتاب محمد بن الحسن الشيباني؛ وقد أفرد الحنبلي الكبير ابن قيم الجوزية للحيل بحثاً طويلاً، وبرغم مناهضته للمكر ومنعه للفرار من أحكام الشريعة وصل في بحثه إلى اعتبار كثير من تلك المخارج مشروعاً خاصة في دائرة التصرفات التجارية.
وأشهر كتاب في هذا الباب هو كتاب الحيل والمخارج المنسوب خطأ إلى أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف الحنفي، فالواقع أن كتابه الحقيقي ليس إلا رواية لكتاب المخارج في الحيل للشيباني، وقد عنى الخصاف بأن يستبعد منها كل إشارة قد تدل على مؤلفه الأصلي؛
والكتاب الذي اشتهر به هو تأليف عظيم الشأن لمؤلف مجهول عاش في حوالي سنة أربعمائة، وهو مصدر فريد في بابه لمعرفة القانون العرفي الذي كان يعمل به في ذلك الزمن في العراق (كما نظن) يكشف لنا عن مستواه العالي واصطلاحاته الراقية، وهذا القانون العرفي يميزه الدور الهام الذي يقوم به الإقرار،
فإنه لا سبيل إلى الرجوع فيه، ولهذا يصلح جيداً لأن يكون مبعثاً للنتائج القانونية المقصودة، كما يميزه دور العدول الأمناء الذين يثق بهم المتعاقدان يقومون بالتوسط بينهما في علاقتهما التعاقدية، وكما تميزه أيضاً كثرة استعمال الوثائق المكتوبة، فكل هذه الخصائص توجد مجتمعة في كتب (المواضعة)،
وهي وثائق يكتبها المتعاقدان وليست لها قيمة قانونية مباشرة، لكنها تصلح لإثبات حقيقة الأمر فيما بين المتعاقدين من العلاقات التي لا يكشف عنها بل يسترها عادةً عدد من التصرفات والإقرارات الموضوعة؛ وتحفظ هذه الوثائق – أي كتب المواضعة – مع الوثائق الفقهية الحقيقية التي توضح وظيفتها عند عدل أمين يثق به المتعاقدان ويعمل هو بمقتضاها فيما بينهما ابتغاء معاملتهما بالعدل والإنصاف ومنع أي منهما عن أن ينتفع بتصرف أو إقرار منفرد لما فيه ضرر لمصلحة الآخر.
وإليكم مثالاً قد يوضح كل هذا إيضاحاً تاماً:
(قلت: رجل له على رجل مال، فوكل رجلاً أن يتقاضى هذا المال ويستخرجه على أن له نصفه أو ثلثه، هل يجوز هذا؟ قال: لا، وإن وكله على هذا الشرط فاقتضى المال كان له أجرة مثله لا يجاوز بها ما جعل له. . . قلت: فهل في هذا من حيلة؟ قال: نعم، الحيلة في ذلك أن يقر الذي باسمه المال لابن هذا الوكيل أو لرجل يختاره الوكيل بثلث المال بحق عرفه له ويوكله بقبضه. . . ثم يوكل الذي باسمه المال والمقر له بالثلث هذا الوكيل باستيفاء المال واستخلاصه فإن خرج المال كان للمقر له الثلث من ذلك. . . .
قلت: فإن قال صاحب المال: أرأيت إن أقررت بثلث المال لمن يريد الوكيل فإذا وقعت الشهادة على ذلك لم يقم هذا الوكيل باستيفاء المال أو أحدث حدثاً تبطل به الوكالة فقد صار هذا الرجل شريكا لي في المال بثلثه، فما الحيلة؟
قال: يعدلون كتاب الإقرار على يدي من يثقون به ويكتبون مواضعة بينهم تكون على يدي العدل يعمل بما فيها ويحملهم عليها، فإن خرج هذا المال بتقاضي الوكيل وقيامه كان لهذا الرجل الثلث. . . وإن لم يخرج من المال شيء أو لم يقم بذلك أو أحدث حدثاً تبطل الوكالة به لم يكن للرجل المقر له بثلث المال شيء ورد العدل منهم الكتب على من يجب ردها عليه، ويحكون في المواضعة أمرهم كله ليعمل العدل بينهم بذلك)
والمصدر الثاني الرئيسي لمعرفة القانون العرفي في بلاد الإسلام هو الشروط والوثائق.
ويوجد إلى جانب الدور الهام الذي تؤديه الوثائق المكتوبة في باب الحيل كتب كثيرة في الشروط عند الحنفية كما هي موجودة عند المالكية والشافعية.
وجدير بالذكر أن أكثر المؤلفين لكتب الحيل من الحنفية ألفوا أيضاً في الشروط، وأنهم من جانب آخر قد اشتغلوا غالبا بالوصايا والأوقاف أيضاً بصورة تجعل من الممكن أن يستبين المرء في الكتب الحنفية على مرور القرون ميلا ظاهرا إلى البحث عن الموضوعات ذات الأهمية العملية، وتلك الأهمية العملية لكتب الشروط ناتجة عن نفس وجودها، ذلك أن الفقه لا يقبل إلا الشهادة الشفوية ولا يستلزم وثائق مكتوبة، وذلك العلم وحده لم يفلح في جعل الشروط في ذلك المركز العظيم الذي هي فيه من عمل الفقه.
وترجع عادة تحرير التصرفات إلى العصر الجاهلي، فقد ظهر أن الوثائق في ذلك الزمن لم تكن محض مذكرات يستعين بها الشهود (كما هي الحال في علم الفقه) بل كانت وثائق مستقلة تنطق بمضمونها لا ريب أنها لم تزدوج بالشهادة الشفوية إلا في مرحلة ثانوية؛ وقد أقر القرآن هذه الحالة في نوع من العقود في الآية التالية: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،
فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا، ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.) وفي آية أخرى ذكر القرآن الوثائق المكتوبة في إعتاق الرقيق على أنها شيء معروف: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً.)
حتى الاصطلاح الخاص بالإعتاق التعاقدي في مصطلح الفقه، وهو الكتابة، يدل على أن ذلك كان مكتوباً في الغالب على الأقل؛ والأمر السابق الذكر وهو أن الشروط والوثائق تقوم في تطبيق الشريعة العملي بدور أهم بكثير مما يعينه لها علم الفقه – ذلك الأمر لا نفهمه إلا ببقاء عادة ثابتة قديمة تقتضي تحرير العقود بالكتابة؛
ومن الراجح أن تلك العادة الموجودة في القانون العرفي العربي الجاهلي كانت تأثرت بنفوذ التمدن العراقي، فإن العراق مشهور بالدور الهام الذي قامت به الوثائق المكتوبة في حياته القانونية والأدبية منذ زمن قديم جداً.
أما الوثائق التي تبينها وتوضحها كتب الشروط، وكذلك الوثائق الأصلية التي احتفظ بها فهي تتفق بطبيعة الحال في مضمونها المادي مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب الظروف والإمكان، وخصائصها البارزة لا تظهر إلا في صيغتها التي تغيرت تغيراً كبيراً على كر القرون، لكنها كانت دائماً خاضعة لقواعد فنية صارمة.
وإليكم خاصة جديرة بالذكر تشترك فيها كتب الشروط القديمة بأجمعها:
قد تلونا آنفاً آية قرآنية تنص على أن (الذي عليه الحق) يكتب ويمل؛ وأما في كتب الشروط القديمة فالقاعدة الأساسية هي يملي الكتاب المدين (أو من يقوم مقامه من المتعاقدين) على المديون (أو القائم مقامه) وأن يقرّ هذا بصحة الوثيقة ويُشهد على ذلك الشاهدين
وثمة مصدر ثالث لدراسة القانون العرفي، وهو التشريع المدني الدنيوي في بلاد الإسلام. ومن الحق أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بتشريع مستقل يقوم إلى جانبها، وتلك التشريعات المدنية حتى في أوائل العصور الحديثة لم تزعم أكثر من أن تكون ملحقات بالشريعة في الدائرة التي سمحت لها بها؛ والواقع أن تلك التشريعات كثيراً ما جاوزت هذه الحدود.
وأشهر مثال لمثل تلك التشريعات هو ما يسمى (بالقانوننامجات العثمانية)، فإنه بينا كانت أكثرها تتصل بمسائل إدارية، قد ردتها الشريعة إلى اختصاص الدولة،
فإن أول قانون من هذه القوانين وهو (قانوننامه) السلطان محمد الفاتح بنظم العقوبات أيضاً والأحكام الشرعية في الواقع لم تنفذ في تلك المنطقة أحياناً كثيرة، وتفترض هذه القانوننامه أن القصاص يمكن إجراؤه بخلاف الحدود، وقد وضعت بدلا منها قانوناً جنائياً كاملا يختلف أصلا عن أحكام الشريعة،
وإن كان يذكرها في مواضع عديدة ويستعير منها بعض القواعد الأساسية؛ ويمتاز هذا القانون الجنائي بالدور الهام الذي تؤديه الغرامات المالية المختلفة المبالغ تبعاً لثروة المذنب.
حتى الزاني بشرط أن يثبت عليه البينة وفاقاً لقواعد الشريعة يعاقب عليه بغرامات مختلفة القدر على حسب كونه متزوجاً أو غير متزوج (وتهمنا ملاحظة التعديل الذي أدخل بهذا على فكرة الإحصان في الشريعة) والأرقاء لا يدفعون إلا نصف المبلغ المفروض على الأحرار، والسكر أيضاً (وهو يقوم مقام الشرب في الشريعة) لا يعاقب عليه إلا بالتعزير؛ وهو يُترك في الشريعة لتقدير القاضي،
وأما في هذه القانوننامه فالتعزير دائماً ضربات بعصا مقرونة بغرامة مالية، ويطبق نفس هذا التدبير على السرقة ولا يقام الحد إلا في سرقة الخيل؛ ويكون في هذه الحالة إما قطع اليد وإما غرامة باهضة جداً، ولابد من أن هذه الجريمة كانت تعتبر خطيرة بصفة خاصة؛
وجلي أن هذا القانون الجنائي يراد به أن يحل محل القسم المطابق له من الفقه تماماً لا إكماله فقط، لكنهم على كل حال يتحاشون أن يقولوا بهذا صراحة ويطلقون عبارات من قبيل (السياسة في مقابلة الجنايات) أو (بدل السياسة) على إبدال الحدود بالغرامات المالية؛ وقد اتخذت هذه القانوننامه أنموذجاً للقوانين العثمانية التي تعالج نفس الموضوع
وعلاقة أخرى بين الشريعة الإسلامية والتشريع المدني، تخالف كل ما تقدم مخالفة تامة، توجد في الدور الأخير من تاريخ الشرع وهو تطوره المعاصر، وحسبنا أن نذكركم بالتعديلات التي أدخلت منذ سنة ألف وتسعمائة وعشرين على الأحوال الشخصية في مصر؛ ولسنا نريد أن نبحث الآن عن تلك الظاهرة المهمة للحياة القانونية المصرية لأن الوقت الذي نملكه قد انتهى.
وإنما نستشهد بها هنا كدليل على أن العلم الأوربي الذي يشتغل بتاريخ الفقه الإسلامي لا يتناول الأزمان الماضية فقط، بل يجهد في استيعاب الحياة الحاضرة أيضاً، وأن موضوعه الواسع ليس ميتاً جامداً بل لا يزال قوياً متطوراً.
فإن كنت قد وُفقت إلى إطلاعكم على شيء من الروح العلمية الخالصة المهيمنة على دراستنا هذه فقد حققت بعض الغرض من هذه الأحاديث كل التحقيق
المصدر: العدد 144 من مجلة الرسالة (وهي مجلة ثقافية ترأس تحريرها الأديب المصري أحمد حسن الزيات باشا (المتوفى: 1388هـ) عدد الأعداد: 1025 عددا (على مدار 21 عاما) وكتب فيها معظم المقالات عن رموز الأدب العربي آنذاك من مثل: زكي نجيب، محمود العقاد، سيد قطب، أحمد أمين، علي الطنطاوي، محمد فريد أبو حديد، أحمد زكي باشا، مصطفى عبد الرازق، مصطفى صادق الرافعي، طه حسين، محمود محمد شاكر والشابي.)
جوزف شاخت
جوزف شاخت
أثار شاخت حفيظة العلماء المسلمين لأنه يشكك في صحة الأحاديث النبوية ويرى أنها وضعت أو “لفقت” خلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث هجري.
ولد شاخت في مدينة راتيبور الواقعة في ألمانيا (حاليا ً بولندا). حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة بريسلاو وانتقل بعدها للعمل في جامعة ليبزيغ ثم في جامعة فرايبورغ الشهيرة.
تمت ترقيته إلى منصب أستاذ كامل عن عمر 25 عاماً فقط. وعام 1932 تبوء شاخت منصب رئيس دائرة الدراسات الشرقية في جامعة كونينسبورغ حيث بقي هناك لحوالي السنتين قبل أن يستقيل بعد وصول الحكم النازي إلى السلطة في ألمانيا.
غادر شاخت بعد ذلك إلى مصر حيث عمل في جامعة القاهرة كأستاذ زائر وعام 1939 استقر في بريطانيا حيث عمل مع وزارة الإعلام لمدة خمسة سنوات، عاد بعدها للتعليم في جامعة اوكسفورد حتى عام 1954.
وخلال هذه الفترة وضع شاخت أشهر كتبه “أصول الفقه المحمدي” عام 1950. وعام 1954 انتقل شاخت إلى جامعة لايدن حيث شغل منصب رئيس دارة العربية قبل أن يغادر إلى جامعة كولومبيا عام 1959 حيث أمضى بقيت حياته.
توفي شاخت عام 1969 بجلطة دماغية في نيويورك. يعتبر شاخت من أكثر الوجوه الإشكالية في مجال الدراسات الإسلامية. رغم إتقانه اللغة العربية وسفره إلى عدد كبير من العواصم والمدن العربية والإسلامية كالقاهرة والجزائر وفاس وتونس وإسطنبول، فإن البعض يعتبره مستشرقا ً بامتياز بسبب مواقفه المشككة بركائز الفقه الإسلامي.
أما البعض الآخر فيعتبر أن معرفته الواسعة بالتاريخ الإسلامي سنحت له بتقديم مقاربة جيدة ونقدية لنشأة الإسلام. بدأ شاخت حياته الأكاديمية بالعمل على عدد من المخطوطات العربية لا سيما تلك منها الموجودة في القاهرة.
وفي هذا الإطار قام بتحقيق مخطوطة كتاب “الحيل والمخارج” للخصّاف في الفقه الإسلامي عام 1923. وفي منتصف العشرينات بدأ اهتمام شاخت بالفقه الإسلامي حيث استغل موقعه في جامعة فرايبورغ وعمل على تطوير معرفته بالقانون ومصطلحاته التقنية.
وفي مطلع الثلاثينيات كتب شاخت مقالات أكاديمية عدة في الفقه وعالج مسائل معاصرة في مقالته “الشريعة والقانون في مصر المعاصرة” 1936. غير أن اهتمام شاخت عاد ليتركز على نشوء الفقه حيث قام بدراسة مستفيضة حول محمد إدريس الشافعي تضمنها كتابه الأشهر “أصول الفقه المحمدي.”
ويعتبر شاخت في هذا الكتاب أن معظم الأحاديث النبوية تم “تأليفها” أو وضعها مع نهاية القرن الثاني هجري / بداية القرن الثالث. ويشكك بصحة عدد كبير من الأحاديث النبوية ويقول أنها وضعت لدعم حجج وأراء الفقهاء في ذلك الوقت.
ويرى شاخت أن الشافعي لعب دورا ً محوريا ً في ذلك لأنه كان في مواجهة أهل الرأي من جهة وأهل الأثر من جهة ثانية.
ومن هنا يعتبر شاخت أن الحاجة لإعطاء سلطة مطلقة غير قابلة للنقض أدت إلى إرجاع جميع الأحاديث إلى النبي محمد. وفي عام 1954 وضع شاخت كتابه “مقدمة للفقه الإسلامي” الذي مثل خلاصة فكره.(المصدر: أبجد)
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي