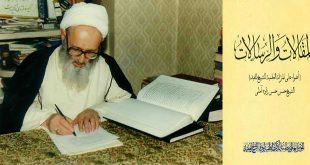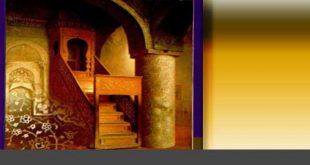الاجتهاد: يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية واعتمادها في كثيرٍ من الأحيان في أغلب الوقائع مع توفّر الشروط المطلوبة قضائياً وأخلاقياً في الحدود المسموح بها لاسيما إذا كانت دليلاً مصاحباً أو مكملاً لأدلة أخرى تصب في نفس المطلوب وتحقق المُدّعى على الراجح إلا فيما يخص دعوى لحوق النسب بالأب الذي لم يدّعِ ولم يقر ببنوة من يُراد إلحاق نسبه به حتى لو تطابق الحمض وكانت نفس البصمة موجودة في الأب وفي من يراد إلحاقه به في النسب. بقلم: رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين
ما مدى مشروعية العمل بفحص البصمة الوراثية في إثبات النسب المتنازع عليه التي يُعبر عنها بالحمض النووي DNA ؟
وهل يقدم استخدام فحص البصمة الوراثية على الأدلة الشرعية في إثبات النسب كونها تعطي نتائج متطابقة بنسبة عالية جداً لا تحتمل الشك؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين.
الجواب وبالله التوفيق: من المعلوم أنّ الشرع الشريف لا يقف عائقاً دون الوصول إلى الحقائق والاكتشافات التي تُسَجَّل وتُحَقَّق تباعاً نتيجة التطور والثورة العلمية الملحوظة في الأزمنة المتأخرة ولا يتناقض معها بل يحث عليها ويشجعها؛ لأنها تصب في خدمة الإنسانية وفي خدمة الشرع الشريف نفسه ما دامت وفق ضوابط الشرع وفي إطار القانون الذي لا يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية، وما ذُكِرَ في السؤال من التوصّل إلى ما يُسَمَّى بالشفرة الوراثية أو البصمة الوراثية أو الحمض النووي فهو قفزة نوعية في سبيل البحث عن القرائن والأدلة التي هي مطلب الشرع الشريف في استصدار الأحكام الشرعية، وقد ثبت أنّ الشارع الحكيم قد لفت إلى هذا الأمر بأكثر من مناسبة، وهو الأمر الذي لا يتنافى مع قضايا العقل الصحيح والفطرة السليمة، وهو أيضاً محل إجماع العقلاء،
فإنّ كثيراً من القضايا والأحكام الشرعية في الحوادث التي تكون بعيداً عن مرأى الحاكم وبعيداً عن المشاهدة لا يكون الحكم فيها إلّا من طريق القرائن ومنها القيافة، فقد ورد مثلاً في إعمال القرائن وتقرير العمل بها قوله تعالى في قصة امرأة العزيز مع نبي الله يوسف عليه السلام، ودعواها أنه أراد بها سوءاً: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِين، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِين ، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم}
وما يشير أيضاً إلى اعتماد الشرع على القيافة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة خولة بنت عاصم زوج هلال بن أمية ورميها بالفاحشة مع شريك بن سحمان من قبل زوجها هلال بن أمية وهي القصة التي ذكرها المفسرون سبباً لنزول آية اللعان في سورة النور بدءاً من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِين} إلى آخر آية اللعان،
فلاعن النبي بين هلال بن أمية وزوجه خولة بنت عاصم وفرّق بينهما وقال: «انظروا إنْ وضعت ما في بطنها على صفة كذا فالولد لزوجها وإنْ وضعته على صفة كذا وكذا فالولد لشريك بن سحمان، فلما وضعت ما في بطنها على الصفة التي رميت بها والوضع طبعاً لم يكن إلا بعد تسعة أشهر من وقوع الحادثة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» يعني الرجم
ومفهوم الكلام أنها لو كانت قد وضعته بالصفة التي رميت بها قبل إجراء اللعان بينها وبين زوجها لكان دليلاً معتمداً على ما رميت به، ولترتب على ذلك حد الزنا، لكن حدوث اللعان والأيمان حال دون ذلك واكتفى الشارع به في الوقت الذي لـمّح إلى جواز الأخذ بالقيافة والقرائن والأوصاف
وقد اعتمد المحققون وقتاً طويلاً حتى هذه الأيام على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وفسقهم وعدالتهم وكفرهم وإيمانهم على بصمة الأصابع لدى البحث عن الأدلة والقرائن في كثير من الجرائم والحوادث، وكان للبصمة الدور البارز في معرفة الجناة وكشف المجرمين، ومن هذه القرائن ما يسمى بالبصمة الوراثية، فإنْ ثبت حقاً أنها تعطي نتائج متطابقة بنسبة عالية جداً لا تحتمل الشك كما ذكر في السؤال فإنها تعد دليلاً قوياً لا يجوز مع التمكّن منه إهماله واطراحه، وإنْ كان معظم الأدلة لا تثمر إلّا الظن وقد يكون هذا منها إلّا أنّ الظن يؤخذ في كثيرٍ من الأحكام الشرعية ومنها شهادة الشهود فإنها أصلاً لا تثمر إلّا الظن كما هو معلوم، ومع ذلك أمر الشرع بالعمل بها ما دامت مكتملة الأركان، وهذا قصارى ما يمكن القضاء التوصّل إليه لإثبات الوقائع وترتب الأحكام الشرعية عليها.
ومع ذلك فإنه يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية واعتمادها في كثيرٍ من الأحيان في أغلب الوقائع مع توفّر الشروط المطلوبة قضائياً و أخلاقياً في الحدود المسموح بها لاسيما إذا كانت دليلاً مصاحباً أو مكملاً لأدلة أخرى تصب في نفس المطلوب وتحقق المُدّعى على الراجح إلا فيما يخص دعوى لحوق النسب بالأب الذي لم يدّعِ ولم يقر ببنوة من يُراد إلحاق نسبه به حتى لو تطابق الحمض وكانت نفس البصمة موجودة في الأب وفي من يراد إلحاقه به في النسب؛ لأن الشرع رتّب ثبوت النسب وصحّة الإلحاق به بثبوت الفراش، والمراد بثبوت الفراش هنا عقد النكاح الصحيح، أو الفاسد الذي أمكن فيه وطؤ الزوج لزوجته، أو كان الوطء منه لشبهة مع مضي أقل مدة الحمل فهذا هو المعيار، لصحة وجواز إثبات النسب وإلحاق الولد بأبيه، واشترط الشرع ذلك في إثبات النسب لإخراج ما ولد عن طريق الزنا وإن كانت المجتمعات الغربية والقوانين النافذة فيها تجوز إلحاق ولد الزنا بأبيه إلّا أن الشرع الشريف أبطل ذلك ونفاه ولم يعتد به،
وقال الشارع صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومعنى ذلك أن الولد ينسب إلى أبيه إذا كان الفراش الذي هو عقد النكاح صحيحاً أو فاسداً كما مر أو حاصلاً عن وطء شبهة حتى لا تختلط الأنساب وتضيع الأعراف والقيم ويَطّلع على عورات الناس من ليس منهم ويأكل تراثهم وأموالهم بالباطل، فلابد في إلحاق النسب من ثبوت الفراش أو الدعوة بأن يدّعي الرجل أنّ الولد ولده أو بالإقرار وإلا فلا، ولو كانت البصمة هي نفسها التي يحملها الأب لجواز أن يكون الولد المدعي للنسب حاصلاً عن زنا وعن طريق غير شرعية؛ هذا ما ترجح لديّ، والله تعالى أعلم..
المصدر: http://www.yemenscholars.com/694
 الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد موقع فقهي